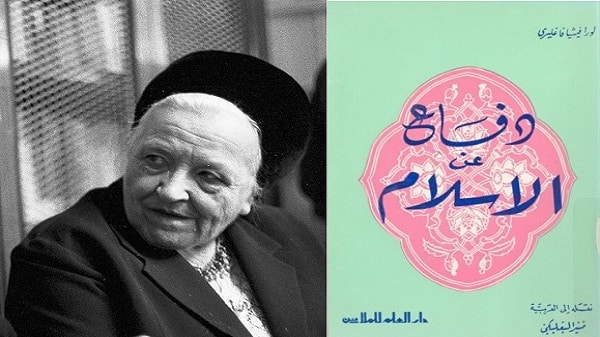الأرقام والإحصاءات المتداولة من الجهات الثقافية الراصدة لواقع القراءة في أمتنا لا تبشر بخير، بل إنها تشكل مزيدا من السدود العائقة دون نهر النهضة المرجو تمامه وإثماره بعد قرنيين من الصدح بها، والعمل من أجلها من مختلف الفاعلين.
من المقطوع به أن الأمم الفاعلة في التاريخ هي الأمم القارئة الممسكة بتلابيب المعرفة، حيث ارتبط التاريخ ارتبطا وثيقا بالكتابة، ويتوارد مؤرخو الحضارة على اعتبار الكتابة والتدوين فيصلا بين عصور ما قبل التاريخ، وما بعده، فما قبل الكتابة هو ما قبل التاريخ، وكان المهاد الأول لها بلاد ما بين الرافدين مع السومريين ورثتهم البابليين والأكاديين، وكانت باكورة الكتابة قبل حوالي خمسة آلاف سنة من الآن.
كان العرب في الجزيرة أمة أمية، والكتابة والقراءة فيها نادرة، ومن جمعهما مع الرمي والسباحة سمي بالكامل، وكانت مراكز الحضارة هي الحيرة، وبصرى، ودمشق، ومكة، وصنعاء، ولكن الغالب على العرب بدوا وحضرا هي الأمية لعسر التعليم، وقلة وسائله، وندرة أصحابه، وطبيعة العصر القديم.
ومع تنزّل القرآن الكريم بدأ الانقلاب الثقافي في حياة العرب، كيف لا؟ وأول آية فيه أمرت بالقراءة :﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾، وهذه القراءة تهدي إلى استحضار عظمة الخالق وتبصّر صنعته، بدء من دقائق العلقة إلى عجائب المجرة، وهي تقود حتما إلى القرب منه تبارك وتعالى، كما دلّ على ذلك ختام السورة ﴿واسجد واقترب﴾
وأما القراءة المقطوعة عن اسم الله تعالى فإنها تقود إلى الضلال والعماية كما كان شأن اليهود:﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ (البقرة، 87)، فهؤلاء القارئون المطبوعة قلوبهم على الغي والضلال شأنهم شأن البهائم العجماء:﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (الجمعة،5).
إن الانقلاب الثقافي الذي أحدثه الإسلام في بحر الجاهلية العربية كبير جدا، حيث صارت القراءة والكتابة شيئا معهودا، بل وعادة مستقرة مع الزمن، ومرجع ذلك الفرائض الدينية المستلزمة لحفظ ما تيسر من القرآن في الصلاة، مما لا ينوب به أحد عن أحد، على خلاف ما كانت عليه أوروبا في أيام سيطرة الكنيسة المحتكرة للعلم والمعرفة، حيث ظل القساوسة ينوبون عن المسحوقين من الفقراء والأقنان في أداء صلواتهم وقراءة التراتيل بدلا عنهم، وما على هؤلاء إلا دفع ما يتوجّب عليهم لغفران ذنوبهم، ثم انصرافهم إلى أعمال الحرث والزرع، ولم يكن يجرؤ على قراءة الكتاب المقدس المكتوب باللاتينية أو اليونانية إلا رجال الدين، حتى أن الكنيسة كفّرت “مارتن لوتر” وحرمته لأنه ترجم الإنجيل إلى الألمانية، وجعله ميسرا مقروءا للعامة.
تعاهد النبي ﷺمسألة القراءة والكتابة في حلق السابقين، ائتمارا بالأمر القرآني: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ (القيامة، 8)، فأمر المسلمين بالقراءة، وحفظ ما تيسّر مما تصح به الصلاة، وحضّهم على التسابق في التحصيل، لأن الرفعة العلمية تقتضي الرفعة الإيمانية: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ (المجادلة، 11) .
وقد وعى المسلمون مرامي القرآن من صناعة الأمة القارئة الكاتبة، وهم يقفون على أطول آية في القرآن وهي أية الدين، ويقال إنها من آخر ما نزل، وقد وردت فيها ألفاظ الكتابة والاستملاء اثني عشر مرة.
بل إن النبي ﷺ تحدى معارضيه من أهل الكتاب بالقراءة واستحضار زبر الأولين للاستدلال على نبوته وصدق دعواه، ونقرأ ذلك في آيات كثيرة منها: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (آل عمران، 93)، ومحاجته للمشركين بهذا التحدي: ﴿ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (الأحقاف، 4).
لقد ترجمت السنة النبوية الأمر بالقراءة إلى واقع عملي، فأعلت من شأن القلم والقراءة والقراء والعلماء والحفاظ، ومن السنة نقرأ حديث عبادة بت الصامت عنه عليه الصلاة والسلام: “إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة “(أبو داود، 4700)، ويكفي استذكار القسم العظيم بالقلم في سورة سميت باسمه، وهي الثانية نزولا على المشهور من الأقوال.
كما أعلى النبي ﷺ من شأن القراءة والكتابة، فجعل فداء بعض الأسرى في بدر تعليم شباب المسلمين، وكان هذا الفعل نواة للكتّاب، ومن هؤلاء الذين تعلموا من أسرى بدر زيد بن ثابت رضي الله عنه، والذي استكمل دراساته بتعلم اللسان السرياني والعبري في بضعة أيام لنباهته وذكائه، وفي الحديث عنه، قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أتعلم له كلمات من كتاب يهود قال: «إني والله ما آمن يهود على كتاب» قال: «فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له» قال: «فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم»( أبو داود، 3645 ) وفي حديث آخر قال: «أمرني رسول الله ﷺ أن أتعلم السريانية» (الترمذي، 2715).
وتجلى الأمر في إنشاء هيئة كتاب الوحي، الذين بلغوا أربعين كاتبا، وينضاف إليهم كتاب الرسائل والعهود، وكان هؤلاء نواة لنظام الدواوين الذي يقتضي عشرات الكتاب المهرة الذين تقوم عليهم أركان الدولة.
ولم يكن الأمر مقصورا على الرجال فقد دفع النبي ﷺ النساء إلى ذلك، ففي حديث الشفاء بنت عبد الله، قالت: دخل علي رسول الله ﷺ وأنا عند حفصة، فقال لي: «ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة» (البخاري، 3877)
ولتوطين الشعور بأهمية القراءة وحفظ العلم سنّ رسول الله القنوت عند نزول مصيبة بالعلم والعلماء، فعن أنس يقول: «ما رأيت رسول الله ﷺ وجد على سرية ما وجد على السبعين الذين أصيبوا يوم بئر معونة، كانوا يدعون القراء، فمكث شهرا يدعو على قتلتهم» (مسلم، 302)، وكان عليه الصلاة والسلام يقدم في الجنازة والدفن القراء على غيرهم، وإذا أخرج سرية أو بعثا أمّر عليهم أكثرهم أخذا للقرآن الكريم، وبرزت ظاهرة القراء منذ العهد النبوي، وكان هؤلاء هم حملة الوحي وحراس الشريعة، وبمقتل جمّاء منهم في معركة اليمامة ضد مرتدي بني حنيفة كان مشروع كتابة المصحف الشريف الأول.
واستمر الخلفاء على هذه السيرة في تقديم أولي العلم والقراءة على غيرهم، ففي وصف إدارة عمر بن الخطاب نقرأ: «وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا» (البخاري، 4642).
ظلت الحضارة الإسلامية حضارة القلم والكتاب، وتبارى المسلمون في صناعة الأمة القارئة طوال ألف سنة، فانتشرت الكتاتيب والجوامع والمدارس والمكتبات، وبرزت ظاهرة الرحلة في طلب العلم والكتب، وانتشرت حوانيت الوراقين والنساخين، التي كان يكتريها الذين قصرت أيديهم عن امتلاك الكتب، ولتجاوز ذلك أبدع المسلمون حكاما وأغنياء وعلماء في تأسيس المكتبات وترجمة الكتب، ويورد أصحاب الفهارس والطبقات أرقاما خيالية لأعداد الكتب في قرطبة والقاهرة وبخارى والري ونيسابور، وبغداد التي كان صبيانها يعرفون القراءة والحساب، في حين لم يكن لدى الملك شارلمان الفرنسي إلا كاتبان في بلاطه، ولم يكن لدى لويس العاشر إلا مائة كتاب يباهي بها ملوك أوروبا، في حين فإن أقل عالم مسلم يملك أضعافها.
ومما يمكن إيراده هنا ظاهرة التعليم الشعبي في مجالس سماع الحديث التي يحضرها الآلاف، حتى أنهم حزروا الحضور في بعضها فبلغوا ثلاثين ألفا بمحابرهم، والمستملون المسمّعون ثلاثمئة وستون، والشواهد كثيرة ذكر بعضها عبد الفتاح أبو غدة في كتابه الماتع” صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل”، وعلي العمران في منتخبه الجميل الموسوم ” المشوق إلى القراءة وطلب العلم”.
كيف العود إلى القراءة، والأرقام والإحصاءات فاضحة ومزعجة في عالمنا العربي، الذي بلغ متوسط القراءة فيه سبع دقائق، مقارنة بمائتي ساعة للآخر الغربي، حتى ذاعت العبارة” إن أمة اقرأ لا تقرأ”
لا حل لهذه السوءة إلا بالكرّ وإعلاء النكير ورفع العقيرة بالحض على تغيير الواقع التربوي في البيوت والبراح العام، وتجاوز معيقات القراءة من الانجرار في الماجريات، والعكوف على وسائل ووسائط التواصل الاجتماعي، والوقوع في أسر العادات الخاطئة، والركون إلى المقالات الحاطة من العلم والقراءة، وواجب الوقت يقضي إبداع برامج تربوية جادة للعود بطلابنا إلى مهيع الجد والاجتهاد، كيف لا والوسائل وفيرة من الكتاب الورقي والإلكتروني وغيره.
إن القلب لينفطر وهو يرى خلو مكتبات عامرة من طلابها ومرتاديها، ففي دوحة الخير خزائن علم مهمة في المكتبة الوطنية وجامعة قطر، ومكتبة مجمع الشيخ عبد الله الأنصاري، ومكتبة علي بن الحسين السادة في الرويس، فضلا عن مراكز الشباب وملحقات المدارس، والمكتبات التجارية، ومعارض الكتب، والكتب الواردة من السوق الإلكترونية، مما لا يدع حجة لأحد في هذا القصور والانكفاف عن معانقة القلم والكتاب.
إن صناعة الأمة القارئة من واجبات الوقت التي ينبغي أن يتظافر عليها الجميع، إذ هي القنطرة الرئيسة للعودة إلى ساحة الريادة والقيادة، ومن ينكص عن هذا أو يجادل فيه، فهو ممن يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وأولئك هم الأخسرون أعمالا.