تحتاج أمتنا إلى جهود ضخمة متواصلة في جميع الميادين، وعلى رأسها الميدان الفكري؛ حتى تستعيد مكانتها، ودورها المنوط بها، والذي مازال صداه يتردد على مسرح التاريخ..فما المقصود بـ”البناء الفكري”؟ وما مصادره؟ وما موقع الأمة الإسلامية اليوم من عالَم الأفكار؟ وماذا عن التحديات التي تعرقل “البناء الفكري”؟.. هذه الأسئلة وغيرها نتوقف معها مع المفكر الأردني الدكتور فتحي ملكاوي.
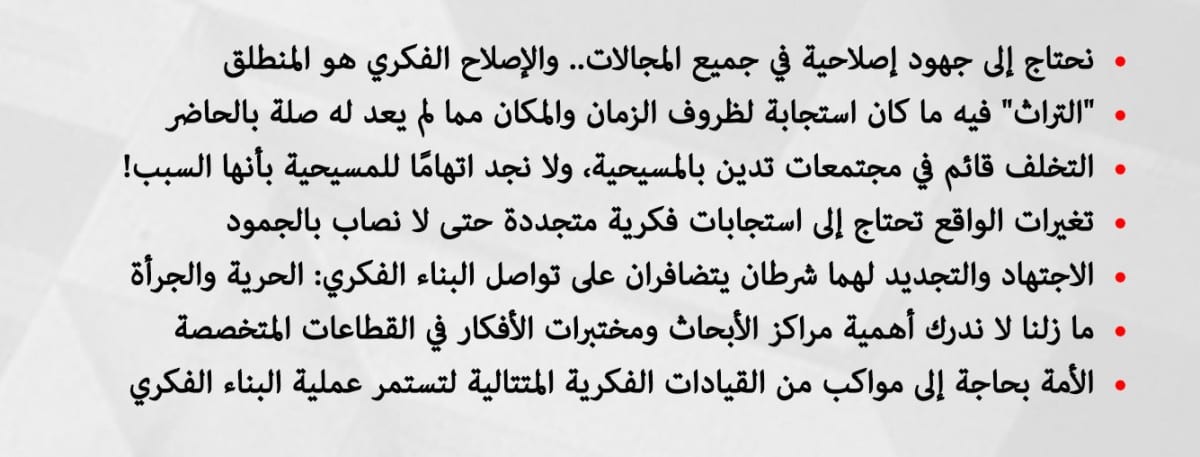
والدكتور ملكاوي تربوي وأستاذ جامعي، من مواليد عام 1943م، حاصل على الدكتوراه في التربية العلمية وفلسفة العلوم من جامعة ولاية ميتشغان الأمريكية، والماجستير في علم النفس التربوي، والبكالوريوس في الكيمياء والجيولوجيا. وهو أستاذ زائر في أكثر من 20 بلدًا في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا، ويعمل حاليًا مديرًا إقليميًا للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ورئيسًا لتحرير مجلة “إسلامية المعرفة”، وعضوًا في مجمع اللغة العربية الأردني. وقد ألَّف وشارك في تأليف 25 كتاباً في التعليم المدرسي والجامعي في موضوعات العلوم ومناهج البحث، ومن كتبه: (منهجية التكامل المعرفي: أساسيات في المنهجية الإسلامية)، (منظومة القيم العليا الحاكمة: التوحيد والتزكية والعمران)، (البناء الفكري: مفهومه ومستوياته وخرائطه)، (التراث التربوي الإسلامي).. فإلى الحوار:
لكم اهتمام بقضية “البناء الفكري”.. ماذا تقصدون بهذا المصطلح؟
البناءُ الفكري، عبارة من كلمتين: بناء، وفكر، وهما كلمتان مفتاحيتان في النشاط البشري، كلٌّ منهما مصدرٌ لفِعْلٍ، وكلٌّ منهما يشير إلى الفعل، وإلى نتيجة ذلك الفعل؛ فالفكرُ موضوعٌ يتم بناؤه، والبناءُ عملٌ موضوعه الفكر. والفكر لا يدخل إلى الإنسان جسماً كاملاً، ولا يأخذه الفرد ممن يعطيه إياه كتلةً كاملةً، لتنتقل ملكيتُه من الـمُعْطِي إلى الآخِذِ؛ إنما يَبْنِيه الإنسان بناءً، لبنةً بعد أخرى، ومستوى بعد آخر.
فالبناء الفكري “عمليةٌ” يمر بها الفرد أو الجماعة أو المجتمع من أجل امتلاك قدر معين من الفكر، ويرافقها تغير أو نمو في الحالة الفكرية. والبناء الفكري هو بِنْيةٌ أو “تكوين” من الآراء والمعتقدات والتوجّهات التي تمر بخاطر الإنسان، أو تنتج عن إعْمال عقله في الأمور، أو يأخذها من غيره بوسائل الإدراك المتعددة.
والبناء الفكري “حالةٌ” فكريةٌ يمكن أن تكون وصفًا للفرد أو الجماعة؛ إذ يمكن أن نجد جماعات أو حركات أو مدارس فكرية تتميز كلٌّ منها عن غيرها في مقدار ونوع ما تمتلكه من بنى فكرية. ويمكن أن تكون الحالة الفكرية وصفًا لحالة الأمة أو المجتمع في مرحلة من المراحل التي تمر بها الأمَّة أو المجتمع. ومن حيث المحتوى يتحدّد البناء الفكري لمجتمع معين بمجموعة الأفكار والآراء والمشاعر وأنماط السلوك المشتركة بين أفراد ذلك المجتمع، وتكون مختلفة عنها في مجتمع آخر، وبذلك يكون للمجتمع الآخر بناءٌ فكريٌّ آخر.
ما المستويات التي يمر عبرها “البناء الفكري”.. وكيف يكون ذلك؟
تمر عملية البناء الفكري في مستويات متعددة من التغير والنمو، ويتفاوت المستوى الفكري في مراحل متدرجة من البساطة والتركيب، كما يختلف البناء الفكري في نوعيته ضمن أوصاف متقابلة، بين حدَّي الوضوح الفكري والغبش الفكري، وحدَّي الاستقرار الفكري والقلق الفكري، وحدّي الوعي الفكري والفوضى الفكرية، وحَدَّي الإفلاس الفكري والغِنَى الفكري. وتتحدّد هذه المستويات بدرجة الوعي الفردي أو المجتمعي، وبمستوى التعليم النظامي وغير النظامي واللانظامي، وبنوعية التوجيه الإعلامي، وغير ذلك من المحددات والمؤثرات.
وقد يكون التفاوت في التدرج والتنوع تعبيرًا عن الفكر الذي تكتسبه شخصيات متنوعة من الناس، ويصبح هذا الفكر عَلَمًا على شخصية من الشخصيات المعروفة في الثقافة المعاصرة، كما هو الحال في تسميات: المفكر، والمثقف، والعالم، والداعية، والمصلح، والفيلسوف؛ حيث يكون لكل منهم بناؤه الفكري، موضوعًا ومستوى.
كيف نميز بين مفهوم الفكر ومحتوى الفكر؟
يتحدد مفهوم الفكر بعمل العقل البشري، وعملُ العقل هو النظر، والتفكير، والتفكُّر، والتدبُّر، والتذكُّر، والتبصُّر، والتأمُّل.. وتتّصف الأفكار الناتجة عن هذه العمليات بالصفة البشرية من الصحة والخطأ، والتمايز والاختلاط، والوضوح والضبابية، والمألوف والمبتكر، والمفيد والضار.
كما تتَّصف هذه الأفكار بما تحمله من محتوى، إذ يتحدد نوع المحتوى بالمجالات المعرفية المختلفة؛ فيكون الفكر سياسيًّا عندما يكون محتوى الفكر هو الموضوعات السياسية؛ مثل نظم الحكم، وأنواع السلطة والتعددية الحزبية، والعلاقات الدولية وأمثالها. ويكون الفكر اقتصاديًّا، عندما تتناول موضوعاته الأموال والممتلكات، ونوعية السوق، وقضايا الإنتاج، والتسويق وأمثال ذلك. وهكذا في سائر المجالات المعرفية.
ما الذي نعنيه في حديثنا عن “عالَـم الأفكار”؟ وما الذي يـميّزه عن العوالم الأخرى؟
لفظ عالَـم في اللغة جمع لا مفرد له من جنسه، ويعني دائمًا صنفًا محددًا من أصناف الأشياء أو القضايا أو الموضوعات؛ ففي المخلوقات المادية نقول عالم الحيوان، وعالم النبات، وعالم الإنسان؛ فالعوالم كثيرة، والله سبحانه ربُّ العالمين.
وفي موضوعات الحقول المعرفية وحقول النشاط البشري نقول: عالَـم السياسية، وعالَـم الاقتصاد، وعالَـم الفن.. ويكتسب الإنسان مستوى مرتفعًا من الأفكار في حقل من حقول التخصّص، كما يكتسب أفكارًا في مستويات مختلفة في حقول متعددة، ويكون لبعض الناس اهتمام بعالَـم الأفكار بحيث يهتم الواحد منهم بالجانب الفكري من السياسة والاقتصاد والفن والتاريخ.. فيمضي في هذا الجانب معظم فكره لنفسه وحديثه مع غيره واهتماماته في حياته.
ويظهر موقع عالم الأفكار، عندما نقارنه بعوالم أخرى، حينما تعيش فئةٌ من الناس في “عالم الأشياء”، فيمضي واحدهم معظم تفكيره وحديثه واهتمامه بأثاث المنزل ومقتنياته ومرافقه ونوع السيارة وتفاصيل الطعام واللباس وأمثال ذلك. ونجد نوعًا ثالثًا من الناس يكون اهتمام الواحد منهم بمن أتى ومن ذهب، ومن قال، ومن لم يقل، ومن اغتنى ومن افتقر، ومن له ومن ليس له، ومن يستحق ومن لا يستحق.. فيستغرق “عالَـمُ الأشخاص” معظمَ اهتماماته.
وثمة عوالم أخرى نجد بعض الأفراد يتميّزون باهتمامهم بها بقدر يفوق غيرهم؛ فإذا كانت عوالم الأفكار والأشياء والأشخاص هي عوالم في الحياة الدنيا، فإننا نجد فئة من الناس لا يفكرون بأمور الدنيا بقدر ما يفكرون بأمور الآخرة، فكأن تفكيرهم فيما يفعلونه في الدنيا يتركز على نتائج هذه الأفعال في الآخرة. ومن هذه العوالم “عالَـم القيم” الذي ينشغل به بعضُ الناس، فيكون هم الواحد منهم هو المعايير التي تحكم سلوك الناس، وتحدد ما يجوز وما لا يجوز، ما يحل وما يحرم، ما ينفع وما يضر.
ومن المهم أن نتذكر أنَّ التمايز بين الناس في مجال اهتماماتهم وانشغالاتهم في هذه العوالم لا يكون في واقع الحياة على سبيل القطع، والتحيز المطلق؛ فلكل فرد من الناس نصيبٌ من هذه العوالم، يزيد وينقص، وكأن هذه العوالم أماكن متحيزة، يدخلها الناس ويمضي كلٌّ منهم قدرًا من الوقت في كل منها، فمنهم من يدخل في كل هذه العوالم دخولاً عابرًا، ومنهم من يمضي بعضَ وقته في عالم وينتقل إلى عالم آخر، ومنهم من يمضي في عالم محدد من هذه العوالم معظم وقته ويمر سريعًا في عوالم أخرى.
وبهذا التمايز في مقدار اهتمام كل شخص بعالم محدد، يقال إنَّ شخصًا يعيش في عالم الأفكار، وآخر يعيش في عالم الأشياء، وثالثًا يعيش في عالم الأشخاص، وهكذا. وربما يفيد هذا التمييز بين العوالم، في تقويم الإنسان لنفسه من حيث قربه أو بعده عن عالم الأفكار؛ حيث يعلم أنَّ العمل بالفكر من أشرف الأعمال.
أين موقع الأمة الإسلامية اليوم من عالم الأفكار؟
من الطبيعي أن تكون نشأة أية أمة مرتبطة بظروف النشأة ونوعية المنشئين، لكن الأمة الإسلامية منذ بَدْء تشكلها في عهد النبوة سرعان ما بدأت تتجاوز ظروف النشأة، ويظهر ارتباطها الوثيق بما قامت عليه من معتقدات وأفكار، وبعد عقود قليلة من الزمن وجدنا الأمة تتكون من أجناس وأعراق ولغات وثقافات، تجتمع حول المعتقدات والأفكار المؤسِّسة، ووجدنا السلطة الفعلية فيها تنتقل من فئة عرقية إلى أخرى، ووجدنا عاصمتها تنتقل من مكان إلى آخر، ومن المؤكد أنَّ الأساس الفكري لبناء الأمة الإسلامية هو الذي حافظ على وجودها واستمرارها عبر القرون.
وقد مرَّت الأمة الإسلامية في تاريخها بمراحل ودورات من التقدم والتخلّف في الاجتهاد والتجديد الفكري. ولذلك وجدنا أنَّ جهود الإصلاح الفكري الإسلامي لم تتوقف عبر العصور. ومع ذلك فإنَّ هذا التاريخ لم يخل من حركات شابتها انحرافات فكرية، أشغلت الأمة واستنزفت جزءًا من طاقاتها الفكرية والعملية، لكنها لم تنحرف بالأمة في مجمل معتقداتها وأفكارها؛ فالمخزون الفكري في الوحي الإلهي والهدي النبوي كان دائمًا، ولا يزال، حاضرًا في حماية الأمة من إمكانية اجتماعها على ضلال.
والأمة الإسلامية اليوم تحتاج إلى جهود إصلاحية في جميع مجالات حياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكن الإصلاح الفكري سيبقى المنطلق للإصلاح في هذه الجوانب وغيرها؛ فالإصلاح السياسي يحتاج إلى فكر سياسي، والإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى فكر اقتصادي، وهكذا.
والإصلاح الفكري المقصود هنا يقتضي استيعاب الفرص والتحديات التي تواجهها الأمة اليوم، في ضوء ما أشرنا إليه من مصادر استمداد الفكر في الخبرة البشرية المعاصرة وتكييفها وتوظيفها، في ضوء المقاصد التي تهدي إليها المرجعية الحاكمة في الوحي الإلهي والهدي النبوي.
ما مصادر البناء الفكري الإسلامي؟ وهل ثمة مرجعية لهذه المصادر؟
يمكن قياس أمر مصادر البناء الفكري الإسلامي على مصادر الشريعة التي تحددت في علم أصول الفقه، وهي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والاجتهاد الذي يتمثّل بالقياس والإجماع. وهي الأدلة المتفق عليها في تقويم الأفكار، مع بعض الاختلافات في مفهوم القياس والإجماع. وثمة أدلة أخرى يلجأ إليها المجتهدون، فيعُدّها بعضُهم مصادر فرعية يُستأنس بها، ويراها آخرون مصادر مختلفًا فيها، وكل ذلك بشروط وضوابط يعرفها علماء الأصول، ومنها العُرف، والاستحسان، والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، وغيرها.
والذي نقوله هنا: إنه لا خلاف على أنَّ القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية مصدران للفكر الإسلامي الذي يتضمن ثلاثة أنواع من الفهم والفقه: فقه النص، وفقه الواقع الذي يراد للنص أن يتعامل معه، وفقه تنزيل النصّ على الواقع.
ولا شك أنَّ علماء الأمة عبر العصور مارسوا عملية تنزيل النصوص على الواقع، ودونت نتائج هذه العملية في مدونات العلوم المختلفة؛ من المذاهب الفقهية المختلفة، وجهود التفسير وشرح الحديث، وتدوين التاريخ وكلام الفرق، وخبرات القضاء، وتوجّهات التصوف والفلسفة، وعلوم الفلك والطب وغيرها من علوم المادة وتطبيقاتها العملية، وخبرات الإدارة المدنية والعسكرية، وغير ذلك مما عرفته الأمة من تراث غني كان اجتهادًا ناميًا ومتطورًا يتعامل مع ظروف الزمان والمكان والحال. وقد أصبح هذا التراث مصدرًا ثالثًا من المصادر التي تبني الأمة على أساسها أفكارها واجتهاداتها.
وثمة مصدرٌ رابعٌ يتصل غالبًا في شؤون الحياة المادية المدنية والإدارية، فكما أنَّ للأمة الإسلامية اجتهاداتها في هذه الشؤون، فالأمم الأخرى أيضًا لها اجتهاداتها، سواءً كانت هذه الاجتهادات من أفراد أو مؤسسات أو مجتمعات، ولم يخل واقع الأمة الإسلامية من تفاعل وتعامل واحتكاك مع الأمم الأخرى، ومن ثم لم يكن ثمة حرج في أن تأخذ الأمة الإسلامية من تجارب الأمم الأخرى ما تجد فيه من المنفعة والحكمة. ولذلك فإننا نعدُّ الخبرة البشرية المعاصرة مصدرًا من مصادر استمداد الفكر في كثير من شؤون الحياة وقضاياها.
وإذا كان التراث الإسلامي مصدرًا يلزم استصحابه والتمكن به والاستفادة منه، فإنه ليس مرجعيةً في حدِّ ذاته، ففيه الصواب وفيه الخطأ، وفيه ما كان استجابةً لظروف الزمان والمكان مما لم يعد له صلة بظروف الحاضر ومستجداته. وكذلك الأمر في الخبرة البشرية المعاصرة، ففيها ما يلزم الاطلاع عليه والتمكّن به والاستفادة منه، لكنه لا يملك صفة المرجعية الحاكمة. وسيكون الاعتماد على التراث الإسلامي والخبرة البشرية المعاصرة من قبيل الاجتهاد المعاصر، المحكوم أحيانًا بما هو قائمٌ من تحديات وما هو متاحٌ من فُرصٍ وإمكانات. ومع بقاء القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية مَصدرَيْن يملكان مرجعية حاكمة؛ فإنَّ كلاًّ من التراث الإسلامي والخبرة البشرية المعاصرة مصدران مهمّان وضروريان، لكنهما محكومان بمرجعية القرآن الكريم والسنة النبوية.
كيف نواجه الأفكار التي تزعم أنَّ الإسلام يُضاد العقل، وأنَّ التفكير من زاوية إسلامية يضع قيودًا على الفكر؟ وما علاقة هذا الزعم بالتاريخ الديني الغربي؟
من اللافت للنظر أنَّ الإسلام أطلق حرية التفكير بصورة لا يمكن أن نجدها في أي دين أو مذهب أو ثقافة أخرى. ونجد في القرآن الكريم مصداق ذلك في كل مجال من مجالات التفكير البشري، بما في ذلك إعمال العقل في قضايا الألوهية والنبوّة والمعاد، وفي قضايا السياسة والحكم والعلاقات الدولية، ومسائل الاقتصاد والإدارة وشؤون المجتمع والأسرة، ونجد الحضَّ على إعمال العقل بسائر وسائل الإدراك من نظر وتبصُّر وتفكّر وتدبُّر وتذكُّر واعتبار، وأساليب التأمّل الفردي والحوار الثنائي، والمؤتمر الذي يجمع ذوي العلاقة بالموضوع، والحوار والمناظرة والمحاججة، ونجد الإيحاء الضمني والتوجيه المباشر بالقصة والاعتبار بالماضي والتخطيط للمستقبل، ونجد الصبر على النَّصَب والمشقة في طلب العلم. وفي كلِّ ذلك دعوةٌ لإعمال العقل، وبناء الفكر، وتنمية المعرفة، والاستزادة من العلم في سائر الميادين.
وإذا كانت الأمة قد قصرت فيما سبق أو تقصر اليوم في الارتفاع إلى مستوى ما يدعو إليه القرآن الكريم في مراتب التفكير وما ينتجه من تنمية وتقدم وترقٍّ في سلّم المدنية والحضارة، فما ذلك إلا الخلل الذي لا بدّ من معالجته، وهو مشكلةٌ في المسلمين لا في الإسلام.
صحيح أنَّ العالم اليوم لا يقتنع بما يمكن أن نذكره من نصوص الإسلام دفاعًا عنه وردًّا لما يتهمونه به، لأن أدلتهم فيما يزعمونه عن الإسلام هو واقع المسلمين المتخلّف الذي يكفيهم شاهدًا على ذلك.. لكننا نجد التخلّف قائمًا في مجتمعات أخرى تدين بالمسيحية، ولا نجد اتهامًا للمسيحية بأنها سبب التخلّف في هذه المجتمعات.
والمهم في هذه المسألة هو الإسراع في النهوض بواقع الأمة الإسلامية لتكون في المستوى الذي يريده الإسلام لها، فذلك لن يكون ردًّا مقنعًا للتهم التي توجه إلى الإسلام وحسب، وإنما سيكون بابًا من أبواب الفتح الذي نرى فيه الناس يدخلون في دين الله أفواجًا.
ونحن نرى أنَّ مزاعم تفسير التخلف بالإسلام ناتجة عن ثلاثة عوامل: العامل الأول هو عاملٌ قائمٌ في الحاضر يشير إلى حالة التخلّف التي تتصف بها مجتمعات المسلمين اليوم. والعامل الثاني عاملٌ تاريخيٌّ يعود إلى تاريخ الغرب وعلاقته بالمسيحية، فقد كانت المسيحية المتحالفة مع الملوك وقوى الإقطاع سببًا في الحجر على التفكير ومحاربة التقدم العلمي كما يشهد بذلك التاريخ الغربي بكل وضوح وصراحة، وكانت حركات التمرد على الكنسية والإصلاح الديني منطلقًا للنهضة والتنوير الأوروبي، ومن ثم جاء الحكم على الدين كله وعلى الإسلام خصوصًا، من قبيل ما كان الحكم على المسيحية.
والعامل الثالث يختص بالمستقبل، الذي يثير الخوف مما سوف تنتهي إليه حالة المسلمين يوم يلتزمون بأحكام الإسلام وتوجيهاته، ويندفعون بقوته الكامنة نحو التفوّق والخيرية، وهو الخوف الذي يثيره العلماء والخبراء الذين يعرفون حقيقة القوة الحضارية الكامنة في الإسلامي، ويعتقدون أنَّ هذه القوة لا بد أن تفعل فعلها ولو بعد حين.
إذن، ما أهم القضايا والموضوعات التي يتأسس عليها “البناء الفكري” في حياة الأمة المعاصرة؟
هذا السؤال يحيلنا إلى ضرورة بناء رؤية كلية لمجموعة من خرائط البناء الفكري التي تجمع مصادر هذا البناء، وموضوعاته، ووسائله، وطرق قياسه وتقويمه، وخرائط أخرى مثل خريطة تاريخ الأفكار، وجغرافيا الأفكار وغيرها.
فخريطة موضوعات البناء الفكري على سبيل المثال تبدأ بموضوعات التأسيس لبناء الفكر لدى كل فرد في الأمة، ونسميها مواد بناء الأمة، وهي اللغة والدين والتاريخ، ثم تأتي مستويات مختلفة من الفكر الذي يوضح حالة الأمة وموقفها من القضايا المثارة اليوم والمتجددة حول مسائل الحياة المعاصرة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتختصُّ بموقع الأمة في العالم ورؤيتها لنفسها وللآخر، ويشتد فيها الجدل حول الهوية والانتماء والتنمية والنوع البشري والعولمة والوطنية وغيرها.
أما النخب التي تحاول أن تبذل جهودًا مباشرة في إصلاح واقع الأمة فإنَّ عليها أن تهتم بموضوعات أخرى تعبر عن الرؤية الفكرية للإصلاح، ولا سيما مداخل العلوم الاجتماعية ونظرياتها، ومداخل التغيير وسُبله وآفاقه، وتجارب النهوض الحضاري وما تقوم عليه من فكر إصلاحي نهضوي.
فمسألة البناء الفكري تجمع متطلبات الوعي العام على مستوى أفراد الأمة وفئاتها، حيث يلزم هذه الأمة أن تسعى لبناء هذا الوعي عن طرق التعليم المنهجي والإعلام الموجه، وهي كذلك مسألة وعي خاصّ يستوعب مسائل متعددة، من قبيل استشراف المستقبل، والتخطيط المبرمج، والتدريب المتخصص، والاختيار المحكم للطاقات البشرية، القادرة على القيادة والريادة في وجوه الإصلاح.
وماذا عن التحديات التي تعرقل “البناء الفكري”، خاصة على مستوى الأمة؟
إذا كان البناء الفكري صفةً للهوية التي يمتلكها الفرد، وينتمي بها إلى أمته، فإنَّ عدم الوعي بخصائص الهوية والانتماء سيكون عائقًا عن الحرص على البناء الفكري الخاص بالأمة. وقد يكون عدم الوعي خاصًّا بالفرد، فتقف المشكلة عنده، وقد تكون صفةً للواقع المجتمعي؛ حيث تفتقد برامج التربية والتنشئة الأسرية، وبرامج التعليم العام، ومؤسسات المجتمع، والتشريعات والقوانين- العملَ بصورة متناغمة، فتتناقض مصادر البناء الفكري ويقع المجتمع في الفوضى الفكرية. وتحصل مثل هذه الحالة في مراحل التحول الاجتماعي التي لا تخضع لوحدة الاتجاه من جهة، أو يكون اتجاه التحوّل قسريًّا وعلى غير وفاق مع الخلفيات الفكرية والثقافية للمجتمع من جهة أخرى.
ومن الطبيعي أنَّ الحالة الفكرية للمجتمع لا تبقى ثابتة مع مرور الزمن عبر الأجيال، فالأحداث والتغيرات التي تحدث في الواقع تحتاج إلى استجابات فكرية متجددة، وعندما تعجز الحالة الفكرية عن التطور للاستجابة للظروف المتجددة والتغيرات المستمرة، فربما يقع المجتمع في حالة من الجمود الفكري الذي يعيق تواصل البناء الفكري. ومن المشهود في حياة الشعوب والأمم أن يظهر فيها مفكرون متميزون يكون لديهم من عبقرية البناء الفكري ما لا يتكرر إلا في عقود أو قرون من الزمن، ويكون تأثير مثل هذا المفكر من العمق بحيث تنشأ على أفكاره مدرسة فكرية قد يمتد تبنِّيها إلى قطاعات واسعة من الأمة. وبعد ذهاب المفكر البَنَّاء تتجمّد أفكار أتباعه عند مستوى معين، ولا يتواصل التجدّد في البناء. وربما يعيق هذا التجمّد ما يلزم من الانفتاح على مصادر أخرى للفكر، ربما تكشف من مشكلات في البناء الفكري، أو عدم قدرته على التعامل مع القضايا المستجدة التي لم يواجهها ذلك المفكر. فالجمود الفكري والعجز عن الوعي بأهمية التجديد الفكري ربما يعرقل استمرار عملية البناء الفكري.
وحتى تستمر عملية البناء الفكري وتتواصل عبر الأجيال فإنَّ الأمةَ بحاجة إلى أن تُنجب مواكب من القيادات الفكرية المتتالية. وأية مرحلة زمنية لا تظهر فيها مثل هذه القيادات الفكرية التي تجدّد للأمة فكرها وفهمها لموروثها الديني والثقافي، ربما تكون مرحلة انقطاع في تواصل عملية البناء الفكري. ومن المؤكد أنَّ الاجتهاد والتجديد يتطلب شرطين يتضافران على تواصل البناء الفكري؛ حرية: تتيحها ظروف المجتمع ليتمتع بها المفكرون المجددون، ويجدون حوافز للاجتهاد والتجديد الفكري.. وجرأة: عند هؤلاء المفكرين المجددين في تحدي الجمود الفكري أو الفوضى الفكرية، أو القهر الفكري، وربما يضطرهم إلى تحمل أثقال من المعاناة الجسدية والنفسية في هذا التحدي.
ومن المؤكد أنَّ وجود المؤسسات الفكرية، التي توفر مساحةً من الحرية الفكرية وظروفًا من العناية والرعاية التي تحفّز على الإبداع الفكري، يساعد في عملية البناء. وفي المقابل، فإنَّ غياب هذه المؤسسات أو عدم قدرتها على توفير الحرية المطلوبة والظروف المناسبة، سيكون معيقًا لعملية التواصل في البناء الفكري. ومع تقديرنا لأهمية وجود هذه المؤسسات الفكرية فإنَّ ذلك لا يجعلنا نغفل عن حقيقة أنَّ الإبداع الفردي هو الأساس في القيادة الفكرية؛ فرأس المال البشري أصبح هو رأس المال الفكري في المؤسسات والمجتمعات.
وقيمة الأفكار لا تظهر إذا بقيت حبيسةً عند صاحبها، بل تظهر هذه القيمة عندما تنتشر وتشيع، وتصبح عنصرًا مهمًّا في الثقافة العامة للمجتمع، أو رأيًا عامًّا في السياسة، أو ممارسةً معينة في الاستهلاك.. فانتقال الأفكار من الفرد المنشئ إلى المجتمع المتلقّي، وفي حركة هذه الأفكار في اتجاه الفعل والتأثير، هو الذي يعبر عن قيمة الفكر وفاعليته. وتشيع الأفكار عادة عن طرق متعددة، منها التنشئة الأسرية والاجتماعية، والتعليم والاتصال والدعاية، لكن منها أساليب قهرية تتم على نطاق ضيق أو واسع، عرفتها بعض المجتمعات في بعض مراحل حياتها، مثل عمليات غسيل الأدمغة، وبرمجة العقول والغزو الفكري. وهي أساليب من البناء الفكري في اتجاه معين وأساليب من القمع الفكري والإعاقة الفكرية في اتجاه آخر.
وننوِّه أخيرًا بأن الخلل في تحديد الضوابط التي توضع لقبول الأفكار ورفضها ربما يكون عائقًا دون تواصل النمو البناء الفكري. ولا سيما عندما ترتبط هذه الضوابط بعدم الخروج على أعراف أو مقولات لا تملك ما يعطيها المرجعية في الحكم والقبول والرفض. فاعتماد مؤسسة معينة أو شخص معين ليشكل هذه المرجعية، قد تعني حرمان بعض الناس من قيمة الأفكار التي تأتي عن غير طريق هذه المؤسسة أو هذا الشخص. وقد يكون العكس تمامًا، فقد يرفض بعض الناس الأفكار القيمة لأنها جاءت من تلك المؤسسة أو ذلك الشخص.
ولا ننكر في نهاية المطاف أنَّ مسألة الحرية الفكرية يتداخل فيها الكثير من التفاصيل والآراء التي تعبر عن مذاهب في الفكر، والضابط الأكبر هو تحقيق المصالح العامة للشريعة في حق الفرد وحق الأمة وحق الإنسانية، ومع ذلك فإنَّ فهم هذا الضابط وتنزيله على الوقائع يبقى مثار جدل بين مذاهب الفكر، وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً.
كيف ترون حالة مراكز الأبحاث ومختبرات الأفكار في العالم العربي والإسلامي؛ وما علاقة هذه الحالة بجهود النهوض والتقدم؟
تميّزت المجتمعات المعاصرة بنشأة مؤسسات للبحوث والدارسات، تتخصص في إنتاج الأفكار وتطويرها وصياغتها، وأحيانًا تطبيقها على عينات تجريبية. وتحمل هذه المؤسسات أسماء مختلفة منها مركز، أو معهد، أو جمعية، أو منتدى، أو مخبر.. ومن الواضح أنَّ هذه المؤسسات تنتج الأفكار لتتمكن الجهات المستهدفة من الاستعانة بها في اتخاذ القرارات المناسبة. وحتى تتمكن هذه المؤسسات من القيام بالمهمات المنوطة بها، توفِّر لها الجهات المستهدفة الدعم المالي، والحرية في تنظيم النشاطات اللازمة من اجتماعات ومؤتمرات ومنشورات، التي يشترك فيها باحثون وخبراء ومختصون بموضوع البحث، من داخل المؤسسة وخارجها، ومن داخل الدولة وخارجها كذلك. ولهذه المؤسسات أولويات بحثية تختص بحل المشكلات القائمة أو المتوقعة، ورسم مسارات المستقبل وفق ما هو محتمل، أو ممكن، أو ما يجب أن يكون!
ومن الجدير بالذكر أنَّ بعضَ المراكز البحثية الأجنبية أخذت تُقيمُ فروعًا في البلاد العربية والإسلامية بصورة تدعو إلى القلق، وقد أصبح واضحًا أنَّ معظمَ مراكز البحوث الدولية لا تكشف عن طبيعة عملها ولا أهدافها، وأنها تمارس التلاعب بالرأي العام والإعلام، وتقدم التوصيات للسياسيين والقيادات الحزبية وأرباب المال والاقتصاد لتدعم توجهات سياسية أو فكرية أو تجارية متنافسة على حساب المصالح الحقيقية للعامة.
ولا تزال معظم المجتمعات العربية والإسلامية للأسف الشديد لا تدرك أهمية هذه المراكز البحثية الوطنية في القطاعات المتخصصة، ولا كيفية الاستفادة من وجودها لتوفير القاعدة المعرفية لصناعة القرارات واتخاذ المواقف في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. ونجد فقرًا ملموسًا في عدد مراكز البحوث المتخصصة، ونوعيتها ومستوى إنتاجها وأثره في الحياة العامة. وتفتقر مجتمعاتنا إلى النظام المؤسسي الذي تتواصل فيه الخبرات، فلا تنقطع بتغير الأشخاص المسؤولين؛ فكلما جاء مسؤول بدأ عمله من جديد، وبدأ يتخذ القرارات والمواقف بصورة يغلب عليها البعد الشخصي، ولا يأخذ بالحسبان قواعد البيانات التي توفرها مراكز البحوث. وغالبًا ما تعتمد على نتائج مراكز بحثية أجنبية، وخبرات مستشارين أجانب.
وليس من السهل أن نتخيّلَ نجاحًا في جهود النهوض والتقدم دون بيانات حقيقية وتحليلات موضوعية للواقع القائم، ورصدًا لاتجاهات التغيير والعوامل المؤثرة فيها، ومن ثم استشراف المستقبل وتوفير متطلبات صناعته أو التعامل الرشيد مع احتمالاته. وليس من السهل أن تتوافر هذه البيانات والتحليلات دون مراكز بحثية تُوفَّر لها الحرية الكافية للبحث والدراسة، وتوضع تحت تصرفها الإمكانات اللازمة للوصول إلى ما يمكن الوصول إليه من نتائج، ثم تعتمد هذه النتائج في اتخاذ القرارات المناسبة.
تنزيل PDF

















