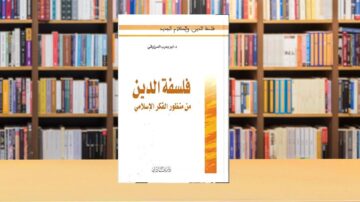يستهلّ الدكتور أبو يعرب المرزوقي كتابه فلسفة الدين من منظور الفكر الإسلامي بتشخيص أزمة الحضارة الإسلامية المعاصرة، مبيّنًا أنها أزمة شاملة تمسّ كل أبعاد الوجود الإنساني، ولا تقتصر على جانب واحد. ويرى المؤلف أن مفتاح فهم هذه الأزمة ومعالجتها يكمن في المقوم الإنساني الجوهري المتمثّل في فلسفة الدين؛ فهذا البعد الفكري هو الأصل الذي تتفرّع عنه سائر أوجه الحياة الحضارية من قيم ومعارف ومؤسسات.
يقسم الفيلسوف المرزوقي كتابه إلى قسمين رئيسيين:
- القسم الأول يعالج أسئلة فلسفة الدين وموقعها في الفكر الإسلامي.
- القسم الثاني يتناول قضايا التأويل (الفهم التفسيري للنصوص الدينية) ونظرية المعرفة من وجهة نظر إسلامية.
يقدّم الكتاب طرحًا فكريًا يجمع بين التحليل الفلسفي الدقيق والمنظور الإسلامي المميز، دون انحياز أيديولوجي أو نزعة انغلاقية؛ إذ يسعى الكاتب إلى بناء تصور موضوعي لفلسفة الدين ينهل من التراث الإسلامي وينفتح على منجزات الفلسفة الحديثة، مؤكّدًا التقاء غايات الدين والفلسفة في البحث عن الحقيقة ذاتها، وفيما يلي عرض لأبرز أفكار الكتاب.
ماهية فلسفة الدين وتميّزها عن الدين الفلسفي والفلسفة الدينية
يحدد المرزوقي مفهوم فلسفة الدين ويميزه عن مفاهيم قريبة منه؛ ففلسفة الدين هي فرع من الفلسفة يبحث في الظاهرة الدينية ككل، ويهدف إلى فهمها بعقلية نقدية موضوعية، دون الاقتصار على دين بعينه. أما “الدين الفلسفي” فهو الرؤية الشخصية للفيلسوف عن الإله والوجود، وهو بذلك موضوع لفلسفة الدين لا بديل عنها. في حين أن “الفلسفة الدينية” تعبّر عن النسق العقائدي والفكري الخاص بكل دين موروث كالفلسفة الإسلامية أو المسيحية.
يخلص المؤلف إلى أن ضبط هذه المفاهيم شرط أساسي لوضع منهج علمي لدراسة الظاهرة الدينية بعيدًا عن التحيزات.
تطور فلسفة الدين تاريخيًا وموقعها في الفكر الإسلامي
يعرض المرزوقي نشأة فلسفة الدين وتطورها، موضحا أن مباحثها وُجدت منذ فلاسفة اليونان وتعمّقت مع فلاسفة الإسلام؛ لكنها لم تُعرف تحت مسمى “فلسفة الدين” بل كانت ضمن الميتافيزيقا والكلام.
أن ظهور فلسفة الدين كفرع مستقل لم يتم إلا في الفكر الغربي الحديث منذ القرن الثامن عشر.
أن الفكر الإسلامي الحديث تأخر في هذا المجال بسبب انحساره في الجدل الدفاعي بين الفلاسفة والمتكلمين.
من هنا يدعو المرزوقي إلى إعادة توظيف أدوات فلسفة الدين المعاصرة من منظور إسلامي لتجديد الفكر الإسلامي وإخراجه من القوالب القديمة.
الأزمة الحضارية والحاجة إلى فلسفة دين إسلامية المنظور
ينتقد المؤلف الاقتصار على المعالجات الجزئية (فقهية أو كلامية أو دعوية) في مواجهة أزمة الفكر الإسلامي، مؤكّدًا أن التجديد الحضاري لا يتم إلا بمعالجة الجذور الفلسفية لفهم الدين. فالدين، بما يحمله من قيم ومعايير كبرى، هو الذي يحدّد نظرة المجتمع إلى الأخلاق والسياسة والجمال والعلم.
لذلك يرى المرزوقي أن تجاوز الأزمة الحضارية يقتضي تبني مقاربة فلسفية جديدة للدين، تقوم على الجمع بين الكونية والخصوصية الإسلامية، وتطرح بعمق قضايا العصر مثل: العلمانية، العولمة، الأخلاق الكونية، والبيئة.
الفطرة ووحدة القيم المتعالية في الرؤية الإسلامية
يركّز المرزوقي على مركزية مفهوم الفطرة الذي يجعل الإيمان بالتوحيد والميل إلى القيم العليا (الحق، الخير، الجمال، العدل) جزءًا من جبلّة الإنسان. يؤكد أن هذه القيم مشتركة بين البشر جميعًا، وأن تنوّع الشرائع إنما يعود إلى اختلاف في وسائل التنزيل التاريخي لا في الغايات المتعالية.
ومن هنا تتميّز المقاربة الإسلامية بأنها:
- كونية الطابع، تخاطب الإنسان بما هو إنسان.
- توحيدية، تلتقي فيها مقاصد الدين والفلسفة في البحث عن الحقيقة.
التأويل الفلسفي للنص الديني
ينبه الفيلسوف المرزوقي إلى غياب المنهج التأويلي الفلسفي في التراث الإسلامي الكلاسيكي، حيث طغى الاهتمام بالظاهر واللغة. لذلك يدعو إلى تأصيل منهج تأويلي يقوم على:
- الموازنة بين النص والعقل.
- مراعاة مقاصد الشريعة وسياق النص.
- الاستناد إلى البنية الكلية للقرآن.
- الإفادة من معطيات العلوم الإنسانية الحديثة دون المساس بقدسية النص.
- ويرى أن هذا التأويل الفلسفي يمكن أن يشكّل أساسًا لتجديد علم الكلام في إطار معاصر.
نظرية المعرفة بين الوحي والعقل
يناقش المرزوقي العلاقة بين العقل والوحي في تحصيل المعرفة، فالعقل أداة ضرورية لفهم العالم، والوحي مصدر مكمّل يوجّه العقل لما قد يقصر عنه، وبذلك يطرح نموذجًا معرفيًا إسلاميًا يقوم على تكامل العقل والنقل، بخلاف الاتجاهات الغربية التي حصرت المعرفة في العقل أو الحس. كما يدعو إلى إبستمولوجيا معاصرة تستند إلى القرآن من جهة، وتنفتح نقديًا على منجزات الفكر الحديث من جهة أخرى، لتقديم رؤية شمولية تواجه المادية والإلحاد المعاصرين.
الخاتمة
يؤكد الفيلسوف المرزوقي على أن فلسفة الدين بمنظورها الإسلامي ليست تنظيرًا محضًا، بل مشروعًا حضاريًا تجديديًا. فهي الكفيلة بإعادة الحيوية للفكر الإسلامي عبر الجمع بين الوحي والعقل، التراث والمعاصرة. ويخلص إلى أن الدين والفلسفة في التصور الإسلامي ليسا خصمين، بل شريكين في السعي نحو الحقيقة، وأن استعادة هذا التلاقي هي المفتاح لنهوض الأمة من أزمتها.