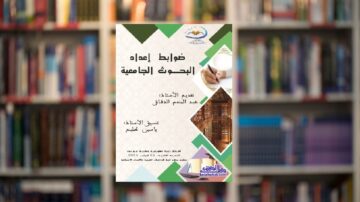في زمن تتزايد فيه الحاجة إلى جودة البحث العلمي، يبرز كتاب “ضوابط إعداد البحوث الجامعية ” كمرجع علمي محكّم يعالج أهم الإشكالات المنهجية التي تواجه الطلبة والباحثين المبتدئين.
الاهتمام المتزايد بالبحث الأكاديمي وجودته جعل من هذا المؤلَّف الجماعي خطوة نوعية، حيث شارك فيه نخبة من الأساتذة والباحثين في إطار دورة تكوينية وطنية، وهو ما أضفى عليه بعدًا عمليًا وتطبيقيًا يُميز محتواه عن الأدبيات النظرية التقليدية. تمحورت فصوله حول معايير اختيار الموضوعات، وضبط المنهجيات، وتصحيح الأخطاء الأكاديمية، مما يجعله أداة فاعلة لصقل المهارات البحثية لدى الطلبة.
هذا الكتاب دعوة حقيقية للنهوض بالبحث الجامعي العربي، من خلال بناء ثقافة علمية قائمة على الفهم، والدقة، والالتزام بالمعايير الدولية في البحث الأكاديمي.
مقدمة تعريفية بكتاب (ضوابط إعداد البحوث الجامعية )
يعتبر كتاب (ضوابط إعداد البحوث الجامعية: أشغال دورة تكوينية وطنية) ثمرة دورة تكوينية شارك في إعداده وتأليفه مجموعة من الأساتذة والباحثين، من أبرزهم الدكتور بلخير سرحاني ، الدكتور مريم نبيه ، والدكتورة هجر شفيق بالإضافة إلى باحثين آخرين، ومن تقديم الأستاذ عبدالمنعم الدقاق، وصدر الكتاب عن مركز أثيل للدراسات العلمية والأبحاث الاجتماعية بالمغرب سنة 2023م (1444هـ).
وتبرز المقدمة أن الهدف الرئيس للكتاب هو مساعدة الطالب والباحث المبتدئ على فهم أسس اختيار موضوع البحث وتحديد المنهجية الملائمة له، والتعرف على أخطاء شائعة في البحوث الأكاديمية وطرق تفاديها. وقد أشار المحررون إلى عنوان الكتاب “ضوابط إعداد البحوث الجامعية” باعتباره إسهامًا في سد فراغ على مستوى الأدبيات المنهجية الموجّهة للباحثين الشباب. وبشكل عام، تُهيئ المقدمة القارئ لمضمون الفصول التالية وترسم الخطوط العريضة لموضوعات الكتاب.
نشأة الاستقصاء الأكاديمي
يؤسس الدكتور بلخير سرحاني للقاعدة التي يُبنى عليها صرح البحث بأكمله وهو الاختيار الموفق للموضوع. ويؤكد الدكتور سرحاني أن اختيار موضوع البحث هو حجر الزاوية الذي يقع عند تقاطع شغف الباحث وحاجة المجتمع وقدرة الباحث على الإنجاز. ويقسم مصادر استلهام الموضوع إلى محورين:
وأكد سرحاني على أن الأعمال الأكاديمية الأكثر تأثيرًا تنبع من مصدر شخصي عميق. فـ “الاهتمام الخاص” ليس مجرد ميل، بل هو وقود المثابرة الذي يضمن الصمود الفكري أمام تحديات البحث. وبالمثل، فإن “الخبرة العملية”، كما يتضح من أطروحة سرحاني نفسه المستلهمة من عمله في التعليم، تحوّل المشكلات الواقعية الملموسة إلى إشكاليات بحثية ذات قيمة تطبيقية مباشرة.
وشدد سرحاني في ورقته على أن الشغف وحده لا يكفي الباحث فعليه أن يشتبك بوعي مع محيطه عبر “الاطلاع الواسع” لكشف الفجوات المعرفية، والتفاعل مع “الأحداث الكبرى” كمحفزات لبحوث مؤثرة، واللجوء إلى “استشارة أهل العلم” كخطوة حاسمة لصقل الفكرة وتجنب المزالق الشائعة.
ووفقًا لسرحاني فإن الموضوع الأمثل يقع في نقطة التقاطع الذهبية بين ما يرغب الباحث في استكشافهِ، وما يحتاج العالم إلى فهمه، وما يمكن إنجازهُ فعليًا ثم إخضاع الموضوع لـ “بوتقة الجدوى”، وهي عملية تقييم صارمة تضمن الأمانة العلمية، والقيمة العلمية (بأن يقدم إضافة حقيقية)، وتوفر المادة العلمية، ومراعاة القدرة الاقتصادية والتناسب مع المدة الزمنية المخصصة للإنجاز.
هندسة البحث والأطر المنهجية للتعليم العالي
قدم الدكتور كريم نبيه تحليلًا للفروق بين مستويات البحث الأكاديمي متخذًا من الدراسات القانونية نموذجًا، وأوضح نبيه أن الرحلة الأكاديمية هي انتقال الباحث من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها.
وميز نبيه البحث العلمي بحسب المستويات العلمية :
- بحث الإجازة (البكالوريوس): هو أداة بيداغوجية لـ”تدريب الطالب”. يتراوح حجمه بين 70 و120 صفحة، وقيمته كمرجع علمي محدودة لأنه لا يُناقش غالبًا.
- رسالة الماجستير: تمثل نقلة نوعية، حيث يُتوقع من الباحث تحليل أعمق. حجمها بين 150 و250 صفحة وتُعتبر مكملة للدراسات النظرية وتخضع لمناقشة رسمية.
- أطروحة الدكتوراه: هي ذروة المسار الأكاديمي، ويُعرَّف البحث فيها بقدرته على إنتاج “معلومات جديدة” وأن يكون “قابلاً للنشر”، بهدف تقديم “مساهمة أصلية في المعرفة”. حجمها يتجاوز 250-350 صفحة وتخضع لنقاش دقيق أمام لجنة رفيعة المستوى.
كما أكد نبيه على أهمية وضع خطة بحثية (تصميم) محكمة تبدأ بتحديد الإشكالية، ثم عرض تصميم منطقي (غالبًا من قسمين رئيسيين)، وتنتهي بتحرير الموضوع بلغة علمية دقيقة.
إتقان صياغة إشكالية البحث
ركز الأستاذ عبد الكريم البزور في ورقته (مهارات بناء الإشكالية في أطروحة العلوم الشرعية والإنسانية) على أن الإشكالية هي “الفعل الفكري المركزي” الذي يمنح البحث هويته وغايته، ومن غير إشكالية حقيقية يتحول البحث من عملية خلق للمعرفة إلى مجرد تجميع للمعلومات، وحذر البزور من أن غيابها قد يحوّل مجالًا علميًا “من العلمية إلى الظنية”.
وقدم البزور مراحل منهجية لبناء الإشكالية:
- مرحلة الإحساس بالمشكلة: تبدأ بشعور الباحث بوجود موضوع جدير بالدراسة، وهو ما يتطور إلى “قلق علمي”.
- مرحلة الإحصاء والاستطلاع: جمع البيانات الأولية والقراءة الناقدة للدراسات السابقة لكشف الفجوات.
- مرحلة التحليل: تفكيك البيانات لتحديد المتغيرات والعلاقات بينها.
- مرحلة صياغة الإشكالية: هي تتويج للاشتباك النقدي مع الأدبيات، وتتم عبر التعبير عن المشكلة في سؤال رئيسي واضح أو تساؤلات فرعية.
وشدد البزور على أن الإشكالية القوية يجب أن تتسم بـالجدة والابتكار، الواقعية، الوضوح والتحديد، والقابلية للبحث.
تحقيق المخطوطات العربية
وفيما يخص تحقيق المخطوطات تطرقت الدكتورة هجر شفيق إلى القواعد المنهجية في تحقيق المخطوطات العربية والأستاذ عبد الله توحو إلى أبجديات تحقيق النص التراثي العربي، مؤكدين أن موضوع التحقيق يعتبر “رسالة علمية”، والنص المخطوط هو “أمانة” . والقائم بتحقيق النصوص تتشابك في شخصيته الفضيلة الأخلاقية مع الخبرة التقنية.
تناولت الدكتورة هجر شفيق في هذا الفصل علماً دقيقاً من علوم التراث، وهو تحقيق المخطوطات وأوضحت أن هذا العمل يتطلب من الباحث (المحقق) مؤهلات خاصة، أهمها التخصص الدقيق في موضوع المخطوط، بالإضافة إلى الصبر والأمانة العلمية.
واستعرضت القواعد المنهجية لعملية التحقيق عبر مراحل متسلسلة:
- اختيار المخطوط: يجب أن يكون ذا قيمة علمية ولم يسبق تحقيقه تحقيقاً وافياً.
- جمع النسخ ووصفها: البحث عن جميع النسخ الخطية المتاحة للمخطوط، ووصف كل نسخة وصفاً مادياً دقيقاً (الورق، الحبر، الخط)، وترتيبها حسب الأهمية، مع اعتماد “النسخة الأم” (نسخة المؤلف) كأساس.
- المقابلة والتحقيق: مقارنة النسخ المختلفة لتسجيل الفروق، وتصحيح أخطاء النساخ، وإثبات النص الأقرب لما أراده المؤلف.
- التعليق والتوثيق: تخريج الآيات والأحاديث، وتوثيق النقول، والتعريف بالأعلام والأماكن، وشرح المصطلحات الغامضة.
مقدمة التحقيق والفهارس: يتوج العمل بمقدمة دراسية وافية حول المؤلف والكتاب، ومجموعة من الفهارس العلمية (للآيات، الأعلام، المصادر، الموضوعات) التي تسهل الاستفادة من النص المحقق.
أبجديات تحقيق النص التراثي العربي
وأكمل الأستاذ عبد الله توحو ما بدأته الدكتورة شفيق حيث قدم دليلاً عملياً للمبتدئين في مجال تحقيق التراث، ركز فيه بشكل خاص على السمات التي يجب أن يتحلى بها المحقق وثقافته العلمية ومن أبرزها :
- خصال المحقق: ضرورة “الإيمان بالتراث” كدافع أساسي للعمل، و”الأمانة العلمية” المطلقة في التعامل مع النص، و”الصبر والجلد” لمواجهة صعوبات التحقيق، بالإضافة إلى “الخبرة والتمرس” بأصول التحقيق و”التضلع في علوم اللغة العربية”.
- قواعد التحقيق: التأكيد على الخطوات المنهجية الأساسية التي ذكرتها شفيق، مثل اختيار المخطوط ذي القيمة، وجمع النسخ وترتيبها، والمقابلة بينها، وتحقيق متن المخطوط، ووضع مقدمة وفهارس علمية شاملة.
الدقة والأخلاق في الاقتباس والتوثيق
اختتم الأستاذ لحبيب العوني فصول الكتاب بمعالجة التوثيق العلمي، معتبرًا إياه شرطا أساسيا للحوار العلمي، ونبه العوني إلى ضرورة معالجة قضية “الاقتباس والتوثيق”، التي يعتبرها من الآليات الأساسية لضمان النزاهة العلمية.
وأرجع العوني أسباب التوثيق الرئيسة إلى أهمية الأمانة العلمية ونسبة الأفكار لأصحابها، مع تمكين القارئ من الرجوع للمصادر الأصلية. وأشار كذلك أهمية حفظ الجهود والاعتراف بجهود الآخرين وذلك عبر التمييز بين إسهام الباحث وما استقاه من غيره.
ثم استعرض العوني أشهر أساليب التوثيق العالمية، مثل:
- APA (جمعية علم النفس الأمريكية): للعلوم الاجتماعية.
- MLA (جمعية اللغات الحديثة): للعلوم الإنسانية.
- Chicago (شيكاغو): للتاريخ والفنون (يعتمد على الحواشي).
- OSCOLA (جامعة أكسفورد): للدراسات القانونية.
- Vancouver (فانكوفر): للعلوم الطبية (يعتمد على الترقيم).
خاتمة
يقدم كتاب “ضوابط إعداد البحوث الجامعية” خارطة طريق شاملة وواضحة للباحثين، تغطي الجوانب المنهجية والأخلاقية للبحث العلمي. من خلال فصوله المتكاملة، يسلح الكتاب الطالب بالأدوات اللازمة لإنتاج بحوث أكاديمية رصينة تساهم بفعالية في إثراء المعرفة.
معلومات الكتاب
- العنوان : ضوابط إعداد البحوث الجامعية
- التأليف: الدكتور بلخير سرحاني ، الدكتور مريم نبيه ، والدكتورة هجر شفيق ومجموعة من الأساتذة الباحثين، تقديم الأستاذ عدالمنعم الدقاق.
- الناشر: مركز أثيل للدراسات العلمية والأبحاث الاجتماعية – المغرب
- سنة النشر: 2023م (1444هـ).
- ردمك : 978-9920-9713-4-8 (ISBN)