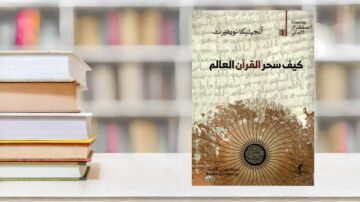صدر كتاب “كيف سحر القرآن العالم” للمستشرقة الألمانية أنجيليكا نويفرت في نسخته الألمانية عام 2017 م، وجاءت ترجمته العربية سنة 2022 م عن دار البحر الأحمر بالقاهرة، بترجمة شعيب صبحي، مع مراجعة مازن عكاشة وتعليق نقدي من طارق حجي. يمثل هذا العمل أول ترجمة كاملة لكتاب نويفرت إلى العربية، وهو ما أتاح للباحثين في الدراسات القرآنية والقراء باللغة العربية الاطلاع المباشر على أطروحاتها التي أثارت نقاشًا واسعًا في الحقلين العربي والغربي.
هدفت المؤلفة نويفرت إلى الإجابة عن سؤالين رئيسين:
- كيف أثّر القرآن في العالم لحظة ظهوره في القرن السابع الميلادي؟
- وكيف أعاد التاريخ لاحقًا تفكيك هذا “السحر” أو إعادة صياغته؟
في هذه المقالة نستعرض محتويات الكتاب، ومن ثم ملخص دراسة نقدية قام بها الباحث محمود عماد ونشرها مركز تفسير للدراسات القرآنية.
المنهج التزامني والرؤية العامة
تتبنى نويفرت منهجا تزامنيا يقرأ النص القرآني كما هو في صورته الكاملة داخل كل مرحلة نزول، بدلًا من تفكيكه وإعادة تركيبه وفق فرضيات تاريخية كما كان شائعا في الاستشراق القديم (المنهج التعاقبي). وتقارب المؤلفة القرآن بوصفه نصًا مقدسًا، لكنه ليس معزولًا عن التراثين اليهودي والمسيحي. فهي ترى أن القرآن بدأ على تماس مع الكتاب المقدس، ثم تطور تدريجيًا إلى نص مستقل يخاطب أمة حية ويشكّل هويتها.
البنية العامة للكتاب
يتكون الكتاب من مقدمات متعددة (للمترجم، والمراجعين، والمؤلفة) توضح سياق الترجمة وأهميته، ويمكن تقسيم فصوله التسعة إلى محاور رئيسة :
- القرآن بلاغًا (الفصلان 1 و2)
- إعادة ضبط الزمان والمكان (الفصلان 3 و4)
- الرب العادل الرحيم (الفصلان 5 و6)
- إعادة فكّ السحر (الفصول 7 و8 و9)
الفصل الأول: القرآن كتراث حي
تدافع نويفرت عن أن النص القرآني ليس مجرد إعادة صياغة لتراث كتابي سابق، بل نص حيّ نشأ داخل بيئة الجزيرة العربية. تستند في ذلك إلى مشروع (كوربس كورانيكوم)، الذي يوثق النصوص والنقوش المعاصرة للقرآن لإثبات استقلاله النصي.
الفصل الثاني: القرآن والشعر الجاهلي
ترى المؤلفة أن القصيدة الجاهلية كانت أداة الصراع القبلي، بينما استخدم القرآن بعض أدواتها البلاغية ليقلب القيم نحو تعزيز الفرد المؤمن ضمن جماعة أخلاقية.
الفصل الثالث: الزمان بين الدائرة والخط
في هذا الفصل توضح الباحثة الألمانية أن القرآن قام بتغيير التصور الوثني للزمان من الدائرة الأبدية إلى الخط ذي البداية والنهاية، رابطا الخلق بالبعث. وقارنت المؤلفة هذا بفكرة “اللوجوس المسيحية”، مع التأكيد على الفارق العقدي.
الفصل الرابع: إعادة قداسة المكان
هنا تستنج المؤلفة أن القرآن أعاد رسم الخريطة المقدسة، جامعًا بين مكة وسيناء والقدس، كما في سورة التين، مع ربط هذه الأمكنة بقصص الأنبياء وبالأسئلة الأخروية.
الفصل الخامس: العدل في القرآن
تتبع نويفرت تطور مفهوم العدل ليصبح مبدأ إلهيًا شاملًا، متجاوزًا التحديدات التوراتية، مع اهتمام خاص بالمستضعفين.
الفصل السادس: الرحمة كمحور عقدي
تحوّل خطاب الرحمة من سياق إنذاري في المكي إلى مركزية واضحة في المدني، خاصة في سورة الرحمن والفاتحة. وربطت المؤلفة هذا بمرويات زكريا ومريم، وهو موضع جدل نقدي.
الفصل السابع: الوصايا وإعادة الصياغة
ترى نويفرت أن سورة الإسراء تقدم صيغة قرآنية معدلة للوصايا العشر، تضيف وصايا اجتماعية وأخلاقية جديدة، مثل رعاية اليتامى وتحريم التبذير.
الفصل الثامن: رحلة الإسراء
فسرت نويفرت الإسراء كحدث يعيد الربط بين مكة والقدس، وله أبعاد سياسية وروحية، وأسهم في ترسيخ الصلاة كركن محوري.
الفصل التاسع: إبراهيم وفك السحر
قدمت الباحثة الألمانية نويفرت صورة إبراهيم عليه السلام وهو ينتقل من نبي روحي في المكي إلى أب مؤسس للأمة الإسلامية في المدني، بما يسحب مركزية القداسة من القدس إلى مكة.
الملاحظات النقدية على أطروحات نويفرت
على الرغم من القيمة العلمية لكتاب «كيف سحر القرآن العالم» من حيث المنهج والثراء التحليلي، إلا أنها اشتملت على مجموعة من الملاحظات الجوهرية التي تمس البناء الفكري للكتاب ومنهجيته في التعامل مع النص القرآني. هذه الملاحظات لا تقتصر على تفاصيل جزئية، بل تمس أحيانًا الأسس التي بنت عليها المؤلفة كثيرًا من استنتاجاتها.
هذه الإشكالات تطرق لها الباحث محمود عماد في دراسة نقدية حول ما جاء في الكتاب، نشرها مركز تفسير للدراسات القرآنية، وهذه أهم الملاحظات التي قام برصدها :
الإفراط في التأويل التيبولوجي (Typology)
يعتبر منهج ” التيبولوجيا” أحد مناهج التراث المسيحي التقليدي حيث يقرأ نصوص العهد القديم باعتبارها رموزًا ونماذج تتحقق في المسيح أو في أحداث العهد الجديد. واستخدمت الباحثة الألمانية نويفرت هذا المنهج أحيانًا لقراءة القرآن، عبر إسقاط رمزية مسيحية على بعض القصص القرآنية. وأبرز مثال على ذلك هو حين فسرت المؤلفة الكبش بأنه يرمز إلى المسيح في قصة إبراهيم والذبح العظيم، في إشارة إلى التشابه مع مفهوم “الأضحية” المسيحية. لكن هذا الإسقاط يتجاهل أن القرآن يرفض أصلًا عقيدة الفداء المسيحي، ويرفض فكرة أن الخلاص يتم عبر تضحية شخص بديلاً عن الآخرين، بل يربط النجاة بالتقوى والعمل الصالح الفردي.
ويرى الباحث محمود عماد أن الإشكال المنهجي الذي وقعت فيه المؤلفة يكمن في أن تطبيق القراءة “التيبولوجية” على القرآن يتطلب افتراض أن القرآن يكمّل أو يتفرع عن السردية المسيحية، بينما القرآن يقدم نفسه بوصفه مصححًا أو مهيمنًا على الكتب السابقة، لا تابعًا لها.
الربط غير المبرر بين الهيكل ومفهوم الرحمة
حاولت المؤلفة الربط بين الرحمة الإلهية في القرآن وقصة زكريا ومريم والهيكل، لتشير إلى انتقال الرحمة كوراثة رمزية من الهيكل إلى مريم، ومن ثم إلى المفهوم القرآني للرحمة. إلا أن المشكلة أنه لا يوجد في النص القرآني ما يسند هذا الربط المباشر. صحيح أن سورة مريم تذكر زكريا ومريم في سياق متصل، لكن ربط ذلك بمفهوم الهيكل وبالرمزية المسيحية للكنيسة هو إسقاط من خارج النص.
ويؤكد الباحث عماد في دراسته أن هذا النوع من التأويل يعرّض البحث لاتهام “التفسير بالإسقاط”، أي فرض معانٍ خارجية على النص القرآني دون وجود شواهد نصية أو تاريخية كافية.
تفسير مثير للجدل لقصة الكبش في إبراهيم
طرحت الباحثة الألمانية نويفرت تفسيرًا للآية { فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ } (الصافات: 102) بأن السعي هنا هو السعي في شعيرة الحج، وربطت ذلك ببناء المذبح ورفع القواعد من البيت في (البقرة: 127). هذا الربط غير مسند من السياق القرآني؛ فالسعي في الصافات هو سياق حياة وعمل مشترك بين الأب والابن، وليس شعيرة الحج. والقرآن يشير إلى أن إسماعيل كان غلاما في سن يستطيع المشي والعمل مع والده، بينما بناء الكعبة ورفع قواعدها جاء لاحقًا في حياته.
ويكشف الباحث عماد أن هذا الربط الخاطئ الذي قامت به المؤلفة يخلط بين سياقين منفصلين زمنيا وموضوعيا.
رفض رواية بدء الوحي في سورة العلق
رفضت المؤلفة أن تكون سورة العلق هي بداية الوحي، استنادًا إلى أن السورة “من وجهة نظرها” وحدة مكتملة الأسلوب والقافية، وهو ما لا يتناسب مع مشهد البداية المرتبك. هذا الموقف يتجاهل الروايات الحديثية المتواترة، ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها، والتي تحدد أن أول ما نزل هو صدر سورة العلق. كما أن اكتمال القافية أو وحدة الأسلوب لا ينفي أن تكون الآيات الأولى هي بداية النزول، فهناك إمكانية أن تكون بقية السورة قد نزلت لاحقًا.
ويؤكد الباحث محمود عماد أن الخطأ الفادح الذي وقعت فيه المؤلفة في كتابها في الاعتماد على الانطباع الأدبي وحده لإعادة ترتيب النصوص، يتجاهل منهجية علوم الحديث وأسباب النزول المعتمدة في التراث الإسلامي.
افتراضات بلا أدلة كافية
افترضت نويفرت أن السور المكية المبكرة اعتمدت أسلوب السجع المشابه لأسلوب الكهانة للتأثير على العرب، وضربت مثالًا بسورة العاديات. إن هذا التشابه الجزئي لا يثبت محاكاة مقصودة، خاصة أن أسلوب القرآن في مراحله المختلفة يتسم بتنوع كبير ولا يقتصر على نمط واحد. كما افترضت المؤلفة أحيانًا أن بعض الشخصيات القرآنية مثل الرجل المؤمن في سورة يس كان مسلمًا غير عربي جاء من أقصى المدينة، دون تقديم دليل تاريخي أو لغوي قوي.
الخلط بين الإسراء والمعراج
أشارت الباحثة الألمانية نويفرت إلى أن الجدل حول طبيعة الإسراء (بالروح فقط أم بالروح والجسد) قد يكون مرتبطًا بمحاولة الرد على المشككين، حيث خلطت المؤلفة بين حادثة الإسراء (من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى) وحادثة المعراج (الصعود إلى السماء)، في حين أن النقاشات التاريخية واللاهوتية في التراث الإسلامي غالبًا ما فصلت بينهما. نسبت بعض الأقوال إلى المعتزلة على أنها رفض للإسراء الجسدي، بينما نصوصهم في بعض المصادر تؤكد وقوع الإسراء يقظة.
فرضية انطلاق القرآن من التراث الكتابي
طرحت الباحثة الألمانية نويفرت أن القرآن بدأ في مرحلته الأولى داخل إطار التراث الكتابي اليهودي والمسيحي، ثم تطور لاحقًا إلى نص مستقل. وينقض الباحث محمود عماد هذا الطرح الذي يقلل من خصوصية القرآن ويجعل أصله تابعا لما سبقه، متجاهلًا إعلان القرآن منذ اللحظة الأولى عن تصحيح الأخطاء العقدية واللاهوتية في التراث السابق. كما أن الادعاء بعدم وجود اشتباك حقيقي مع عقائد اليهود في المرحلة المكية يناقض وجود إشارات واضحة في السور المكية لهذه العقائد.
أثر هذه الملاحظات على موثوقية بعض النتائج
أكد الباحث محمود عماد في ختام دراسته النقدية لكتاب “كيف سحر القرآن العالم” أن هذه الملاحظات لا تعني التقليل من الجهد الذي قامت به الباحثة الألمانية ، إلا أنه أشار إلى أن بعض النتائج التي توصلت إليها نويفرت اعتمدت على فرضيات مسبقة أو تأويلات إسقاطية، مما يقتضي من القارئ التعامل معها بوصفها اجتهادات قابلة للنقد، والموازنة بينها وبين الأدلة النصية والتاريخية التي قد تدعم أو تنقض هذه الفرضيات، بالإضافة إلى الاستفادة من منهجها التحليلي مع الحذر من فرضياتها التأويلية غير المدعومة.
خاتمة
جمع كتاب “كيف سحر القرآن العالم” بين العمق الأكاديمي والحس الأدبي، إلا أن بعض استنتاجاته تعكس ميلا إلى الفرضيات الاستشراقية القديمة، وتستلزم قراءة نقدية واعية تراعي خصوصية النص القرآني وتاريخ تلقيه، وتشكل فرصة لفهم كيف ينظر الاستشراق الحديث إلى النص القرآني والحاجة إلى نقده وكشف ما يحتويه من ثغرات منهجية.