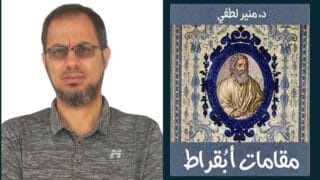قدمت الرأسمالية نفسها بوصفها قاطرة التقدم والرفاهية للمجتمعات المختلفة، واستطاعت إحراز النجاح رغم انتقادات ماركس وإنجلز إذ تم اعتمادها كنظام اقتصادي في جل البلدان الأوروبية، لكن زيف تلك الدعايات ما لبث أن تكشف منذ سبعينات القرن التاسع عشر من خلال الركود الاقتصادي الذي استمر قرابة عقدين والذي رافقه تحولات اجتماعية وثقافية مهمة، ثم توالت الأزمات الاقتصادية الحادة في القرن العشرين بدءا من أزمة الكساد الكبير 1929-1939 وصولا إلى الأزمة الأسيوية 1997.
وقد عبر الأدب عن هذه الأزمات وما أحدثته من الرأسمالية من تغيرات على المستويين الفردي والاجتماعي، والكاتب النرويجي بيورسون هو أول من جعل الرأسمالية موضوعا للدرس الأدبي في روايته (إفلاس) عام 1875، ثم تبعه مواطنه هنريك إبسن بعد عامين فقط من خلال مسرحيته (أعمدة المجتمع) ثم توالت الأعمال الأدبية خلال القرن العشرين التي تناولت الرأسمالية وقدمت انتقادات جوهرية لها، ومن أشهرها مسرحيتي آثر ميلر (كلهم أبنائي) و(موت بائع متجول)، ومسرحية (بعد كل هذه السنين) لسيدني بوكس، و(القرد الكثيف الشعر) ليوجين أونيل وغيرها من الأعمال التي يضيق المقام عن حصرها.
ومن بين هذه الأعمال يمكن التوقف أمام عملين يتكاملان فيما بينهما في تصوير تداعيات الرأسمالية إذ يختص أولهما بدراسة شخصية الرأسمالي الذي تضمر مشاعره تحت وطأة الرغبة في جني الأرباح ، وثانيهما يجسد شخصية العامل ضحية النظام الرأسمالي الشره الذي ما إن يتقدم به العمر حتى يتم سحقه ويلقي به خارجا لينتهي به الحال منتحرا أو متسولا قوته من مكتب رعاية العاطلين.
أعمدة المجتمع: التماهي بين العام والخاص
يصنف الكاتب النرويجي هنريك إبسن (1828 -1906) كواحد من أهم نقاد الرأسمالية من الأدباء، فقد تناولها في مسرحيتين من أهم مسرحياته الاجتماعية؛ ففي ( بيت الدمية) صور إبسن أثر الرأسمالية على الفئات المجتمعية الأضعف من خلال امرأة شابة تدفعها ظروف مرض زوجها إلى الاقتراض بفائدة كبيرة، وهو ما دفعها للعمل سنوات كي تستطيع تسديد القرض وفوائده في مواعيدها بانتظام الأمر الذي أثر على حياتها العائلية سلبا، وأما في (أعمدة المجتمع) فقد حطم ابسن الهالة التي أخذت ترتسم حول شخصية رجل الأعمال الذي كان يصور على أنه رمز النجاح المزدوج الاجتماعي والأسري.
تدور (أعمدة المجتمع) حول رجل الأعمال كاستن بيرنك صاحب حوض بناء السفن الذي يتمتع بسمعة طيبة في مجتمعه فمن جهة مشروعاته يروج لها أنها لا ترجو إلا تقدم المجتمع ولا تستهدف تحقيق منفعة ذاتية لشخصه، ومن جهة أخرى تترأس زوجته جمعية مساعدة الأخوات الساقطات التي تستهدف نشر الفضيلة المجتمعية، وبهذه الكيفية استطاع بيرنك أن يصبح أحد قادة المجتمع الذين يلعبون دورا في تحديد ما هو المقبول وما هو المرفوض مجتمعيا، لكن هذه الصورة التي يرسمها بيرنك لنفسه سرعان ما يتبدى زيفها فقد لعبت الأكذوبة دورها في صنع أسطورته مرتين؛ الأولى حين اضطر في مقتبل حياته المهنية إلى الادعاء بسرقة ثروة الأسرة لتسكين ثائرة الدائنيين، والثانية حين مارس الرذيلة لكنه سرعان ما ألقى بالتهمة على أحد أصدقائه وبرأت ساحته، ومن هاتين الكذبتين شيد الرجل نجاحاته العملية والعائلية، فهو “صنيعة الكذب والتضليل” ولا شيء سواهما.
ومن خلال المسرحية يبدو وعي إبسن بالصراع الطبقي بين العمال وأصحاب رؤوس الأموال، فهو يضع رئيس العمال في مواجهة مستر بيرنك وتدور بينهما حوارات تكشف عن التناقض بين وجهتي نظر العمال وأصحاب رؤوس الأموال، فقد أدخل بيرنك الآلات الحديثة في حوض السفن دون تدريب العمال على كيفية استعمالها، واتخذ ذلك حجة للاستغناء عن حوالي ثلث العاملين، وحين عاتبه رئيس العمال أجابه بقوله:
“أنا لا أستهدف الربح، عليّ أن أقدر حاجات المجتمع الذي أعيش فيه ومطالب المنشآت التي أديرها، إن التقدم يجب أن يأتي عن طريقي وإلا فلن يتقدم المجتمع أبدا” وعندئذ أجابه رئيس العمال أنه مثله يبغي تقدم المجتمع لكنه يخشى على مستقبل العمال الذين ستحل الآلات محلهم متسائلا ” كيف يمكن للعلوم الحديثة وحليفها رأس المال أن تفرض الآلات الحديثة قبل أن يتعلم جيل بأسره كيفية استخدامها، ولم يجد رجل الأعمال ما يجيبه به إلا القول “إن على الضعيف فيهم أن يتنحى تاركًا مكانه للقوي” كاشفا بذلك عن داروينيته الكامنة التي طالما أخفاها تحت شعارات التقدم الكاذبة.
وفي هذا الحوار الذي صاغه إبسن منذ قرن ونصف يستوقفنا أمران؛ أولهما كون الحداثة وسيلة بيد الأقوى لسحق الضعيف، فقد استخدمت لقهر العمال والمستضعفين داخل الغرب كما استخدمت لقهر الشعوب غير الأوروبية في الخارج، وثانيهما التماهي بين العام والخاص لدى رجل الأعمال الذي يتوهم أن مصلحته الذاتية الضيقة هي مصلحة المجتمع لا فارق بينهما، وهذا التصور هو نفس تصور السلطويين السياسيين في كل زمان الذين يتوهمون أن دولهم لن تقوم لها قائمة بدونهم.
لكن وعي إبسن بصراع البروليتاريا مع رأس المال لم يجنح به إلى اعتناق النهج الماركسي الثوري المتطرف، وإنما جنح نحو الاعتدال وتبنى نهجلا أخلاقيا حلا للصراع؛ فرجل الأعمال أرسل إحدى السفن إلى البحر دون إجراء أعمال الصيانة الكافية معرضها إياها للغرق بحجة ” أن اسمه كفيل بتغطية عيوبها”، وتصادف أن ابنه الصغير قد فر من المنزل وركب السفينة خلسة، وعندئذ أدرك رجل الأعمال أن قيمة الحياة الإنسانية تفوق قيمة الربح، وأنه لابد أن يحدث تغييرا في الكيفية التي تدار بها مشروعاته المختلفة على نحو يدمج القيم الأخلاقية مع الحداثة ورأس المال.
وفاة بائع متجول: الرأسمالية تسحق أبنائها
وهي أحد أعمال الكاتب المسرحي الأمريكي اليساري آرثر ميلر ( 1915-2005) ذائعة الصيت، وهي واحدة من أهم الأدبيات النقدية للرأسمالية والتي حققت انتشارا كبيرا منذ صدورها عام 1949، وفيها يرسم ميلر شخصية أحد ضحاياها الذين آمنوا بقيمها وساروا على هديها وأورثوها لأبنائهم لكنها سرعان ما سحقته عندما أصبح عاجزا عن العمل، فلم يجد بدا سوى الانتحار.
الشخصية المحورية في المسرحية هي (ويلي لومان) البائع المتجول الذي تجاوز الستين من عمره أمضى منها ستة وثلاثون عاما بائعا جوالا لمنتج تافه هو الجوارب النسائية لصالح إحدى الشركات، وكان عليه أن يقطع بسيارته قرابة سبعمائة ميل في الرحلة الواحدة، وما إن تقدم به العمر حتى اعترته الهلاوس السمعية والبصرية وأعاقته عن العمل بكفاءة وتدهورت مبيعاته، فأوقفت الشركة صرف راتبه مكتفية بمنحه عمولة عن مبيعاته الضئيلة، ثم فصلته عن العمل حينما طلب لومان من مدير الشركة العمل بالمقر لأنه لم يعد قادرا على الترحال، وفي هذا الموقف لم يبد رجل الأعمال الشاب أي تعاطف مع المسن الذي أمضى ثلث قرن يخدم والده وشركته الناشئة “وألقى به كقشرة فاكهة” أكلت وتم التخلص من بقاياها كما يقول لومان، لقد كشف ميلر من خلال ذلك المشهد المؤثر أن البيع والربح هما القيمتان المسيطرتان على سوق العمل بل وعلى المجتمع الأمريكي بأسره، وأن هذا السوق غدا قاسيا ولا إنسانيا فهو يستغل الإنسان بلا رحمة لآخر قطرة ثم يلقي به خارجا.
المصير الذي لاقاه لومان جاء على الرغم من إيمانه بقيم الرأسمالية وأهمها تحقيق الثراء من خلال المنظومة الرأسمالية وعبر أدواتها المتاحة، لكنه لم يفطن إلى أن الكد والاجتهاد بل والعلم ليس لهم دور كبير في هذا تحقيق الثراء وإنما هو الحظ، يبدو ذلك من خلال الشخصيات الناجحة بالمسرحية كشقيقه الذي قادته المصادفة إلى القارة الأفريقية وهناك وجد الماس، أو شخصية رجل الأعمال الشاب الذي ورث شركة عن أبيه، أما الشخصيات الباقية فقد وقعت في فخ وعود النظام الرأسمالي البراقة ولم تحرز نجاحا يذكر، وربما يكون ميلر قد أراد من وراء ذلك أن يومئ أن قيم الكد والاجتهاد ليس لهما مدخل في نجاح الرأسمالي.
الوجوه القبيحة للرأسمالية -كما رصدها ميلر- تطل علينا من خلال حوارات المسرحية المتوالية، ففي حوار دار بين لومان وزوجته ليندا يتحدث لومان عن الأقساط الكثيرة التي ينوء بها كاهله، فهناك قسط المنزل الذي استمر يسدد أقساطه خمسة وعشرون عاما كاملة، وهناك قسط ثان للسيارة وثالث للثلاجة، وجميع هذه الأشياء تلفظ أنفاسها مع حلول آخر قسط وفي هذا الصدد يقول لزوجته ” كم أتمنى ولو مرة واحدة في حياتي أن امتلك شيئا قبل أن يتلف، إنني في صراع دائم مع خرابة الخردة.. أتعلمين أنهم يضبطون هذه الأشياء بحيث لا تدفعين آخر قسط حتى تكون قد استهلكت تماما”، وفي حوار آخر للزوجة مع ولديها يبين ميلر أن التكريم والاحترام ينبغي أن يتوفرا لأي إنسان وليس لمن حاز معايير النجاح الرأسمالي، فتقول ليندا ” لا تقل إن ويلي لومان رجل عظيم فلم يجني ثروة، ولم ينشر اسمه في الصحف، وهو ليس أعظم شخصية في التاريخ، لكنه إنسان وثمة شيء فظيع يحدث له، ويجب ألا نسمح له بالسقوط في قبره مثل كلب عجوز” وبهذه الكلمات يكون ميلر قد كشف عن أسوأ عيوب الرأسمالية على الإطلاق وهي سحقها الإنسان واهانته وتقديسها للقوة والثراء.
ومما سبق يتضح أن الأدب لعب دورا في دحض أكاذيب الرأسمالية وأنها لا تستهدف سوى تحقيق التقدم والازدهار، إذا أن هذا التقدم الموعود قد أتى على حساب الإنسان وطمأنينته النفسية.
تنزيل PDF