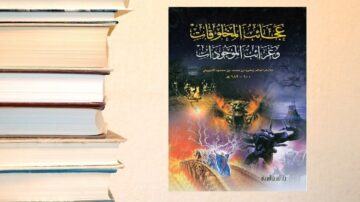أسفرت حركة نشر المخطوطات والفهارس التراثية عن حقيقة مؤداها أن التراث العلمي العربي في الطب والبيولوجيا والفلك والملاحة وغيرها لا يقل ضخامة عن التراث العلمي في العلوم الشرعية واللغوية والتاريخية، ففي مجال علوم الحيوان والنبات هناك ما يتعذر إحصاؤه من المصنفات، وضمن هذه الفئة يحتل كتاب (عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات) للقزويني مرتبة متقدمة يشهد بذلك وجود ما لا يقل عن سبعة عشر تلخيصا وترجمة له فضلا عن مئات البحوث والدراسات التي تناولته بالدراسة والبحث.
زكريا القزويني: سيرته ومصنفاته
هو أبو يحيى عماد الدين زكريا بن محمد بن محمود القاضي، وينتهي نسبه إلى الإمام مالك بن أنس، نزحت أسرته من المدينة المنورة واستوطنت قزوين، ولد عام 600 ه وقيل بعدها بخمس سنوات، وتلقى علومه فيها، عرف الترحال منذ وقت مبكر ففي صدر شبابه رحل إلى دمشق وتعرف بها على ابن عربي، ثم استقر في العراق وعين قاضيا لمدينتي واسط والحلة في عهد الخليفة المستعصم آخر خلفاء بني العباس، بعد سقوط الدولة العباسية (656 ه) انصرف للكتابة والتأليف، واتصل بعطاء الملك الجويني حاكم العراق أيام المغول، وتوفي بمدينة واسط (682 ه) ونقل جثمانه إلى بغداد ودفن بها[1].
خلف القزويني بضع مصنفات تدل على تضلعه في العلوم الطبيعية والتاريخ والجغرافيا، وهي:
- آثار البلاد وأخبار العباد، وهو كتاب في التاريخ افتتحه بمقدمة عن الحاجة إلى إحداث المدن والقرى وعن خواص البلاد، ثم أفاض في الحديث عن أخبار الأمم الماضية والسلاطين والعلماء.
- خطط مصر، وهو في الجغرافيا، وفيه وصف لخطط القاهرة.
- الإرشاد في أخبار قزوين، وهو في تاريخ موطنه قزوين.
- عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، وهو موسوعة في علوم النبات والحيوان والفلك والجيولوجيا.
خصائص الكتاب ومنهجه
كتاب عجائب المخلوقات هو “أول عرض منظم للكونيات في المصنفات الإسلامية” كما يصفه عزيز العزي، وكان مصدرا لكثير من المصنفين التراثيين الذين أتوا بعد القزويني: مثل الدميري ونقل عنه في كتابه (حياة الحيوان) والدمشقي في (نخبة الدهر)، حقق الكتاب شهرة واسعة في العالم الإسلامي حيث ترجم إلى الفارسية والتركية، كما ترجم اللاتينية والألمانية والفرنسية، وحققه المستشرقون: فلوجل، وستنفلد، رسكا. وأقدم طبعة عربية للكتاب هي طبعة وستنفلد الصادرة عام 1848 في لايبزيك، ثم طبع بالقاهرة عام 1887 على هامش كتاب (حياة الحيوان الكبري) ثم توالت طبعاته بعد ذلك[2].
انتهج القزويني في كتابه منهجا محكما بينه في المقدمة المعمقة التي استهل بها الكتاب، ويمكن إيجازه في العناصر التالية:
- العناية بالمفاهيم، ينطلق القزويني دوما من المفاهيم مهما بدت واضحة وجلية، فهو مثلا يخصص مقدماته الأربع للتعريف بالألفاظ التي يتألف منها عنوان الكتاب: عجائب، المخلوقات، غرائب، الموجودات، ويقدم تعريفا موجزا لكل منها مراعيا الدلالة اللغوية للفظ، ثم يردف بأمثلة توضح ما يندرج تحتها.
- الميل إلى التعليل العقلي، لا يقف القزويني أمام الظواهر والوقائع جامدا، وإنما ينحو نحو تعليلها وتفسيرها، ولنضرب مثالا يتضح به المراد ويتعلق بما ذكره من خواص المغناطيس الذي إذا أصابته رائحة الثوم بطلت خاصة الجذب به، وإذا غسل بالخل عادت إليه، ” فإذا رأيت مغناطيسا لا يجذب الحديد فلا تنكر خاصته، فاصرف عنايتك إلى البحث عن أحواله حتى يتضح لك أمره”[3].
- التصنيف، يفتتح القزويني كل باب من أبواب الكتاب بتقسيم ما يندرج أسفله مفتتحا بالتقسيمات الرئيسة وصولا إلى التقسيمات الفرعية والدقيقة، كما ذكر في المقدمة الثانية أن المخلوق إما أن يكون قائم بذاته أو قائما بالغير، والقائم بالذات إما أن يكون متحيزا أو لا يكون، فإن كان متحيزا فهو الجسم، وإن لم يكن فهو الجوهر الروحاني…[4].
- طرح التساؤلات: يميل القزويني إلى طرح التساؤلات في معالجته للمسائل، ويبدو أنه لا يقصد من ذلك إثارة القارئ وإنما بعثه على التفكر وإعمال عقله، ومن ذلك حديثه عن النحل وأنه ينبغي للإنسان أن يسأل نفسه من أين جاء الشمع الذي تصنع منه الخلايا، وكيف صنعت بهذه الدقة على نحو يعجز معه المهندس الحاذق أن يماثلها من دون فرجات [فرجار] أو مسطرة[5].
- تنوع المصادر، استعان القزويني بعدد كبير من المصادر في الكتاب، وأحصى له عزيز العزي نحو 65 مصدرا رجع إليها واقتبس منها، وكان أكثر اقتباسه عن ابن سينا يليه أرسطو ثم ابن وحشية ثم بليناس ثم الجاحظ ثم بطليموس، إضافة إلى مشاهداته وحواراته، وإلى القرآن الكريم والحديث الشريف وهما من المصادر التي رجع إليها كثيرا[6].
- سلاسة العبارة، وهي سمة مميزة للقزويني الذي يكتب بلغة رشيقة ليس فيها إغراب أو تقعير، حتى يُظن أنه من كُتاب عصرنا وليس من أهل القرن السابع.
بنية الكتاب ومحتواه
يتألف الكتاب من مقدمة وقسمين كبيرين أو مقالتين حسب وصف القزويني:
أما المقدمة فيبدو أن صاحبها كان مولعا بالمقدمات المطولة الوافية حيث جعل لكتابه أربع مقدمات، استهلها بشرح غاية الكتاب، وحول ذلك يقول إنه لما كان بعيد عن وطنه فإنه ألِف المطالعة والقراءة والنظر في عجائب صنع الله تعالى كما أرشد الله تعالى عباده قائلا (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها)، “وليس المراد من النظر كما يقول تقليب الحدقة ونحوها؛ فإن البهائم تشارك الإنسان فيه… والمراد هو التفكر في المعقولات والنظر في المحسوسات والبحث عن حكمتها وتصاريفها ليظهر لك حقائقها[7]
وهذه العبارة على وجازتها تبين أن القزويني-وغيره من علماء الإسلام-إنما كانوا ينطلقون من فكرة الاتصال الوثيق بين الدين والعلم، وأن الأول يحض على الثاني ويدعو إليه. وأما دعوى الانفصال التي شاعت في الغرب فليست إلا تنكبا عن المسار الذي سار فيه المسلمون وغيرهم من أهل الحضارات السابقة.
تطرقت المقدمة كذلك إلى بيان سبب تأليف الكتاب إذ يقول القزويني “ولقد حصل لي بطريق السمع والبصر والفكر والنظر حكم غريبة، فأحببت أن أقيدها لتثبت، وكرهت الذهول عنها مخافة أن تفلت” وفي هذه العبارة فائدة لطلاب العلم وهي ضرورة تقييد الفكرة أو المعرفة خشية أن تفلت من العقل، ويبدو أنها جعلت بعض الباحثين يعتقد أن تدوين الكتاب مر بأطوار عدة حيث كان القزويني ينقح ويراجع ما كتب، وهي الفكرة التي ذهب إليها المستشرق وستنفلد والأستاذ باقر علوان[8].

أما متن الكتاب فقد قسمه إلى قسمين أو مقالتين حسب تعبيره، كل منهما تضم فصولا.
المقالة الأولى، تسمى “العلويات” أي ما يتعلق بالسماء من كواكب وبروج ومدارات ومجرات والشمس والقمر والكواكب (الزهرة، المريخ، المشترى، عطارد، وزحل) وقد أسهب في الكلام عنها جميعا
كما تحدث عن المجرة وأن العرب تسميها أم النجوم، وتحدث عن أثر الشمس على الأحياء عموما والإنسان خصوصا، وعن تأثر حركة النبات بالشمس، وتحدث عن دورات أفلاكها وهو دائم الإشارة في ذلك إلى أرصاد بطليموس.
واختتم حديثه عن العلويات بالزمان، وذكر أنهم عرفوه بأنه مقدار حركة الفلك كما ذهب أرسطوطاليس، وعند غيره مرور الأيام والليالي، ثم ساق تعريفه للزمن قائلا ” وزمانك عمرك وهو معلوم القدر عند الله تعالى، وإن لم يكن معلوما عندك، وما مثله كمسافة ساع يسعى في قطعها قوي على السير لا يفتر طرفة عين، فما أعجل انقطاعها ولو كانت بعيدة” [9]ثم واصل حديثه عن الأيام والشهور وأيام العرب وأيام الأمم الأخرى.
المقالة الثانية، وتسمى السفليات، وبدأها بالحديث عن الشهب وانقضاض الكواكب، وتحدث عن الهواء والرياح والمطر وما يتعلق بهم، ثم انتقل للحديث حول الرياح والرعد والبرق، ومما ذكره في ذلك قوله “اعلم أن البرق والرعد يحدثان معا لكن البرق يرى قبل الرعد”،[10] ثم ذكر ما يفيد أن الصوت أسرع من الضوء، ثم تطرق إلى الهالة وقوس قزح وذكر سبب تكونه وتعدد ألوانه، ثم انتقل للحديث عما أسماه (كرة الماء) وفيه تحدث تفصيلا عن البحار مثل بحر القلزم وبحر الصين وبحر فارس وبحر الخزر وغيرها وعدد الحيوانات البحرية والبرمائية التي تعيش في كل منها.
وتطرق بعدها إلى الحديث عن (كرة الأرض) وتحدث فيه عن أقوال القدماء في هيئة الأرض، وعن العوارض التي تعترضها مثل الزلازل والهزات، ثم عالج التضاريس الجغرافية للأرض كالجبال والأنهار والعيون والآبار ومنها انتقل إلى دراسة المعادن في جوف الأرض، والأحجار والنباتات وأنواعها، والحيوانات وفصائلها ثم درس الإنسان وتشريحه وذكر حقيقة الأنوثة والذكورة وكيفية الحمل والولادة وما إلى ذلك من موضوعات تتصل بالعلوم البيولوجية.
وتشير هذه الطائفة الموسعة من الموضوعات وكيفية معالجته لها أن صاحبها يتمتع بعقل موسوعي، جعله قادرا على مقاربة علوم مختلفة بذات الكفاءة، ورغم هذا فإن هناك ملحوظتين بهذا الخصوص.
الأولى، إن في الكتاب من الملاحظات والتعليلات ما أثبته العلم الحديث، وبرهن على صحته مثل: ملاحظته حول كثرة نسل الحيوانات والحشرات التي تتعرض لمخاطر الفناء، وهي منحة إلهية حتى لا تفنى وتنقرض، كذلك تتبعه لدورة حياة الضفدع وذكره تأثير الكحول في تخديره الذي يمكن أن يبلغ حد الموت.
والثانية، إن الكتاب في الجهة المقابلة حوى بعض الترهات والخرافات التي لا يمكن إثباتها والبرهنة عليها عقلا، ومن ذلك قوله: إن الأربعاء الأخير من الشهر يوم نحس مستمر[11]“، ومثل هذه الأقوال يمكن عزوها إلى النقل من المصادر، أو تأثره بالثقافة الشفهية السائدة في عصره.
وفي الأخير يمكن القول إن عجائب المخلوقات للقزويني موسوعة إسلامية تشهد أن العلم كان موصولا بالدين، وأن غايته لم تكن سوى التفكر في المعقولات والمحسوسات لأجل تحقيق الهداية والطمأنينة للإنسان، وليس السيطرة والاستحواذ وإعلان سيطرة الإنسان على الموجودات كما هو الحال في العلم الحداثي.