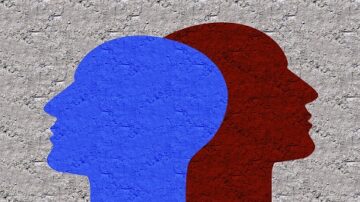انبعثت القومية العربية في القرن التاسع عشر، وزاد مدّها، حتى إنها وجدت صداها عند الساسة والشعوب.
ولم ينتصف القرن العشرون حتى أنشأ العرب جامعتهم العربية، وبثّوا الإذاعات الموجهة للعرب مثل: إذاعة صوت العرب.
وأضافت بعض الدول والممالك والإمارات اسم (العربية) إلى اسمها تقديرًا لعروبتها، واحتفاء بها.
والناظر لأحوال العرب بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أرباع القرن من نيلهم استقلالهم يجد أنهم لم يجتمعوا أو يتحدوا رغم العوامل المتضافرة التي تسهل من هذا الاتحاد، وتعمل على تذليل العقبات الواقفة في سبيله.
وكثيرًا ما نلقي باللائمة على المؤمرات الغربية التي تعمل على عدم إتمام الاتحاد العربي، أو خروج دولة قوية ينضوي تحتها كل هؤلاء الإخوة الأشقاء.
وهي بالفعل قائمة وفاعلة، ولكن لا يمكن تحميلها وحدها مسؤولية تفرقنا وتشرذمنا.
وبعد إنعام النظر في تاريخنا وجدت أن العروبة وحدها لم تكن في يوم من الأيام موحدة للعرب، رغم وحدة اللغة، واتصال الأرض، واتحاد النسب.
فهذا التاريخ الموغل في القِدم يقول: إن العرب قبل الإسلام لم تكن لهم دولة جامعة ترعى مصالحهم، وتقوم على رعايتهم.
وكانوا قبائل متناحرة متنازعة متقاتلة تقوم الحروب بينهم على أتفه الأسباب، فتسفك الدماء، وتقطّع الأرحام.
فهذه حرب البسوس، وتلك داحس والغبراء، حروب طال أمدها، سنين طويلة تُقطَف فيها الرءوس، ويهلك الحرثُ والنسل.
وهؤلاء بنو العمومة من الأوس والخزرج في يثرب تقوم بينهم الحرب فلا يهدأ أوارها.
وهذه حرب الفجار التي كانت في الحرم في أيام حرام.
وقد حاول العرب إيقاف هذه المظالم، ومنع تلك الدماء مثلما حدث في حلف الفضول الذي تداعت إليه قبائل من قريش “فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته”([1]).
ولكنه لم يوقف هذا الطوفان الهادر من الدماء، ولم يعمل العرب على تثبيته، وتدعيم أركانه، والبناء عليه.
وقد قامت بعض الدول العربية، لكنها كانت دولاً ليست مستقلة اسقلالاً تامًّا، بل كانت ما تكون بالدول الوظيفية.
فدولة الغساسنة في الشام كانت حليفة للإمبراطورية الرومانية، وكانت حارسة لحدودها الشرقية، واشتركت في الحرب ضد الدولة الفارسية.
ودولة المناذرة في العراق التي كانت تابعة للإمبراطورية الفارسية.
وكم نشبت الحروب بين تلك الدولتين العربيتين.
ثم جاء الإسلام فأقام للعرب دولة موحدة، وإمبراطورية كبيرة ضمت تحت جناحها أجناسًا من غير العرب.
فوحدة العرب كانت لعامل جديد دخل عليهم، هذا العامل غير عامل العروبة، إنه عامل الإسلام، الذي جمع العرب تحت لوائه.
والملاحظ أن العرب يتحيزون ويتعصبون لأفكارهم وتوجهاتهم أكثر من تعصبهم لعِرْقهم وجنسهم؛ فالشيعة العرب ييممون وجوههم قِبل قم وآيات الله، والمسيحيون العرب يبحثون عن جذور أخرى لهم غير العروبة، فمسيحيو مصر يمجدّون الفرعونية، ويعتبرون الفتح العربي لمصر غزوًا، وييممون وجوههم قِبل الغرب والبيت والأبيض.
لذا إذا عوّل أحد على أن تكون العروبة وحدها عاملاً لتوحيد العرب، فالتاريخ القديم والمعاصر يثبت خطأ هذا التفكير والتوجه.
وأن العرب يحتاجون إلى عامل زائد فوق كونهم عربًا؛ إذ إن الدم وحده لا يكفي لاجتماعهم، ووحدة اللسان وحده لا يكفي لاتحادهم.
والناظر لأقوى أسباب اتحاد العرب هو إيمانهم أنهم مادة الإسلام ونواته، وعنصره الفاعل، فإذا حادوا عن هذا الطريق ضُرب عليهم الذلة والصَّغار، وجاء الله بآخرين يحملون كلمة الله إلى العالمين، ويقيمون دولة الحق والعدل، قال النبي -ﷺ: “رأيت غنمًا كثيرة سوداء دخلت فيها غنم كثيرة بيض.
قالوا: فما أولته يا رسول الله؟
قال: “العجم يشركونكم في دينكم وأنسابكم“.
قالوا: العجم يا رسول الله؟!
قال: “لو كان الإيمان معلقًا بالثريا لناله رجال من العجم، وأسعدهم به الناس“([2]).
وقد هدم الإسلام الاعتزاز بالنسب والتعصب له، وجعل المفاضلة بالتقوى والإيمان.
ورسول الله -ﷺ- أعطى مفهومًا مغايرًا للعروبة عما استقرّ في الأذهان، والذي يتمسك به الكثيرون حتى الآن، ويجعلون التعصب للنسب والدم أشبه ما يكون بالتعصب للدين؛ فقد جاء قيس بن مطاطية إلى حلقة فيها سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، فقال: هؤلاء الأوس والخزرج قاموا بنصرة هذا الرجل، فما بال هؤلاء؟
فقام معاذ، فأخذ بتلبيبه حتى أتى به النبي -ﷺ- فأخبره بمقالته.
فقام رسول الله -ﷺ- مغضبًا يجر رداءه حتى دخل المسجد، ثم نودي: الصلاة جامعة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: “يا أيها الناس، إن الرب رب واحد، وإن الأب أب واحد، وإن الدين دين واحد، ألا وإن العربية ليست لكم بأب ولا أم، إنما هي لسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربي“.
فقال معاذ وهو آخذ بتلبيبه: يا رسول الله، ما تقول في هذا المنافق؟
فقال: “دعه إلى النار“.
قال: فكان فيمن ارتد، فقتل في الردة([3]).
فالعربية هي عربية اللسان؛ إذ لا نقاء لدم أحد؛ فالشعوب مختلطة، وجذروهم واحدة، فلا يفخر أحد على أحد بنسبه ودمه.
وفي الحديث: “ومن دخل في هذا الدين فهو عربي“([4]).
فالعروبة تحتاج لعامل معها يطفئ نار العصبيات والخلافات والانقسامات والانشقاقات، وطالما ظلّ الإسلام مُبعدًا عن صدارة المشهد فسيظل العرب في صراعاتهم يعمهون، ولن يذوقوا حلاوة الوحدة والقوة والاجتماع.
([1]) سيرة ابن هشام، (1/133-134).
([2]) أخرجه الحاكم في “المستدرك”، (4/437) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما، وقال: “هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه”، ووافقه الذهبي.
([3]) أخرجه ابن عساكر في “تاريخ دمشق”، (24/225)، وقال: “هذا حديث مرسل، وهو مع إرساله غريب، تفرد به أبو بكر سلمى بن عبد الله الهذلي البصري، ولم يروه عنه إلا قرة”.
وقال ابن تيمية في “اقتضاء الصراط المستقيم”، ص(169): “هذا الحديث ضعيف، وكأنه مركب على مالك، لكن معناه ليس ببعيد، بل هو صحيح من بعض الوجوه”.
وقال الألباني في “السلسلة الضعيفة”، ح(926): “ضعيف جدًّا”.
([4]) أخبار أصبهان، (1/27)، وقال الألباني في “السلسلة الضعيفة والموضوعة”، ( 5/71 ): “ضعيف جدًّا”.