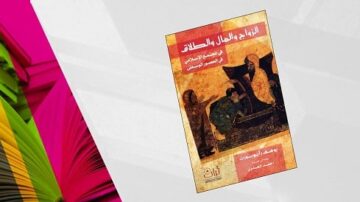عكف المؤرخون لأزمنة طويلة على دراسة التاريخ السياسي بوصفه التاريخ الأهم للبشرية، لكن اهتمامًا متزايدًا بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي أخد ينمو تدريجيا منذ عقود وبات الآن يحظى بقبول الدارسين وتشجيع المؤسسات البحثية الدولية، وأسفر عن صدور مؤلفات عديدة تتناول جوانب مختلفة من التاريخ الاجتماعي منها كتاب (الزواج والمال والطلاق في المجتمع الإسلامي في العصور الوسطى) ليوسف رابوبورت الباحث والمحاضر في التاريخ الإسلامي الوسيط بجامعة لندن.
نشر الكتاب للمرة الأولى عام 2005 ضمن سلسلة دراسات كامبريدج للحضارة الإسلامية، وهي سلسلة مرموقة تصدر عن جامعة كامبريدج منذ عام 1983، وصدرت ترجمته العربية عن مركز تراث للبحوث والدراسات عام 2015، وجاءت في ثلاثمائة وثمانون صفحة، ونقله إلى العربية بلغة رصينة تخلو من التصحيف والإسقاط أحمد العدوي المحاضر بإحدى الجامعات التركية.
يقع الكتاب في خمسة فصول ويذيله كشاف للمصطلحات والأسماء، ويدرس باستفاضة ظاهرة الطلاق في المجتمع الإسلامي خلال العصر المملوكي في ثلاث من الحواضر الإسلامية الكبرى وهي: القاهرة والقدس ودمشق، مقارنا بينها في أساليب الطلاق ودواعيه وكيفياته ومآلاته، وهو لا يقصر دراسته على بحث الطلاق لدى الأسر المسلمة وإنما يمتد ليدرس هذه الظاهرة لدى الأقليات اليهودية والمسيحية في الشرق الإسلامي، وهو يبرهن من خلال الوثائق على أن الكنائس المسيحية رغم رفضها لمبدأ الطلاق إلا أنها تأثرت بمحيطها الإسلامي واضطرت مرغمة على إضفاء الشرعية عليه.
ويمثل الكتاب خروجا وتحديا لنمطين من الرؤى والتصورات السائدة والمستقرة حول الطلاق؛ الأولى تتعلق بالرؤية الاستشراقية لظاهرة الطلاق في المجتمعات الإسلامية في العصور الوسيطة، فقد افترض المستشرقون أن المجتمعات الإسلامية كانت تنظر إلى الطلاق نظرة سلبية وتعمل على بقاء معدلاته عند حدوده الدنيا وقد رسخ من هذه الفكرة أن الطلاق يتناقض مع قيم الذكورية في الهيمنة والسيطرة، وغياب النزعة الفرية التي يمكنها أن تدفع الزوجين إلى الطلاق، والاعتقاد أن النساء مضطرات للتمسك بالزواج لكونهن لا يستطعن الخروج للعمل واكتساب عيشهن، وسيادة النظرة المعاصرة حول الطلاق في عصر الحداثة باعتباره هدم لكيان الأسرة، وكلها تتضافر وتوحي أن الطلاق كان ينظر إليه كما ننظر إليه نحن في أيامنا هذه.
أما الرؤية الثانية، فتتعلق بالصورة الذهنية التي ترسمها المؤلفات الفقهية والأدبيات الشرعية التي تصور الزوج قيمًا على زوجته –وعلى نساء أسرته الكبيرة أحيانا- ورأسا للسلطة الهرمية داخل أسرته، وأن دور الزوجة هو دور التابع لزوجها، ومن ثم فإن الطلاق يعد نازلة تحل على رأس الزوجة التي تفقد الرعاية الاقتصادية والاجتماعية للزوج، وتهدد بفقدانها حضانة أبنائها إذا ما قررت الزواج مجددا.
ويتساءل رابوبورت هل تعكس الرؤيتان واقع الأسرة في العصر المملوكي، واستدعت الإجابة طرح عدد من التساؤلات الفرعية من قبيل: ما هو مصير المطلقات بعد الطلاق، أين كن يذهبن، وما مصير الأبناء، وما هي موارد الرزق المتاحة أمام المطلقات، وماذا عن مواقف الأسر الاجتماعية من الزواج بالمطلقة؟ وبعد مناقشة مستفيضة خلص أن الصورة التي ترسمها الأدبيات الشرعية في العصر المملوكي تعد مثالية إلى حد بعيد وتعبر عن رؤية رجال الشريعة وتصورهم لشكل العلاقة الزوجية، حيث كما أن الصورة الاستشراقية تعد خيالية ولا تعبر أيضا عن حقيقة المجتمع في ذلك العصر الذي اعتبر الطلاق ظاهرة طبيعية ولم ينظر إليه بوصفه وصمة عار تلحق بالمرأة أو علامة على تحلل المجتمع ونذيرا بانهياره.
وتأسيسا على هذا يبحث الكتاب في الأسباب المؤدية إلى انتشار ظاهرة الطلاق، فيفرد للعوامل الاقتصادية الثلاثة فصول الأولى التي تدور حول الاستقلال المالي للمرأة، ويخصص للعوامل القانونية الفصلين الأخيرين، وبهذا التقسيم يكون قد أهمل دراسة بعض القضايا من مثل: أسس وقواعد اختيار الأزواج، وتعدد الزوجات، والتسري والحب الزوجي وكيفية التعبير عنه، وما إلى ذلك من قضايا مرتبطة بالطلاق.
يدرس الفصل الأول مسألة المهور وأثرها في تقسيم الملكية داخل المجتمع الإسلامي، ذلك أن النساء المملوكيات كن يتلقين مهورهن في شكل “الجهاز” الذي هو يصبح عقب الزواج ملكية خاصة لهن، وفي معظم الحالات كانت قيمة الجهاز تفوق قيمة المهر حيث كانت الأسر تعتبره جزء من نصيب المرأة في ثروة العائلة، ولذلك كانت قيمة الجهاز تسجل ضمن عقد الزواج وكانت الأسر تتفاوض لجعله كبيرا حتى يتعذر على الزوج الوفاء به حال الطلاق، وكما يستخلص رابوبورت في هذا الفصل فقد باتت المهور أحد أدوات إعادة توزيع الملكية داخل المجتمع.
ويركز الفصل الثاني على مسألة العمل النسائي المأجور، وهو يدرس مسألة العمل لدى النساء المتزوجات الذي كان قوامه النساء من ذوات المهور الأقل قيمة، ولدى النساء العزباوات اللواتي تركزن في قطاع النسيج، ويذهب إلى أن أجور النساء كان لها أثر فأجر المرأة المتزوجة كان أمر بالغ الأهمية لتحقيق التوازن داخل الأسرة ولفهم ظاهرة الطلاق المتكرر، وأما العازبة فربما أدى إلى بقائها بدون زواج لفترة طويلة بسبب استقلالها الاقتصادي وعدم اضطرارها للزواج من أجل الحاجة.
ويختص الفصل الثالث المعنون ب ” التسييل المالي للنفقة الزوجية” بالبحث في اقتصاديات الزواج من خلال تناول الصداق، وهو يرصد نماذج من مطالبات النساء بمؤخر صداقهن في حياة الزوج حيث كان الزوج يضطر إلى تقسيطه أحياناعلى أقساط سنوية، الأمر الذي يغاير الصورة الشائعة عن أن النساء لم يكن بمقدورهن المطالبة بذلك بسبب ضعفهن ورغبتهن في عدم تقويض الأسرة، كما يتناول أيضا مسألة النفقة الزوجية الواجبة على الزوج وهي القضية التي عالجتها المحاكم الشرعية كثيرا، والتي تحولت إلى عامل رئيس من عوامل انتشار الطلاق.
وينتقل الفصل الرابع إلى دراسة الجوانب القانونية للطلاق، فيميز أولا بين ثلاث صيغ تستخدم في إيقاعة، وهي الطلاق الذي هو حق للرجل، والخلع الذي هو أداة النساء لفصم الرابطة الزوجية حال تعنت الزوج ورفضه التطليق، والفسخ وهو قرار القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية بناء على أسباب معتبرة شرعا، ويقوده ذلك إلى دراسة نماذج تطبيقية من الطلاق نظرتها المحاكم الشرعية مقارنا إياها بالنماذج التي نظرتها المحاكم العسكرية المملوكية ذاهبا إلى أن الأخيرة بفعل تدخلها المتزايد في الشئون الأسرية وفرت ملاذا قضائيا للنساء من تهديدات الطلاق التي امتلكها الرجال.
وأما الفصل الخامس والأخير فيختص بدراسة موقف علماء الشريعة من الطلاق وذلك من خلال موقفهم من “أيمان الطلاق” وهو طلاق معلق على عمل يقوم به أحد الزوجين، وهو يدرس محاولة ابن تيمية وتلاميذه لتغيير ما هو سائد ومتفق عليه حول يمين الطلاق؛ حيث قاس يمين الطلاق على الحلف بالله وافترض أن يمين الطلاق يتطلب عمل من أعمال الكفارة ولا يتطلب حل عقدة النكاح، وبعد أن منع مرتين من الإفتاء زج به في السجن في نهاية الأمر، وهو ما حدا برابوربورت إلى الاعتقاد أن الأمراء المماليك اعتبروا الطلاق شأنا عاما يتطلب تدخلهم وليس شأنا خاصا يمكن حسمه بين الأفراد.
وبالجملة، يعدُ كتاب رابوبورت واحدًا من الكتابات التي تميط اللثام عن جانب مجهول من التاريخ الاجتماعي الإسلامي، ومما يحسب له أنه لم يقع أسيرا للسرديات الاستشراقية المعتادة حول المرأة المسلمة في القرون الوسيطة إلا أنه رغم ذلك شابه الانطلاق من المنظور النسوي في دراسته، واستخدمه لمصطلحاته مثل “الجندر” و”الذكورية” و”البطريركرية” وما إلى ذلك، وللمرء أن يتساءل هل يمكن للمؤرخ أن ينطلق في دراسته للتاريخ من المناهج والمصطلحات المعاصرة التي صيغت لتلائم المجتمعات والعلاقات المعاصرة، وهل يعد اللجوء إليها انحيازًا مسبقًا لأفكار معينة يُراد إسقاطها على الواقع التاريخي.