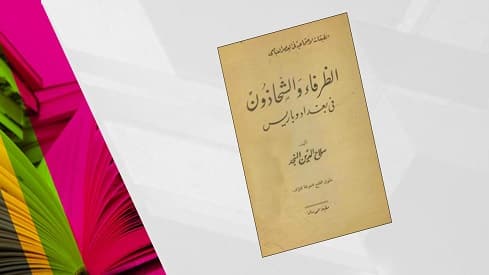التاريخ الاجتماعي -بشكل عام- هو العلم الذي يركز على الاهتمامات الاجتماعية في التاريخ، ويرصد حركة المجتمع بمختلف طبقاته وفئاته، وقد ازدهر بصفته علما مستقلا خلال الستينات والسبعينات من القرن العشرين، مجسدا ردة فعل على تركيز دراسات التاريخ الاقتصادي والسياسي في فئات الصفوة.
ويعتبر التاريخ الاجتماعي من أهم أنواع التاريخ، ذلك بأنه يصور الجانب الأعمق من حياة الأمم والمجتمعات، ويكشف عن طباعها المستكنة وعاداتها الظاهرة، ويتناول بالتوثيق ما يختلج في نفوس عقلائها وما ينطلق فلتاتٍ على ألسنة مجانينها، فهو يعبر عنها أصدق تعبير وأدقه، وليس التاريخ السياسي -في حقيقته- إلا مظهر بسيط لتفاعلات التاريخ الاجتماعي، مع أنه أي التاريخ السياسي يهتم بالمتغير والمتحول سريعا، أما التاريخ الاجتماعي فيهتم بالثابت والمستمر طويلا، فالتغيير الاجتماعي لا يقع -غالبا- إلا بعد قرون.
ورغم أهمية التاريخ الاجتماعي إلا أنه لم يحظ لدى المسلمين بأهمية كبرى، ومع ذلك فلا يعدم الناظر في تراثنا الإسلامي القديم مصنفات اهتمت بهذا الجانب، وتأتي كتب الجاحظ في مقدمة ذلك، وفي العصر الحديث كتب العلامة صلاح الدين المنجد بحثا طريفا لطيفا عميقا بعنوان: (الظرفاء والشحاذون بين بغداد وباريس)، سنحاول التعريف به في هذا المقال.
يقدم المنجد في بحثه الظريف الطريف صورة طبقتين متباينتين في السلم الاجتماعي هما: طبقة (الظرفاء) التي تمثل الطبقة الأرستقراطية في ذلك العصر، والتي تقع في أعلى الهرم الاجتماعي، وطبقة (الشحاذون) التي تقبع في قاع الهرم الاجتماعي، ويقارن بين هاتين الطبقتين في مدينتين تمثل كل واحدة منهما رمزا لحضارتها، وفي زمنين يمثلان أوج ازدهار كل منهما، وهما (بغداد القرن الرابع الهجري) و(باريز القرن العشرين).
وقد بين المنجد في مقدمة كتابه دوافعه للكتابة في هذا الموضوع، ومنها “إظهار الحضارة الإسلامية وما بلغته من سمو وعلاء”، وقد رصد ظاهرة غياب هذا النمط من التأليف عن التراث الإسلامي، وفسره بأن أهل كل فن صرفهم الوفاء لعلومهم عن رصد هذه الطبقات وتدوين حياتها وتقاليدها، “فالأدباء كانوا يقصدون اللهو، والمؤرخون عقلتهم حادثات السياسة والحرب فأهملوا المجتمع، وعلماء البلدان تركوا صورا قلائل قد تفيدك، والرحالون غرهم ما كانوا يلاقون من إكرام وترحاب، فوصفوا ما أحاط بهم، من مظاهر خارجية، وأهملوا التحري والاستقصاء”.
عرض المنجد في كتابه لتعريف الظرف والظرفاء وآدابهم المرعية وتقاليدهم في اللباس والزينة والهدايا والتحف، مبرزا تفوق البغداديين على الباريزيين في ذلك، رغم تباعد الأزمنة وتباين الأمكنة، كما أوضح أن الفرس هم من علموا العرب وأورثوهم هذه العادات والتقاليد المترفة الناعمة.
وناقش أيضا ارتباط الظرف في بغداد بالمروق من الدين والتهتك والفسوق، مما يذكر بحال كثير من شبابنا المعاصر الذي يرى أن المدنية متلازمة مع ترك الصلاة ورقة الدين وتبني الآراء العقدية المنحرفة والشاذة، قال: “أصبحت الزندقة سبيلا إلى الظرف، وأضحى الجاهل الغر يتطفل على الزندقة، وينتحلها ليعد من الظرفاء.
أما في باريز فقد “نشأ مبدأ الظرف في قصر رامبويه، وكانت المركيزة صاحبته أول من دعا إلى الظرف في فرنسا، فكان يجتمع في قصرها العظيم الظراف الكبار من الأرستقراطيين والأدباء والشعراء”، ثم تلتها بعد بعد ذلك في هذا السبيل السيدة مدام لامبيير ففتحت بهوها وأحاطت نفسها بالأدباء والفلاسفة، وتبعتهم مدام دُدِيفاند والآنسة دونيسبيناس، وأصبحت هذه الأبهة الأدبية مركز الظرف.
وعند المقارنة بين تقاليد الظرفاء وأذواقهم في بغداد وباريس سيلاحظ القارئ أن ظرفاء بغداد كانوا أرهف حسا وأسمى ذوقا من ظرفاء باريس، فقد سبقوهم إلى كل طريف وظريف، فستجد التفنن في الأطعمة، والحرص على المشاكلة بين أجزاء قطع الثياب، وتناسق ألوانها مع لون الحذاء والخاتم إلخ، إلى أذواق عالية في تقاليد الإهداء بين المحبين.
أما الشحاذون المساكين فقد كانوا أيضا يعيشون في بؤسهم وحرمانهم إلى جانب أولئك المتنعمين الظرفاء، وقد كانت بغداد القرن الرابع الهجري مدينة بالمفهوم المعاصر، حيث لا ترحم المدن الكبيرة إلا الموسر والقادر على معافسة الحياة فيها بجهده وماله، فهي كما قال الشاعر: تصلح للموسر لا لامرئ ** يبيت في فقر وإفلاس
فهذا أبو الشمقمق يجوع في بغداد إلى الحد الذي يدع عياله يأكلون خبز الغضارة، ويشربون بول الحمارة، وهذا أبو فرعون يحمل صبيته على ظهره ويطوف بهم أسواق بغداد لعله يجد من يطعمهم أو يكسوهم، وغيرهم مئات حالهم أبأس وأرذل من ما ذكرنا.
وقد اكتظت شوارع ومساجد بغداد القرن الثالث والرابع الهجريين بالشحاذين المتوسلين، الذين يتسقطون فتات الموائد من منازل الأغنياء الموسرين، تماما مثلما كانت باريس تعج بالبؤساء والمحرومين، لكن بؤساء بغداد مثقفون وعلماء وشعراء، أما بؤساء باريس فكانوا ذوي عاهات وجهلة وقتلة.
وكانت للشحاذين في بغداد تقاليد مرعية، رصدها الجاحظ الذي كان أول من اهتم بهم وكتب عنهم، فقد سرد في وصية خالويه المكدي لابنه، عندما جاءه الموت عددا من فِرَقِهم، وبَيَّنَ طرفا من أسرارهم، فقال: “وهذا خالويه المكدي، وكان قد بلغ من البخل والتكدية، وفي كثرة المال المبالغ التي لم يبلغها أحد. قالوا له: أتعرف المكدين؟ قال: وكيف لا أعرفهم، ولم يبق في الأرض مخطراني، ولا مستعرض الأقفية، ولا شحاذ، ولا كاغاني، ولا بانوان، ولا قرسي، ولا عواء، ولا متشعب، ولا مزيدي، ولا إسطيل، إلا وكان تحت يدي، ولم يبق في الأرض كعبي ولا مكد إلا وقد أخذت العرافة عليه”.
وهذه كلها مصطلحات لفرق الشحاذين وطبقاتهم بناء على طريقة كل واحد منهم في السؤال والشحذ، وأنت ترى أن هذه المصطلحات تشكل ثروة اجتماعية وثقافية ولغوية هائلة يمكن أن تكون موضوع بحث ودراسة.
وفي الختام فإن كتاب (الظرفاء والشحاذون في بغداد وباريس) لصلاح الدين المنجد كتاب لطيف غزير النفع طريف الفكرة، جمع فيه المؤلف مادة مكتنزة ثرة عن هاتين الطبقتين، ووضع أيدينا على جانب مهمل من تاريخ الحضارة الإسلامية، وأبرز سَبْقَهَا في أمور كثيرة، ومنها تقاليد الظرف التي يظن كثير من ناشئتنا بل مثقفينا أنها جاءتنا مع الغرب ومنه.