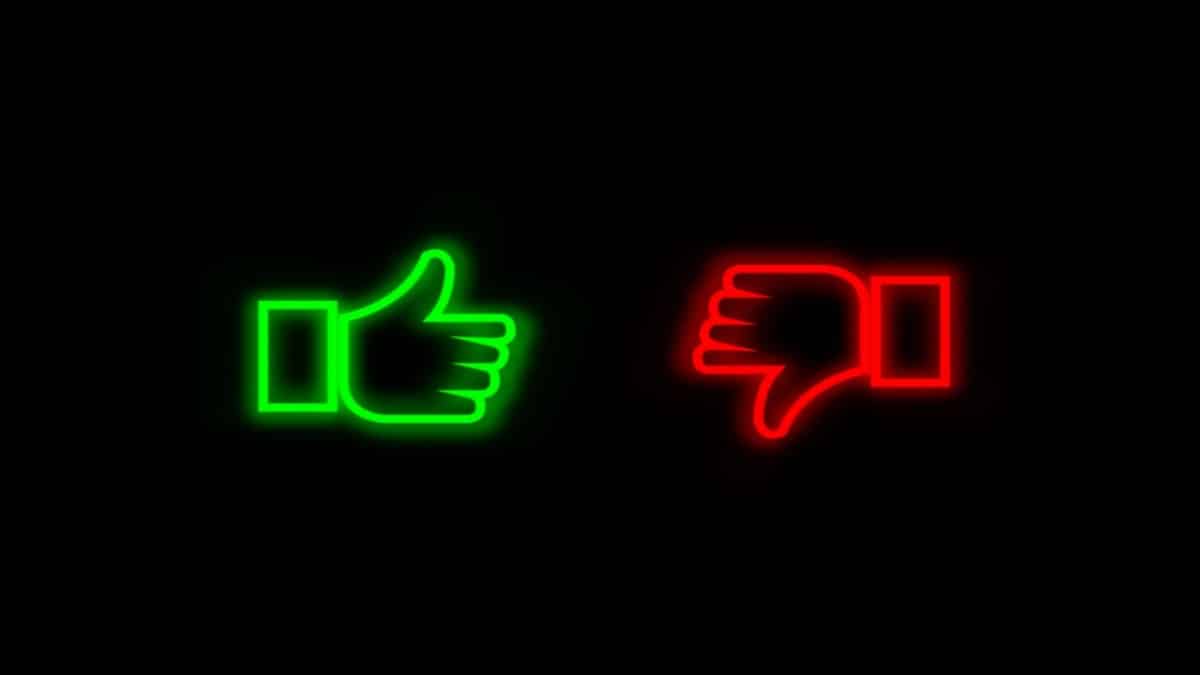جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال: قال النبي ﷺ: «الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم، كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم، أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه».[1]
إن اللَّه يغار على حرماته، ويغضب إذا ارتكبت محارمه، وما لحق رسول الله ﷺ بالرفيق الأعلى إلا كانت الشريعة واضحة المعالم، حلالها وحرامها، وهنا يقول “الحلال بين، والحرام بين” كل المسلمين يعلمون الحلال من المأكل والمشرب والملبس والمركب والنكاح والمعاملات وما يحتاجونه في حياتهم، ومن خفي عليه منهم حكم وجد العلماء الراسخين في العلم يستجيبون لكل سائل في ليل أو نهار، دون مقابل، فتلك رسالتهم، وهذا واجبهم، فلا عذر لجاهل أو متجاهل، ولا عذر لمشتبه في الأحكام، فقد ترك ﷺ فينا ما إن تمسكنا به لن نضل بعده أبدًا، كتاب الله وسنة نبيه محمد ﷺ.
نعم هناك بعض الأمور القليلة التي قد يخفى حكمها على العامة، ويترددون في حلها وحرمتها، بل قد يخفى حكمها على غير الراسخين في العلم، فيبدو خلاف فيها بين العلماء، منهم من يحلها، ومنهم من يحرمها، والأسلم حينئذ اتقاؤها، والبعد عنها، كأنها محرمة باتفاق وبظهور دون إخفاء، فإن كانت في حقيقة الأمر محرمة فقد برئ منها، واجتنبها، وبعد عنها، وإن كانت في حقيقة الأمر حلالاً، وبعد عنها خوفًا من الوقوع في الحرام، أثيب على هذا القصد ونال أجرًا.
فالبعد عنها مكسب على كل حال والوقوع فيها خسارة على كل حال، إن كانت حرامًا ووقع فيها، وإن كانت حلالاً، ووقع فيها تجرأ على الوقوع في أمثالها، وتساهل في الشبهات، ولم يتحرز عما هو قريب من المحرمات، فيقع في الحرام من غير قصد، والعاقل من ترك ما يريبه، ويشك فيه، وعمل بما لا يريبه، ولا يشك فيه[2]، عملاً بقوله ﷺ: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس».[3] وطهارة القلب، وإبعاده عن الريب والشك أفضل الطاعات.
والاحتياط في أمور الدين ** من فر من شك إلى يقين
وهذا يحيل إلى قصة ابي العلاء المعري الشاعر من جادله في البعث وأنه يضيع عمره سدى في الصلاة والصيام والطاعات فرد عليهم بمنطق سليم ورأي مكين:
قالَ المُنَجِّمُ وَالطَبيبُ كِلاهُما ** لا تُحشَرُ الأَجسادُ قُلتُ إِلَيكُما
إِن صَحَّ قَولُكُما فَلَستُ بِخاسِرٍ ** أَو صَحَّ قَولي فَالخُسارُ عَلَيكُما
طَهَّرتُ ثَوبي لِلصَلاةِ وَقَبلَهُ ** طُهرٌ فَأَينَ الطُهرُ مِن جَسَدَيكُما
وَذَكَرتُ رَبّي في الضَمائِرِ مُؤنِساً ** خَلَدي بِذاكَ فَأَوحِشا خَلَدَيكُما
إِن لَم تَعُد بِيَدي مَنافِعُ بِالَّذي ** آتي فَهَل مِن عائِدٍ بِيَدَيكُما
وهذه الجملة في الحديث: (الحلال بين والحرام بين.. إلخ)، فيها تقسيم الأحكام إلى ثلاثة أشياء؛ لأن الأمر إما أن ينص على طلبه مع الوعيد على تركه، أو ينص على تركه مع الوعيد على فعله، أو لا ينص على واحد منهما، فالأول الحلال البين والثاني الحرام البين؛ فمعنى قوله (الحلال بين) أي لا يحتاج إلى بيانه ويشترك في معرفته كل أحد والثالث مشتبه لخفائه فلا يدرى هل هو حلال أو حرام؟ وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه؛ لأنه إن كان في نفس الأمر حراما، فقد برئ من تبعته وإن كان حلالا فقد أجر على تركه بهذا القصد، ولا يعول على الأصل في الأشياء إذ مختلف فيه حظرا وإباحة …
وقد يفهم من الحديث منع إطلاق الحلال والحرام على ما لا نص فيه وقال به بعض أهل العلم؛ لأنه من جملة ما لم يستبن، لكن قوله ﷺ لا يعلمها كثير من الناس يشعر بأن منهم من يعلمها.
وجملة: (يوشك أن يواقعه) تقتضي الدنو، القرب أي قرب؛ لأن متعاطي الشبهات قد يصادف الحرام وإن لم يتعمده أو يقع فيه لاعتياده التساهل.[4]
وجملة: (لا يعلمهن كثير من الناس) جاء المقصود بها بينا واضحًا في رواية الترمذي بلفظ “لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي؟أم من الحرام؟ “ ومفهوم “كثير” أن معرفة حكمها ممكن وواقع، يعلمه القليل من الناس، وهم العلماء المتخصصون المجتهدون، فهي شبهات – على هذا – في حق غيرهم، أما في حقهم فتصبح بينة الحل أو الحرمة، والمشتبهات اختلف أهل العلم في المراد بها:
قال ابن حجر “: وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء:
أحدها: تعارض الأدلة كما تقدم.
ثانيها: اختلاف العلماء، وهي منتزعة من الأولى.
ثالثها: أن المراد بها مسمى المكروه، لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك.
رابعها: أن المراد بها المباح، ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه، بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأولى… والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادا ويختلف ذلك باختلاف الناس”.[5]
والأكثر على أن المشتبهات، ما ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس، ولا يعلمون حكمها. ولعل الحكمة من وجودها كذلك في التشريع أن تكون شاهدًا على قصور العقل البشري، فلا يغتر، ولا يتمرد، ويستسلم، ويعترف بصحة قوله تعالى {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: 85]{وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} [يوسف: 76] وهذان القولان يتساوقان مع قوله تعالى {وَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ } [آل عمران: 7] فالرأي الأول يتفق مع من وقف على {والراسخون في العلم} أي يعلمون تأويله، والرأي الثاني يتفق مع من وقف على {وما يعلم تأويله إلا الله} أي والراسخون في العلم لا يعلمون تأويله، ويسلمون به.
(فمن اتقى الشبهات) أي جعل بينه وبين الوقوع فيها وقاية، أي من بعد عنها، وحذر منها، ومن الوقوع فيها، واستوثق في دراستها للعلم بحكمها و”الشبهات” بضم الشين وضم الباء، جمع شبهة.[6]
وجملة: (والمعاصي حِمى الله) وفي رواية للبخاري وغيره «ألا إن حمى الله تعالى في أرضه محارمه» المراد بالمحارم والمعاصي: فعل المنهي المحرم، أو ترك المأمور الواجب، والحِمَى: المحمي.. وفي اختصاص التمثيل بالحمى نكتة،وهي أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مخصبة يتوعدون من رعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة، فمثل لهم النبي – ﷺ – بما هو مشهور عندهم، فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه فبعده أسلم له، وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه، فلا يأمن أن يقع فيه بعض مواشيه بغير اختياره، وربما أجدب المكان الذي هو فيه ويقع الخصب في الحمى فلا يملك نفسه أن يقع فيه، فالله سبحانه هو الملك حقا وحماه محارمه.[7]
[1] ـ صحيح البخاري / الحديث رقم: (2051).
[2] ـ فتح المنعم شرح صحيح مسلم (6/ 329).
[3] ـ سنن الترمذي / الحديث: (2451).
[4] ـ فتح الباري لابن حجر (4/ 291).
[5] – نفس المصدر: (1/127).
[6] ـ فتح المنعم شرح صحيح مسلم (6/ 330).
[7] ـ نيل الأوطار (5/ 247).