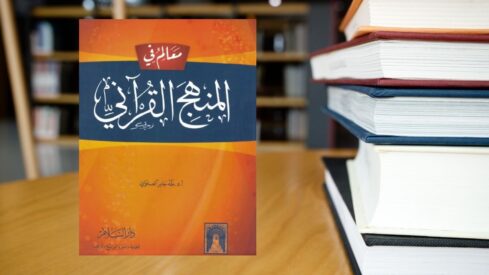استعرض كتاب :” معالم في المنهج القرآني ” لمؤلفه الدكتور طه جابر العلواني-رحمه الله- قضية القضايا للفكر الإسلامي في هذا العصر الجديد الذي يتشكل ويتبلور من حولنا؛ قضية المنهج والمنهجية، تلك القضية التي يتوقف على التجديد فيها حصول تجديد حقيقي في فكرنا الإسلامي، وتغيير قواعد ممارسة العلم والعمل داخل أمتنا تمهيدا لشهودها الحضاري الذي طال انتظاره.
في هذا الكتاب المكون من مقدمة وفصلين حاول الدكتور العلواني أن يلفت أنظار الباحثين في الفكر الإسلامي إلى أن أهم أسباب أزمتنا الحضارية الراهنة هو غياب”المنهاج القرآني”، وأن هناك حاجة حاجة ترقى إلى مستوى الضرورة للبحث عن معالم هذا المنهج القرآني الذي هو السبيل الممهد للإجابة عن سؤال أزمتنا الراهنة بشكل صحيح .
ما المنهج ؟
المنهج-كما يبين المؤلف-هو وسيلة إلى قيادة العقل الإنساني إلى الحقيقة، أو إلى ما يغلب على الظن أنه الحقيقة، وهو ضابط صارم يحدد للعقل مساره بمنتهى الصرامة، سواء أمارس العقل التحرك في الكون، أم في نصوص الوحي بحثا عن الحقيقة.فهو وسيلة وأداة لبناء قواعد التفكير، وإرساء دعائم ضوابط البحث العلمي والمعرفي، التي من شأنها أن تعصم الذهن من الوقوع في الخطأ في الفكر وفي البحث العلمي.وللمنهج مصادر بناء وتكوين تنتجه فإذا صلحت مصادر التكوين المنهجي، واستقامت صلح المنهج واستقام، وإن هي اختلت أو اضطربت اختل المنهج واضطرب (ص27-30). والمؤلف يؤكد أن المراد”بالمنهاج” المقترن مع”الشرعة” ليس المعنى البسيط السهل المتبادر إلى الذهن، وهو المعنى اللغوي أي:الطريق النهج أو الواضح، البين، بل المعنى الواسع اتساع”الشرعة” التي اقترن بها، وهو المعنى الفلسفي (ص147).
المنهج العلمي الحديث
يتناول المؤلف تطور المنهج العلمي الحديث من “العقل الفطري” إلى”العقل الفطري الوضعي” الذي تطور بدوره إلى “العقل الوضعي” الذي أنتج مذهب”الوضعية”.مؤكدا أن الوضعية تعبر عن نظرة فلسفية متكاملة إلى الكون والحياة والإنسان، تتسم بتكريس العلمانية، وتكريس مبدأ عزل التصورات والمفاهيم الدينية عن القضايا العلمية، والتأكيد على ضرورة ارتباط المنهج في العلوم الإنسانية بالنموذج الطبيعي التجريبي، واعتبار ذلك وسيلة وحيدة للكشف عن الحقائق العلمية في مجال الطبيعة أو مجالات الإنسان، وإبعاد الفكر الديني الميتافيزيقي عن المنهج في الإطار المعرفي الوضعي إبعادا تاما (ص40-41).
وقد فتحت “الوضعية” الباب على مصراعيه نحو”العقلية العلمية” عبر عمليات هدم وتفكيك أدت إلى بروز”العقلية العلمية” التي قادت البشرية نحو”القواعد المنهجية المشتركة للتفكير”.ثم تكرس انتصار العقلية العلمية ونجحت وبهرت الناس وأصبحت”قواعد التفكير المشتركة” التي أوجدها العلم، والضوابط المنهجية المنبثقة عنه هي القاعدة التي يتحرك الجنس البشري في جميع أنحاء العالم وفقا لها بمستويات مختلفة (ص37). وبذلك صار العلم إطارا لحركة العقل البشري لا يقاس إلى شيء، بل يقاس كل شيء عليه.
وهم الحياد المنهجي
يشدد المؤلف على ضرورة وعينا بأنه ليس هناك منهج علمي محايد مستقل عن الفلسفة التي انبثق منها، فمناهج البحث قد تم توظيفها لدى المذاهب المعاصرة لتكرس تصوراتها، وتعبر عن رؤيتها الكلية حول العالم والإنسان والحياة.والمناهج السائدة كلها قد استبعدت الوحي والدين، ولم تسمح بحال أن تكون للرؤية الدينية-ظاهريا- أي تأثير على المنهج.وإن كان المؤلف يؤمن عن خبرة وتجربة بالتأثير غير المباشر للتصورات والرؤى التوراتية والتلمودية في مناهج العلوم الاجتماعية المعاصرة (ص40).
استعمار .. لا عالمية
يرى المؤلف أن ولادة العقل العلمي في أوربا بكل ما كان ولا يزال فيها من رواسب ونقائض، جعل”العالمية” التي كان يمكن للعلم أن ينتجها للبشرية، تتحول إلى استعمار يوظف العلم للسيطرة والهيمنة الاستعمارية (ص38).فمنذ القرن التاسع عشر حتى اليوم وتلك العقلية تسيطر على العالم-كله- وتنحت وتذيب خصوصيات الأمم والشعوب (ص38). لقد أوربا حولت الإنسان عن مسيرته باتجاه “الضوابط المنهجية للتفكير الإنساني المشترك”لتدخله عالم الاستعمار، فصادرت توجهاته المعرفية نحو الوحدة الإنسانية، أو ما يهيىء لها في الأقل، ثم تسلمت أمريكا الراية من أوربا لتحول تلك الاتجاهات-كلها- إلى عولمة مفتعلة قائمة على مطامع شركاتها الكبرى وجشعها، وسياسات توظيف النفوذ السياسي لخدمتها (ص 39).
مصادرة .. لا عولمة
فالعولمة التي انبثقت عن عولمة وسائل الإنتاج صارت مصادرة على”عالمية قرآنية” كانت تنتظر فرصتها للظهور موظفة وحدة التفكير المنهجي الذي أنتج قواعد علمية مشتركة بين البشر، وحقق عالمية الانتماء والتفاعل بين بني الإنسان، وعالمية القواعد المشتركة للتفكير. هذان الوجهان للعالمية يحتمان على صاحب أي خطاب، وكل خطاب أن يكون خطابه عالميا، وأن يتوجه نحو القواعد المشتركة للفهم البشري الحالي التي يضبطها ويحكمها”منهج علمي صارم” لا يسمح للأوهام والأخطاء والخرافة والشعوذة أن يتسرب شيء منها إلى العقل الإنساني (ص39) .
أزمات دون حل
وهنا نستطيع أن ندرك أسباب فشلنا في العثور على حلول قرآنية لأزماتنا وإجابات شافية عن عويص إشكالياتنا ومسائلنا، لأننا نقارب القرآن من زوايا مختلفة، ليس”المنهج” من بينها.فبعض الأحيان نقاربه تعبدا، ونقاربه بواسطة التفاسير بكل ما فيها، ونقاربه أحكاما وفقها، ولكننا لا نقاربه مقاربة منهجية بحثا عن كوامن”المنهجية الكونية التركيبية ومحدداتها”فيه، بل إن الأكثر لا يقرون بوجود منهج علمي في القرآن، فبعضهم ينكر ذلك جهلا، وبعضهم ينكره لأسباب أخرى عديدة (ص104-106).
منهج الخروج من الأزمة
الأزمة الكونية القائمة على “كونية المنهج” لا يمكن الخروج منها، وإنقاذ المنهج من إشكالاتها، إلا بكتاب كوني يستوعب التفكيك، وينطلق في مجالات إعادة التركيب، ويستوعب العدمية والعبثية ويتجاوزها ليتجه باتجاه الغائية، ويعيد بناء سائر التصورات والمفاهيم الكونية التي أهملتها أو فككتها نظريات العلم المنبت عن ينابيعه الإلهية وغاياته الربانية الكونية، وما نجم عن نظريات ما عرف “بالحداثة وما بعد الحداثة” من تفكيك خطير لم تصحبه قدرات تركيبية موازية له (ص 23). والمؤلف من خلال توكيده على ضرورة الكشف عن منطق القرآن، ومنهجه يريد الوصول إلى التوكيد بيقين أن الأزمات الإنسانية قد استفحلت واستبسلت، بحيث لم يعد من الممكن معالجتها بأي فكر أو منطق غير الفكر الكوني والمنطق الكوني (ص82).
القرآن..المنهج الكوني
لذلك يطرح الدكتور العلواني فكرة وجود “منهج قرآني” انطلاقا من قوله تعالى:”لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا”.مؤكدا أن ورود كلمة “منهاج” في قوله تعالى”لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا”، كانت بمثابة إعلان وتنبيه للمتدبرين عن وجود هذا المفهوم في هذا الكتاب الكوني العظيم الذي نزل”تبيانا لكل شيء” (ص67-.68). فمفهوم”المنهاج القرآني” أهم المفاهيم القرآنية، بعد التوحيد.
البداية .. فقه الواقع
يؤكد المؤلف أن”مفهوم الواقع” هو نقطة البداية الصحيحة في إطار محاولة الكشف عن”منهج القرآن المجيد في إعادة بناء الأمة”، وهو”علم جديد” له مبادئه ومكوناته ومقاصده، يمكن أن نطلق عليه”فقه الواقع” “.وموضوع هذا الفقه” يتناول الأفكار والتصورات والعقيدة وأركانها وأثرها في بناء الرؤية الكلية، وتأسيس الدواعي والدوافع والإرادات، وإيجاد الوعي التام بها بالنوايا والعزائم الصادقة، ووسائل تقييم الفعل الانساني ومعرفة مآلاته، وآليات التغيير وعوامل الاستمرار في الواقع والتجديد والتجدد الذاتي، وعلاقة عناصر وأركان واقعنا بعناصر وأركان واقع الآخر، كل ذلك إدراك لشروط ودعائم العمل الفكري، وكيفيات نشر الأفكار (ص99).
من الواقع إلى النص
ينبه المؤلف إلى أن فقه الواقع سيؤدي إلى نقلة حقيقية في كيفية صياغة أسئلتنا المتعلقة بأزمات واقعنا بشكل صحيح، مما يؤدي لإجابات قرآنية تسهم في حل هذه الأزمات..ففي عصر النبوة كان القرآن هو الذي ينزل على الواقع فيعالج مشكلاته….فلم تثر مشكلات إلا وكان القرآن يتنزل بحلها.
أما في عصرنا هذا، فإن الأمر قد اختلف، فنحن المطالبون-الآن-بأن نتقن دراسة وتحليل وفهم مشكلاتنا وصياغتها بصيغة السؤال، ثم نأتي بها إلى القرآن لنطرح بين يديه ونلتمس منه الجواب أو الهداية إليه فنتلوه ونحاوره حتي نبلغ سبيل الرشد في أزمتنا…. فوحدهم الذين يفضي القرآن إليهم بمكنون منهجيته-كما يؤكد المؤلف-هم أولئك الذين يبحثون بين يديه وملؤ عقولهم ونفوسهم وجلودهم هم عام و”أزمة عالمية أو إقليمية” في الأقل، لم يجد أولئك لها حلا من داخل أي نسق معرفي بشري سواء أكان موضوعيا أو وضعيا، فجاءوا القرآن ضارعين خاضعين يلتمسون الحل فيه وهم على يقين أن الحل لا يخرج عن محكم آياته.
مداخل البحث في قضايا المنهج
ينبه المؤلف أن النصوص المتعلقة بالمنهج يمكن الوصول إليها بجهود أخرى ووسائل قد تختلف قليلا أو كثيرا عن جهود ووسائل المجتهدين في قضايا الأحكام، فإذا كانت صيغ آيات التشريع والأحكام ظاهرة بينة بنصوصها ودلالاتها والقرائن والأمارات التي تنبه إليها مما يسر على الأصوليين عمليات رصدها وإحصائها ولو بشكل تقريبي، وإذا كان المجتهد في قضايا الأحكام يهتم بصيغ الأمر والنهي والعموم والخصوص والإجمال والبيان والحقيقة والمجاز وما إلى ذلك…
فإن الباحثفي قضايا”المنهج والمنهجية” لابد أن يستوعب ذلك-كله- ويضيف إليه مداخل أخرى نحو”الجمع بين القراءتين”، والنظر إلى القرآن المجيد المكنون في”وحدته البنائية”و”اياته وسننه بأنواعها” ،إضافة إلى ضرورة المران على معرفة وتمييز المطلق من المقيد، والنسبي والثابت من المتغير، وما يتعلق بعالم”الغيب المطلق”-عالم الأمر- وما يتعلق “بالغيب النسبي” الذي يتكشف على الزمن، وما سيق لاستيعابه وتجاوزه أو للتصديق عليه والهيمنة عليه بعد ذلك، وما يندرج من ذلك في عالم الإرادة، أو عالم المشيئة وما سيق من أخبار الماضين لوعظ الآخرين، وبيان النعمة الإلهية عليهم بالتخفيف والرحمة، وما سيق للتوكيد على ضرورة الالتزام به والتأسي بالنبيين الذين جاؤوا به، أو للإشارة إلى نسخه وتجاوزه لمعرفة مواطن الاتفاق والاختلاف مع الأمم السابقة.وهذا-كله- ينبه إلى أن”المنهج القرآني” أمر يحتاج إلى بحث وجهد وكد وكدح.
المحددات المنهجية القرآنية
يشير المؤلف إلى أنهناك ثلاث محددات منهجية قرآنية أساسية هي :
الأول: التوحيد باعتباره محور الرؤية الكلية القرآنية .
الثاني: الجمع بين القرآتين: قراءة الوحي وقراءة الكون.
الثالث: الوحدة البنائية للقرآن الكريم والاستيعاب الكوني.
هذه المحددات الثلاثة، وفي مقدمتها”الجمع بين القرآتين”، تكشف لنا عن استيعاب القرآن المجيد لمبدأ”الصيرورة”، وتعطي للصيرورة مدلولا كونيا يستوعب المعنى الوضعي ويتجاوزه (ص88 ).وهذا الجمع بين القرآتين، إنما هو خطوة منهجية تتوقف على معرفة منهجية وفلسفة العلوم الطبيعية ليتم الجمع بينهما وبين منهجية القرآن المعرفية بالشكل المنهجي (ص 89). ومن هنا فإن الانطلاق من آية سورة المائدة لصياغة المفهوم قرآنيا، وقراءة جميع الآيات التي أوردت شبكة من المفاهيم الفرعية والمصطلحت القرآنية الإلهية التي أحاطت بمفهوم “المنهاج” في إطارها كما تحيط حبات العقد بواسطته..مثل:الصراط المستقيم والسبيل الأهدى والسبيل السوي وسبيل الله والهدى والنور والاتباع والاقتداء والشفاء والأسوة الحسنة والطريق الواضح البين الذي لا يخشى سالكه تيها أو ضلالا، هو السبيل للتوصل إلى المنهج القرآني (ص 68).
دور السنة في بناء المنهج المعرفي القرآني
يؤكد المؤلف إن القرآن المجيد، هو المصدر المنشىء الوحيد للمنهج، وتتكامل السنة الثابتة معه في جانبها الموحى به بوصفها المصدر المبين على سبيل الإلزام.كما أنها المصدر التطبيقي الذي يقدم للبشرية”نموذج التأسي” بما يشتمل عليه من ترجمة عملية للهدى القرآني، ونقله إلى سلوكيات إنسانية تندرج فيها المواقف التاريخية بأبعادها الزمانية والمكانية(ص125).
ففي الكتاب الكريم”تنظير” كما نعبر في أيامنا هذه، وفي السنة”تطبيق”.وفي القرآن خطاب، وفي السنة بيانه وتأويله العملي والقولي.ولذلك كان لكل منهما منهجه في التعامل وأدواته، والاختلاف في مناهج التعامل وأدواته لا يغير من طبيعة العلاقة بينهما في الاستنباط المنهاجي والترابط بينهما.ويؤكد المؤلف على حصر دائرة إنتاج مفاهيم إنتاج” الإطار المرجعي” في جانبها المصدري والتنظيري في الكتاب الكريم بوصفه المصدر المنشىء، والسنة الثابتة بوصفها المتكاملة معا والمصدر المبين (ص128). فما يمكن أن يندرج تحت مفهوم”منهج” هي تلك السنن المطبقة لتعليمات وأوامر الكتاب الكريم، فهي بيان تطبيقي يقترن فيها في كثير من الأحيان القول بالعمل، مثل:”صلوا كما رأيتموني أصلي” ص137.
وفي إطار المنهج لا يستقيم القول بوجود”منهج” في القرآن، والقول:إن رسول الله-صلى الله عليه و سلم- قد أعطي خوارق حسية متحدى بها،كالخوارق التي أعطاها الله موسى وعيسى ومن سبقهما من رسل وأنبياء، فالقرآن قد خاطب العقل الإنساني بخطاب يستطيع العقل الإنساني التحاور معه، وإن كان يعجز عن تحديه الإتيان بمثله.وإذا فهمنا الفرق بين المعجزات الحسية ومعجزة القرآن، هو التحدي، فلن نتوقف طويلا عند محاولات نفي أو تأويل أو تفسير المعجزات الحسية…ولكن التفسير الأكثر علمية للمعجزات الحسية هو تفسيرها بطريقة منهجية باعتبارها مؤشر وعي على طبيعة العلاقة بين عوالم الأمر الإلهي والإرادة الإلهية والمشيئة الربانية، وإدراك للعلاقة بين عالمي الغيب والشهادة (ص140).
ثمرات المنهج القرآني
أولا: المنهج القرآني يجدد علومنا
يؤكد المؤلف أن التوصل إلى”المنهج القرآني” أمر لابد منه لمراجعة تراثنا وتنقيته، والتصديق عليه، لأن الحياة لا تقف والمستجدات لا تنقطع. والمنهج القرآني هو القادر على أن يراجع ما بني حول القرآن المجيد من تراث، ويقدمه إليه لتصديقه بعد نقده وإعادته إلى حالة الصدق، ثم الهيمنة عليه، واستيعابه وتجاوزه بحيث تكون الهيمنة والمرجعية دائما للقرآن على كل ما عداه، ويكون الحجة والناطق بالحق على كل ما سواه.كما أن المنهج القرآني يمكن الباحثين من تحديد فترات التوقف والانقطاع في تاريخنا وتراثنا (ص145). بل إن مشكلات عصر التدوين التي أحاطت بالقرآن وحجبت الكثير من أنواره لا يمكن تجاوزها، وإخراج القرآن من أسرها بدون المنهج القرآني المعرفي المعادل للمنهج العلمي والمستوعب له، والمتجاوز له في طاقاته و قدراته (ص146).
ثانيا:المنهج القرآني بداية التحرر من الوضعية والمادية
كما أن”المنهج القرآني” سوف تعيد صياغة فلسفة العلوم الطبيعية في بعدها الكوني الذي يتضمن غاية الحق من الخلق في الوجود وفي الحركة، وبذلك يحرر القرآن”المنهجية المعاصرة والعلوم” التي انبثقت عنها من التأويلات الوضعية والمادية التي أصابتها بقصور مناقض للأصول التي تكونت بمقتضاها، وبنيت عليها بحيث صارت الحتمية العلمية سبيلا إلى الاغتراب الإنساني (ص62). فـ القرآن الكريم يعزز الموقف العلمي ويطهر”المنهج العلمي” ويقوم بعملية تصديق عليه وتنقية له من جوانب النقص واستحضار للأبعاد الغائبة عنه، ويقوم بعد ذلك بالهيمنة عليه ووضعه في إطاره، و اعتباره قائما على تلك السنن الثابتة التي لن تجد لها تحويلا، ولن تجد لها تبديلا ص112
مجرد بداية
يؤكد المؤلف أن كتابه هذا مجرد بداية لتوضيح ولفت الانتباه إلى جوانب المنهج المعرفي القرآني، فالأمر بحاجة إلى جهود وطاقات أكثر بكثير من جهد فرد أو أفراد، فهذا الكتاب يفتح الطريق أمام سائر أصناف علماء الأمة من فيزيائيين وطبيعيين وعلماء اجتماعيات وإنسانيات، وعلوم ومعارف نقلية ليبحثوا في القرآن المجيد في ضوء هذه الرؤية لعلنا نصل-ولو بعد حين- إلى الكشف عن “منهجية القرآن المعرفية” وننعم ببلورة قواعده، ومعالجة مشكلات “الأسرة الإنسانية” به. ف”المنهج” لا تستقر قضاياه، ولا تكتمل أدواته ووسائله إلا بعد أن يجري تداوله، وتنضجه حوارات العلماء ومداولاتهم، ويجرب فيما وضع له.
صعوبات في طريق المنهج القرآني
يؤكد المؤلف أن العلماء المعاصرين خاصة من أولئك المتخصصين”بفلسفة العلوم الطبيعية والمناهج بل واللاهوت” لن يسلموا بهذه الدعوى بسهولة:دعوى وجود منهج علمي قرآني، بل ستجد هذه الدعوى في بادىء الأمر معارضة شديدة، لما استقر في الأذهان من أن القرآن كتاب ديني…. لكنه يقرر وبكل ثقة: إن القرآن المجيد ميسر ومهيأ للتعامل مع المنهج العلمي التجريبي ، بل لا سبيل للتعامل مع القرآن أفضل من التعامل المنهجي معه.
خاتمة
يطرح الدكتور العلواني-رحمه الله- في هذا الكتاب، قضية المنهاج القرآني، التي شغلته معظم حياته الفكرية فهو-كما يقول- لم ينقطع عن التدبر في الآية الكريمة”لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا”، وصار يسميها بآية “الشرعة والمنهاج” حتى توصل إلى الحقيقة الناصعة، وهي أن القرآن الكريم المجيد المكنون،كما اشتمل على الشريعة بتفاصيلها، فقد اشتمل على المنهج بمحدداته-كلها-وأن الله-تبارك و تعالى- كما أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، فصل لنا الشريعة، فقد أودع كتابه”المنهاج”القادر على التصديق على سائر ما وصلت البشرية إليه من مناهج والهيمنة عليها. وإذا لم يشعر المتقدمون بالحاجة إلى الكشف عن المنهج القرآني، وتسميته منهجا للتعامل مع قضايا القرآن خاصة”بالمنهج”، بقطع النظر عما ساد في الأذهان من ضرورة التقيد بالمأثور والمروي في فهم القرآن عن السلف، وعدم تجاوز فهمهم بأي حال، أو لأية أسباب أو تصورات أخرى، فذلك لا ينفي وجود منهج علمي كامن في القرآن، ومنطق مصاحب له (ص143).
فالمنهج القرآني حقيقة لم تكتشف بعد، واستفادتنا الحقيقية من القرآن في عصرنا الراهن، هي رهن اكتشاف منهجيته الكونية، والدخول إليه بأزماتنا وإشكالياتنا الكبرى المتولدة من واقعنا بشكل صحيح، وبعقول ونفوس مهيئة تماما لتلقي حلوله، وتلقي جوابه، هو السبيل الآمن لحل مشكلاتنا الراهنة التي تزداد سوءا.ووحدها المنهجية القرآنية عندما تتضح سبيلها للمسلمين هي القادرة على تمكيننا من إجراء المراجعات الواجبة على علومنا ومعارفنا النقلية، وممارسة النقد المفتقد في قضاياها، وإعادة الحيوية والفاعلية لها، في ذات الوقت الذي تعطينا الأجوبة الصحيحة لحل مشكلاتنا الراهنة ليتحقق الحلم الذي طال في “إحياء علوم الدين” وتحقيق”الشهود الحضاري” للمسلمين.