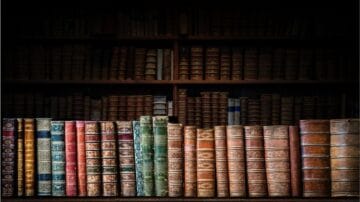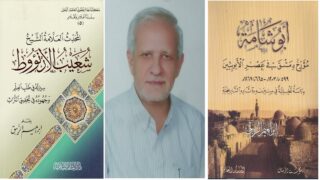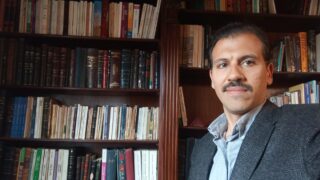اعتني المسلمون بالتصنيف عناية كبيرة، إذ لم يكد القرن الأول الهجري ينتصف حتى بدأت حركة التأليف أو التدوين التي ارتبطت في منشأها بالحديث الشريف ثم اتسعت دائرتها خلال القرنين التاليين وشملت كافة التخصصات العلمية، لكن هذا الاهتمام صاحبه من جانب آخر انبعاث ظاهرة الإتلاف المتعمد للكتب في التراث، وهو يتخذ أحد شكلين:
- الأول، إتلاف خارجي، وأعني به قيام سلطة ما بتدمير مؤلفات كاتب بعينه أو مجموعة مؤلفين أو مكتبات، لدواعي سياسية أو اجتماعية أو قبلية أو دينية أو مذهبية، ومن أمثلتها: تدمير المغول لمكتبات بغداد وإلقاء كتبها في نهر دجلة في القرن السابع الهجري، وقيام بعض القبائل العربية بتتبع الكتب التي تذكر نقائصها فتحرقها أو تلقي بها إلى البحر، وكذلك إتلاف بعض أرباب المذاهب لكتب المذاهب المخالفة لها بدافع التعصب.
- والثاني، إتلاف ذاتي، كأن يقوم مؤلف بتدمير كتاب له أو سائر كتبه مدفوعا بعوامل ذاتية، وهو مسلك ظهر على نحو خافت في القرن الأول ثم انتشر في القرون التالية ، فما الذي يدفع مؤلف لإتلاف كتبه، وكيف انتشرت هذه الفكرة ولماذا انحسرت، وكيف نظر إليها العلماء، وما تأثيرها على الحياة الفكرية عموما.
إتلاف الكتب: الامتداد والتراجع
بدأ بعض المؤلفين إتلاف كتبهم في وقت مبكر خلال القرن الأول على نحو خجول حين أقدم نفر من الزهاد وكتبة الحديث الشريف على إتلاف آثارهم المدونة بتأثير الورع والتقوى، لكنها أخذت في الذيوع مع القرن الثاني في ظل عصر التدوين الذي اقتصر أولا على تدوين الحديث ومن بعده المغازي والسير ثم ما لبث أن امتد إلى التأليف في اللغة والأدب والتاريخ وسائر صنوف المعرفة، ذلك أن اتساع دائرة التصنيف والمصنفين أفضى بالضرورة إلى اتساع مماثل لدائرة الإتلاف، ثم بدأت الظاهرة في الانحسار تدريجيا منذ القرن الرابع إلى أن اضمحلت تماما في القرن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.
وقد حاولت بعض الدراسات مؤخرا في رصد أعداد المؤلفين الذين أتلفوا كتبهم، ورصد ناصر الحزيمي في كتابه (حرق الكتب في التراث العربي) 37 حالة من حالات الإتلاف، ورصد مجدي عبد الجواد الجاكي في بحثه القيم ( إتلاف المؤلفين كتبهم في التراث العربي) 66 حالة موزعة على أربعة عشر قرنا، وبيانها كالتالي:
في القرن الأول ظهرت ثلاث حالات بما يعادل 4.5 بالمائة من حالات الإتلاف، وتضاعف هذا العدد في القرن الثاني ثمانية أضعاف إذ بلغت حالات الإتلاف 23 حالة بما يوازي 35 بالمائة من مجموع الحالات، وفي القرن الثالث ظهرت 17 حالة بما يعادل 27 بالمائة، ومنذ القرن الرابع بدأ معدل الإتلاف في التراجع الملحوظ إذ أمكن رصد ست حالات إتلاف وست حالات في القرن الذي يليه بما يماثل 18 بالمائة في الحالتين، وشهد القرن السادس تراجعا ملموسا إذا بلغت حالات الإتلاف ثلاث حالات فقط بما يوازي 4.5 بالمائة من مجموع الحالات، وابتداء من القرن السابع استقر معدل الإتلاف عند ثلاثة بالمائة إذ تم رصد حالتي إتلاف فقط في القرن السابع والثامن والتاسع، أما القرن العاشر فلم يسجل سوى حالة واحدة، على حين لم يتم رصد أي حالات خلال القرون الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وسجل القرن الرابع عشر حالة واحدة فقط[1].
تبين هذه الإحصاءات أن معدل الإتلاف بلغ أوجه في القرنين الثاني والثالث إذ سجلت فيهما أربعون حالة إتلاف بما يوازي 61 بالمائة من مجموع الحالات، ويمكن تفسير ذلك بما عرف عن علماء الرعيل الأول من التقوى والورع إذ ربما قام أحدهم بتدمير مؤلفه لأنه نقل فيه حديثا غير صحيح أو عن راو غير ثقة، أو رغبه منه في الانصراف إلى العبادة، أو لأنه لم يقم بإحكامها علميا فيما يظن، أو لتفضيل جلهم السماع والحفظ على التدوين والكتابة، وهو اتجاه كان شائعا بين علماء السلف في الفترة المبكرة، ودارت بينهم نقاشات كثيرة في ذلك رصد بعضها الخطيب البغدادي (463 ه) حيث يقول ما نصه:
“ثبت أن كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول إنما هي لئلا يضاهى بكتاب الله تعالى غيره ، أو يشتغل عن القرآن بسواه. ونُهي عن الكتب القديمة أن تتخذ لأنه لا يعرف حقها من باطلها وصحيحها من فاسدها .. ونهي عن كتب العلم في صدر الإسلام وجدته لقلة الفقهاء في ذلك الوقت، والمميزين بين الوحي وغيره لأن أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا في الدين ولا جالسوا العلماء العارفين، فلم يؤمن أن يلحقوا ما يجدون من الصحف بالقرآن ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه كلام الرحمن، وأمر الناس بحفظ السنن إذ الإسناد قريب والعهد غير بعيد، ونُهي عن الاتكال على الكتاب لأن ذلك يؤدي إلى اضطراب الحفظ حتى يكاد يبطل، وإذا عدم الكتاب قوي لذلك الحفظ الذي يصحب الإنسان في كل مكان[2]
وأيا ما كانت الدواعي التي تقف وراء ازدهار الإتلاف في القرنين الثالث والرابع، فإنه اضمحل تماما منذ القرن الحادي عشر بعدما انحسم الخلاف بين الحفظ والتدوين لصالح الأخير، ولم يعد العلماء يتحرجون من التدوين مع بعد الزمان عن عصر النبوة، وكذلك كانت لآراء بعض العلماء الأثبات الذين استنكروا إتلاف الكتب، أثرها الإيجابي في الحد من انتشار الإتلاف.
علماء الشريعة وإتلاف الكتب
لعل الإمام أحمد بن حنبل ( 241ه) كان من أوائل من أوائل من تطرق لمسألة إتلاف بعض المؤلفين لكتبهم فقد روي عنه قوله “لا أعلم لدفن الكتب معنى”، كما ذكر أنه سئل عن رجل أوصى بدفن كتبه معه فقال “لا يعجبني أن يدفن العلم”[3].
وتوسع ابن الجوزي (597 ه) في بحث المسألة وناقشها مع بعض علماء عصره، وخلص إلى أن “في الناس من غلب عليه قصر الأمل، وذكر الآخرة، حتى دفن كتب العلم! وهذا الفعل عندي من أعظم الخطأ وإن كان منقولا عن جماعة من الكبار ولقد ذكرت هذا لبعض مشايخنا؟ فقال: أخطؤوا كلهم”. وهو يضيف أن بعض حالات الإتلاف يمكن تأويلها -أي تسويغها- كأن تشتمل على أحاديث عن قوم ضعفاء، أو كان فيها شيء من الرأي لا يُحب أن يؤخذ عنها، ولكن بعضها الآخر لا يمكن تأويله بل هو مغالاة و “محض تفريط، فالحذر الحذر من فعل يمنع منه الشرع، أو من ارتكاب ما يُظن عزيمة وهو خطيئة، أو من إظهار ما لا يقوى عليه المظهر فيرجع القهقري”.[4] كما يقول.
مبررات الإتلاف وكيفياته
يستفاد مما سبق أن مبررات إتلاف المصنفين لكتبهم في التراث تعددت، وتباينت طرائقهم في ذلك ما بين دفن وهو أكثر الطرق شيوعا، أو حرق أو إلقاء في نهر أو تمزيق أو تخريق أو محو، وأما المبررات فيمكن تقسيمها ضمن فئات في الآتي:
- مبررات شرعية: وتتمثل في الرغبة في التفرغ للعبادة، وعدم الرغبة في اتخاذ كتاب مع كتاب الله تعالى، ومن أمثلتها قيام أبو عمرو بن العلاء (..) وهو أحد القراء السبعة، ومن أعلم الناس بالقرآن الكريم والعربية والشعر، وهو في النحو في الطبقة الرابعة من علي بن أبي طالب، ومما يرويه ابن خلكان عنه أنه “كانت كتبه التي كتب عن العرب الفصحاء قد ملأت بيتا له إلى قريب من السقف، ثم إنه تقرأ – أي تنسك – فأخرجها كلها، فلما رجع إلى علمه الأول لم يكن عنده إلا ما حفظه بقلبه” [5]أي أنه بعد أن تقدمت به السن واضمحلت ذاكرته لم يكن لديه من علم إلا ما احتفظت به ذاكرته. ومنها إقدام سفيان الثورى تمزيق كتبه وإلقائها في الفضاء وهو يردد: “ليت يدى قُطعت من هنا ولم أكتب حرفًا”.
- مبررات علمية: وتتمثل في رجوع بعض المؤلفين عن بعض ما كتبوه، أوالخوف من تحريفها بعد مماتهم، ومن أمثلة الأولى قيام الإمام الشافعي رضي الله عنه بالتخلص من كتبه التي عرفت بالمذهب القديم، وحول هذا المعنى يقول الإمام النووي : ليس القول القديم مذهبا له، فإنه غسل كتبه القديمة، وأشهد على نفسه بالرجوع عنها هكذا نقل عنه أصحابه[6] وكان سبب الإتلاف أن كتبه القديمة أقل إحكاما من الجديدة فرجع عنها، وهو ما يؤيده الإمام أحمد الذي سئل عن كتب الشافعي فأجاب السائل: عليك بالكتب التي عملها بمصر فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها ثم رجع إلى مصر فأحكم تلك”[7]، وعلى شاكلتها إتلاف السيوطي لبعض كتبه بالغسل بسبب رجوعه عما أورده فيها، إذ يقول في (حسن المحاضرة) وقد بلغت مؤلفاتي إلى الآن ثلاثمائة سوى ما غسلته ورجعت عنه[8].
أما الثانية وأعني الخوف من تحريف الكتب فقد كانت مسلك نفر من العلماء، وهو ما يفهم من قول الخطيب البغدادي الذي يصرح بأن ” كان غير واحد من السلف إذا حضرته الوفاة أتلف كتبه أو أوصى بإتلافها خوفا من أن تصير إلى من ليس من أهل العلم فلا يعرف أحكامها ويحمل جميع ما فيها على ظاهره وربما زاد فيها ونقص فيكون ذلك منسوبا إلى كاتبها”[9]، ومن أبرز من أقدم على ذلك عبيدة بن عمرو السليماني، وإسحاق بن راهوية، وعبد الله بن المبارك.
- مبررات ذاتية ونفسية: كأن يخشى المصنف من الاتكال على الكتابة ويهمل أمر الحفظ، الذي آثره علماء السلف وقدموه على الكتابة، أو أن يضن بعضهم بالكتب على أهل زمانه الذين لم يقدروه حق قدره أو بأهل الأزمان المقبلة، ومن أمثلته قيام محمد بن سيرين بإتلاف معظم ما كتب خشية الاتكال على الحفظ، إذ روي أنه كان إذا كتب حفظ ما كتبه ثم أتلفه. ومنهم عروة بن الزبير الذي كتب الحديث ثم محاه لكنه عاد وندم على فعلته وقال : كتبت الحديث ثم محوته فوددت أني فديته بمالي وولدي. وقريب منه ما قاله منصور: وددت أني كتبت على كذا أو كذا قد ذهب عني مثل علمي”[10]. أما الضن بالكتب على من ليس أهلها فلعل فيما فعله أبو حيان من إحراق كتبه مثالا جيدا، ذلك أنه في أخريات أيامه حرق بعض كتبه وغسل البعض الآخر بالنار ضنا بها على من لا يعرف قدرها، وتطاير خبره بين الناس حتى سمع به القاضي أبو سهل بن محمد فكتب إليه مبينا قبيح صنيعه فلم يأبه أبو حيان له واعتذر منه[11]. ومنها إتلاف علي بن عيسى الربعي، وهو من أئمة النحاة ، شرح سيبويه حين نازعه ابن أحد التجار في مسألة، فقام مغضبا وأمسك بالكتاب وصب عليه الماء وغسله، وهو يردد “لا أجعل أولاد البقالين نحاة”[12].
نخلص مما سبق إلى أن إتلاف المؤلفين لكتبهم لم يرق لأن يصبح ظاهرة في التراث، كما لم يؤثر تأثيرا سلبيا على الحياة الفكرية الإسلامية لأن من قاموا به لم يزد عددهم عن بضع عشرات وبعضهم ربما أتلف شيئا من مؤلفاته ظنا منه أنه لم يحكمها وهو أمر ينم عن نزاهة علمية واستقامة خلقية. من جانب آخر يبرهن اضمحلال معدل الإتلاف على وجود تقييم ذاتي للأفكار والممارسات العلمية ضمن الحضارة الإسلامية ، وأن بعضها ربما أثبت جدارته فاستمر وبعضها الآخر ربما تبين ضرره فاضمحل واندثر.
[1] مجدي عبد الجواد الجاكي، إتلاف المؤلفين كتبهم في التراث العربي، القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، تراثيات، ع 17، 2015، ص 79-80.
[2] الخطيب البغدادي، تقييد العلم، نسخة المكتبة الشاملة.
[3] مجدي عبد الجواد الجاكي، المرجع السابق، ص 80.
[4] ابن الجوزي، صيد الخاطر، نسخة المكتبة الشاملة.
[5] ابن خلكان، وفيات الأعيان، 3/ 466.
[6] بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 11/59.
[7] شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، 10/55.
[8] مجدي عبد الجواد الجاكي، المرجع السابق، ص 94.
[9] الخطيب البغدادي، المرجع السابق.
[10] نفس المرجع السابق.
[11] ياقوت الحموي، معجم الأدباء، المكتبة الشاملة.
[12] الصفدي، الوافي بالوفيات، 6/477.
تنزيل PDF