عند الحديث عن الغيب وأزمة الإنسان المعاصر، يجب أن نقول أن الإنسان والغيب قضية كبرى ودائمة في الفكر الفلسفي، فالغيب ليس مسألة عابرة، يستطيع أن يقفز عليها الإنسان ثم يكمل طريقه، ولكنها قضية مركزية، تنتظم حولها حياة الانسان، اعتقادا، ومعاشا، ومصيرا، لذا سعى الإنسان منذ القدم لاقامة علاقة مع الغيب، الذي يعتبر الإله المسألة الكبرى فيه، والتي تتفرع عنها كل القضايا.
ومن ناحية أخرى سعى الإنسان –عبر وسطاء- للتحاور مع الغيب، والاطلاع على أسراره، لذا عرفت كل الحضارات الكهنة والعرافين الذين يدعون معرفة الغيب، وأبدت المجتمعات احتراما للأشخاص الذين يزعمون أنهم يعرفون الغيب، كما استعان الإنسان بوسائل توهم أنها تساعده على معرفة الغيب، مثل الاستعانة بالنجوم، أو الجن، أما الأديان السماوية فكان شأنها مختلفا مع الغيب، فاعتبرت الأديان أن الرسول والنبي هما الواسطة في معرفة الغيب.
مركزية الغيب
في رحلة الغيب وأزمة الإنسان المعاصر، ومع ظهور الأفكار والتيارات التنويرية والحداثية، على مدار القرون الأربعة الماضية، ظهرت محاولات لتغير هوية الدين، في أهم قضية مركزية فيه وهي الغيب، ساعية إلى نقل المركز من الخالق سبحانه إلى الإنسان، ومن السماء إلى الأرض، فغيرت الحداثة وما بعدها مفهوم الغيب، محاولة إنشاء لاهوتا منبثقا من المادة والمحسوس، ينشيء غيبا مرتبطا بالمادة.
والغيب هو كل ما غاب عن حواس الإنسان، وقد اعتنى القرآن بالغيب إيمانا، وانبثاقا للسلوك والحركة عن هذا الإيمان، فورد الغيب في القرآن في حوالي ستين موضعا، وتعدد الغيب الذي تحدث عنه القرآن، بدءا من الخالق سبحانه، والآخرة، والملائكة، وصروف القدر، والمستقبل، وفي تفسير “البحر المحيط” لأبي حيان الغرناطين يقول “الإيمان بالغيب لازم للمكلف دائما”.
ومن النادر أن يوجد من ينكر الغيب كلية، ولكن تتفاوت درجات الإيمان بالغيب، حتى الماديين والمؤمنين بالمحسوس لديهم غيب، فعندما لا يستطيعون تفسير أمر ما ينشئون قصة، مثل أن الجزيئات تتحرك فوق الأسطح، أو محاولة الفلاسفة الماديين تجاوز الغيب، كما في مقال الفليسوف البريطاني “راسل” عام 1952 “هل هناك خالق؟” والذي تحدث فيه عن إبريق من الخزف بين الأرض والمريخ، وهذا الإبريق صغير لا ترصده التليسكوبات، وقال أن تلك الفرضية لا يمكن إثباتها، ولا يمكن إنكارها، وانطلق للزعم أن المقدس لا يمكن إثباته.. ولا يمكن نفيه! غير أن “راسل” تغافل أن الإيمان بوجود ذلك الإبريق أو عدمه لا ينشأ عنه أي تكليف أو عمل، أما الإيمان بالخالق سبحانه وتعالى، فيؤسس لرؤية للكون ينبثق عنها عمل وحركة.
الغيب والعقل
في تفسير “المنار” يشير الشيخ “محمد رشيد رضا” إلى قضية ذات أهمية كبيرة في مسألة الغيب، وهي أن”الغيب لا يُعرف بالقياس، ولا مجال فيه لعقول الناس”، ومعنى هذا أن الأدوات والأقيسة التي ابتكرها الإنسان لا يدخل الغيب ضمن نطاقها، لهذا فإداركه لا يتأتي إلا من طريق الإخبار، وليس الإدارك الحسي المباشر، وهو ما أكده تفسير “الظلال” في أن البشر ليسوا مهيئين لإدراك الغيب بعقولهم المجردة، فيقول: “ليسوا مهيئين بطبيعتهم التي فطرهم الله عليها للاطلاع على الغيب، وجهازهم البشري الذي أعطاه الله لهم ليس “مصمما” على أساس استقبال هذا الغيب إلا بمقدار، وهو مصمم هكذا بحكمة.
مصمم لأداء وظيفة الخلافة في الأرض، وهي لا تحتاج للاطلاع على الغيب، ولو فتح الجهاز الإنساني على الغيب لتحطم، لأنه ليس معدا لاستقباله إلا بالمقدار الذي يصل روحه بخالقه، ويصل كيانه بكيان هذا الكون، وأبسط ما يقع له حين يعلم مصائره كلها، ألا يحرك يدا ولا رجلا في عمارة الأرض، أو أن يظل قلقا مشغولا بهذه المصائر، بحيث لا تبقى فيه بقية لعمارة الأرض”.
والغيب حاجة ضرورية للإنسان في حياته، فالغيب ذو سعة عظيمة، وإذا كان الكون المُشاهدة لم يدركه الإنسان أو يفسر ظواهره، فما الظن بالغيوب التي تلف الكون، وتهتف في صمت بوحدانية الخالق وإبداعه، وأن هناك من يشارك الإنسان الحياة، وينظم حركة الكون، ولا يراهم، فهناك ملائكة للجبال، وأخرى للريح، وملائكة للموت، في كتابه “الغيب والعقل: دراسة في حدود المعرفة البشرية” لـ”إلياس بلكا” تأكيد أن “الاعتماد المفرط على الحواس يقيد الإنسان” فالغيب طاقة وقدرة معرفية عظيمة، تتحرك عندما ينتهي سقف المعرفة العقلية، وكما يؤكد “عباس العقاد” أن هناك ما فوق العقل وما ضد العقل، فما ضد العقل هو الخرافة، أما ما فوق العقل فهو الغيب، الذي يمنح الإنسان وعقله طاقات معرفية لن يستطيع أن يصلها العقل بأدواته ووسائله ومناهجه.
والحقيقة أن محاولة تنحية الغيب، بحجة أن الغيب يقف عقبة أمام العقل، أمر يثير السخرية، فما يثبته تاريخ بعض الحضارات الإنسانية، التي أنتجت العلوم وكان العقل حاضرا وراء منجزها الحضاري، نجد أن هناك من عبد الحجارة والأبقار والأشخاص، فلم يستطع العقل أن يقدم لهم هداية بمفرده، وهنا ينشأ دور ومكانة الأنبياء والرسل، فهم يقومون بدور تبليغ الغيب وتكاليفه.
وانفصال العقل عن الغيب يخلق ضلالات كبرى، وحيرة عظيمة للبشرية، وهو ما يعاني منه الإنسان المعاصر، الذي غيب الغيب من حياته، ملتمسا من المادة والمحسوس أن يكون هو نهايته وغاية إداركه، وهي قضية أشار لها القرآن في قصة “هدهد سليمان” فحضارة سبأ القوية سجدت للشمس، عندما فقدت الإيمان بالغيب.
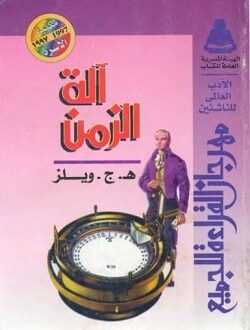
وغياب الاستدلال العقلي والحسي على الغيب، يجعل البشر جميعا على مسافة واحدة من الغيب، إما الإيمان والتسليم، وإما الرفض والإنكار، وهو اختبار للبشر على أن يقبلوا تلقي أوامر السماء من خلال الأنبياء والرسل، وبالتالي يكون الغيب هو الاختبار الحقيقي للإنسانية.
وكان الشاعر الفارسي فريد العطار، يقول:”كيف يدرك الله بالاستقراء وليس كمثله شيء” ومن ثم فليس بالضرورة أن تكون الغيبيات قابلة للفهم للجميع، جاء في تفسير الظلال:”إذا كان العقل البشري لم يوهب الوسيلة للاطلاع على هذا الغيب المحجوب؛ فليس سبيله إذن أن يتبجح فينكر؛ فالإنكار حكمٌ يحتاج إلى معرفة، والمعرفة هنا ليست من طبيعة العقل، وليست في طوق وسائله، ولا هي ضرورية له في وظيفته”.
الغيب وآلة الزمن
وفي مسألة الغيب وأزمة الإنسان المعاصر، فإن هذا الإنسان (المعاصر) المفتقد للإيمان بالغيب، يشطب الضمير من حياته، فالضمير هو نتاج حضور الله في أعماق الإنسان، وإذا غاب الخالق، سبحانه وتعالى، من أعماق الإنسان، غاب الضمير.
ومن الناحية الأخرى، فإن الإيمان بالغيب يمنح الإنسان عقلا لمقاومة الخرافات، فالحداثة رغم إيمانها المفرط بالعقل، وادعاءها أنها تنزع السحر عن العالم،إلا أنها لم تقض على الخرافات، ولكن أعادت إنتاجها بشكل جديد يناسب الإنسان المعاصر، ورؤيته الجديدة للكون، فنمت-مثلا- مخاوف الإنسان من المخلوقات الغريبة التي تغزو الأرض للسيطرة عليها.
وعندما نتحدث عن الغيب وأزمة الإنسان المعاصر، نستذكر رواية “آلة الزمن” The Time Machine التي كتبها البريطاني “هربرت جورج ويلز” وصدرت عام 1895، والتي تحكي قصة آلة اخترقت الزمن، ومضت بعيدا في المستقبل بصاحبها، الذي شاهد دمارا، واضمحلالا للجنس البشري، لذا قرر أن يعود للزمن الذي جاء منه، وهو القرن التاسع عشر مرة أخرى، بعدما امتلأت روحه بالاحباط مما شاهده في المستقبل.
والحقيقة أن الغيب يقاوم الخرافة، ولا يسمح لها أن تستقر، فالخالق سبحانه، قصر علم الغيب على نفسه، وبالتالي فالبشر جميعا متساوون أمام علم الغيب، لذلك جاءت الآية الكريمة :” عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ” في سورة “الجن” الذي دارت الأساطير حول معرفته بالغيب، وهو وهم اتخذه البعض ليعبد الجن ظنا منهم أن عنده علم الغيب.
والإيمان بالغيب هو الذي يميز بين العقل الديني عن العلماني، والإيمان بالغيب يصوغ المنظومة المعرفية، التي تحديد الرؤية الكونية والوجودية، فإذا انتفى الإيمان بالغيب اختلت تلك المنظومة.

