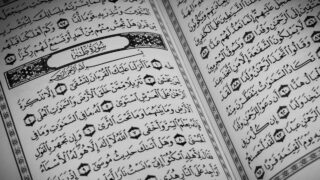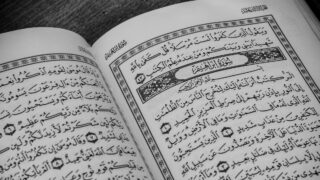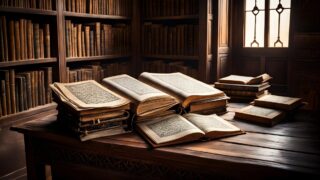قال الأكاديمي المصري الدكتور خالد فهمي، أستاذ اللغويات بكلية الآداب جامعة المنوفية، إن الأمة الإسلامية “أمة كتاب”. مبينًا، في “أمسية رمضانية” حول القرآن الكريم ودوره ورسالته، أن التاريخ الحديث عن القرآن الكريم، حتى في الغرب، يوضح أن أكثر ما يميز هذه الأمة أن لديها نَصًّا استطاع أن ينقلها من حالة الأمية التي تعني الجهل، إلى حالةٍ تَسيَّدت العالمَ بفضل هذا الكتاب، حتى قُرنت به.
وأشار خالد فهمي، في أمسية بـ”صالون الخميلة” برعاية الأديب ناصر صلاح، إلى ما ذكره عالِمٌ سويدي مختص في صناعة الكتاب، حيث قال: إن العالَم انتقل نقلة فجائية بالغة الهزة، بسبب القرآن الكريم. كما قال صاحب (تقاليد المخطوط العربي): لا يوجد كتاب في العالم صنع ما صنعه هذا الكتاب.
وأكد أستاذ اللغويات أن أهم خصيصة للأمة العربية أنها “أمة كتاب”، “أمة القرآن الكريم”؛ وأن هذه الفكرة- أننا أمة كتاب- ستنشئ فيما بعد واحدًا من أكثر أشكال العمران تميزًا في الوجود البشري؛ فمن حيث التأصيل النظري نرى أن القرآن الكريم جعل ثلث مقاصده يدور حول “العمران”، بينما يدور الثلثان الآخران حول “التوحيد” و”التزكية“.
وأضاف: “التوحيد” هو المحور الأول، ويُنتج المقصدَيْن الثاني والثالث.. ثم تأتي “التزكية”، وهي المقصد الثاني، وتعني الانتقال بالإنسان من حالة التوحش إلى حالة التَّأنُّس.. وبعد أن يحقق “التوحيدُ”: “التزكيةَ”، يدفع الإنسانَ إلى “العمران”؛ الذي انطبع في حضارتنا بقيم “التوحيد” و”التزكية”.
كما تطرق د. خالد فهمي، إلى نقطة أخرى تتصل بالتعامل مع القرآن الكريم؛ وهي أن الله تعالى جعل القرآنَ “مادة استشفاء”؛ فإذا كان من الطبيعي أن تحدث أعطاب في هذا الوجود وفي حركة الحياة، فإن هذا يستدعي تدخلاً ممن بيده تحقيق الأسباب لإنزال “الشفاء. قال تعالى: { وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ } (الإسراء: 82). وهذا هو معقد النظر الثاني في تعاملنا مع الكتاب العزيز.
وأضاف: القول بأن القرآن مُعدِّل للكون وضابط له، لا يعني إهدار الكون؛ فقد استقر النظر الإسلامي على أن المسلم الفطن العاقل الذي فهم التوحيد فهمًا إيجابيًّا، وتجلَّى في تأنُّسِه، ثم تجلَّى في إنتاجه العمراني؛ عليه أن يتحرك مستهديًا بالنموذجين، أي بالوحيَيْن: الوحي المسطور (الكتاب العزيز)، والوحي المنظور (الكون).
وأوضح أن الحركة التراتبية في الوجود التربوي للنموذج النبوي، بحياة النبي ﷺ، قد بدأت بـ”المنظور” قبل “المسطور”.. وكذلك تجارب الأنبياء؛ بدأت إما بالتجول والانتقال، أو الهجرة، أو العزلة الإيجابية المثمرة تأملاً.. وأن الوحي قد تنزَّل على قلب النبي ﷺ بينما كان في حراء ، أي في رحاب الوحي المنظور (الكون).
وتابع: بالنظر والتأمل والتفكر نُحصِّل “الوحي المنظور”، ثم يأتي “الوحي المسطور” (القرآن الكريم) ليضبط ويعدِّل ما حصَّله الإنسان بإدراكاته الحسية النظرية، وبإدراكاته العقلية التفكرية: حذفًا وتثبيتًا وإضافةً وتوجيهًا وتعليمًا. فيلزم أن تجمع “الوحيَيْن” في نفسك.. ثم تعدِّل النظرَ، بموجب “الوحي المسطور”، القرآن الكريم، تمهيدًا لاستلهام هذا الوجود الكوني واستثماره؛ إنْ في تثبيت الإيمان واستدامته، وإنْ في استثماره في العمران؛ الذي هو ناتج “التوحيد”، و”التزكية” أو التأنس.
وأشار الدكتور خالد فهمي إلى أن النبي ﷺ ما مرَّ على ظاهرة وجودية كونية إلا وعاملها معاملة المتأنِّسين، أي تحويلها إلى إنسان.. ومن ذلك:
• كان ﷺ يعطف على الجذع، الذي يبكى.. و(البكاء) فعلٌ إنساني.
• وكان يعطف على الجمل، وقال لصاحبه: “أما تتَّقي اللَّهَ في هذِهِ البَهيمةِ الَّتي ملَّكَكَها اللَّهُ؛ إنَّهُ شَكا إليَّ أنَّكَ تجيعُهُ وتدئبُهُ”.. و(الشكوى) فعلُ إنسانٍ مأزوم ومضيَّق عليه.
• مرَّ النبي ﷺ وأصحابه، بـ”ظَبيٌ حاقِفٌ في ظلٍّ وفيهِ سَهمٌ”. فأمر ﷺ “رجُلًا يقِفُ عندَهُ لا يَريبُهُ أحدٌ منَ النَّاسِ حتَّى يجاوِزَه”. أي حتى لا يتعرَّضَ له أحدٌ، ويُزعجه.
• قال النبي ﷺ، لمن أخذ فرخ عصفور: “مَن فجعَ هذِهِ بولدِها؟ ردُّوا ولدَها إليها”.
وخلص د. خالد فهمي، من هذه الأحاديث والشواهد النبوية، إلى أن هذا الخُلق النبوي تسرَّب أو ترسَّخ في الوعي الجمعي الإسلامي.. فكان التعامل مع الحيوانات والطيور، باعتبارها ذات أرواح مثل الإنسان.
وأضاف: بذلك يسير الإنسان في حركة العمران، بعد تحصيله التأنُّس، على ضابط ما يراه في الكون مهتديًا بقوانين القرآن الكريم.. وهذا أنتج ثلاث نظريات في إعجاز القرآن الكريم:
النظرية الأولى: قررت أن اللغة هي مدخل الإعجاز: وهذه النظرية أسبق النظريات وأقدمها.. وحديثًا قرر الشيخ محمد أبو زهرة، في كتابه (معجزة القرآن)، أن القرآن معجزة لغوية.
النظرية الثانية: تهتدي بعلوم الكون: ورائدها مالك بن نبي في كتابه (الظاهرة القرآنية).. وعدَّل ذلك الشيخ محمود شاكر؛ حين رأى أن التَّهَدِّي بالقرآن من داخل علوم الكون لا يتقدم على المعجزة اللغوية؛ فضبَطَ المسألة.
النظرية الثالثة: نظرية الحِجَاج: أي الإفحام وقَطْع المعاند؛ كما قرر الدكتور عبد الله صولة، التونسي.. وهي تصلح لمخاطبة غير العرب.
فالنظرية الأولى: هي القمة، وتصلح للنخبة العربية.. والثانية: تصلح لعموم المسلمين.. والثالثة: تصلح خارج العالم العربي، لعموم الناس، ممن فقدوا الآلة اللغوية لفهم إعجاز القرآن.
وانتهى الدكتور خالد فهمي، في أمسيته الرمضانية حول القرآن الكريم، إلى أن القرآن يظل ضامنًا لحركة التَّهَدِّي في الكون، وضامنًا لوجود الأمة، وضامنًا لأداء رسالتها في الوجود.
تنزيل PDF