هذه قاعدة من قواعد العمل في الدنيا، أوضحها سبحانه لبني آدم جميعاً، حيث الجزاء من جنس العمل (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها). أي أن ما تقوم به أيها الإنسان من عمل طيب، سيكون مردوده الطيب عليك، وبالمثل العمل السيئ.
إنها سنة من السنن الإلهية في هذا الكون. العمل الصالح لا يأتي إلا بالصالح من النتائج والعواقب، والعمل السيئ لا شك أنه شؤم ولا يأتي بنتائج تسر صاحبه، لا دنيا ولا آخرة.
يقول الشيخ أبوبكر الجزائري في تفسيره (إن أحسنتم) أي أحسنتم في طاعة الله وطاعة رسوله بالإخلاص فيها وبأدائها على الوجه المشروع لها، (أحسنتم لأنفسكم) أي أن الأجر والمثوبة والجزاء الحسن يعود عليكم لا على غيركم (وإن أسأتم) أي في الطاعة فإلى أنفسكم سوء عاقبة الإساءة.
الآية جاءت ضمن سياق الحديث عن بني إسرائيل، الذين كانت أعمالهم وتعاملهم مع أنبيائهم والشعوب الأخرى بين مد وجزر. عمل صالح كان يديم لهم سلطانهم على الأرض حيناً من الدهر. ثم تتطور الأمور عندهم بصورة وأخرى، فكانت تتجه أعمالهم إلى النوع الطالح الضار السيئ حيناً من الدهر، فكانت تلكم الأعمال الطالحة غير الطيبة من أصلها، تطيح بهم وسلطانهم في الأرض، يتيهون سنوات وسنوات.
ها هنا حكى الله عنهم، كما جاء في مفاتيح الغيب للرازي، أنهم لما عصوا، سلط عليهم أقواماً قصدوهم بالقتل والنهب والسبي، ولما تابوا أزال عنهم تلك المحنة وأعاد عليهم الدولة، فعند ذلك ظهر أنهم إن أطاعوا فقد أحسنوا إلى أنفسهم، وإن أصروا على المعصية فقد أساؤوا إلى أنفسهم.
لا يمنع أن نذكر ها هنا باختصار ذلكم المد والجزر الذي كان عليه بنو إسرائيل في تاريخهم، لنصل إلى ما هم عليه اليوم، كي تتبين حقيقة هذه النوعية من البشر أكثر فأكثر للغافلين من هذه الأمة، وهم كُثُر، وكيفية التعامل معها.
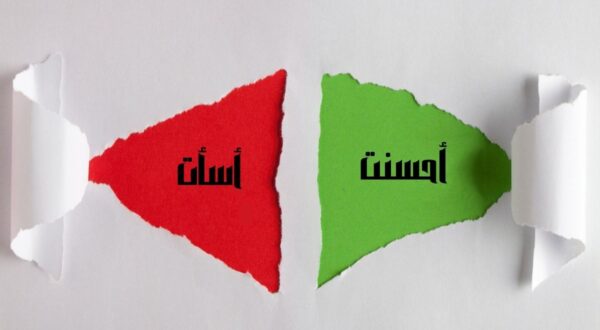
ذكر ابن عاشور في تفسيره، التحرير والتنوير، أن اليهود بعد أن عادوا إلى أورشليم وجددوا مُلكهم ومسجدهم في زمن داريوس الفارسي الذي أطلق لهم التصرف في بلادهم التي غلبهم عليها البابليون، فمكثوا على ذلك مائتي سنة من سنة 530 إلى سنة 330 قبل الميلاد، ثم أخذ مُلْكُهم في الانحلال بهجوم البطالسة ملوك مصر على أورشليم، فصاروا تحت سلطانهم إلى سنة 166 قبل الميلاد، إذ قام قائد من إسرائيل اسمه ميثيا وكان من اللاويين، فانتصر لليهود وتولى الأمر عليهم وتسلسل المُلك بعده في أبنائه في زمن مليء بالفتن إلى سنة أربعين قبل الميلاد.
دخلت المملكة تحت نفوذ الرومانيين وأقاموا عليها أمراء من اليهود، ثم تمردوا للخروج على الرومانيين، فأرسل قيصر بالجيوش في حدود سنة أربعين بعد الميلاد، فخربت أورشليم واحترق المسجد، وتم أسر نيف وتسعين ألفاً من اليهود، وقُتل منهم في تلك الحروب نحو ألف ألف، ثم استعادوا المدينة وبقي منهم شرذمة قليلة إلى أن وافاهم الإمبراطور الروماني أدريانوس، فهدمها وخربها ورمى قناطير المِلح على أرضها كيلا تعود صالحة للزراعة، وذلك سنة 135 للميلاد. وبذلك انتهى أمر اليهود وانقرض، وتفرقوا في الأرض ولم تخرج أورشليم من حكم الرومان إلا حين فتحها المسلمون في زمن عمر بن الخطاب سنة 16 للهجرة، صُلحاً مع أهلها وهي تسمى يومئذ إيلياء.
هؤلاء القوم أو غيرهم من ظلمة وفسّاق الأرض اليوم، يبدو أنه ليس لديهم للتاريخ مساحة في حياتهم للتأمل والاتعاظ من سير الأولين الغابرين، لاسيما اليهود المتصهينين الذين لم تتوقف آلات القتل والإجرام عندهم منذ أن أدخلتهم بريطانيا ثم أمريكا إلى الأرض التي بارك الله حولها.
إنهم من فساد إلى آخر، ومن ظلم إلى ما هو أكثر ظلما. وإن ما يجري في غزة، إنما ظلم لن يتركه الحق تبارك وتعالى هكذا يمضي، بل سيكون لهذا الظلم والظلمة وأعوانهم، يوم قادم لا ريب فيه، في الدنيا أولاً ثم الآخرة.
الشاهد من الحديث كله، وخلاصة ما أروم إليه من هذا السرد السريع للتاريخ وربطه بآيات القرآن الكريم، أن الآية الكريمة (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها) حتى وإن كانت ضمن سياق الحديث عن بني إسرائيل، القوم الذي أرهقوا أنبياء الله ورسله، إلا أنها لكل قوم وملة، في كل زمان ومكان، بل لكل إنسان يعيش عمره المقدّر في هذه الحياة الدنيا. إنها تثبت وتقرر القاعدة الحياتية التي ذكرناها في المقدمة، وخلاصتها أن الإنسان إن أحسن فإنما يُحسن لنفسه، وإن أساء فإنما على نفسه. فكل أحد منا يأتي يوم القيامة فردا.
إنها القاعدة التي لا تتغير في الدنيا وفي الآخرة؛ كما يقول سيد قطب في ظلاله. القاعدة التي تجعل عمل الإنسان كله له، بكل ثماره ونتائجه. وتجعل الجزاء ثمرة طبيعية للعمل، منه تنتج، وبه تتكيف؛ وتجعل الإنسان مسؤولاً عن نفسه، إن شاء أحسن إليها، وإن شاء أساء، لا يلومن إلا نفسه حين يحق عليه الجزاء.

