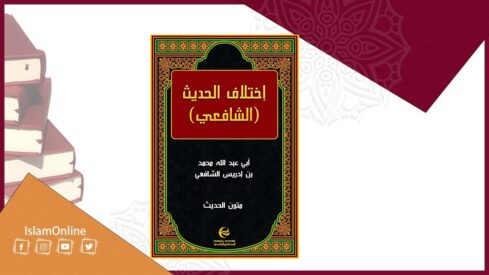حين بعد العهد بلسان العرب وبعد العهد بزمن النبوة، أصبحت أحكام النظر والتأويل في النصوص مختلفة وغير منضبطة، نتجت خلالها نيران الاختلاف والاضطراب في الفهوم، وساعد على ذلك فشو البدع وزيغ الفكر مما أدى إلى رد صحيح المنقول من السنة النبوية، إما بحجة عدم حجية الخبر الواحد في الاعتقاد، أو بدعوى وجود التناقض بينه وبين النصوص الأخرى، أو بناء على التأويل المرجوح ونحو ذلك، وهي مشكلة حقيقية تعم المجتمع الإسلامي حينه، فجاء الإمام الشافعي رحمه الله في نهاية القرن الثاني، جامع بين علمي الحديث والفقه ليكون أول من يقعد قواعد الاستنباط للناس، ويقسم ويرتب العلوم، ويؤصل الأصول المعينة على فهم الكتاب والسنة على النهج السوي من خلال كتبه ومناقشاته العلمية.
يقول الإمام أحمد: “لولا الشافعي، ما عرَفْنا فِقه الحديث” [1]
قال الإمام الفخر الرازي في كتابه “مناقب الشافعي”: “كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلَّمون في مسائل من أصول الفقه، ويستدِلون، ويَعترِضون، ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفةِ دلائل الشريعة، وفي كيفيَّة مُعارضتها وترجيحاتها، فاستنبط الشافعي عِلمَ أصول الفقه، ووضع للخلق قانونًا كليًّا يُرجع إليه في معرفة مراتب أدلَّة الشرع، فثبت أن نسبة الشافعي إلى علمِ الشرع كنسبة أرسطو إلى علمِ العقل[2]“.
وقد عصم الله تعالى به الناس من الزلل فى عملية استنباط الأحكام الشرعية، ولذا اتفقت الكلمة على أنه بحق هو أكبر “مجدد القرن الثاني”.
مقاصد كتاب اختلاف الحديث للشافعي
يُقصد بمختلف الحديث: تقابُل حديثين أو أكثر على سبيل المُمانَعة في الظاهر لا في حقيقة الأمر.
ويُعد كتاب الاختلاف أول تدوينٍ في الساحة العلمية لإرساء قواعد وأصول لمن أراد أن يتفقه في التوفيق بين النصوص المختلفة أن يمر من خلالها وإلا زل وضل وأضل.
قال الإمام السيوطي في ألفيته:
أول من صنف في المختلف الشافعي فكن بذا النوع حفي.
والكتاب حاوي بين دفتيه جملة صحيحة ومستحسنة من الأحاديث تفوق 300 حديثا تحت 79بابا بعد المقدمة الطويلة – ثلاث عشرة صفحة تقريبا- نثر خلالها فوائد جمة ذات الصلة بمنهج التعامل مع السنة النبوية، وحرر بعض القضايا على صيغة السؤال والجواب بين متحاورين لقصد الإيضاح وتقريب صور المسائل.
ويمكن تصنيف مباحث الكتاب إلى عنصرين رئيسين:
العنصر الأول: المباحث المتصلة بالدفاع عن السنة النبوية
لا ريب أن مقصد الإمام الشافعي العام من تأليف هذا الكتاب هو الدعوة إلى الاعتزاز بمكانة السنة في النفوس والدفاع عن حياضها، فسطور مقدمة الكتاب كاشفة لهذا المقصد، حيث استهلها ببيان:
1. مكانة السنة ووجوب الإذعان لأحكامها وتحكيمها في جميع القضايا الدينية، وأنها والقرآن في تأسيس الحكم سواء.
2. أتبع ذلك بمسألة حجية الخبر الواحد، وأسهب القول في توضيحه وأقام الأدلة على صحة الاحتجاج به، وذكر العديد من الوقائع المأثورة الصحيحة الداعمة لهذا المذهب؛ مثل إرساله عليه الصلاة والسلام بعض الأفراد من الصحابة لتبليغ الناس شرائع الدين.
“ولا كان لأحد وجه إليه رسول الله عاملا يعرفه أو لا يعرفه له من يصدقه صدقه أن يقول له العامل: عليك أن تعطي كذا وكذا، أو تفعل بك كذا، فيقول: لا أقبل هذا منك؛ لأنك واحد حتى ألقى رسول الله فيخبرني أن علي ما قلت إنه علي، فأفعله عن أمر رسول الله لا عن خبرك.”[3].
ولهذا اشترط الشافعي في قبول الحديث والاحتجاج به: اتصال سند الحديث وصحته؛ فإذا كان كذلك وجب قبوله، ولا عذر للعالم بالعدول عنه لأنه حجة قائم بنفسه.
3. ثم اشتد نكيره على من يترك بعض السنن الثابتة بدعوى التأويل مع قصور النظر، وأن ذلك دعوى عريضة لا دليل عليها، وأقام الدليل على فساد مسلكهم ومذهبهم.
العنصر الثاني: المباحث المتصلة بضبط الأسس النظرية والتطبيقية في دفع التناقض عن السنة النبوية
بما أن الفقه هو أهم ثمرة علم مختلف الحديث فقد اعتنى الشافعي في الكتاب اعتناء بالغا، حيث مثل بعدد هائل من التطبيقات الفقهية، فكان يناقش الأحاديث بالتحليل والشرح الذي يزيل الإشكالات الواردة عليها، ونبه على بعض ركائز أساسية تضبط الفهم الصحيح في هذا المسار، ومن ذلك أنه:
1 – لا مقابلة للحديث الضعيف مع الحديث المقبول، حيث أشار إلى هذا الضبط في خاتمة مقدمة الكتاب بقوله: “وجماع هذا أن لا يقبل إلا حديث ثابت كما لا يقبل من الشهود إلا من عرف عدله، فإذا كان الحديث مجهولا أو مرغوبا عمن حمله كان كما لم يأت؛ لأنه ليس بثابت”[4]
2 – لا دعوى التعارض بين الحديث النبوي وما دونه، قال رحمه الله: “لم يجز أن نعارض بقول أحد قول رسول الله ﷺ”[5] كائنا من كان، وإنما يفترض ذلك بين الحديثين المرفوعين.
3 – لا تناقض حقيقي بين الحديثين ما دام لهما السبيل إلى الاعمال، قال رحمه الله: “كلما احتمل حديثان أن يُستعملا معًا استعملا معًا، ولم يُعطل واحد منهما الآخر”[6]
ولما غابت هذه الأسس عند بعض المستعجلين أدى بهم ذلك إلى التخبط في التعامل مع السنة، وقد استظهر الشافعى صنيع هؤلاء في الكتاب بقوله: “وصفت في كتابي هذا المواضع التي غلط فيها من عجل في العلم قبل خبرته”.[7]
طرق إزالة الاختلاف بين الأحاديث المتعارضة
سلك المؤلف مراحل ثلاث لرفع التناقض والوقوف على حقيقة المراد من نص الحديث:
أولا: مسلك الجمع بين الأحاديث بعدة اعتبارات، إما الجمع بتخصيص العموم أو بتقييد المطلق، أو بحمل الوجوب على الندب لوجود صارف، أو بحمل المجمل على المفسر، أو بجعلها من قبيل المباح واختلاف التنوع لا اختلاف التناقض والتضاد، أو باختلاف المقامات والأحوال وغير ذلك من طرق التوفيق بين الأحاديث. والأمثلة على هذا المسلك كثيرة جدا في الكتاب.
وقد افتتح المؤلف أبواب الكتاب بـــ “باب الاختلاف من جهة المباح” وذكر عديدا من الأحاديث المتعارضة لكنها من جهة المباح لا اختلاف التضاد.
ومما ذكر: حديث” وضوء النبي ﷺ أنه توضأ مرة، وأنه توضأ ثلاثا ثلاثا أو مرتين مرتين.
قال الشافعي: ولا يقال لشيء من هذه الأحاديث: مختلف مطلقا، ولكن الفعل فيها يختلف من وجه أنه مباح لاختلاف الحلال والحرام، والأمر والنهي، ولكن يقال: أقل ما يجزي من الوضوء مرة، وأكمل ما يكون من الوضوء ثلاث[8]
ثانيا: مسلك النسخ عند تعذر الجمع، حيث حرر المؤلف في بعض الروايات المختلفة بأن التناقض بينها مدفوع بإثبات وجود الحكم الناسخ وإلغاء الحكم المنسوخ، وحصر طرق الاستدلال البينة على النسخ في ثلاثة أمور: 1- إما بالنص المرفوع أو الموقوف أو المقطوع، 2-وإما بالاجماع، وعبر عنه بالعامة، 3-وإما بمعرفة تاريخ المتقدم من المتأخر.[9]
ومن أمثلة ذلك في الكتاب: حديث عمار «فتيممنا مع رسول الله إلى المناكب» رأى الشافعي أن ذلك حين نزول آية التيمم ثم كان منسوخا بفعل النبي ﷺ بعده.
ثالثا: مسلك الترجيح، لا يصير المؤلف إلى الترجيح إلا بعد استنفاذ طرق الإعمال لجمبع الأحاديث، وعندها ينتهج منهج الترجيح بينها لرفع التعارض ثم يأخذ بالراجح منها مدعما بأدلة مقنعة، قال رحمه الله في هذه المرحلة:” لا يخلو أن يكون أحد الحديثين أشبه بمعنى كتاب الله، أو أشبه بمعنى سن النبي ﷺ، مما سوى الحديثين المختلفين، أو أشبه بالقياس، فأي الأحاديث المختلفة كان هذا فهو أولاهما عندنا أن يصار إليه”[10] وإنه يشير بهذا القول بأن وجوه الترجيح كثيرة.
ومن ذلك ترجيح حديث« التغليس بالصبح » على حديث « أسفروا بالصبح»قال الشافعي:” فقلنا: إذا انقطع الشك في الفجر الآخر وبان معترضا فالتغليس بالصبح أحب إلينا،.. لأن التغليس أولاهما بمعنى كتاب الله، وأثبتهما عند أهل الحديث، وأشبههما بجمل سنن النبي ﷺ، وأعرفها عند أهل العلم”[11].
وترى ترجيح الإمام هنا أكثر من وجه، حيث رجح الحديث من جهة الإسناد، وبدلالة الكتاب، وبضوء السنة المشهورة، وأنه قول الجمهور.
وهذه نبذة يسيرة عن منهج الإمام الشافعي في التعامل مع الأحاديث المتناقضة في الظاهر.
وفي الأخير، يبقى القول: إن الكتاب لا يخلو من الأحاديث الضعيفة وإن كان قليلا جدا، وإنه غير مرتب على ترتيب كتب الفقه المشهورة، وكذا لم يستوعب أبواب الدين ولا يشمل الأحاديث المتختلفة في الفقه، لكن برر النووي للشافعي بأنه “لم يقصد استيفاءه، بل ذكر جملة ينبه بها على طريقه”[12]
ويبقى الاحتفاء بالكتاب بأنه فريد في بابه وأول لبنة في قواعد علم المختلف، وكل ما أُلف بعده عيال عليه، وبذلك قد أدى الإمام الشافعي خدمة جليلة للمحدثين، كما أنه أدى خدمة أخرى في سد باب شكوك في السنة النبوية الصحيحة عن بوابة دعوى التناقض في الحديث النبوي.
[1] منهاج المحدثين، لعلى عبد الباسط مزيد. ص:238
[2] مناقب الشافعي. ص: 57
[3] – اختلاف الحديث 8/589
[4] – المصدر السابق 8/598
[5] – المصدر السابق 8/618
[6] – المصدر السابق 8/598
[7]– المصدر السابق
[8] المصدر السابق 8/599
[9] المصدر السابق 8/598
[10]– المصدر السابق 8/598
[11] – المصدر السابق 8/633
[12] – تدريب الراوي 2/180
تنزيل PDF