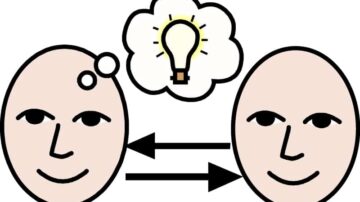“- من تظن نفسك؟
– أنا المتحدث باسم الحقيقة…
– بل الحقيقة أنا حصراً وقصراً!”
ومن ثم يبدأ النقاش في الدخول للمراحل المعتادة .. علو الصوت .. الشخصنة .. الحدة .. الشتم والتجريح .. الإتهام بالخيانة والعداء..”
هذا المشهد بات يلازمنا بشكل دائم تقريباً، سواء كان النقاش في السياسة أو في الدين، بل وحتى في الرياضة، ولا فرق إن كان النقاش بين رفقاء يتسامرون في مجلس أو على شاشات الفضاءيات أو على صفحات الإنترنت، فالمشهد بات مألوفاً لدرجة تكاد لا تخلو منها جهة من الجهات الأربع.
ونحن هنا نواجه مشكلتين مركبتين، حيت تتمثل الأولى في غياب المقدرة على رؤية الآخر و من باب الأولى الإعتراف له بأحقية الرأي ومن ثم مقارعته الحجة بالحجة. وتكمن المشكلة الثانية في تدني وإنحطاط مستوى النقاش نزولاً للشتم و الإتهام و التجريح حتى على المستوى الشخصي.
حول ثلاثة محاور سيدور حديثنا، التعليم والتربية و المجتمع، فماذا هو أثر كل منهم؟ وهل لنا أن نضعهم في قفص الإتهام لما يحدث من تدني للغة الحوار؟
وقبل الخوض في غمار هذه المغامرة لابد من أن أوضح أن أي تعميم سيرد في هذا المقال إنما المقصود ذلك الجزء المعني من المشكلة، فالتعميم المطلق يعد في حد ذاته أحد الأسباب التي أسهمت في إشعال نار المشكلة التي نحن بصددها هنا، هذا عوضاً على أنني من المؤنين أن كلمة “كل” من أصعب الكلمات استخداماً وخصوصاً إذا ما تعلق الأمر بالناس وعقائدهم وطباعهم و سلوكهم.
السمة التي يتصف بها كل فرد هي نتيجة تفاعله واستجابته للمحيط، فما بين التربية و التعليم و المجتمع تتكون الشخصية، وليس بالضرورة أن تتفق إستجابات جميع الناس لذات الظروف، بل إن تباين هذه الإستجابة هو ما يميز كل واحد منّا عن الآخر، لكن تبقى في المجتمعات سمات عامة نتيجة للتشابه الكبير في ظروف المجتمع و طرق الإستجابة، وهو ما يمكن أن نسميه السمات الحاكمة، وبالطبع فنحن في هذه العجالة سنعرض لبعض أهم تلك المحطات وليس لحصرها؟
التربية
“أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة”
من هنا سننطلق نحو التربية كخطوة أولى لمحاولة فهم النتيجة، فما بين إحترام الكبير و غياب شخصية الصغير تظهر البذرة الأولى للمشكلة، فهذا الصغير إن لم ينشأ في مجتمع يعطيه فرصة ليقول رأيه، أو حتى ليناقش رأي يعطاه، فهذا بلا شك سيشكل في داخله مغالطة منطقية أولى في لغة الحوار و فنونه، وهذا أمر مشهود في مجتمعاتنا، فالأكبر هو الأعلم على الإطلاق، ولا مجال للصغير لمناقشة هذه المسلمة.
“أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة” هذا المثل المتداول لا يخلوا من الصحة فلاشك أن الحياة تكسب المرء خبرة و دراية، لكن أخذه على عمومه يعريه من صحته ليصبح علم الكبير مطلق الصحة و غير قابل للنقاش، وهذا مربط الفرس في أول عقدة من عقد الحوار.
“خليك على مجنونك ليجيك الأجن منه”
هذا المثل المتداول أيضاً يشكل سداً منيعاً في عقول النشأة أمام أي محاولة للتفكير خارج القوالب المفروضة سلفاً، فأنت لن تأتي بأفضل مما أتينا به نحن من قبلك، فالزم حدودك و فكر كما نفكر و إلا كنت شاذاً عن المجتمع منبوذا فيه.
فهذه الأساليب القمعية الناعمة وما شابهها شكلت المكون الأول لمعضلة ثقافة الحوار، منتجة أجيال من الجمود الفكري الراسخ على فهم أوحد، ولا يقبل سواه بديلاُ بل لايقبل فيه نقاشاً، ويرى في كل مخالف له شاذ خارج عن جادة الصواب المطلق الذي يعيشه هو.
التعليم
“أحادية الطرح”
لو أخذنا الدين مثالاً، لوجدنا أن كل بلد يطرح المناهج الدينية بشكل أحادي، فيدرّس مدرسته الفكرية و مذهبه و عقيدته على أنها هي الفهم الصحيح المطلق للدين، بل قد يذهب بعض المتشددين للقول بأن كل ما خالف ذلك فهو ليس من الدين أصلاً، ليتبع ذلك عملية سحب بين مفهوم الكافر و المخالف، للتولد في ذهنية المتلقي ثنائية قاتلة لا وسط فيها، فإما تكون على قولي وهو الصواب المطلق أو أنك ضد الدين و كافر وبالتالي سأتعامل معك بأحكام مسبقة حادة لاتقبل القبول.
ولنا أن نسوق هذا المبدأ على مختلف مناحي التعليم التي تطرح الأفكار على أنها مطلقة الصحة، مما يعطي حاملها منعة ذاتية ضد أي قبول للآخر.
المجتمع
“المنزلق الحدر”
في عالم السياسة مثلاً، تتشكل في العقل الجامد صورة نمطية للمخالف وهي على الأغلب تكون كالآتي: أنت لا تريد الدولة الإسلامية، إذن أنت ضد الدين، أو أنت لا تريد النظام الديمقارطي إذا أنت ضد الحرية، وهكذا. فتشكل هذه المعادلة القاتلة مفرقاً رئيسياً في كل حوار، فيتم تقسيم الناس لصنفين، فأنت إما معي أو ضدي، وهذا قد نجده في مختلف التيارات الفكرية سواء كانت دينية أو غير دينية.
لينتج عن هذا منزلق حدر يبدأ بمخالفة الرأي لينتهي بالتكفير و التخوين و التبديع، ومعاملة الآخر على أنه عدو لدود و شر على الناس تجب محاربته بكل السبل.
“إعلام السلعة”
هذا السَعَر الذي أصاب وسائل الإعلام نتيجة لهثها وراء المادة و تسليع كل شيء حتى الأفكار، بات يزكي نار الخلاف، فتجد عند بعض القنوات أن من أهم معايير استضافة الضيوف أن يُقدّم فيهم الأجرأ على الشتم و السب، سعيا وراء مشاهدات أكثر و شهرة مشبوهة، فغياب الرسالة السامية عند بعض الفضائيات جعل الإعلام مشاركاً في هذه اللعبة القذرة، و بعد أن عشنا – ولا زلنا- نعيش تسليع و تشييء المرأة و المتاجرة بها ها نحن نعيش زمن تسليع وتشييء الأفكار.
هذه الأمثلة على ما يمكن أن يكون قد تسبب به كل من التربية والتعليم والمجتمع من ضرر لبنية الإنسان الفكرية في نشأتها، يدعونا للعمل على حل تلك المشاكل من جذورها والبحث في أعماقنا ومناهجنا ومجتمعاتنا على الأسباب التي تجعل الحوار يهبط لتكل المستويات الضحلة بل و المنحطة أحياناً.
لابد لنا من وقفة جادة وجريئة، نواجه فيها أنفسنا لمحاربة الإسفاف والتدني، فخروج الشعوب اليوم إلى أفق الحريّة يحمّلها مسؤولية عظيمة تجاه الوعي الجاد والأفق الواسع الذي يسع جميع الأفكار، فالفكرة لا يقويّها ويضمن بقاءها شيء مثل انفتاحها وصلاحها.