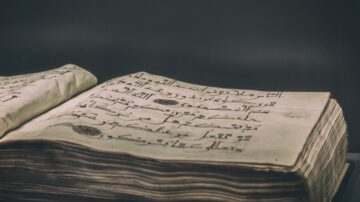يذهب كثير من العلماء والكتّاب والباحثين والدعاة والوعاظ إلى التساهل في رواية أخبار السيرة وسائر الأخبار التاريخية، وهذا أمر معلوم، لكنه منضبط بضابط مهمّ، وهو أن لا يندرج تحتها أحكام شرعيّة أو قضايا عقديّة أو ما يتعلق بالكلام في الصحابة وعدالتهم أو الطعن في الرواة.
فالمقصود بالتّساهل في ذلك ما يكون من جهة ضبط الناقل لا من جهة عدالته، فمن ثبت فيه الجرح من قِـبل عدالته لم يقبل منه الخبر ولو كان تاريخيًّا أو في فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب، وأمّا إن لم يعلم ذلك فالأمر واسع بشروط، وهي:
- أن يكون له إسناد في الكتب المعتبرة.
- أن لا يكون منكرًا من جهة المعنى نكارة ظاهرة.
- أن لا يثبت فيه الخطأ ثبوتا علميا.
- أن لا يكون مرويا من طريق مجهول أو أكثر لا سيما إذا ثبت خلافه.
- أن لا تقع فيه مخالفة صريحة لوقائع التاريخ الثابتة.
- أن لا يكون في الخبر ما يدل على باطل يقدح فيمن نُسب إليه.
- أن لا يُعرف الخبر إلا من رواية الخصم، ويكون الخبر مخالفًا لأصول المنسوب إليه أو لمذهبه الذي عاش به.
- أن لا يكون الخبر مخالفًا للواقع المشهود([1]).
ويُستأنس في هذا بما ورد عن الإمام أحمد، فعن عباس الدوري قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول- وهو على باب أبى النضْر([2])– وسأله رجل فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في محمد بن إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي؟ فقال: أما موسى بن عبيدة فكان رجلا صالحا، حدّث بأحاديث مناكير، وأما محمد بن إسحاق فيكتب عنه هذه الأحاديث يعنى المغازي ونحوها، فإذا جاء الحلال والحرام أردنا قومًا هكذا، قال أحمد بن حنبل بيده وضم يديه وأقام أصابعه الإبهامين)([3]).وقد بوّب الخطيب البغدادي بمبحث: (ما لا يفتقر كتْبُهُ إلى إسناد) فقال: (وأمّا أخبار الصالحين وحكايات الزهاد والمتعبّدين ومواعظ البلغاء وحِكم الأُدباء فالأسانيد زينة لها، وليست شرطا في تأديتها… ثم روى بسنده عن سعيد بن يعقوب قال: سمعت ابن المبارك وسألناه، قلنا: نجد المواعظ في الكتب فننظر فيها، قال: لا بأس، وإن وجدت على الحائط موعظة فانظر فيها تتعظ. قيل له: فالفقه؟ قال: لا يستقيم إلا بالسماع)، ثم قال: على كل حال فإنّ كتب الإسناد أولى سواء كان الحديث متعلّقا بالأحكام أو بغيرها)([4]).
وقال الدكتور أكرم ضياء العمري: (أمّا اشتراط الصحّة الحديثيّة في قبول الأخبار التاريخيّة التي لا تمسّ العقيدة والشريعة ففيه تعسّف كثير، والخطر الناجم عنه كبير؛ لأنّ الروايات التاريخية التي دوّنها أسلافنا المؤرخون لم تعامل معاملة الأحاديث، بل تمّ التساهل فيها، وإذا رفضنا منهجهم فإنّ الحلقات الفارغة في تاريخنا ستمثل هوة سحيقة بيننا وبين ماضينا مما يولّد الحيرة والضياع والتمزق والانقطاع… لكن ذلك لا يعني التخلّي عن منهج المحدّثين في نقد أسانيد الروايات التاريخية، فهي وسيلتنا إلى الترجيح بين الروايات المتعارضة، كما أنّها خير معين في قبول أو رفض بعض المتون المضطربة أو الشاذّة عن الإطار العام لتاريخ أمّتنا، ولكن الإفادة منها ينبغي أن تتمّ بمرونة، آخذين بعين الاعتبار أنّ الأحاديث غير الروايات التاريخية، وأنّ الأولى نالت من العناية ما يمكنها من الصمود أمام قواعد النقد الصارمة)([5]).
ولذا وجدنا الإمام الطبريّ رحمه الله في تاريخه يصرّح بمنهجه في رواية الأخبار التاريخيّة، وأنّه مجرّد ناقل بالإسناد من غير مراعاة لصدقيّة الخبر من جهة العقل والإمكان والاستحالة، قال: (وليعلم الناظر في كتابنا هذا أنّ اعتمادي في كلّ ما أحضرت ذكره فيه مما شرطت أنّـي راسمه فيه، إنّما هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه، والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه، دون ما أدرك بحجج العقول، واستنبط بفكر النفوس، إلا اليسير القليل منه، إذ كان العلم بما كان من أخبار الماضين، وما هو كائن من أنباء الحادثين، غير واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم، إلّا بأخبار المخبرين، ونقل الناقلين، دون الاستخراج بالعقول، والاستنباط بفكر النفوس فما يكن في كتابـي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه، أو يستشنعه سامعه، من أجل أنّه لم يعرف له وجها في الصحّة، ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدّيَ إلينا)([6]).
نظرة في التعامل مع الأحاديث الضعيفة في السيرة فيما تتضمن نقصا في شخص النبيّ ﷺ- ولو من وجه –
وأعني بهذه الأخبار كلّ خبر يحوي في باطنه – ولو بوجه ما- نقصًا في شخص النبيّ ﷺ وإن لم يكن ذلك ظاهرًا ظهورًا بيّنًا، لكن يحتمل بعض ذلك إذا أنعمنا فيه النظر، فكلّ حديث ضعيف- ولو كان ضعفه يسيرًا- إذا دلّ- ولو دلالة ضعيفة بوجهٍ ما- على نوع نقصٍ أو إهانةٍ ونحو ذلك للنبيّ ﷺ لم يُتساهل في روايته وتمريره على أنّه لا يضرّ ما دام ليس في الأحكام والعقائد، لأنّ شخصَ النبيّ ﷺ ليس كمثله أحد من البشر شرفًا وقدرًا، بل إذا وجب تنزيه المسلم عمّا ينقص من قدره فمن باب أولى وأوجب تنزيه شخض النبيّ ﷺ.
وباختصار أقول: كلّ حديث في سيرة رسول الله ﷺ لم يثبت سنده، ودلّ معناه على شيء من نقص فيه ﷺ، فإنّه يمنع من روايته وإعماله أو الاقتداء به، والمعنى أنه ينبغي النظر في المعنى الذي دل عليه الحديث من كل الجوانب، ولا يكفي ما يتبادر لأول وهلة من محاسن المعنى في الظاهر، ولأضرب على هذا أمثلة.
المثال الأول
قصّة اليهودي الذي كان يؤذي النبي ﷺ ويضع القمامة عند باب بيته: فقد اشتهر في حديث كثيرٍ من الوعاظ والخطباء وغيرهم أنّ يهوديّا كان يؤذي النبي ﷺ بوضع القمامة على باب بيته، ويوردونهذه القصّة على سبيل امتداح حلم النبيّ ﷺ وسماحته ورحمته التي شملت المسلم وغيره، فهل ترى هذه القصّة صحيحة؟
قبل الجواب عن هذا يحسن أن أذكّر بأنه قد صحّ أنّ النبي ﷺ كان له خادم يهوديّ يخدمه، ولما حضرته الوفاة دعاه إلى الإسلام فأسلم، وهناك رواية شبيهة بهذه وهي أنّه ﷺ عاد جارًا يهوديّا مرض فدعاه إلى الإسلام فأسلم.
أما الرواية الأولى فرواها البخاريّ وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهوديّ يخدم النبي ﷺ، فمرض فأتاه النبي ﷺ يعوده فقعد عند رأسه فقال له: “أسلم”. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم ﷺ فأسلم فخرج النبي ﷺ وهو يقول: “الحمد لله الذي أنقذه من النار”([7]). وفي رواية: (كان يضع للنبي ﷺ وضوءه ويناوله نعليه)([8]).
وأمّا الرواية الثانية فرواها ابن السنيّ من حديث بريدة رضي الله عنه قال: كنّا جلوسًا عند رسول الله ﷺ فقال: “اذهبوا بنا نعود جارنا اليهودي”. قال: فأتيناه. فقال: ” كيف أنت يا فلان؟” فسأله، ثم قال: “يا فلان اِشهد أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله”. فنظر الرجل إلى أبيه وهو عند رأسه فلم يكلّمه، فسكت فقال: “يا فلان اِشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله”. فنظر الرجل إلى أبيه فلم يكلمه ثم سكت ثم قال: “يا فلان اِشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله”. فقال له أبوه: اشهد له يا بني. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله. فقال: “الحمد لله الذي أعتق رقبة من النار”([9]).
هذه الرواية تشبه رواية البخاريّ غير أنّ هذه تتحدّث عن جار يهوديّ مرض لا عن خادم يهوديّ خدم النبيّ ﷺ، والصحيح رواية البخاريّ، وقد يقال في الجمع بين الروايتين أنّ ذلك الخادم كان جارًا للنبي ﷺ، غير أن بعضهم زاد عليها قصّة وضع القمامة على باب بيت النبيّ ﷺ، وهي زيادة منكرة لا أصل لها في كتب السنّة، وإنما هي قصة يحكيها الوعاظ والخطباء وبعض الكتاب. والمحفوظ رواية البخاري أنّ ذلك اليهودي الذي دعاه للإسلام فأسلم إنما كان غلاما خادمًا، ويستحيل أن يكون الخادم الغلام ممن يؤذي النبي ﷺ، فيضع القمامة على باب بيته، كيف يؤذيه وهو خادمه وحامل نعله ووضوئه؟ وبهذا نقطع بأنّ قصّة إيذاء الجار اليهودي للنبيّ ﷺ بوضع القمامة أو الشوك على باب بيت النبي ﷺ منكرة مردودة، فلا تصحّ متمسكا لدعاة السماحة المبالغ فيها إلى هذا الحدّ. ولا يصحّ أن يقال إنّ هذا الحديث ضعيف يجري في سياق الحديث عن الأخلاق والفضائل، والجواب أنّ هذه القصّة منكرة باطلة، لا يجوز الاعتماد عليها في تأصيل خلق السماحة والحلم، وفي الصحيح من الأحاديث ما يغني.
وهذه القصّة كما ترى فيها نوع انتقاص لشخص النبي ﷺ وإذلال له، مع سكوت الصحابة كمثل عمر بن الخطاب وغيره عن هذا، كيف يعقل أن يكون يهودي في المدينة ممن وجبت عليهم دفع الجزية وهو صاغر أن يؤذي النبي ﷺ بما يهان به المرءُ في كلّ الأعراف، ثم يسكت عنه النبي ﷺ وأصحابه؟
المثال الثاني
قصة زواج النبي ﷺ من خديجة رضي الله عنها. ومن الروايات التاريخيّة التي يقصّها بعض الدعاة ويروجها بعض الكتّاب، واستغلها بعض المغرضين من المستشرقين وغيرهم قصّة زواج النبي ﷺ من خديجة رضي الله عنه، وهذه القصّة رواها أحمد بن حنبل([10]) والطبراني([11])، من طريق حماد بن سَلَمة عن عَمّار بن أبي عمار عن ابنِ عباس، فيما يَحْسِبُ حماد: أنّ رسول الله صلي الله عليه وسلم ذكر خديجة، وكان أبوها يَرغَب أن يزوجه، فصَنعت طعاماً وشراباً، فدعت أباها وزُمَراً من قريش، فطَعمُوا وشربوا حتى ثَمِلُوا، فقالت خديجة لأبيها: إن محمد بن عبد الله يخطَبني، فزوّجْني إياه؟، فِزوَّجها إياه، فخلعتْه وألبستْه حُلةً، وكذلك كانوا يفعلون بالآباءَ، فلماَ سُرِّي عنه سُكْرهِ نظر فإذا هو مُخَلَّق وعليه حُلة، فقال: “ما شأني؟ ما هذا؟ “، قالت: زوجتني محمد بن عبد الله، قال: أنا أزوِّج يتيم أبي طالب؟!، لا لعمري!، فقالت خديجة: أما تستحي؟، تريد أن تُسفِّه نفسَك عند قريش؟، تخبر الناس أنك كنتَ سكرانَ؟!، فلم تزل به حتى رضي.
فهذه الرواية بهذا اللفظ عليها ثلاثة مآخذ: الأول: من جهة الإسناد. الثاني: من جهة التاريخ. الثالث: من جهة المعنى.
أمّا من جهة الإسناد، ففيه كلام، حيث تفرّد حماد بن سلمة بهذه الرواية، وأداها على الشكّ، وفي طريق آخر يرويه عن علي بن زيد بن جدعان عن عمار بن أبي عمار، وعلي بن زيد ضعيف، لذا حكم الشيخ شعيب الأرناؤوط بضعفها، قال: (إسناده ضعيف، فقد شكّ حماد بن سلمة في وصله إذ قال الرواة عنه: “فيما يحسب حماد” ولم يجزم، ثم إنّ حماد بن سلمة قد دلّسه، فقد أخرجه البيهقي في “الدلائل” من طريق مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس: أنّ أبا خديجة زوج النبي ﷺ وهو- أظنه قال:- سكران، فعاد الحديث إلى علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني من طريق سليمان بن جرير، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. قلنا: وأخرج ابن سعد في “الطبقات” عن محمد بن عمر الواقدي، عن محمد بن عبد الله بن مسلم، عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم. وعن ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وعن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة، عن ابن عباس قالوا: إن عمها عمرو بن أسد زوجها رسول الله ﷺ، وإنّ أباها مات قبل الفجار)([12]).
أمّا من جهة التاريخ، فإنّ الذي زوّج خديجة إنّما هو عمُّها عمرو بن أسد كما دلّت عليه الروايات الأخرى، فقد (أورد ابن سعد عن محمد بن عمر الواقدي نحو القصّة التي رواها عمار بن أبي عمار، ثم قال: وقال محمد بن عمر: فهذا كله عندنا غلط ووهل، والثبت عندنا المحفوظ عن أهل العلم أنّ أباها خويلد بن أسد مات قبل الفجار، وأنّ عمّها عمرو بن أسد زوجها رسول الله ﷺ([13]). وبه قال الزبير بن بكار وغيره، ذكره ابن الأثير في “أسد الغابة”([14])، وبه قال أيضا المبرد وطائفة معه، ذكره السهيلي في “الروض الأنف”)([15]).
أمّا من جهة المعنى فالأمر أشدّ- فيما يبدو لي-، لأنّ فيها دلالة على انتقاص مقام النبي ﷺ وأنّه دون السيّدة خديجة وأقلّ شأنًا، إذ كيف يعقل أن يرفض أبوها مَن أجمعوا على أمانته وشرفه ومكانته وهي من مكانة بني هاشم، وكيف يُردّ أبو طالب وهو سيّد قريش، ثم إنّ الأخطر من ذلك ما دلّت عليه هذه الرواية من إقرار النبيّ ﷺ وتواطئه- ولو بالسكوت- مع خديجة على ترتيب هذا الزواج، أكانت هذه أخلاق النبيّ ﷺ، أيقبل بزواج مبنيّ على غشّ وتزوير وحيلة؟ كلّا ما هكذا كانت أخلاقه ﷺ، وهل يمكن أن يهيء الله محمّدًا ﷺ للرسالة وهو واقع في مثل هذا؟ كلّا، مع ما في الرواية من ضعف، فلا يليق روايتها بحجّة أنّها ليست في الأحكام والعقائد لما دلّت عليه من المعاني الفاسدة، والله أعلم.
وممّا يزيد في تقرير ضعف هذه الرواية ورود رواية مخالفة لها صريحة في أنّ الذي زوج خديجة إنّما هو عمّها عمرو بن أسد- كما سبقت الإشارة إليه-، ولم يقع من ذاك الأمر الذي ورد في الرواية الأولى من السكر ونحوه، هكذا جاءت هذه الرواية في كتب السيرة، ومن ذلك ما رواه ابن سعد في الطبقات قال: قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، أخبرنا موسى بن شيبة عن عميرة بنت عبيد الله بن كعب بن مالك عن أم سعد بنت سعد بن الربيع عن نفيسة بنت منية قالت: كانت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي امرأة حازمة، جلدة، شريفة، مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير، وهي يومئذ أوسط قريش نسباً، وأعظمهم شرفاً، وأكثرهم مالاً وكل قومها كان حريصاً على نكاحها لو قدر على ذلك، قد طلبوها وبذلوا لها الأموال، فأرسلتني دسيساً إلى محمد بعد أن رجع في عيرها من الشأم، فقلت يا محمد: ما يمنعك أن تزوج؟ فقال: ما بيدي ما أتزوج به، قلت: فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قال فمن هي؟ قلت: خديجة، قال: وكيف لي بذلك؟ قالت قلت: علي، قال: فأنا أفعل؛ فذهبت فأخبرتها، فأرسلت إليه أن ائت لساعة كذا وكذا، وأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها فحضر ودخل رسول الله، ﷺ، في عمومته، فزوجه أحدهم، فقال عمرو بن أسد: هذا البضع لا يقرع أنفه، وتزوجها رسول الله، ﷺ، وهو ابن خمس وعشرين سنة، وخديجة يومئذ بنت أربعين سنة، ولدت قبل الفيل بخمس عشرة سنة. قال: أخبرنا محمد بن عمر عن محمد بن عبد الله بن مسلم عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم وعن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قالوا: إن عمّها عمرو بن أسد زوجها رسول الله، ﷺ، وإن أباها مات قبل الفجار([16]).
وممن صحّح هذه الرواية السهيليّ في الروض الأنف قال: (وذكر مَشيَ رسول الله ﷺ – إلى خويلد بن أسد مع عمه حمزة رضي الله عنه، وذكر غير ابن إسحاق أنّ خويلدا كان إذ ذاك قد أهلك، وأن الذي أنكح خديجة رضي الله عنها هو عمّها عمرو بن أسد، قاله المبرد وطائفة معه، وقال أيضا: إنّ أبا طالب هو الذي نهض مع رسول الله ﷺ، وهو الذي خطب خطبة النكاح، وكان مما قاله في تلك الخطبة: “أمّا بعد فإنّ محمّدا ممن لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، فإن كان في المال قل، فإنما ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك”، فقال عمرو: هو الفحل الذي لا يقدع أنفه فأنكحها منه، ويقال قاله ورقة بن نوفل، والذي قاله المبرد هو الصحيح لما رواه الطبري عن جبير بن مطعم، وعن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنهم كلهم قال: إنّ عمرو بن أسد هو الذي أنكح خديجة رسول الله ﷺ، وأنّ خويلدا كان قد هلك قبل الفجار وخويلد بن أسد هو الذي نازع تبعا الآخر حين حجّ وأراد أن يحتمل الركن الأسود معه إلى اليمن، فقام في ذلك خويلد وقام معه جماعة، ثم إنّ تبّعا روع في منامه ترويعا شديدا حتى ترك ذلك وانصرف عنه والله أعلم([17]).