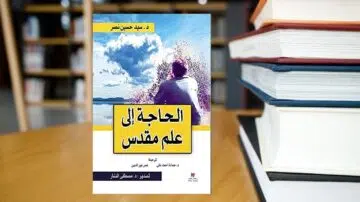يتربّع سيد حسين نصر (المولود بطهران عام 1933)، أستاذ كرسي الأديان بجامعة جورج واشنطن، على عرس ثلّة من المفكرين المعاصرين الذين أسهموا بشكل كبير في الوعي بالإسلام: تاريخا، وحضارة، وفلسفة. وقد ارتحل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الثانية عشرة من عمره، وهنالك حصل على درجة البكالوريوس في الفيزياء، فالماجستير في الجيولوجيا والجغرافيا الفيزيائية، ثمّ الدكتوراه في الفلسفة وتاريخ العلوم من جامعة هارفارد.
عاد حسين نصر إلى إيران عام 1958، وعمل أستاذا في جامعة طهران حتى العام 1979، ثم رئيسًا لها في الفترة (1968-1972)، كما شغل مناصب عدّة، ومن أبرز مؤلفاته: “المعرفة والمقدَّس”، “ثلاثة حكماء مسلمين: ابن سينا، السهروردي، ابن عربي”، “مقدّمة إلى العقائد الكونية”، “دراسات إسلامية”، “الإسلام أهدافه وحقائقه”، “الحاجة إلى علم مقدس” والذي صدر أخيرا بترجمة د. حمادة أحمد علي وعمر نور الدّين، وتصدير د. مصطفى النشَّار (القاهرة: نيو بوك للنشر والتوزيع، 2017).
الدين والتراث في مدرسة الحكمة الخالدة
بحكم انتمائه لمدرسة “الحكمة الخالدة” التي تُعْنى بالتُّراث – كما فسَّرَهُ أساتذة التُّراث وشارِحُوهُ في “مدرسة التُّراثيون”: كالشَّيخ عبد الواحد يحيى، والشيخ أبو بكر سراج الدين وغيرهما- يولي سيد حسين نصر عناية خاصّة بمسائل الدين وما يرتبط بها من قضايا الوحي والإنسان والألوهية. ومن شأن هذه النّظرة الواسعة للدّين أن تفتح أبواب الفهم على طول وعرض الأديان الأخرى، وتحلُّ تعقيد المسائل العالقة، وتفسّر معنى تعدّد الأديان وعلائقها المختلفة، فضلا عن عدم إغفالها للجوانب الاجتماعية والنفسية للأديان بصفة عامة.
وبحسب المؤلِّف، فإنَّ المقصود بالعلم الأسْمى، العلم المقدَّس، ذلك الذي يبحث تجلّيات “المبدأ الرَّباني” في نور المبدأ ذاته؛ وهو ما يمكن تسميتُه بعلم “الإلهيات”، فهو العلم الذي يبطنُ في مركز كيان الإنسان ذاته، كما أنه يبطنُ في الأديان الرشيدية Orthodoxالأصيلة كافة، والتي تُدْرَكُ بالبصيرة، لا بالعقلانية ولا بالتَّجريبية. ويتجذَّر هذا المبدأ الرئيس في طبيعة “المقدَّس” التي تصدر عن الحقيقة بوصفها معرفة الوجود التَّوحيدية المتعالية على عدم التَّقابُس بين الذَّات والموضوع.
بحسب المؤلِّف، فإنَّ المقصود بالعلم الأسْمى، العلم المقدَّس، ذلك الذي يبحث تجلّيات “المبدأ الرَّباني” في نور المبدأ ذاته؛ وهو ما يمكن تسميتُه بعلم “الإلهيات”
ومن هذا المنطلق يسعى أصحاب مدرسة الحكمة الخالدة إلى إبراز جوانب علم الإلهيات في سياق تجلّياته الرُّوحية والفكرية. واتساقا مع ذلك المنحى الدّراسي ركّز المؤلّف في الجزء الأول من كتابه على جملة المبادئ الأولى بفصلين ينصبَّا على طبيعة الله تعالى والرُّوح، وهما مفهومان تابعان للعلم المقدَّس، ويليه دراسةٌ عن الأبدية والزَّمن تتناول الميتافيزيقيا الجوهرية التي ينصبُّ اهتمامُها على العلوم التي تعالج العرضيَّة والاحتمال. وإلى جانب ما سبق يتضمَّن الجزء الثاني من الكتاب دراستيْن تتناولان تساؤُلا جوهريا عن تعدُّد الصور المقدَّسة والعوالم الدّينية، فيما يتناول الجزء الثالث طرحاً للعلوم التُّراثية، أو المقدَّسة، التي ترعْرعتْ وحُفِظتْ في حضارات غير غربية، والتي لم تُعانِ بدرجة كبيرة من آثار العلوم العلمانية كما حاق بالغرب، حيث وُلدت الحداثةُ ورضعتْ وترعرعتْ قبل أن تنتشر إلى قارات أخرى ممَّا أدَّى في الأخير إلى نشوء توتُّر بين العلوم الغربية من جهة، والعلوم التُّراثية التي ما زالت تعيش بدرجة ما، كما تعيش الرّسالة الرُّوحية لعلوم الكون التُّراثية من جهة أخرى.
ومن هنا يشتمل الجزء الثالث على ثلاثة أبواب عن المواجهة بين منظور التُّراث إلى العالم وبين “مهْزَلة” الحداثة؛ الباب الأول يتعامل مع موضوع ملحٍّ للغاية ألا هو مشكلة البيئة، والذي يعالجه المؤلِّف من منظور الدّراسة المقدَّسة للطبيعة؛ وخصوصا في التُّراث الإسلامي، والباب الثاني يُقدّم فيه نقدا تراثيا لفكرة التقدُّم بالتطور المادي المؤيَّد بالعلم الحديث، والباب الثالث يختم بالعودة إلى موضوع علم الإلهيات ذاته والحاجة الماسَّة إلى زرع مفاهيمه في السّياق المعاصر.
تلك كانت بنية الكتاب لجهة فصوله ومضامينه، أمَّا الغاية الكبرى للكتاب فتتمثَّل في نقد الادّعاءات الشُّمولية للعلم الحديث، أو على الأقل العلْمويَّة والوضعية المنطقية التي تدَّعي احتكار المعرفة. وتأكيد الحاجة إلى “العلم المقدَّس” الذي ضلَّ في متاهات النّسيان عن “الحكمة الخالدة” التي تعتبر العلوم تطبيقاً لها وبقايا منها.
الذَّات العلية بوصفها حقيقة لانهائية
تُقدّم مدرسة “الحكمة الخالدة” الله سبحانه وتعالى بوصفه حقيقة لا نهائية، ويجب أن يُفهم تعبير “اللانهائي” هاهنا على نحو ميتافيزيقي وليس على نحو حسابي، كما أنَّ “اللانهائية” مصدرٌ لكلّ الممكنات الكونية وقبل الكونية Metacosmic. فتعبير الله “لا نهائي” هاهنا ليس بمعنى أنه لا يمكن لشيءٍ أن يعلوه فحسب؛ بل بمعنى أنَّه حقيقة لا مُتناهية تحْوي كلَّ الممكنات، وعلى نحو ميتافيزيقيٍ هو كليَّة الإمكان، وهو ما يقرّره الإنجليل بالقول: “إنَّ الله هو كلُّ ما يمكن”،
ويؤكّده القرآنُ حين يُشدّد على أنَّ لله سبحانه وتعالى سلطانا فوق كلّ شيء، في إشارة إلى أنَّ طبيعة الله “اللانهائية” هي “كليَّة الإمكان”، أو “كلية القدرة }فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ{.[يس: 83] وتعني الآية أنَّ الحقيقة الأساسية لكلّ الأشياء قائمة في الطَّبيعة الرَّبانية، ومن المفيد هنا أن نستدعي كلمات: الإمكان، والاقتدار التي لها الدَّلالة نفسها حتَّى نقول: “إنَّ الله كليُّ الإمكان، وكليُّ القدرة”.
سُّورة الإخلاص في مُجْملها عبارة عن وحي ومثال مقدَّس للمذهب الميتافيزيقي الذي يتناول الطَّبيعة الرَّبانية في إطلاقها ولا نهائيتِها.
ففي سورة “الإخلاص” التي تلخّصُ مفهوم “الرُّبوبية” عند المسلمين تُشير كلمة }قُلْ{ إلى التَّجلِّي الرَّباني وإلى اللوجوس؛ أي الأداة الرَّبانية للتَّجلي، فيما تشير كلمة }هُوَ{ إلى الماهيَّة الرَّبَّانيّة؛ أي الله سبحانه في ذاته وبما هو أصل للهُويَّة. أمَّا كلمة }أَحَدٌ{؛ فتشهدُ بالأحدية والإطلاق، فالله واحدٌ لأنَّه مُطلق، كما أنَّه مُطلق لأنَّه واحد. وأخيرًا تُفيد كلمة }الصَّمَدُ{ أنَّ الله مصدرُ كلّ شيء؛ كناية عن “اللانهائيَّة”، وأنَّ وجوده كليُّ الإمكان، فيما تؤكّد الآيتان الأخيرتان }لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ{ أنَّ الله مُتعال عن العلاقات والمقارنات.
وينتهي سيد حسين نصر من وراء ذلك إلى تقرير أنَّ السُّورة في مُجْملها عبارة عن وحي ومثال مقدَّس للمذهب الميتافيزيقي الذي يتناول الطَّبيعة الرَّبانية في إطلاقها ولانهائيتِها، وأنَّ المعرفة هي مصدرُ الوحي الباطني؛ أو “البصيرة”.
التُّراث وصيغ التَّجلّي الإلهي
إنَّ مفهوم الدّين يتسع في نطاق “الحكمة الخالدة” لينطوي على المجال الأولاني والتَّاريخي معًا. فالتَّراث – بمفهوم مُعلّمي “مدرسة التراثيون”- ينطوي في ثناياه على كلّ صيغ التَّجلّي الإلهي، كما أنَّ الدّين في ذاته ترابي البنيَّة، ولا يسبر غوره عالَمُ الظَّاهر وحقيقته الصورية، تماما كما يحتاج عالم الظاهر Phenomenal إلى الباطن، أو الأَسْمَى Noumenal، فمفهوم “الظَّاهر” ذاته يفترض وجود “الباطن”، كما يستلزم الجانب الصُّوريُّ من الدّين بدوره جانبا لاصوريا. فالدّين ينطوي على بُعْدٍ برَّانيٍّ يتولَّى الجانب الصُّوريَّ من الحياة الإنسانية، ولكنْ بموجب كوْنه دينًا مكتفيًا بذاته – كي يهْدي الإنسان إلى فروض الدّين ويؤمِنُ بحقائقه، ويعيش حياة فاضلة سوية ويفوز بالخلاص- فله كذلك بُعْدٌ جُوَّانِيٌّ يتولَّى جانب اللاصوري والجوهري،
من جهة أخرى تحرص “مدرسة التُّراثيون”، التي ينتمي إليها سيد حسين نصر، على دراسة الدّين بتبتُّلٍ، ومُعارضة كلّ نسبية تتْرَى في الدّراسات الأكاديمية الحديثة للدّين والمفاهيم الضَّيقة عن الحق التي ترى تجليًا واحدًا للحقّ على أنَّه الحقُّ بما هو. كما تحرص أيضًا على المبدأ المنطقي الذي يؤكّد أنَّه “لا مُطْلَق إلّا المطلق”؛ فكلُّ ما عداه نسْبِيٌّ.
كل عالَم ديني تُتَنَزَّلُ الشرائع والرموز التي تقدّسها سُنّة تراثية، والبركةُ التي تُحيي الدين، وكلها مطلقة في حوضها دون أن تُصبح مطلقة بما هي
وفي هذا السّياق بلور الشَّيخ عيسى نور الدّين، أحد أهمّ روَّاد هذه المدرسة، مبدأ “المطْلَق النّسبيّ”، ففي حين أنَّ شمسنا هي الشَّمس بما هي في نطاق مجموعتنا الشَّمسية؛ فإنَّها مجرد شمس بين شمُوس أخرى بالنَّظر إلى المجرَّات الكبرى. وقلْ مثل ذلك عن كلّ عالَمٍ دينيٍ، فهُنالك الكلمة، أو اللوجوس، الذي قد يكون نبيًا، أو كتابًا مقدَّسًا، أو أيّ تجلٍّ آخر للرُّبوبيَّة أو رُسُلِهَا إلى “الوعاء الإنسانيّ” القابل، وسواءٌ أكان بالعربية كالقرآن، أم كجسد المسيح – وهي “مُطْلَقَاتٌ” في عالَمها الدّيني بوحي مُنزَّل- فإنَّ “المطلق هو المطلق مُطْلقًا”، ولذا كانت تلك التَّجليات “مُطْلَقة نسبيًا”؛ بمعْنى أنَّ المطلق في الميتافيزيقيا العُليا هو ما وراء الوجود، بينما “المطلق النّسبي” هو الوجود نفسه.
يتحصّل مما سبق أن في كل عالَم ديني تُتَنَزَّلُ الشرائع والرموز التي تقدّسها سُنّة تراثية، والبركةُ التي تُحيي الدين، وكلها مطلقة في حوضها دون أن تُصبح مطلقة بما هي، ويتردد في أعماق قلب كل دين صدى صوت الله تعالى قائلا “أنا”؛ فليس هناك إلا ذات أسمى واحدة تستطيع قول “أنا”، لكن لها كثير من الأصداء الكونية – وحتى ما قبل الكونية – للكلمة، فهي واحدة ومتعددة في الآن ذاته، وكما يقول جلال الدين الرومي: “حين يصل العدد إلى مائة؛ فإن التسعين حاضرة كذلك. واسم أحمد هو اسم الأنبياء جميعا”.
بين التُّراث والحداثة … الحاجةُ إلى علم مقدَّس
إنَّ الإشكالية الكبرى التي ينْهض كتاب سيد حسين نصر من أجل معالجتها يمكن تصويرها، أو بالأحرى اختزالها، في ذلك التَّضاد الكبير ما بين العلوم التُّراثية من جهة، والحداثة الغربية من جهة أخرى. فبحسب المؤلِّف، فإنَّ العلوم التُّراثية قد غُرسَتْ في كلّ الحضارات الإنسانية من مصر القديمة حتَّى الآرتيك وشعوب المايا، لكنَّ الصّياغة البليغة للعلوم التُّراثية التي عاشت حتَّى اليوم، بدرجة أو أخرى، إنَّما ظهرتْ في حضارات الشَّرق؛ مثل العلوم الهندية والإسلامية. ومن الأوْفق أنْ نلتفت إلى تلك العوالم لاسْتِكْنَاه علائقها بالعلوم الغربية الحديثة،
وإذا كان ثمَّة بقيَّة من أمل في استعادة “علم الإلهيات”، الذي هو على النَّقيض من العلمانية التي تَدَّعي لنفْسِها الهيْمنةَ على العالَم، فلا بدَّ من تفحُّص كُنْه العلاقة بين العلوم الغربية والحضارات الشَّرقية، والتي كانت مكْنزًا رئيسًا للتُّراث والمقدَّسات حتَّى يومنا هذا، ولا بدَّ أيضًا من التَّعامل – بدرجة أوسع – مع طبيعة العلم الغربي، والتي سعتْ إلى تقليده كثيرٌ من البلاد الآسيوية، فانتشرت بين كثير من القارات، وتسبَّبتْ في كوارث بيئية تُهدّد بانهيار منظومة الطَّبيعة بشكل كلّي. ومن هنا يُدرك كثيرون ضرورة إعادة النَّظر في علاقة العلوم الغربية بالثقافات الشَّرقية التي انهمكتْ حاليا في تبنّي تلك العلوم والتقنيات التي تقوم عليها.
وفيما يتعلَّق بقضايا البيئة يؤكّد المؤلّف؛ أنَّ المنظور الإسلاميَّ للطَّبيعة والبيئة يرجع إلى القرآن الكريم باعتباره الآية الربانية المركزية في الإسْلام. فرسالة القرآن الكريم – بمعنًى ما – هي عودةٌ إلى الرّسالة الأولانيَّة القديمة من الله تعالى إلى الإنسان، فهي تُخاطب ما كان أولانيا باطِنًا في طبيعته؛ ولذا سُمّي الإسلامُ “الدّين الحنيف”؛ بمعنى: القديم، والأولاني. فالقرآن الكريم لا يخاطب بني الإنسان فحسب؛ ولكنه يخاطب أيضًا الكونَ الكليَّ بأجمعه، كما أنَّ الطَّبيعة تُشارك في الوحي القرآني كذلك.
وقد تردَّد هذا البُعْدُ في القرآن الكريم طوال قرون عند المسلمين الذين يُسمُّون الكونَ الأنطولوجي “القرآنَ التَّكويني/ كتاب الله المنظور”، في حين كان المصحف هو “القرآن التَّدويني/ كتاب الله المسطور”. ونتيجة لذلك؛ فإنَّهم رأوا على وجه كلّ مخلوقٍ حروفًا وكلماتٍ من قرآن الكون،
وإذا كان ثمَّة بقيَّة من أمل في استعادة “علم الإلهيات”، الذي هو على النَّقيض من العلمانية التي تَدَّعي لنفْسِها الهيْمنةَ على العالَم
وأخيرًا، فإنَّ أحوج ما يحتاجُه العالَم اليوم هو “الحكمة”؛ وهي المعرفة الأسْمى، أو “علم الحقيقة”، أو الميتافيزيقيا بمعناها التُّراثي Scientia Sacra، كما طرحها روَّاد “مدرسة التُّراثيون”. والسَّبب في ذلك يرجع إلى أنَّ المبدأ الذي لا تخلو منه الطَّبيعة ينطبق على كلّ نطاق الميتافيزيقا والعلوم التُّراثية والكونيَّة، وقد أدَّى اختفاءُ الميتافيزيقيا الأصلية في الغرب إلى احتلال موْقعها بكلّ أنواع التَّهافت الفلسفيّ التي أدَّت في النّهاية إلى انتحار الفلسفة في فكر ما بعد الحداثة،
كما أدَّى كسوفُ “العلم المقدَّس” في العالم الحديث إلى ما يتراوح بين الغيبية Occultism، وبين فلسفة العصر الجديد التي طرحت العلوم التُّراثية لبخس صور التُّراث والعلوم المقدَّسة فيها بتقويمها من منظور “الوضعية المنطقية Positivism”، وكانت النَّتيجة المترتّبة على ذلك مصفوفة طويلة من سُوء تفسير المقدَّسات وتشْويهها، والتي أصبحتْ جزءًا لا يتجزأُ من المشهد الثقافي اليوم!
ويبقى الرَّهان معقودا على عودة المقدَّس وبروزه إلى الواجهة مرة أخرى، وهو ما عبّر عنه المؤلف في آخر فقرة من كتابه [ص 240] بالقول: “وما فتئ الاحتياجُ إلى العلم المقدَّس قائما، وسوف يقوم، حتَّى يُعاد تأسيس العلوم المقدَّسة الأصيلة في نور الميتافيزيقا التي تحكمُها جميعًا بالضَّرورة … فيلزم أولا فهم الحاجة إلى علم مقدَّس، ومن ثمَّ ممارسته، وبمجرد تحقُّق الاحتياج تظهر البدائل غير الأصلية على حقيقتها، فلن يتوانى عن التَّشكُّل والظُّهور علمٌ مقدَّسٌ حقيقيٌّ ينبثق عن العلم الأسمى؛ إلا أنَّه يهتمُّ بعالَم التَّجلّي والكون الأكبر والكون الأصغر [الإنسان]،
وعسى أن يكون هذا الكتاب خطوة متواضعة نحو تحقيق هذه الغاية، والتي يتوقَّف عليها إحياءُ فكر التُّراث وروحانيته للذين يطمحون إلى معرفة المطلق ومعرفة النّسبي في نور المطلق”.