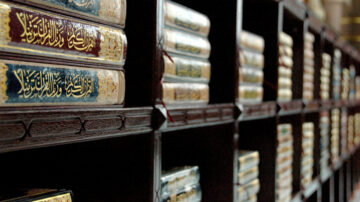معنى حديث “الكبرياء ردائي” وشرح مفرداته
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:
“قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدًا منهما، ألقيته في جهنم” رواه مسلم.
يُشير الحديث إلى أن صفتي الكبرياء والعظمة هما من خصائص الله تعالى، ومن تجرّأ على ادّعائهما، فقد نازع الله في صفاته، وهذا أعظم الجرائم.
الرداء والإزار في اللغة يرمزان إلى الصفات الملازمة، والمعنى أن الكبرياء والعظمة صفتان لا يليقان إلا بالله وحده.
أقوال العلماء في تفسير الحديث
قال ابن بطال في شرح البخاري: فالمستكبر على الله تعالى لاشك أنه منازعه رداءه، ومفارق دينه، وحرام عليه جنته كما قال عليه السلام أنه: (لا يدخلها إلا نفس مسلمة) ومن لم يخشع لله قلبه عليه مستكبر؛ إذ معنى الخشوع التواضع وخلاف الخشوع والتواضع التكبر والتعظم، فالحق لله على كل مكلف إشعار قلبه الخشوع بالذلة والاستكانة له بالعبودية خوف أليم عقابه، وقد روى عن محمد بن علي أنه قال: (ما دخل قلب أمرىء شىء من الكبر إلا نقص من عقله قل ذلك أو كثر).
“المستكبر على الله منازع له في ردائه، وحرام عليه الجنة”.
جاء في كتاب المفهم، قال القرطبي:
إذا تقرَّر هذا: فالكِبرِيَاءُ والعَظَمَةُ مِن أوصافِ كمالِ الله تعالى واجبان له؛ إذ ليست أوصافُ كمالِ الله وجلالُهُ مُستفادةً مِن غيره، بل هي واجبة الوجود لذواتها، بحيثُ لا يجوزُ عليها العدَمُ ولا النقص، ولا يجوزُ عليه تعالى نقيضُ شيءٍ من ذلك، فكمالُهُ وجلالُهُ حقيقةٌ له؛ بخلاف كمالنا، فإنَّه مستفادٌ مِنَ الله تعالى، ويجوزُ عليه العدَمُ وطروءُ النقيضِ والنقصِ.
وإذا كان هذا، فالتكبُّرُ والتعاظُمُ خُرقٌ مِنَّا، ومستحيل في حقِّنا؛ ولذلك حرَّمهما الشرع، وجعلهما من الكبائر؛ لأنَّ مَن لاحظَ كمالَ نفسه ناسيًا مِنَّةَ الله تعالى فيما خصَّه به، كان جاهلاً بنفسه وبربِّه، مغترًّا بما لا أصلَ له، وهي صفةُ إبليسَ الحاملةُ له على قوله: أَنَا خَيرٌ مِنهُ وصفةُ فرعونَ الحاملةُ له على قوله: أَنَا رَبُّكُمُ الأَعلَى ولا أقبَحَ ممَّا صارا إليه؛ فلا جَرَمَ كان فرعونُ وإبليسُ أَشَدَّ أهلِ النار عذابًا؛ نعوذ بالله من الكِبرِ والكفر.
وأمَّا مَن لاحظ مِن نفسه كمالاً، وكان ذاكرًا فيه مِنَّةَ الله تعالى عليه به، وأنَّ ذلك مِن تفضُّله تعالى ولطفه، فليس مِنَ الكِبرِ المذمومِ في شيء، ولا مِنَ التعاظُمِ المذموم، بل هو اعترافٌ بالنعمة، وشُكرٌ على المِنَّة. والتحقيقُ في هذا: أنَّ الخَلقَ كلَّهم قوالبُ وأشباح، تجري عليهم أحكامُ القُدرة؛ فمَن خصَّه الله تعالى بكمالٍ، فذلك الكمالُ يرجعُ للمكمِّلِ الجاعل، لا للقالَبِ القابل. ومع ذلك: فقد كمَّل الله الكمالَ بالجزاءِ والثناءِ عليه؛ كما قد نقَصَ النقصَ بالذمِّ والعقوبةِ عليه، فهو المُعطِي والمُثنِي، والمُبلِي والمعافي؛ كيف لا وقد قال العليُّ الأعلى: أَنَا اللهُ خَالِقُ الخَيرِ وَالشَّرِّ؛ فَطُوبَى لِمَن خَلَقتُهُ لِلخَيرِ وَقَدَرتُهُ عَلَيهِ، وَالوَيلُ لِمَن خَلَقتُهُ لِلشَّرِّ وَقَدَرتُهُ عَلَيهِ؛ فلا حِيلَةَ تعمل مع قهر؛ لَا يُسأَلُ عَمَّا يَفعَلُ وَهُم يُسأَلُونَ.
وذكر ابن فورك في كتاب “مشكل الآثار وبيانه”، قَوْله عليه الصلاة والسلام فِي صفة أهل الْجنَّة (.. وَمَا بَين الْقَوْم وَبَين أَن ينْظرُوا إِلَى وَجه رَبهم فِي جنَّة عدن إِلَّا رِدَاء الْكِبْرِيَاء على وَجهه):
فأَما قَوْله (إِلَّا رِدَاء الْكِبْرِيَاء) فيحْتَمل أَن يكون المُرَاد بِهِ إِلَّا مَاله من صفة الْكِبْرِيَاء ونعت العظمة، من حَيْثُ لَهُ أَن يمنعهُم المنظر وَلَا يتفضل عَلَيْهِم؛ مُعَرفا لَهُم بذلك أَن النّظر إِلَى الله تَعَالَى ابتداء نعْمَة وَفضل، وَله أَن لَا يتفضل بِهِ لِأَنَّهُ المتصف بالكبرياء والمنعوت بالعظمة، وَله أَن يتفضل وَأَن لَا يتفضل. وَالْمرَاد بِهِ أَن ذَلِك صفة من صِفَاته ونعت من نعوته.
قال الخطابي – رحمه الله تعالى- في شرحه لـ (سنن أبي داود) :
معنى الحديث: أن الكبرياء والعظمة صفتان لله سبحانه، اختص بهما لا يشركه أحد فيهما، ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما؛ لأن صفة المخلوق التواضع والتذلل، وضرب الرداء والإزار مثلا في ذلك. يقول- والله أعلم- كما لا يشرك الإنسان في ردائه وإزاره أحد، فكذلك لا يشركني في الكبرياء والعظمة مخلوق.
وجاء في كتاب الإحياء للإمام الغزالي:
العظمة والكبرياء من الصفات التي تختص بي ولا تنبغي لأحد غيري، كما أن رداء الإنسان وإزاره يختص به لا يشارك فيه، وفيه تحذير شديد من الكبر ومن آفاته حرمان الحق، وعمى القلب عن معرفة آيات الله وفهم أحكامه، والمقت والبغض من الله، وأن خصلة تثمر لك المقت من الله والخزي في الدنيا والنار في الآخرة وتقدح في الدين لحري أن تتباعد عنها.
قال ابن تيمية في بيان المقصود من الحديث:
وليس ظاهر هذا الحديث أن لله إزارًا ورداء، من جنس الأزر والأردية التي يلبسها الناس ، مما يصنع من جلود الأنعام ، والثياب كالقطن والكتان ؛ بل الحديث نص في نفي هذا المعنى الفاسد، فإنه لو قال عن بعض العباد : إن العظمة إزاره، والكبرياء رداؤه: لكان إخباره بذلك عن العظمة والكبرياء ، اللذين ليسا من جنس ما على ظهور الأنعام ، ولا من جنس الثياب ما يبيّن ويظهر أنه ليس المعنى : أن العظمة والكبرياء هما إزار ورداء ، بهذا المعنى.
إلى أن قال:
والكبرياء والعظمة : لا تصلح إلا لله رب العالمين ، الرب الخالق الباري الغني الصمد القيوم، دون العبد المخلوق الفقير المحتاج.
والكبرياء فوق العظمة، كما جعل ذلك رداء وهذا إزارًا…
وهما [أي العظمة والكبرياء] ، مع أنهما لا يصلحان إلا لله : فيمتنع وجود ذاته بدونهما ، بحيث لو قدر عدم ذلك ، للزم تقدير المحذور الممتنع من النقص والعيب في ذات الله، فكان وجودهما من لوازم ذاته ، وكمالها التي لا ينبغي أن تعرى الذات وتتجرد عنها، كما أن العبد لو تجرد عن اللباس ، لحصل له من النقص والعيب بحسب حاله ، ما يوجب أن يحصل له لباسًا.
وأيضًا : فاللباس يحجب الغير عن المشاهدة لبواطن اللابس ، وملامستها ؛ وكبرياء الله وعظمته تمنع العباد من إدراك البصر له ، ونحو ذلك، كما في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم عن أبي موسى عن النبي ﷺ أنه قال: (جنات الفردوس أربع ، ثنتان من ذهب ، آنيتهما وحليتهما وما فيهما ، وثنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلاَّ رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن).
فهذا الرداء الحاجب، الذي قد يكشفه لهم ، فينظرون إليه: سماه رداء الكبرياء؛ فكيف ما يمنع من إدراكه وإحاطته؛ أليس هو أحق بأن يكون من صفة الكبرياء” انتهى من “بيان تلبيس الجهمية “(6/ 270- 277).
وقال في موضع آخر:
وفي قوله “الله أكبر” إثبات عظمته، فإن الكبرياء تتضمن العظمة، ولكن الكبرياء أكمل، ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول: “الله أكبر” فإن ذلك أكمل من قول الله أعظم، كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: “يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته”1، فجعل العظمة كالإزار والكبرياء كالرداء، ومعلوم أن الرداء أشرف، فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح بلفظه، وتضمن ذلك التعظيم
الكبرياء تتضمن العظمة، ولكن الكبرياء أكمل، ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول: “الله أكبر” فإن ذلك أكمل من قول الله أعظم
مظاهر الكبر وآثاره في حياة الإنسان
من مظاهر الكبر:
1 – حب التقدم على الناس وإظهار الترفع عليهم.
2 – التبختر والاختيال في المشية.
3 – تزكية النفس والثناء عليها.
4 – الفخر بالآباء من أهل الدين والفضل.
5 – الفخر بالنسب – وذلك مذموم ومستقبح جداً – وقد يبتلى به بعض أولاد الأخيار من لا بصيرةله ولا معرفة بحقائق الدين. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لم يُسرعْ بِهِ نَسَبُهُ))
تحذيرات القرآن الكريم من الكبر
ذمّ الله الكبر في مواضع كثيرة، منها:
- {إنه لا يحب المستكبرين}
- {سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق}
- {إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين}
وما ذكر فرعون وإبليس إلا تحذير من نتائج الكبر:
“أنا خير منه” (إبليس)، “أنا ربكم الأعلى” (فرعون).
خطوات علاج الكبر واكتساب التواضع
اعلم أن الكبر من المهلكات ولا يخلو أحد من الخلق عن شيء منه، وإزالته فرض عين ولا يزول بمجرد التمني بل بالمعالجة واستعمال الأدوية القامعة له. وفي معالجته مقامان:
- استئصال أصله، وقلع شجرته من مغرسها في القلب.
- دفع العارض منه بالأسباب الخاصة التي بها يتكبر الإِنسان على غيره.
المقام الأول: علاج أصل الكبر
في استئصال أصله، وعلاجه علمي وعملي، ولا يتم الشفاء إلا بمجموعهما:
أولًا: العلاج العلمي
وذلك بأن يعرف نفسه ويعرف ربه تعالى، ويكفيه ذلك في إزالة الكبر، فإنه لو عرف نفسه حق المعرفة لأيقن أنه لا يليق به إلا التواضع، وإذا عرف ربه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا لله ويكفيه أن يعرف معنى هذه الآيات من كتاب الله، قال تعالى: (قُتِلَ الْأِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ * مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ * مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ * ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ * ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ * ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ) [عبس: 17 – 22].
فقد أشارت الآيات الكريمة إلى أول خلق الإنسان وإلى آخر أمره وإلى وسطه..
قال مالك بن دينار: «كَيْفَ يَتِيهُ مَنْ أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ مَذِرَةٌ ، وَآخِرُهُ جِيفَةٌ قَذِرَةٌ ، وَهُوَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ يَحْمِلُ الْعَذِرَةَ».
ثانيًا: العلاج العملي
وهو عبارة عن التواضع لله بالفعل ولسائر الخلق بالمواظبة على أخلاق المتواضعين، من أحوال الصالحين.
قال الإمام عبد الوهاب الشعراني – رحمه الله تعالى – في كتابه «المختار»: ومن وصية الإمام النووي – رحمه الله تعالى -: «لا تستصغر أحداً فإن العاقبة منطوية، والعبد لا يدري بم يختم له، فإذا رأيت عاصياً فلا تر نفسك عليه، فربما كان في علم الله أعلى منك مقاماً، وأنت من الفاسقين، ويصير يشفع فيك يوم القيامة!
وإذا رأيت صغيراً فاحكم بأنه خير منك، باعتبار أنه أحقر منك ذنوباً، وإذا رأيت من هو أكبر منك سناً فاحكم بأنه خير منك باعتبار أنه أقدم منك هجرة في الإسلام، وإذا رأيت كافراً فلا تقطع له بالنار لاحتمال أنه يسلم ويموت مسلماً».
فينبغي لك أن تعلم أن الخيّر من هو خيّرُ عند الله في دار الآخرة وذلك غيب وهو موقوف على الخاتمة، فاعتقادك في نفسك أنك خير من غيرك جهل محض.
المقام الثاني: فيما يعرض من التكبر بالأسباب السبعة
ونحن نذكر طريق العلاج من العلم والعمل في جميع أسبابه السبعة:
الأول: النسب: فمن يعتريه الكبر من جهة النسب فليداو قلبه بمعرفة أن هذا جهل من حيث إنه تعزز بكمال غيره، ومن كان خسيسا فمن أين تجبر خسته بكمال غيره وبمعرفة نسبه الحقيقي أعني أباه وجده، فإن أباه القريب نطفة قذرة، وجده البعيد تراب، وقد عرف الله تعالى نسبه فقال: {وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (8)} [السجدة: 7، 8]
فإذا كان أصله من التراب وفصله من النطفة فمن أين تأتيه الرفعة؟ فهذا هو النسب الحقيقي للإنسان، ومن عرفه لا يتكبر بالنسب.
الثاني: الكبر بالجمال: ودواؤه أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاء، ولا ينظر إلى الظاهر نظر البهائم، ومهما نظر إلى باطنه رأى من القبائح ما يكدر عليه تعززه بالجمال، إذ خلق من أقذار ووكل به في جميع أجزائه الأقذار، وسيموت فيصير جيفة أقذر من سائر الأقذار، وجماله لا بقاء له، بل هو في كل حي يتصور أن يزول بمرض أو سبب من الأسباب، فكم من وجوه جميلة قد سمجت بهذه الأسباب. فمعرفة ذلك تنزع من القلب داء الكبر بالجمال لمن أكثر تأملها.
الثالث: الكبر بالقوة: ويمنعه من ذلك أن يعلم ما سلط الله عليه من العلل والأمراض، وأنه لو توجع عرق واحد في يده لصار أعجز من كل عاجز، أو أن شوكة لو دخلت في رجله لأعجزته، وأن حمى يوم تحلل من قوته ما لا ينجبر في مدة فمن لا يطيق شوكة، ولا يقدر على أن يدفع عن نفسه ذبابة، فلا ينبغي أن يفتخر بقوته. ثم إن قوي الإنسان فلا يكون أقوى من حمار أو بقرة أو فيل أو جمل، وأي افتخار في صفة يسبقك بها البهائم.
السبب الرابع والخامس: الغنى وكثرة المال: وفي معناه كثرة الأتباع والأنصار، والتكبر بالمناصب والولايات، وكل ذلك تكبر بمعنى خارج عن ذات الإنسان، وهذا أقبح أنواع الكبر، فلو ذهب ماله أو احترقت داره لعاد ذليلا، وكم في اليهود من يزيد عليه في الغنى والثروة والتجمل، فَأُفٍّ لشرفٍ يسبقه به يهودي، أو يَأخُذُهُ سارقٌ في لحظةٍ فيعود ذليلًا مفلسًا.
مالك بن دينار: كَيْفَ يَتِيهُ مَنْ أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ مَذِرَةٌ ، وَآخِرُهُ جِيفَةٌ قَذِرَةٌ ، وَهُوَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ يَحْمِلُ الْعَذِرَةَ؟
السادس: الكبر بالعلم: وهو أعظم الآفات، وعلاجه بأمرين:
- أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد، وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عُشْرَهُ من العالم، فإن من عصى الله تعالى عن معرفة وعلم فجنايته أفحش وخطره أعظم.
- أن يعرف أن الكبر لا يليق إلا بالله عز وجل وحده، وأنه إذا تكبر صار ممقوتا عند الله بغيضا، فهذا ما يزيل التكب ويبعث على التواضع.
وإذا دعته نفسه للتكبر على فاسق أو مبتدع فليتذكر ما سبق من ذنوبه وخطاياه لتصغر نفسه في عينه، وليلاحظ إبهام عاقبته وعاقبة الآخر فلعله يختم له بالسوء ولذاك بالحسنى، حتى يشغله الخوف عن التكبر عليه، ولا يمنعه ترك التكبر عليه أن يكرهه، ويغضب لفسقه، بل يبغضه ويغضب لربه إذ أَمَرَهُ أن يغضب عليه من غير تكبر عليه.
السابع: التكبر بالورع والعبادة: وذلك فتنة عظيمة على العباد، وسبيله أن يلزم قلبه التواضع لسائر العباد، قال وهب بن منبه: ((ما تم عقل عبد حتى يكون فيه خصال)) وعد منها خصلة قال:
((بها ساد مجده، وبها علا ذكره أن يرى الناس كُلَّهُمْ خَيْرًا مِنْهُ، وإنما الناس عنده فرقتان: فرقة هي أفضل منه وأرفع، وفرقة هي شر منه وأدنى، فهو يتواضع للفرقتين جميعا بقلبه، وإن رأى من هو خير منه سره ذلك وتمنى أن يلحق به، وإن رأى من هو شر منه قال: لعل هذا ينجو وأهلك أنا، فلا تراه إلا خائفا من العاقبة، ويقول: لعل بِرَّ هذا باطن فذلك خير له، ولا أدري لعل فيه خُلُقًا كَرِيمًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله فيرحمه الله ويتوب عليه، ويختم له بأحسن الأعمال، وبري ظاهر فذلك شر لي، فلا يأمن فيما أظهره من الطاعة أن يكون دخلها الآفات فأحبطتها))، قال: ((فحينئذ كمل عقله وساد أهل زمانه)).
والذي يدل على فضيلة هذا الإشفاق قوله {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ} [المؤمنون: 60] أي أنهم يؤتون الطاعات وهم على وجل عظيم من قبولها، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ} [المؤمنون: 57] وقال تعالى: {قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ} [الطور: 26].
وقد وصف الله تعالى الملائكة عليهم السلام مع تقدسهم عن الذنوب ومواظبتهم على العبادات بِالدَّؤُوبِ على الإشفاق فقال تعالى مُخْبرًا عنهم: {يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ} [الأنبياء: 20] {وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ} [الأنبياء: 28]
فمتى زال الإشفاق والحذر غلب الأمن من مكر الله، وذلك يوجب الكبر، وهو سبب الهلاك، فالكبر دليل الأمن والأمن مهلك، والتواضع دليل الخوف، وهو مسعد.
فإذن ما يفسده العباد بإضمار الكبر واحتقار الخلق أكثر ما يصلحه بظاهر الأعمال.
فهذه معارف بها يزال داء الكبر عن القلب، إِلَّا أَنَّ النَّفْسَ بعد هذه المعرفة قد تضمر التواضع، وتدعي البراءة من الكبر وهي كاذبة، فإذا وقعت الواقعة عادت إلى طبعها، فعن هذا لا ينبغي أن يُكتفى في المداواة بمجرد المعرفة، بل ينبغي أن تكمل بالعمل، وتجرب بأفعال المتواضعين في مواقع هيجان الكبر من النفس، وبيانه أن يمتحن النفس بالامتحانات الدالة على استخراج ما في الباطن، والامتحانات كثيرة، فمنها: أن يناظر في مسألة مع واحد من أقرانه، فإن ظهر شيء من الحق على لسان صاحبه فثقل عليه قبوله والانقياد له والشكر له على تَنْبِيهه فذلك يدل على أن فيه كبرًا دفينًا، فليتق الله فيه ويشتغل بعلاجه.
أما من حيث العلم فبأن يذكر نفسه خسة نفسه، وخطر عاقبته وأن الكبر لا يليق إلا بالله تعالى.
وأما العمل فبأن يكلف نفسه ما ثقل عليه من الاعتراف بالحق، وأن يطلق اللسان بالحمد والثناء، وَيُقِرَّ على نفسه بالعجز، ويشكره على الاستفادة ويقول: “ما أحسن ما فطنت له، وقد كنت غافلاً عنه فجزاك الله خيرًا كما نبهتني له” فالحكمة ضالة المؤمن فإذا وجدها ينبغي أن يشكر من دله عليها.
فإذا واظب على ذلك مرات متوالية صار ذلك له طبعًا، وسقط ثِقَلُ الْحَقِّ عَنْ قَلْبِهِ، وطاب له قبوله.
وكل ذلك من أمراض القلوب وعلله المهلكة له إن لم تتدارك. وقد أهمل الناس طب القلوب واشتغلوا بطب الأجساد مع أن الأجساد قد كتب عليها الموت لا محالة، والقلوب لا تدرك السعادة إلا بسلامتها إذ قال تعالى: {إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء: 89].