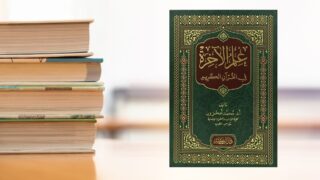شكل تزايد حضور الدين في المجال العام على مستوى العالم تحديا كبيرا للعلمانية بشتى صورها، فبعد أن كان الدين في بداية القرن العشرين مع الثورة الشيوعية هو “أفيون الشعوب” الذي يُستخدم لتخديرها عن القعود عن الثورة، أصبح مع نهايات ذلك القرن العشرين وبدايات القرن الحالي هو مصدر الإرهاب والعنف والدموية في العالم، ولم تكتف القراءة العلمانية بذلك بل رجعت إلى التاريخ وقرأته بطريقة متعسفة وأجبرته على النطق كارها أن الدين مسؤول على الدم المسفوك على صفحاته.
وكتاب “حقول الدم” للكاتبة البريطانية كارين أرمسترونغ هو إجابة مطولة على سؤال محوري حول العلاقة بين الدين والعنف، فعلى أكثر من (655) صفحة تسرد أرمسترونغ قصة الإنسان مع الدم في الحضارات المختلفة، والكاتبة بريطانية متخصصة في علم الأديان، وراهبة كاثوليكية سابقة، ولها أكثر من خمسة وعشرين كتابا، ولها آراء منصفة تجاه الإسلام.
تضع أرمسترونغ فرضية ارتباط الدين بالعنف تحت الاختبار في مسيرة الإنسان التاريخية، لتكشف أن العنف له مسببات اقتصادية وسياسية واجتماعية تقف وراء العنف المنسوب إلى الدين، وترفض أرمسترونغ مقولات العلمانية بأن الدين هو سبب جميع الحروب الكبرى في التاريخ، حيث تؤسس العلمانية مقولاتها على وجود ترابط بين الدين والتعصب المؤدي إلى العنف.
الدين قبل الحداثة
تكشف أرمسترونغ عن التحولات التي طرأت على مفهوم الدين في العصر الراهن، فالدين قبل القرن الثامن عشر لم يكن منفصلا عن بقية شؤون الحياة واقعا ومفهوما، كما أن الدين في الحضارات ما قبل الحديثة لم يكن مواجهة بين الإنسان والإله، فقد كان الدين موقفا يتخلل سائر أنشطة الحياة، وهو ما يعني خطورة القراءة الأيديولوجية للتاريخ بأثر رجعي، فالرؤية العلمانية وقعت في هذا الخطأ المنهجي حيث أعادت قراءة التاريخ استنادا إلى أفكارها في الفصل بين الديني والسياسي متناسيا قوة حضور الدين وتشابكه مع الحياة في الأزمنة السابقة.
تنطلق أرمسترونغ من حقيقة تاريخية وهي أن الدولة لا يمكن أن تقوم ولا أن تحافظ على وجودها من دون استعمال العنف والقوة والإكراه، وهذا المدخل في علم الاجتماع الإنساني يقود إلى فهم عمليات التوظيف الكبيرة التي تعرض لها الدين عبر التاريخ من قبل الدولة في ممارسة العنف، لكن في المقابل كان الدين يشكل تحديا كبيرا ومستمرا وقائما لعنف الدولة البنيوي أو في أقل الحالات يسعى الدين لتخفيف آثار عنف الدولة.
ويبدو أن موقف العلمانية الحاد من الدين جعلها تُحمل الدين مسؤولية العنف، وتغض النظر عن الدور الحقيقي للدولة، فالتاريخ يؤكد أن الأيدلوجيات العلمانية (الشيوعية-النازية-الفاشية) كانت شديدة العنف والدموية، وشديدة التعصب والانغلاق، كما أن عنفها صدرته للعالم في حركة استعمارية اتسمت في بعض المناطق بالإبادة، وفي أخرى بالاستعلائية، ثم توجت تطرفها في حروب عالمية حصدت عشرات الملايين من البشر.
لذا تنتقد أرمسترونغ الرؤية العلمانية الاختزالية للعلاقة بين الدين والعنف، وترى أن مسببات العنف ودوافعه معقدة، وبذلك تصبح الحرب حتمية، والحضارة لم تنشأ أو تستمر من دون قوة الإكراه والعنف، فمنذ البدايات الأولى لاستقرار الإنسان بعد اكتشافه للزراعة، ظهر العنف المنظم ولم يكن ذلك العنف مرتبطا بالدين، ولكنه كان مرتبطا بالسرقة المنظمة، فالعنف يولد في أي مكان يكون فيه توزيع القوة والموارد غير متكافئ، فالعنف البنيوي عم جميع الحضارات الزراعية القديمة، حيث كانت نخبة لا تتعدى 2% تقوم بسرقة معظم الإنتاج الذي تنتجه الأغلبية لتحافظ تلك الأقلية على نمط حياتها الأرستقراطي، لذلك لم يكن هناك غنى عن الحرب في المجتمعات الزراعية، ومنذ ظهور الدولة أصبحت الحرب حقيقة راسخة في الإنسانية، فالقوة العسكرية كانت شرطا لقيام الدول والإمبراطوريات العظمى، بل اعتبر بعض المؤرخين أن النزعة العسكرية هي العلامة التي تميز الحضارة.
ومن هنا أصبح الدين جزءا من لعبة الحرب والسلام، ولما كانت الحضارات والأيديولوجيات مشبعة بالدين في عصور ما قبل الحداثة فكان لزاما أن تحتاج الحرب إلى عنصر مقدس، فقد كان القتل قديما يغلف بالأسطورة، ومنها الدينية حتى يخلق القاتل مسافة بينه وبين عدوه، يتم فيها تضخيم الفوارق، ثم تطوير سرديات بأن الأعداء ليسوا بشرا.
كبش الفداء
تؤكد أرمسترونغ أن الغرب والعلمانية وضعا الدين ككبش فداء لعنف الدولة، حتى بدا من كثرة التداول والتكرار والإلحاح أن الربط بين الدين والعنف يحمل براهينه في داخله ولا يحتاج إلى جدال حوله، فكثير من البشر كانوا يشعرون قبل الأزمنة الحديثة أنهم جزء من وجود أكبر وأوسع أي ينتمون إلى الكون الفسيح، وكان هذا شعورا يلمس باطن الإنسان، وجعل الإنسان لا يبحث عن السعادة فقط في حياته، وإنما اجتهد أن يجعل لحياته معنى وقيمة، وعلى هذا أسبغ على الحرب بعضا من أساطيره وتقديسه، ويكشف تاريخ الإنسان أن كل التقاليد الدينية الكبرى نشأت داخل كيان سياسي، فلا يوجد تقليد ديني أصبح “دينا عالميا” من دون رعاية من قوة عسكرية إمبراطورية، وكل تقليد ديني كان عليه أن يطور أيديولوجية للإمبراطورية..ولكن السؤال: هل كان الدين مساهما في عنف الدولة بشكل لا يقبل الانفصال؟ وكم العنف في تاريخ البشر المسؤول عنه الدين؟
الواقع أن الحرب أصبحت إحدى حقائق الإنسانية منذ ما قبل الديانات الإبراهيمية الثلاث، وتجلى ذلك في الحضارة السومرية القديمة التي كانت الزراعة عمادها، وتقدم ملحمة “جلجامش” في منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد دليلا على ذلك، فـ”سومر” كانت تتسم بالطابع العسكري، فتقدم الملحمة صورة العنف العسكري كسمة مميزة للحضارة، فقد كان رجل الحضارة رجل حرب بالأساس، وكانت تلك الحضارات القديمة تنظر إلى الحرب كعمل أخلاقي يحقق النفع للبشرية، وهنا تبدو الحقيقة الكبيرة أن العنف يكمن في قلب الوجود الاجتماعي، وفي معظم الثقافات القديمة، فالبشر كانوا يتنازعون لأجل تصورات مختلفة عن المجتمع، وكان من الصعب التمييز بين ما هو ديني وما هو دنيوي.
كان الضغط العلماني والحداثي شديدا على الدين المسيحي في أوروبا بداية من القرن السابع عشر الميلادي وهو ما جعل المسيحية كدين تنزوي إلى أن تكون عقيدة جوانية داخلية للفرد أكثر من تجليها في المجتمع والسياسة، ففلاسفة الاتجاه العلماني مثل توماس هوبز مثلا رأوا أن سيطرة الدولة على الكنيسة أمر ضروري للسلام، لذا طالب هوبز بملكيات قوية تتغلب على الكنيسة وتفرض عليها الوحدة الدينية، وطالب بأن تخضع القوى المدمرة للدين، غير أن كلام هوبز أثبت الواقع الأوروبي أنه مختزل وبسيط فالحروب الأوروبية بعد ذلك استمرت وحشيتها سواء بوجد العامل الديني أو بغيابه، فحرب الثلاثين عاما في أوروبا والتي تسببت في مقتل 35% من سكان أوروبا الوسطى، على الرغم من الحضور الديني في ذلك الصراع إلا أنه لم يكن الدافع الوحيد للحرب، كما أن الحرب اعتمدت على المرتزقة، وهنا قاتل أصحاب الدين والمذهب الواحد بعضهم البعض في تلك الحرب كما جرى مع الكاثوليك فقد قاتلوا على الجبهتين.
وتلفت أرمسترونغ الانتباه إلى مفارقة وهي أن رواد الحداثة والتنوير الأوروبي، فجون لوك أحد الذين صاغوا الأخلاق الليبرالية للسياسة، ويعتبره البعض رائد التسامح، كان رافضا لأن تتكيف الدولة مع الكاثوليكية أو الإسلام، وأيد السلطة الاستبدادية المطلقة للسيد على العبيد، وكان مجادلا عن الاستعمار في بعض المناطق، ويلاحظ في قضية الاستعمار أن معظم المفكرين في مرحلة الحداثة المبكرة متفقين أن أي عمل عسكري ضد السكان الأصليين عادلا لأن هؤلاء السكان لا يمتلكون الحق القانوني في أراضيهم، فالحداثة الغربية قدمت للغرب الاستقلال السياسي والابتكارات التقنية، لكن وجهها في الشرق كان قبيحا حيث جاءت بالاستعمار القائم على العنف العسكري.
وفي الفترة من 1914 حتى 1945 مات حوالي 75 مليونا في أوروبا بسبب العنف الذي لم يكن للدين أي علاقة به، فارتكب الألمان أكثر الأمور فظاعة وهم يعيشون في أكثر المجتمعات تطورا في أوروبا، وعبرت تلك الدموية في الحداثة عن غياب فكرة قداسة الروح الإنسانية، ففي أغسطس عام 1945 ألقيت قنبلة هيروشيما فقتلت 140 ألف إنسان على الفور، اما قنبلة نجازاكي فقتلت 24 ألفا في الحال، وهنا تجلت مشكلة الحداثة التي نزعت القداسة عن الحقل السياسي وهو ما جعل قرار الإبادة للعنصر البشري قرارا لا يهتز له قلب أو ضمير، وأصبحت القومية هي “الوثن” الجديد الذي يشرعن القضاء على الآخرين وليس الدين.