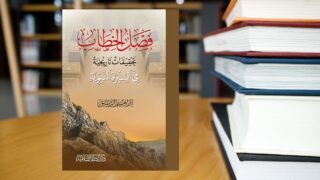الحديث عن التأثير الممتد لرسالة خاتم المرسلين النبي محمد ﷺ ونصيب العالم منها، يستبطن أمرين مهمين، أولهما: الإقرار بأن رسالته ﷺ لم تكن خاصة بقوم دون قوم، ولا بزمان دون زمان؛ وثانيهما: الانشغال بما يمكن أن تقدمه هذه الرسالة لعالمنا اليوم، أي هل ما زالت محتفظة بالفاعلية نفسها التي كانت عليها أول الأمر أم لا؟ فكيف تناول المفكر الموسوعي الأستاذ محمد فريد وجدي هذين الأمرين، وهو أحد أبرز من كتبوا عن السيرة النبوية في العصر الحديث؟
إن سيرة النبي ﷺ وشخصيته وجوانب حياته المختلفة، ما زالت موضع تأمل وتدبر من الباحثين والمفكرين، لا أقول من أتباعه والمؤمنين به فحسب، وإنما من مؤرخي الحضارات، وراصدي الأفكار، والمهتمين بتاريخ الأمم والشعوب.. وكلما تناول السيرةَ باحث أو كاتب، خرج منها بالمزيد، وتكشَّفت له جوانب تضاف لما سبق أن تكشَّف لغيره من الباحثين والكتاب..
فالسيرة النبوية ذات حضور دائم وعطاء متجدد، مثلما أن القرآن الكريم كذلك، من حيث الحضور والعطاء.. ذلك أن النبي ﷺ هو مبلِّغ هذه الرسالة للناس، وهو القدوة التي جعلها الله نموذجًا حيًّا لدعوته، وهو التطبيق الأتم والأكمل لِمَا اشتمل عليه القرآن الكريم من هدايات وتشريع.. فنحن أمام “رسالة” متجددة العطاء، وأمام “سيرة” متجددة العطاء أيضًا..
وفي كتابه المهم (السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة)، أفرد الأستاذ محمد فريد وجدي (1878- 1954م)، فصلاً مهمًّا بعنوان: (نصيب العالم من رسالة خاتم المرسلين محمد ﷺ)، بيَّن فيه الأثر المتميز والخالد الذي وجدته الأمم في الإسلام.. بحيث رأت فيه عقولُهم وقلوبهم ما كانوا ينشدون من خير، وما كان يؤرقهم من سؤالات.
تغيير الخريطة
وفي البداية، يوضح فريد وجدي أن الحركة التي أحدثها الإسلام لو كانت انحصرت في بيئتها التي نشأت فيها، لما ساغ لنا أن نذكر نصيب العالم منها؛ ولكنها ما لبثت بعد انتقال النبي ﷺ إلى الرفيق الأعلى، أن جاوزت جميع الحوائل التي وُضعت أمامها.. وكانت هذه الرسالة سببًا مباشرًا لتغيير خريطة العالم في مدة لا تزيد على ثمانين سنة.
كما يضيف كاتبنا الموسوعي: ولو كانت هذه الحركة ذات صبغة استعمارية، لانحسرت بعد بلوغ شوطها الأقصى، تاركة وراءها أحاديث الفظائع التي ارتكبت لتدويخ الأمم، ولسلبها ما بأيديها من المال والعتاد، ككل حركة من هذا النوع حدثت في خلال العصور؛ ولكن هذه الحركة لم تسكن حتى بعد وصول الفتوحات التي اقتضتها إلى نهايتها التي قُدِّرت لها، بل حتى بعد طُروء الضعف والفتور على بنية الدولة الإسلامية التي تمثلها، بل حتى بعد أن ضاع استقلال أكثر الممالك الإسلامية.
وهذا يدل- كما يخلص فريد وجدي- على أن قوام الحركة التي أحدثها الإسلام، “عنصر أدبي[أي معنوي] له وقع عظيم في النفوس؛ وذلك لبقائه مؤديًا مهمته في أثناء دور الفتور الذي أصاب جماعته؛ وقد شوهد أنه اشتد وازداد سلطانًا على العقول عندما بلغ هذا الفتور أقصى درجاته في القرن الأخير”.
إذن، يوضح فريد وجدي ثلاثة أمور مهمة؛ الأول: أن الحركة التي أحدثها الإسلام أخذ منها العالمُ بنصيب كبير؛ لأن رسالته ﷺ لم تكن خاصة بقوم ولا محصورة في زمان.. الثاني: أن هذه الحركة لم تكن ذات صبغة استعمارية، وإلا انكشف ما ارتكبته من مآسٍ ومجازر، بعد أن انفضّ سلطاها، ووهنت قوتها.. الثالث: أن سر حركة الإسلام لا يرجع لقوة مادية حملتها للناس وأجبرتهم على اعتناقه، وإنما السر يكمن في عنصرها المعنوي، أي في العقيدة والفكر والمنهج.. ذلك العنصر الذي ظل يفعل فعله- من جذب النفوس، ولفت العقول إليه- حتى بعد أن دخل المسلمون في طور من الفتور والضعف والتمزق..
ولعل هذا الأمر الأخير هو ما يجعل البعض يتساءل الآن مندهشًا: لماذا يظل الإسلام قادرًا على مخاطبة أرقى العقول البشرية، رغم ما وصل إليه حال المسلمين من تفرق وتشتت وتخلف عن ركب الحضارة! والإجابة: إنه القرآن الذي يسري نورُه سريانًا ذاتيًّا، لا حاجة له بأتباعٍ يحملونه، ولا بسلطانٍ يُجبر الآخرين على اعتناقه.. إنه بذاته يحمل قوته بين دفيته، ويسطع نوره من بين حروفه وكلماته يخترق الأفئدة ويقنع العقول!
اثنا عشر أصلاً
ثم يبين الأستاذ محمد فريد وجدي أن الإسلام حينما نشأ كان بجزيرة العرب يهود ونصارى، نزحوا إليها هربًا من اضطهاد الفرس والرومانيين؛ فأخذوا، ولاسيما اليهود، يقدحون في الإسلام ويحرِّضون المشركين على مقاومته.. فكان ينزل في الرد عليهم قرآنٌ يدحض ما يفترون، ويبين وَهْنَ ما إليه يستندون.. فاجتمع من شبهاتهم والرد عليها شيءٌ كثير من الحوار، تجلَّت فيه الأصول التي يقوم عليها الإسلام، والمبادئ التي شرع ليبثَّها في القلوب، ويحمل على احترامها العقول، ويبين ما عليه خصومه من مجافاة المنطق ومخالفة الواقع والتعويل على الوساوس والجمود على الأضاليل؛ حتى كادت تختنق فيها فطرتهم الإنسانية، فتخلط بين ما هو حسن وما هو قبيح!
وأما هذه الأصول، فهي كما يوضح فريد وجدي:
(1) شُرع الدين لتربية الإنسان وتكميله، لا لتسخيره وتذليله.
(2) دين الله واحد لا يتعدد، وإنما تعددت الأديان بسبب ما أدخله عليه زعماؤها من آرائهم، وما حمَّلوها من تأويلاتهم.
(3) خُلق العالم الإنساني كله من أب وأم، فجميع أفراده إخوان، وقد انقسموا بسبب كثرتهم إلى شعوب وقبائل؛ فيجب أن يتعارفوا ويتآلفوا، لا أن يتناكروا ويتناحروا.
(4) قوام الدين العقل، ومادته العلم، وميزانه الدليل؛ العقل المطْلَق من أسْرِ الأوهام التقليدية، والعلم القائم على الأعلام الوجودية، والدليل الخالص من مؤثرات الأهواء النفسية.
(5) التكاليف الدينية مَقِيسة على الاستطاعة البشرية، وللعاجز عن أدائها المعذرة.
(6) لا وساطة بين الله وعبده، ولا سلطان لطائفة تنتحل لنفسها هذه الوساطة، وليس أحد بملزم أن يتبع رأي غيره؛ فهو حر لا يتقيد إلا بما تتقيد به الكافة أمام الشريعة العادلة.
(7) التقليد غير جائز لأنه كما يكون في حق يكون في باطل، وفي الاتباع غنى عنه، ولا اتباع إلا بعد النظر في أدلة المتبوع، ومحاكمة أقواله إلى المنطق والعلم.
(8) الدين لا يحرم على الإنسان إلا ما يضره، ولا ينهاه إلا عما يفسده، ولا يعاقبه على الخطأ والنسيان، ولكن على العمد والإصرار.
(9) كل إنسان مسئول عن نفسه، وعن أعماله، ومطالب بالدفاع عن ذاته، لا يغنيه في ذلك لجوؤه إلى ملك مقرب، ولا انتسابه إلى نبي مرسل، أو وليّ حميم.
(10) لا فضل لنفس على نفس، ولا سلطان لضمير على ضمير، ولا مزية لأمة على أمة؛ فالكل أمام الله سواء، وإنما التمايز بتقوى الله وطاعته.
(11) المنح الإلهية، سواء أكانت مادية أو روحية، حق للكافة على السواء، تُعطَى للمستحق لها بلا تمييز بين الأجناس والألوان واللغات.
(12) المثل الأعلى للاجتماع أن يكون الناس أمة واحدة، يدينون بدين واحد، هو دين البشرية الأول الذي نزل على أسلافهم، ولكن بعد تجريده من زيادات المتزيِّدين، وأهواء المتحكّمين، وأضاليل المؤوّلين؛ وأن يكونوا أمة عالمية خاضعة لأحكام العقل، ومتمشية مع فتوحات العلم، وماضية قُدُمًا في تحقيق المُثُل العليا من الإنصاف والمساواة والحرية والاستقلال، والتطهر من بقايا الوحشية والصفات الحيوانية.
انتشار سريع ومستمر!
ثم يتطرق فريد وجدي إلى حدث حيَّر مؤرخي العالم الغربي، وهو حدث في حد ذاته يوجب الحيرة، ألا وهو “السرعة التي انتشر بها الإسلام في بيئات لا تعرف العربية، وبدون دعوة منظمة”.. بخلاف الدين الموسوي الذي لم يجاوز في انتشاره أسرة إسرائيل، والدين المسيحي الذي بقي ثلاثة قرون محصورًا في طوائف مبعثرة لم تقم لها دولة، إلى أن تولى الإمبراطورية الرومانية قسطنطين الأول، وكانت أمه قد ربّته على الديانة المسيحية؛ فحمل قومه على النصرانية، واعتبرها الديانة الرسمية للإمبراطورية، فقامت بعثاتٌ تبشيرية استُعمل فيها الإجبار والإغراء.
ويضيف وجدي: “لكن الإسلام- الذي يحرم مثل هذا الإجبار في نصوص صريحة من كتابه: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} (البقرة: 256)، ولم تكن له قط إدارة دعاية منظمة- قد سرى إلى أقصى ما يمكن أن تسري إليه دعوة.. ثم استمر تياره في السرعة حتى بلغ ما هو عليه الآن، مقاومًا كل الدعايات السيئة التي تحاط بها سمعته، ومتغلبًا على جميع العقبات التي توضع في طريقه، مستمرًا على ما هو عليه، واثقًا بقوته الذاتية”.
ويخلص فريد وجدي، إلى أن هذه الظواهر الغريبة- من سرعة الانتشار دون إجبار، ودون وجود دعاية منظمة- لا يمكن تعليلها إلا بأن هذا الدين حمل إلى الناس روحًا إلهيًّا؛ فيه من قوة السريان، وعظم السلطان، ما لجميع الحقائق الخالدة.
ويؤكد صاحب (السيرة المحمدية في ضوء العلم والفلسفة) أن أصول الإسلام ومبادئه لا تزال فيها قوة الاستمرار حتى بعد ضعف أهله، وذبول دولته.. لافتًا إلى أن هذه المسألة أكثر تحييرًا للعقول؛ لأن الناس قد اعتادوا أن يفتتنوا بدين القوي ومذهبه وعاداته، حتى أهوائه وأوهامه ووساوسه وفسوقه، بل بلاهاته وجنونياته؛ واتفقوا على أن يتحولوا عن الضعيف وكل ما يتصل به من عقائد وعادات وتقاليد، وأن يشنعوا عليها، ويتشاءموا منها، وأن يتوقعوا كل سوء من الأخذ بها.. لكن دعاية الإسلام- الذاتية- تنجح حيث تخيب جميع الدعايات الأخرى التي تدعو إلى أديان الأمم القوية، ذات المدنيات الفاتنة، والأموال الطائلة، تبذلها تألفًا للناس وجذبًا لمودتهم!
وأخذ فريد وجدي يعدِّد على ذلك شواهد كثيرة، من انتشار الإسلام في أفريقيا، وفي مصر، وانتشاره في آسيا، وفي بلاد الفرس التي كانت بها حضارة ومدنية، وفي بلاد ما وراء النهر إلى الصين، بل وبين القبائل العربية نفسها التي لم تكن تعرف الوحدة ولا تدين لغير القوة، وكانت الحروب بينها دائمة التسعرّ، فتآخت في دين الله وسادها النظام وساهمت في بناء مجد المسلمين ورفع أعلام مدنيتهم الفاضلة..
حتى أوروبا- كما يبّين وجدي- أفادت من ظهور الإسلام من الناحية الأدبية؛ حين اتصلت به في إسبانيا وفي صقلية جنوب إيطاليا، وتعرّفت على ما قام به المسلمون من تأسيس المدارس، ونشر العلوم، وبناء المستشفيات، وإقامة المراصد، وإنشاء الجامعات التي فتحوها لمن يقصدها من الطلاب، غير ناظرين إلى أجناسهم ولا أديانهم ولا ألوانهم.. “فكان ذلك سببًا مباشرًا في انتشار علوم المسلمين وآدابهم في أوروبا، واندست معها أساليبهم في التمحيص، وأصولهم في التدقيق؛ فتنبهت عقول، وفكرت في مصيرها نفوس، وأدركت حالتها قلوب؛ فكان ذلك سببًا في نهضة أوروبا الحديثة”، كما يشهد منصفو الأوروبيين.
فهل يمكن أن يثبت لنا إنسان بأن دينًا من الأديان، أو نظامًا من النظم، عمَّ خيرُه الأرض، ونالت كل أمة منه نصيبًا، مثل ما عمَّها من الإسلام، إما مباشرة وإما بواسطة؟
هذا ولم يتم الإسلام جولتَه العالميةَ بعدُ- كما يلفت فريد وجدي- ولا تزال أمم في الأرض لم تبلغها منه دعواه، وأمم قد ضُلِّلت فيه تضليلاً بعيدًا؛ ولكنه بما أُودع من قوة وحق، سيتغلب على هذه العقبات كلها حتى يسود العالم كله: {سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (فصلت: 53).