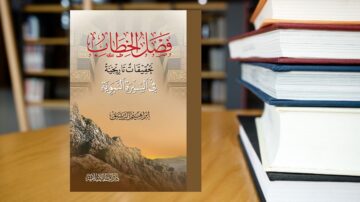رَسَخَ في قرارة النفس أن العلامة السوري إبراهيم عمر الزيبق فارس صنديد في حلبة الدراسات الأيوبية تحقيقا وتصنيفا، وثبت ذلك مع كثرة نتاجه الثري في هذا الميدان الرحب، الذي لا تعقد الخناصر فيه إلا عليه، وانقادت إليه أزمة حادثاته. ثم في ذرور العام 2023م تغير هذا المفهوم الراسخ، بل نسف نسفا، وذاك بعد نشره كتاب “فصل الخطاب” ذي العنوانة المقتبسة من قول رب العزة في قصة نبيه داود الأواب: { وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب } (ص: 20).
والمفسرون طرائقُ قددا في معناها، ولعل المجمع عليه والموافق لما يحمله هذا الكتاب بين طياته: الشهود والأيمان، أو علم القضاء. فالزيبق العالم ههنا قاض يحكم في ما اختلف فيه؛ إذ أوتي فهما وفصلا، بتوفيق من الله تعالى.
قبل الولوج في رياض هذا السفر الفاذ المشتمل على المسك الفتيق والدر النفيس، ثمة وقفة مكيث مع الإهداء، فإهداءات العلامة إبراهيم الزيبق لها أنفاس مسموعة، وكلها مائزة بلمسة من وفاء: فتارة يُهْدِي لأبيه، وتارة لزوجه، وتارة لأحد أصدقائه العظام كرمزي دمشقية ومحمد بن ناصر العجمي، وتارة لأثيرته دمشق الآسرة، وتارة – كالحال هنا – لأحد مشايخه الكبار، فيُهْدِي كتابه “فصل الخطاب” لعبقري اللغة العربية في سورية، إنه الخريت النقاب العلامة أحمد راتب النفاخ رحمه الله، قائلا: “إلى من أشرب قلبه حب العربية.. فعاش حياته لها.. نافحا طلابه كنوزها.. منافحا أعداءها”.
صدر كتابه هذا عن دار البشائر الإسلامية ببيروت في أبهى إهاب وقد لبس رداء الجمال، وهو مكون من خمس عشرة مقالة، أو وقفة مع وقائع السيرة النبوية، وجميعها وقفات تستحق القراءة على مكث.
9 وقفات مع ” فصل الخطاب “
ولضيق المقام، سأكتفي بوقوف خاطف مع تسعة منها، وفق ترتيبها الوارد بالكتاب:
في المقالة الأولى “هل ولد رسول الله ﷺ عام الفيل؟” يؤكد أن الأوفق تاريخيا في زمن ولادة النبي ﷺ أنها كانت في القرن السادس للميلاد، دون تحديد واقعة الفيل بسنة تتوافق مع سنة ولادته. ويدحض ما توصل إليه الباحث التونسي هشام جعيط (ت. 2021م) أن هجمة أبرهة على العرب وقعت سنة 547م وفاق النقوش، وأنها لم تك باتجاه مكة؟!
فيذكر الزيبق – وهو المؤرخ المحدث – أن حملة أبرهة على مكة واقعة تاريخية لا شك في وقوعها، ويقول: وما أدري كيف استقام له ذلك، واعتماده في بحثه بالأساس على القرآن كما قال في كتابه “تاريخية الدعوة المحمدية في مكة”؟! ثم يتابع حديثه، قائلا: وهذا الباحث مشبع بالأفكار الاستشراقية حول الإسلام، بل إنه في بعضها أشد منهم دفاعا عنها، وهو يستند في تأريخه للسيرة إلى وجهة نظر وضعية تاريخية، وليس إلى وجهة نظر إيمانية.
وفي المقالة الثانية “قصة استرضاعه في بني سعد” ينفي ما حيك في خبر استرضاعه من جدب البادية وتأبي المرضعات عليه ليتمه، حتى منت عليه حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية بأخذه على كره منها؛ فإرضاعه كان على ما كانت العرب تعتقده وقتئذ أن إرضاع الولد في البادية سبب لنجابته. كما ينفي ما رأته حليمة من بركاته، فهو خبر عار من الصحة ليس له إسناد يثبت به.
وفي المقالة الثالثة “حادثة شق صدره ﷺ في صغره” يذكر أن الحادثة وقعت مرتين في حياته، مرة في صغره وله نحو خمس سنين، ومرة ثانية في كبره عند إسرائه. وهو هنا يرد على من يحاول التشكيك في صحة هذا الخبر، كالأديب المصري محمد حسين هيكل (ت. 1956م) في كتابه “حياة محمد”؛ إذ الخبر وصل إلينا من غير شذوذ ولا علة، من أربع روايات، والرواية المعول عليها في صحته ما أخرجه الإمام أحمد في “المسند” والإمام مسلم في “صحيحه” عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
وفي مقالته الرابعة “قصة لقائه ﷺ في بصرى الشام راهبين في صباه وشبابه” تجد دراسة نقدية، حاول فيها ما استطاع – وبوفاء المؤرخ – أن يتحرر من موقف مسبق قد يغريه في قبول هذه القصة، أو يدفعه إلى رفضها، ذاكرا أنه ليس أضر على البحث العلمي من ألفة الأخبار والأفكار، مما حدا به في سبيل الوصول إلى حقيقتها أن يسلك منهج المحدثين، وذلك بالإحاطة برواياتها، وعزوها إلى مظانها، وبيان حال رواتها من العدالة والضبط، وأسانيدها من الاتصال والانقطاع، مع النظر في متونها بحثا عن نكارة أو شذوذ، ثم الحكم عليها بما يليق بها من صحة أو ضعف.
فيذكر أن ما شاع من خبر هذه القصة في كتب السيرة النبوية قديما أو حديثا، هو الخبر التالف الذي لا يصمد للنقد العلمي، أما الخبر الأقرب إلى الصواب فقد طوي من كتب السيرة؛ فالنبي ﷺ لم يتلق أية إشارة قبل بعثته أنه سيكون رسول هذه الأمة، وذلك في قوله تعالى: { وما كنت ترجوٓا أن يلقىٰٓ إليك ٱلكتٰب إلا رحمة من ربك } (القصص: 86).
ويبين الأستاذ الزيبق أن الكتاب الأوربيين تلقفوا هذه القصة، ونسج خيالهم حولها من الأساطير الكثير. وخالف الشيخ الألباني وشيخه شعيب الأرناؤوط والشيخ عبد القادر الأرنؤوط، الذين صححوا هذه القصة، معتمدين على ظاهر إسناد الحديث، ولم يعرجوا على متنه، ومن المعروف أن صحة الإسناد لا تقتضي صحة المتن، والحكم على الحديث اجتهاد يحتمل الاختلاف.
كما أن الشيخ الألباني قال في كتابه “نصب المجانيق”: “رحم الله من قال: الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف الرجال”. فمتن القصة قد اختلف ألوانا من راو إلى آخر، مما يدل على اضطرابها، وضعف رواتها.
فلو كان النبي ﷺ وهو صبي مع عمه أبي طالب في تجارته إلى الشام والتقى بالراهب بحيرا، لتركت هذه الحادثة – لو وقعت – أي أثر في مجتمع مكة، ولمهدت لهم تصديق النبي ﷺ حين جهر بدعوته، ولاحتج بها النبي ﷺ على قريش، ولا سيما على عمه أبي طالب، ولما نسيها أو تناساها النبي ﷺ. فالمستغرب أنها طويت من وقائع السيرة، فلم ترد على لسان النبي ﷺ طول حياته، وهو أمر يستدعيه منطق الحدث لو وقع حقا.
وفي مقالته الخامسة “زواجه ﷺ من خديجة بنت خويلد” يؤكد أن خبر زواج النبي ﷺ من خديجة رضي الله عنها على غير رضى من أبيها وإسكارها له، لا يلتفت إليه لنكارته.
واعتمد على هذا الخبر الضعيف التالف المستشرقون للغض من منزلته بين قومه. فيرى العلامة الزيبق أن ما ورد في تزويج أبيها لها وهو سكران لم يثبت بإسناد يصح به، ثم إن في متنه نكارة، وهي روايات على ضعفها تنبو عن منطق العرف في ذلك العصر؛ لأنها لا تتفق وما كان لبني هاشم ولرسول الله ﷺ من منزلة في قريش وقتئذ ونسب عريق، ولا سيما أن النبي ﷺ وخديجة يلتقيان في النسب بجدهما قصي بن كلاب، وبنو قصي متكافئون في الشرف؛ فدعوتهم يومئذ واحدة والدية عليهم جميعا. ثم يرجح أن عمها عمرو بن أسد هو الذي زوجها من رسول الله ﷺ.
وفي مقالته السادسة “هل ذبح رسول الله ﷺ للأوثان قبل بعثته؟” يبين الزيبق أن ثم من يطرح هذه القضية من الباحثين المعاصرين راميا من ورائها – وإن وراء الأكمة ما وراءها – أن النبي ﷺ قبل بعثته كان في طفولته وشبابه على دين قومه. والرواية قائمة على لقاء النبي ﷺ بزيد بن عمرو بن نفيل بأسفل وادي بلدح على طريق التنعيم، فقدم إليه النبي ﷺ سفرة فيها لحم، فأبى زيد أن يأكل منها، ثم قال: “إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه”.
وساق بعض الدارسين المحدثين هذا الخبر مساق الاحتجاج به؛ للطعن في عصمة النبي ﷺ قبل البعثة، وفي البحث العلمي النزيه لا وجه للاشتغال بما لا يصح من الآثار والأقوال. ففي “مسند أحمد” أن النبي ﷺ كان يقول لخديجة قبل البعثة: “أي خديجة، والله لا أعبد اللات أبدا، والله لا أعبد العزى أبدا.
وأجمع علماء المسلمين أن الأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة، فشأن النبي ﷺ في ذلك شأن غيره من الأنبياء، يكونون – وهم في حالة خلو عن الإيمان قبل أن يوحى إليهم – غير مشاركين لأهل الضلال من قومهم. فالنبي ﷺ – مع كراهيته للأوثان – لم يك مجاهرا بذمها بين قريش، ولا معلنا بمقتها، بل إنه لم يك يظهر لقومه خلافا أبدا، على ما يجد في صدره من ضيق لما هم عليه.
ويرى العلامة الزيبق أن ذلك من دلائل نبوته؛ لأنه لو كان جاهر وقتئذ بذم أصنامهم، ثم عابها بعد نبوته لقال الناس: إنه حين عجز عما أراد ادعى النبوة ليحقق ما يريد، ولن يصدقه حينئذ أحد. ثم يقول: فما أثارته هذه القضية من شبهة لا يعدو مجرد لغط لا يقوم على فهم سليم بريء من الهوى، ولا يستند إلى حديث صحيح، ولا مقبول، وليس له من غاية يتغياها إلا الطعن برسول الله ﷺ وعصمته من الشرك قبل بعثته، افتئاتا عليه وبغضا لدعوته.
وفي مقالته السابعة “هل حاول النبي ﷺالانتحار حين فتر الوحي عنه؟” يذكر أن معظم مؤرخي السيرة – قديمهم ومحدثهم – يثبتون أن النبي ﷺ حين فتر الوحي عنه هم بإلقاء نفسه من جبل شاهق، وشاع الخبر حتى غدا عند الكثرة الكاثرة منهم حقيقة مسلمة، دون تمحيصه وإخضاعه لما يستحق من نقد وتوثيق، ولا سيما أن فيه طعنا صريحا يتنافى وما تقتضيه نبوته من العصمة من الذنوب.
والروايات الصحيحة التي يعتمد عليها في فواتح مبعث النبي ﷺ لم تذكر لنا أنه حين فتر الوحي حزن حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. فيؤكد الزيبق أن الخبر من بلاغات ابن شهاب الزهري (ت. 124ه = 741م)، ومعلوم عند أهل العلم بالحديث أن بلاغات الزهري واهية، ليست بشيء، حتى إنهم قالوا لشدة ضعفها: هي بمنزلة الريح. فجماع القول أن خبر هم النبي ﷺ بإلقاء نفسه من شاهق، لا يصح بوجه من الوجوه، مع اضطرابه وضعف رواته.
وفي مقالته الثامنة “أحابيش قريش عرب صرحاء أم عبيد أرقاء؟” حار بعض الكتاب المعاصرين في معرفة أصل أحابيش قريش، وذهبوا في التعريف بهم مذاهب شتى، متخذين من بعض أقوال المستشرقين مصادر لهم، مثل المؤرخ العراقي جواد علي (ت. 1987م)، فيبين الزيبق – وبفهم سليم للأخبار، ويعضدها مستند ودليل – أنهم عرب صرحاء.
وفي مقالته التاسعة “قصة الغرانيق” فصل القول في قصة صفة أصنام قريش – اللات والعزى ومناة – فوضح أن الغرانيق هي في الأصل الذكور من طير الماء، وكانوا يزعمون أن الأصنام تقربهم من الله، وتشفع لهم إليه، فشبهت بالطيور التي تعلو وترتفع في جو السماء.
ثم يذكر أنها قصة ظاهرة البطلان، يوردها المستشرقون في تضاعيف السيرة للطعن في حقيقة الوحي ونفي عصمته ﷺ ، وأنه إنما يختلق القرآن الكريم من عنده اختلاقا. وهي على وهنها وبطلانها، تعلق بها أكثرهم، وعلى رأسهم الألماني ثيودور نولدكه (ت. 1930م)، والبريطاني مونتغمري وات (ت. 2006م)، وتجدد اهتمام الغرب بها على مستوى شعبي سنة 1988م، إثر صدور رواية سلمان رشدي “آيات شيطانية”، متخذا منها مطية للهجوم على القرآن الكريم، وعلى نبينا ﷺ ، وصحابته الغر الميامين. وردا على غضب المسلمين في العالم عما جاء فيها من تشويه للحقائق، أيدها كثير من الأوربيين.
وقصة الغرانيق نافح عنها المستشرقون، وما في هذا غرابة، متنكبين المنهج العلمي في البحث؛ لأنها صادفت هوى في نفوسهم، وهم الحريصون أشد الحرص على الطعن بنبوة النبي ﷺ بأي سبيل! أما الغرابة حقا فهي ممن حاول إثبات وقوعها من بني جلدتنا، تمسكا بظاهر أسانيدها رواية، وجهلا أو تجاهلا لفن الحديث في نقد المتن دراية.
ثم يبين الزيبق أن الداعي إلى اختراع هذه القصة إيجاد تفسير لما صح من سجود المسلمين والمشركين في مكة معا حين تلا عليهم النبي ﷺ “سورة النجم” الغراء، وهي أول سورة أعلنها – على التغليب – رسول الله ﷺ بمكة، فتلاها على المشركين، فحين فرغ النبي ﷺ من قراءتها سجد، وسجد معه المسلمون والمشركون على سوية واحدة، ما بقي أحد إلا سجد، إلا أمية بن خلف، أخذ كفا من تراب، فرفعه إلى جبهته، فسجد عليه، وقال: هذا يكفيني.
وملخص قصة الغرانيق تيك أن النبي ﷺ لما رأى تولي قومه عنه، تمنى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب بينه وبين قومه، فجلس يوما في ناد من أنديتهم حول الكعبة، فقرأ عليهم: {والنجم إذا هوى } حتى بلغ {أفرأيتم اللات والعزىٰ . ومناة الثالثة الأخرى } (النجم: 1-20) ألقى الشيطان كلمتين على لسانه – مما كانت قريش تقوله أثناء طوافها حول الكعبة – “تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى.
فلما سمعت ذلك قريش، فرحوا، وسجدوا مع المسلمين. فيوضح العلامة الزيبق أن تلكم رواية باطلة لا تصح من وجه، وأنها وردت بأسانيد مرسلة أو مسلسلة بالضعفاء، ينكرها أهل النظر، بيد أن ابن حجر – وقد غلبت عليه ههنا الصنعة الحديثية رواية، وغابت عنه دراية – تمحل الأسباب لإثبات وقوعها، وهي من كبواته. فقصة كهذه على خطورتها مساسا بالعقيدة، لا تصحح بأسانيد مرسلة وضعيفة، وإن كثرت وتباينت مخارجها، ولم تتوافر فيها شروط تصحيح المرسل كلها. وقد رد هذه القصة كثير من علماء المسلمين قديما وحديثا، كالفخر الرازي وابن العربي والقاضي عياض، وممن نقدها من المحدثين سندا ومتنا الشيخ الألباني في كتاب له أسماه “نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق”.
ذلكم غيض من فيض هذا البحر الزخار. وفي الأخير، أقول للعلامة الزيبق: أعطني يديك اللتين دافعت بهما عن رسول الله حتى أقبلهما. والسلام.