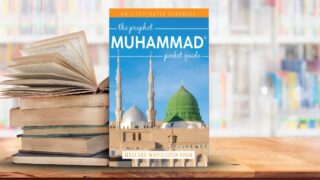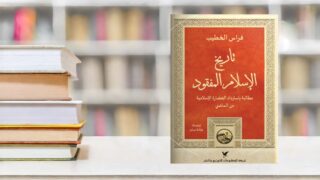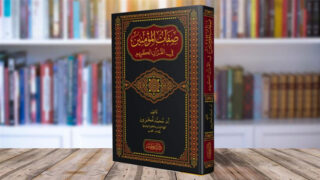“مقاليد الهداية” هو الكتاب الأول من ثلاثية المقاليد للكاتب سالم القحطاني (مقاليد الهداية، مقاليد العلم، مقاليد القراءة) التي يستهدف من خلالها المبتدئين في مجالات الهداية والعلم والقراءة، وحديثنا في هذه المقالة يقتصر على الكتاب الأول (مقاليد الهداية)، الذي سيجد فيه القارئ مصابيح لمن سلك طريق الاستقامة وقناديل تربوية في سياسة النفس والتعامل مع الناس، بالإضافة إلى مراجع مكتوبة ومرئية وصوتية تُعين القارئ على الاختيار وتحميه من أن يتوه في رفوف المكتبة.
قسم سالم القحطاني كتابه “مقاليد الهداية” إلى قسمين: خاطب في الأول الجنسين، في حين خصص القسم الثاني للنساء، وقد اعتمد أسلوباً واضحاً مبسطاً، وكان حريصاً على تقريب المعاني وفكِّ طلاسم المفاهيم والمصطلحات، ووضع منهجية رائعة ومفيدة، تمثلت في العناية بالاختصار غير المخل، وتقديم زبدة ما قاله العلماء والباحثون في مجال الاستقامة، بالإضافة إلى الابتعاد عن المصطلحات العلمية التي لا يعرفها إلا المتخصصون، والإحالة إلى المصادر المرئية والصوتية النافعة، وفي السطور التالية سنقف على جوانب من القضايا الواردة في هذا الكتاب.
مفاهيم ومصطلحات
أول ما اعتنى به القحطاني هو محاولة فكُّ طلاسم المفاهيم والمصطلحات المعلقة بموضوع هذا الكتاب، حيث توقف مع أربعة مفاهيم قد تواجه من يسلك طريق الهداية، أولها مفهوم “مطوَّعْ” الذي يعود إلى عهد الكتاتيب ويُطلَق في المجتمعات الخليجية على معلم القرآن ومن أطلق لحيته وقصَّر ثوبه. ورغم أن المؤلف لا يرى -مبدئياً- مشكلة في استعمال مصطلح “مطوَّعْ”، إلا أنه صرَّح بأنه يعتبر من المفاهيم التي جلبت الكثير من الإشكاليات وتركت الكثير من الآثار السيئة على المجتمعات، منها: المزيد من التفرقة بين المسلمين، وانتشار ثقافة التمايز والطبقات والتصنيف، وإعطاء انطباع خطير للناس بأن الدين الإسلامي إنما نزل على “المطاوعة”، الأمر الذي أدى إلى استسهال البعض اقتحام المعاصي متذرعاً بحجة “أنا لست مطوَّعْ”، ولعل هذا هو ما جعل القحطاني يتمنَّى أن يختفي مصطلح “مطوَّعْ” من ثقافة المجتمعات الخليجية والعربية.
أما المفهوم الثاني الذي توقف معه القحطاني فهو مفهوم “القدوة”، ومن المعلوم أن القدوة أمر جوهري في حياة الإنسان مهما كان، ولهذا كان القرآن الكريم واضحاً في هذا المجال، حيث قال إن القدوة الحسنة هي الرسول ﷺ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا}، وعلى هذا المنهاج نجد سفيان الثوري يقول: “إن رسول الله ﷺ هو الميزان الأكبر، وعليه تُعرض الأشياء: على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل.
ولا شك أن المسلم مطالب بترويض نفسه على الاقتداء بالنبي محمد ﷺ منذ دخوله إلى عالم الهداية حتى يلقى الله وهو عنه راضٍ، ولكن لا بد للمسلم في هذا الميدان من الحذر من الانبهار بالقدوات السيئة والمشاركة في الحملات الهادفة إلى تحطيم القدوات الحسنة، وقد أماط الدكتور محمد موسى الشريف اللثام عن هذه القضية في كتابه “القدوات الكبار بين التحطيم والانبهار”.
ويأتي مفهوم “التشدد” في المرتبة الثالثة بعد مفهومي “مطوع” و”القدوة”، ولا جدال في أن “التشدد” من المفاهيم التي تمثل تحدياً حقيقياً في طريق الاستقامة، وذلك لأن الشاب حين يتجه إلى التدين فإن من أول ما يوصف به ويُحذَّر منه هو “التشدد” فيصبح في حيرة من أمره، رغم أن الشرع يذم التشدد والغلو ويدعو إلى الوسطية والاعتدال: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا}.
وإذا نظرنا إلى مواقف البشر إزاء ظاهرة التشدد، فسنجد أن هناك فئتين: الأولى تَعتبِر أن كل من أعفى لحيته وقصَّر وغص بصره وتجنب أكل المال الحرام متشدد، ولا يَخفى على من له بصيرة أو أثارة من علم أن مواقف هذه الفئة تكشف عن فهم خاطئ وجهل عميق بحقيقة الإسلام، أما الفئة الثانية فأناسٌ متشددون حقاً يتجاوزن حدود الشرع ويغالون فيما أمر الله به، فيمتنعون عن القصر في السفر، ويرفضون الجِماع ليلة الصيام، ويمتنعون عن أكل الحلوى تقرباً إلى الله، ونظراً لخطر هاتين الفئتين على الإسلام والمسلمين دعا سالم القحطاني إلى تنجبهما وطالب بالالتزام بأوامر الله ونواهيه.
وغير بعيد من مفهوم “التشدد” يأتي مفهوم “الصغائر والكبائر”، وعلى سبيل الاختصار يمكن القول إن الكبائر هي الذنوب التي تستحق عقوبة محددة، أما الصغائر فهي الذنوب التي ليست فيها عقوبة محددة، ورغم كل ذلك فهناك ترابط دائم بين الصغائر والكبائر، ولهذا فقد أشار المؤلف في سياق حديثه عن هذا المفهوم إلى أمور مهمة ينبغي إدراكها، منها: أننا إذا تجنّبنا الكبائر فإن الله سبحانه وتعالى يُكفّر عنا الصغائر، وأن الإصرار على الصغيرة يحوِّلها إلى كبيرة، هذا بالإضافة إلى ضرورة التفريق في التعامل مع الأشخاص الذين يقعون في كبيرة والذين لا يقعون فيها.
في دروب الحياة
وبما أن الإنسان لا يعيش منفرداً بل يعيش بين الناس، فإنه لا بد أن يواجه مسائل عديدة وهو يسير في دروب الحياة المتشعبة، إلا أن أول شيء سيتعامل معه بعد الهداية هو نفسه الأمارة بالسوء التي بين جنبَيْه، والتي عليه أن يعمل على تهذيبها وإصلاحها وتقويمها قبل أن ينتقل إلى مرحلة التشابك مع الآخرين من أجل إصلاحهم، ومن أهم الأمور في هذا الباب: ضرورة التدرج في العبادات واستحضار قوله ﷺ “القصدَ القصدَ تبلغوا”، ثم الوعي بأن الحماسة المُفرطة في دعوة الناس قد تصبح مهلكة فتسبب مشاكل عديدة للشاب الجديد على طريق الاستقامة، فيضر نفسه ويضر الإسلام.
وأثناء تعامل الإنسان مع نفسه بعد الهداية، ستواجهه الكثير من الهواجس المقلقة التي ينبغي أن يتعامل معها بحكمة وهدوء وصبر حتى تنجلي عنه ظلمات البدايات، ومن تلك الهواجس: الهاجس المتعلق ببقايا الخطايا والذنوب التي يعسر عليه التخلص منها، فيتساءل: هل يمنعه هذا من أن يستقيم ويكون من المهتدين؟ والجواب أن هذا لا يعني أنه ليس على طريق الاستقامة بل هو عليها إن شاء الله، ولكن ينبغي عليه الاستمرار في طريق التدين والهداية وبذل الجهد الدائم للتخلص من بقايا الذنوب والخطايا والحرص على تجديد التوبة والاستغفار وعقد العزم أن لا يعود لمربع الذنوب من جديد.
ولا شك أن الخوف من الرياء في العبادات من أكثر الأمور التي يشتكي منها الكثير من الناس في طريق الهداية، فكلما ذهب الإنسان إلى المسجد خاطبه الشيطان قائلاً: أنت تذهب إلى المسجد لكي يراك الناس وليس من أجل مرضاة الله، والحق أن الشيطان يسعى من خلال هذا الخطاب السخيف إلى أن يُعيدنا إلى مربع الضلال والكسل، ولهذا على الإنسان أن يرُدَّ على الشيطان رداً قاصياً من خلال: الإعراض عن تلك الوساوس التي يثيرها إبليس في ذهنه، والاستمرار في الطاعة وعدم قطعتها، واستحضار أنك تتعامل مع الله وهو الذي سيثيبك إن أحسنت ويعاقبك إن أسأت، وبالتالي فلا داعي للاهتمام بما سيقوله الشيطان.
وفي مقابل الخوف من الرياء، هناك معضلة “العجب والغرور” الذي يُعدُّ من أبرز مداخل الشيطان إلى النفس، ولهذا فقد قال أحد السلف الصالح إن “العجب يهدم المحاسن”، ومن الخطير أن العجب قد يدفعك إلى الإحساس بأنك وصلت مرحلة عالية من الصلاح، فتبدأ تحتقر وشتم وتذمُّ وتُعيِّر إخوانك العصاة، وهذا خطأ فادح ونتائجه عليك وعلى الإسلام ليست إيجابية، فالقرآن الكريم يدعوك إلى ممارسة الدعوة إلى الله بحكمة وموعظة حسنة: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}، وقد جاء في الأثر: “من عيَّر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله”، قال ابن القيم معلقاً: “تعييرك لأخيك بذنبه أعظمُ إثماً من ذنبه، وأشد من معصيته”.
والحقيقة الخالدة أن الإنسان في كل مراحل حياته لن يجد من مرشداً وهادياً ومثبتاً ومنوراً وشفاءً أحسن من القرآن الكريم: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ}، ولهذا فعليه أن يداوم على قراءته آناء الليل وأطراف النهار، ولكن لا ينبغي أن تقتصر علاقتنا بالقرآن على حفظه وتجويده، بل يجب أن تتعدى إلى مرحلة فهمه وتدبره والعمل به: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ}.
ولا جدال في أنه لا يوجد بعد القرآن الكريم مصدر أكثر صحةً وثراءً من السنة النبوية، فهي الوحي الثاني وهي المبينة للقرآن الكريم، وانطلاقاً من هذه الحقيقة فإن الإنسان مطالب منذ دخوله عالم الهداية بأن تكون له علاقة مع أحاديث الرسول ﷺ من خلالها حفظ متونها وقراءة شروحها النوعية، فالقراءة من أهم الوسائل العظيمة لتحصيل العلم والثقافة واليقين، ولهذا جاء الأمر بها في القرآن الكريم: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}.
ولأن البيت هو المكان الذي يقضي فيه الإنسان أكثر أوقاته حياته، كان من الطبيعي أن تواجهه فيه بعض المظاهر التي ينبغي أن يأخذها على محمل الجد وهو يسير في طريق الهداية، وعلى رأسها بر الوالدين {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}، والتعامل مع الإخوة والأخوات والأقارب بفرق وحكمة فـ “الأقربون أولى بالمعروف”، ثم الحرص على بناء شبكة صداقات طيبة فـ “المرء على دين خليله”، والاعتزاز بالهوية الإسلامية فـ “نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله”، كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وينبغي أن يكون من المعلوم بداهة لدى المسلمين عامة وخاصة أن هذين المصدرين (القرآن والسنة) هما اللذان يعينان المسلم على الثبات على هذا الدين المبارك ويحولان بينه وبين الانتكاسة والعودة للفجور والفسوق والمجاهرة بالمعاصي، قال ﷺ: “تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي”.
الفتاة الصالحة
ونظراً لأن هناك حرباً شرسةً لا هوادة فيها تُشنُّ على المرأة المسلمة من أجل إخراجها من عباءة دينها الحنيف وإغراقها في بحر الانحلال والتفسخ والفجور حتى تصبح نسخة من المرأة الغربية، قام سالم القحطاني بتخصيص القسم الثاني من كتابه “مقاليد الهداية” للمرأة المسلمة، فقدم فيه مجموعة من القضايا التي تَهُمُّ الفتاة المسلمة وهي تسير على طريق الهداية، وتساعدها في تشكيل وعيها بطريقة صحيحة، وتدعوها إلى التمسك بالدين الإسلامي وتعاليمه، للحيلولة بينها وبين الركض وراء نظريات دعاة الانحلال والفجور، ويأتي اهتمام المؤلف بالمرأة هنا من باب قول الرسول ﷺ: “استوصوا بالنساء خيراً”.
لقد كانت قضية الحجاب الشرعي أول قضية من القضايا التي عرضها القحطاني في هذا القسم المهم، ولعل السبب في ذلك هو أن أول ما يشغل الفتاة حين تستقيم على الطاعة هو قضية الحجاب، تلك القضية التي تثير الكثير من الأسئلة التي كانت من المسلمات في السابق، مثل: ما معنى الحجاب؟ وهل هو عادة أم عبادة؟ وإذا كان عبادة فما منزلته من الدين؟
وسيلاحظ القارئ أن سالم القحطاني أجاب على هذه الأسئلة، حيث ذهب إلى أن العلماء اتفقوا على أن المقصود بالحجاب الشرعي أن تستر المرأة جميع بدنها، ولكنهم اختلفوا في الإجابة على سؤال: هل يجب على المرأة تغطية الوجه واليدين وهل إذا لم تغطهما تكون آثمة؟ ويبدو أن هناك رأيين مشهورين للفقهاء حول هذه المسألة، أحدهما يقول إنها تأثم، والثاني يرى أنها لا تأثم.
ومهما يكن من أمر، فإن الحجاب الشرعي فرض بنص القرآن الكريم والحديث الشريف، وهو مطلوب خلقاً وذوقاً لأنه من الأمور التي كرَّم الله بها المرأة المؤمنة وميّزها به عن غيرها من النساء الأخريات، قال الله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ.. إلخ}، ويقول ﷺ: “صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا”.
وغير بعيد من قضية الحجاب الشرعي تبرز جدلية الحشمة والأناقة، فغالباً ما “تظن بعض الأخوات أنها إذا استقامت على الطاعة فيجب أن تكون شعثة المظهر، وتترك العناية بأناقتها ومظهرها أمام زوجها أو أهلها أو صديقاتها وتظن أن هذا هو مقتضى الزهد في الدنيا”، ولا شك أن هذا فهم مغلوط لمعنى الاستقامة في الإسلام، فالإسلام لم يمنع المرأة من التزين لتصبح أنيقة، وإنما وضع قيوداً شرعية على زينتها تكريماً لها وحفاظاً عليها من الذئاب البشرية، فلم يسمح لها بإبداء تلك الزينة إلا لمن تجوز له رؤيتها شرعاً كما في الآية السابقة من سورة النور: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ.. إلخ}.
وفي سياق الحديث عن الزينة والجمال، قد يكون من المهم الإشارة إلى أن الهوس بعمليات التجميل والغلو المبالغة في العناية بجمال الوجه وإهمال الروح والنفس والعقل يُعدُّ آفة كبيرة من آفات الحياة الغربية التي نجحت في أن تُقنع المرأة بأنها إذا لم تكن جميلة من المظهر فلا قيمة لها، وهذا هو ما يسمى بـ “تسليع المرأة”، أي تحويلها من إنسان له روح وفكر وعقل إلى مجرد جسد وسلعة لا تختلف عن السيارة الفارهة والمنزل الجميل والهاتف الذكي.
ومن الآفات التي خرجت من رحم الحياة الغربية أيضاً ما يعرف بالنسوية وأخواتها، وقد دخل الغرب إلى هذا الموضوع من بوابة الأسرة (المرأة) بعد أن أسقط الخلافة الإسلامية، وهدف الغرب من النسوية وأخواتها إفساد الأسرة المسلمة، وقد نجح في جوانب من هذه الحرب الخطيرة المستمرة.
وفي سياق الحديث عن آفة النسوية، قدم سالم القحطاني تنبيهات مهمة للفتاة المسلمة، منها: أن تفتخر بإسلامها وحجابها وأن تتذكر أنه لا يوجد دين رفع من شأن المرأة أكثر من الإسلام، وأن تقرأ في سيرة الصحابيات والتابعيات والصالحات من بعدهن فهؤلاء هن القدوة، وأن تكون على وعي تام بمصطلحات من قبيل: حقوق المرأة، التمييز ضد المرأة، النسوية، الجندر، الضحية، وأن تقرأ اتفاقية “سيداو” التي تتألف من (30 مادة)، لتكتشف تصادمها مع الشريعة والفطرة.
تنزيل PDF