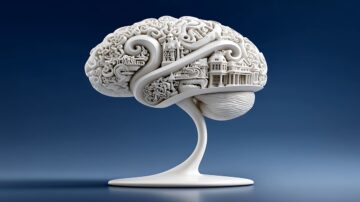لكل قصة بداية، وقصةُ التنمية البشرية تبدأ غالبًا بصورةٍ تأسر الألباب: صروحٌ زجاجية تناطح السحاب، جسورٌ معلقة تمتد فوق الماء كأنها خيوط من ضوء، ومدنٌ ذكية تَعِدُ باليُسر والكفاءة. هذا هو وجه “العمران” الذي نعرفه، وجهٌ صاخبٌ، لامعٌ، وماديّ الطابع. لكن، لو أرهفنا السمع قليلًا خلف ضجيج آلات البناء وزجاج الواجهات البرّاقة، قد نسمع همسًا خافتًا يطرح سؤالًا مقلقًا: أين الناس في كل هذا؟ أين الروح
لماذا تبدو بعض ساحاتنا العامة، رغم جمال تصميمها، باردةً وغريبة؟ ولماذا نشعر أحيانًا في أحدث الأحياء السكنية بوحشةٍ لا نعرف مصدرها، رغم توفر كل خدمات الرفاهية؟ إنها أسئلةٌ لا تطرحها جداول البيانات ولا تقارير الجدوى الاقتصادية، لكنها تحدد الفرق بين بناء “مساكن” وبناء “ديار”، بين تشييد “مبانٍ” وإقامة “عمران” حقيقي.
الجواب يكمن في “ميزانٍ” دقيق وحسّاس، ميزانٌ لا تراه العيون، لكن تشعر به القلوب. في كفّته الأولى توضع خطط الهندسة، والميزانيات المالية، والتقنيات الحديثة. وفي كفّته الثانية، توضع الثقافة، والقيم، والهوية، وذاكرة المكان، ونسيج العلاقات الإنسانية. حين يختل هذا الميزان، وتميل الكفة الأولى بثقلها المادي على حساب الثانية، تبدأ أجمل الصروح في التصدع من داخلها، ليس في أساساتها الخرسانية، بل في أساسها الإنساني.
“العمران”: عمارة الروح قبل عمارة الصروح
إن مفهوم “العمران” في ثقافتنا أوسع وأعمق من مجرد البناء والطوب. جذره اللغوي “عَمَرَ” لا يعني فقط شيّد وبنى، بل يعني أيضًا أحيَا وسَكَن وأصلح. العمران هو بثّ الحياة في المكان، وهو عكس الخراب والخواء. إنه الحالة التي تزدهر فيها الحياة الإنسانية بكل أبعادها: الروحية، والاجتماعية، والاقتصادية. وبهذا المعنى، فإن بناء ناطحة سحاب في صحراء قلبٍ قاحل ليس عمرانًا، بل هو مجرد هيكل أصم.

يمكننا أن نميز بين نوعين من البناء: “عمران الشكل” و”عمران الروح”. الأول هو الجسد، هو كل ما هو مرئي وقابل للقياس: الكيلومترات من الطرق، وأعداد الشقق السكنية، وارتفاع الأبراج. أما الثاني، فهو الروح التي تسري في هذا الجسد: منظومة القيم التي تحكم تعاملات الناس، الثقة المتبادلة بينهم، الشعور بالانتماء للمكان، القصص المشتركة التي ترويها جدران حيّ قديم، ودفء العلاقات الذي يحول الجيران إلى أهل.
عندما تركز خطط التنمية على “عمران الشكل” وتهمل “عمران الروح”، فإنها تبني جسدًا جميلًا لكنه بلا حياة. جسدٌ قد يبهر الناظرين، لكنه لا يأوي ساكنيه حقًا، لا يمنحهم السكينة ولا يشعرهم بالانتماء.
أعراض اختلال الميزان: حين تتكلم الشواهد
حين تُهمل الثقافة في ساحة التنمية، لا تكون النتائج مجرد أرقامٍ في تقرير، بل تصبح واقعًا معاشًا نراه في تفاصيل حياتنا اليومية. من أبرز هذه الأعراض:
الاغتراب الاجتماعي
تُصمَّم أحيانًا أحياءٌ سكنيةٌ حديثةٌ وفق نماذج مستوردة تتجاهل “ثقافة الحي” (الفريج) المتوارثة. تصبح الوحدات السكنية مجرد صناديق متراصة، تفصل بين الجيران جدرانٌ سميكةٌ وفراغٌ اجتماعي هائل. يمضي الجار سنواتٍ دون أن يعرف جاره، وتذبل شبكات التكافل والدعم التي كانت يومًا صمام أمان للمجتمع. نفقد ذلك الشعور بأن “جارك هو أهلك الأقرب”.
المشاريع اليتيمة
كم من مشروعٍ بُني بأعلى المعايير، ثم وقف مهجورًا لا يرتاده أحد؟ سوقٌ عصريٌ لا يقصده التجار لأنه لا يلبي طريقة بيعهم وعرضهم المعتادة، أو مركزٌ ثقافيٌ يقدم برامج لا تلامس وجدان المجتمع ولا تتحدث لغته. هذه المشاريع ليست فشلًا هندسيًا، بل هي فشلٌ ثقافي، لأنها لم تنبع من رحم المجتمع، بل هبطت عليه من الأعلى، فلفظها وبقيت يتيمةً بلا أهل.
تآكل الهوية
العمران هو الذاكرة المادية للأمة. عندما نزيل حيًا تاريخيًا بكامله لنبني مكانه مجمعًا تجاريًا حديثًا، فنحن لا نزيل مجرد حجارة قديمة، بل نمحو قصصًا وذكريات وأشكالًا من الحكمة المتراكمة عبر الأجيال. نمحو حكمة الأجداد في التكيف مع المناخ، وفنهم في بناء علاقات الجوار، وجمالياتهم التي عكست هويتهم. شيئًا فشيئًا، تصبح مدننا نسخًا مكررة من بعضها البعض، بلا طعمٍ أو لونٍ أو رائحةٍ خاصة.
استعادة التوازن: كيف نبني تنميةً تشبهنا؟
إن إدراك الخلل هو نصف الطريق نحو الإصلاح. أما النصف الآخر، فيكمن في تبني منهجية جديدة في التنمية، منهجية تعيد للثقافة مكانتها في قلب المعادلة. وهذا يتطلب ثلاثة أعمدة رئيسية:
أولًا: الإصغاء قبل التخطيط
يجب أن تبدأ رحلة أي مشروع تنموي ليس في مكتب استشاري، بل في مجلس الحي، وفي سوق القرية، وبين الناس. يجب أن يتحول المهندس والمخطط إلى مستمعٍ وتلميذ، يتعلم من حكمة أهل المكان، ويفهم احتياجاتهم الحقيقية، ويحترم أحلامهم. المشاركة المجتمعية ليست ترفًا، بل هي البوصلة التي توجه سفينة التنمية إلى بر الأمان.
ثانيًا: حكمة الدمج بين الأصالة والمعاصرة
التقدم الحقيقي لا يعني القطيعة مع الماضي. إن أعظم الإبداعات هي تلك التي تنجح في نسج خيوط الماضي العريقة في ثوب المستقبل الزاهي. يمكننا أن نبني مدنًا ذكية تستلهم من تصميم البيت العربي القديم حكمته في التهوية الطبيعية والخصوصية. ويمكننا أن نؤسس شركات تقنية تدار بقيم الأمانة والإحسان المتجذرة في ثقافتنا.
ثالثًا: قياس ما يهم حقًا
حان الوقت لنتجاوز مقاييس النجاح المادية البحتة. فإلى جانب قياس الناتج المحلي الإجمالي، يجب أن نبتكر أدواتٍ لقياس “رأس المال الاجتماعي”، ومستويات الثقة في المجتمع، ونسبة المشاركة في الأعمال التطوعية، ومدى شعور الناس بالفخر والانتماء. إن الربح الحقيقي ليس ما يدخل في الجيوب، بل ما يستقر في القلوب والنفوس.

خاتمة: عمارة الأرض.. عبادة واستخلاف
في نهاية المطاف، إن السعي نحو “العمران” ليس مجرد مشروعٍ اقتصادي أو هندسي، بل هو في جوهره فعلٌ روحي عميق. إنه تحقيقٌ لمعنى “الاستخلاف في الأرض” الذي كُلّف به الإنسان. وهذه المهمة العظيمة لا يمكن أن تتم بقلبٍ غافلٍ عن طبائع البشر، أو بعقلٍ يتجاهل ثراء الثقافات وتنوعها.
إن التنمية التي لا ترى في الإنسان إلا رقمًا في معادلة الإنتاج، هي تنميةٌ عرجاء، مهما بدت قامتها طويلة. أما التنمية المتوازنة، فهي التي ترى في كل مشروع فرصةً لتقوية الروابط، وتعميق القيم، وتكريم الهوية الإنسانية. إنها التنمية التي لا تبني مجرد طرقٍ ومبانٍ، بل تبني جسورًا من الثقة، وتؤسس لصروحٍ من الكرامة. وذلك هو العمران الذي يبقى أثره، وتُروى حكايته، وتطيب الحياة فيه.