علق ويلفريد سكاون بلنت Blunt Wilfrid Scawen في كتابه (مستقبل الإسلام – The Future of Islam) على أن الإسلام بحاجة إلى ” إصلاح ذاتي” يشبه الإصلاح الذي حدث في أوروبا. أشار بلنت إلى أن جامعة الأزهر – كانت كتاباته عن الأزهر في عام 1882 وما بعده – قد وضعت أسس الإصلاح الاجتماعي والسياسي.
شهد الإصلاح الديني الأوروبي تحدي مارتن لوثر لبنية الكنيسة الكاثوليكية الرسمية، وأدى إلى ولادة حركة البروتستانت في جميع أنحاء القارة والعالم. أتاحت حركة لوثر الوصول إلى النص الديني للجميع، والذي كان حكرا قبل ذلك على فئة ضيقة من أصحاب المناصب الرسمية في الكنيسة الكاثوليكية، مما فتح أبواب إعادة التفسير وتقويض هيكل السلطة الدينية القائمة. في الواقع، كانت المحصلة النهائية أن لوثر تمكن من تغيير عقيدة الكنيسة التي كانت متمسكة بها لقرون وتحويل المجتمع إلى شيء مختلف تماما.
وعلى نفس المنوال، رغب الكاتب ويلفريد بلنت في وجود نسخة مماثلة لمارتن لوثر لدى المسلمين وعبر عن الأمل في حدوث “إصلاح” مشابه في العالم الإسلامي بحيث يعمل على تحدي السلطة الدينية القائمة ويمكن من خلالها أن تسود روح جديدة من التفسير.
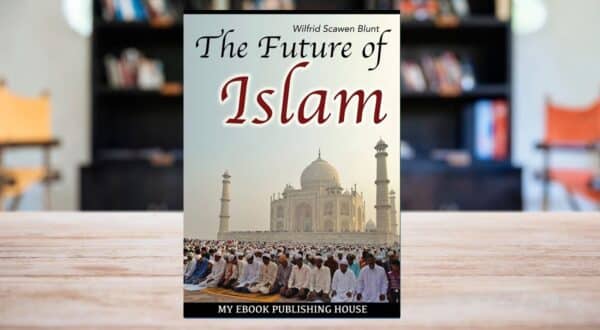
فكرة “الإصلاح الإسلامي” قدمت من قبل الأوروبيين منذ أوائل القرن السابع عشر، عندما بدأ التدهور الاقتصادي والسياسي للمسلمين مقابل تحول هائل حدث نتيجة “اكتشاف – أو بمعنى أدق استعمار – العالم الجديد”، وصاحب ذلك تغيرات في أنماط التجارة والاقتصاد المؤثرة تلقائيا على الضرائب والتعريفات الجمركية، وتأثير الحروب الأهلية، وضعف الحكم وعدم فعاليته وتقسيم البلاد وفقد بعض المناطق وبداية الاستعمار.
لم تكن تلك الأسباب في مجملها تتعلق أساسا بتفسير النصوص الدينية، ولا بالسلطات الدينية لأنها كانت على الهامش إلى حد كبير، لأن السلطة التنفيذية في المجتمعات الإسلامية لم تكن مستندة إلى رجال الدين، بل كانت تعتمد على الحكم الوراثي وغالبا ما كانت تستند على القبائل.
وبالتالي، كانت فكرة الحاجة إلى “الإصلاح الإسلامي” فكرة دخيلة، نسقت المعايير فيها وفقا للنموذج الأوروبي وجعلته مقياسا للقراءة والتفكير حول العلاقة بين الدين وتشكيل المجتمع. ومن بوابة النقد، يقدم التاريخ الأوروبي وتطور عملية الإصلاح لديه كنموذج عالمي يجب تقليده في جميع أنحاء العالم. ومن هذا المنطلق كان الدفع من أجل “الإصلاح الإسلامي” مطلوبا وبدأ الشروع فيه.
إن العنصر الأكثر أهمية هو معرفة الكيفية التي بدأت بها عملية “الإصلاح الإسلامي” والقضايا التي سلط عليها الضوء وأخذت جل التركيز. في بداية القرن التاسع عشر، حاول القادة المسلمون إبطاء أو عكس مسار الركود السياسي والاقتصادي؛ ولذلك شرعوا في مبادرات مختلفة لإصلاح المجتمع، والتي كانت في جوهرها تقبل الطرح القائل بأن دور الإسلام في المجتمع يمثل إشكالية.
في هذا السياق، فسرت أعراض الانحطاط والتدهور على أنها الأسباب الحقيقية، من أهمها: سوء فهم التحولات في العالم، ونقص الاستعداد الداخلي لمواجهة هذه التحديات بسبب الفساد والمحسوبية، وتقسيم الأراضي والمجتمعات، وعدم اكتراث النخب للنهوض بالمجتمع. كانت الأزمات عديدة لكن الوصول للنص الديني والقيادات الدينية لا تدخل من ضمن الأسباب الرئيسة لهذا التدهور بنفس الطريقة التي كانت عليها الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا حيث لا يوجد في الإسلام “بابا” أو “سلطة كنسية” مركزية تمنح الحق الإلهي في الحكم للخليفة.
كان على المسلمين مواجهة أزمات كبيرة وصراعات وتحديات ضخمة وعوامل متعددة ومتراكمة ومن كل اتجاه وفي مختلف أنحاء العالم ؛ إلا أن الوصول إلى النص المقدس – القرآن الكريم – لم يكن السبب في هذه الأزمات، وفيما يتعلق بسلطة رجال الدين فالأمر مختلف، ولا يملك ذات الديناميكية والخصائص لما وقع في أوروبا. كان يُطلب من المسلمين إعادة التشريع على نهج التاريخ الديني لأوروبا وتشكيله كمعيار عالمي، وهذا من الناحية المنهجية خطأ معيب في أحسن الأحوال.
وهنا لا أقلل من شأن المشاكل الموجودة في الاقتراب من النص الديني الإسلامي والعديد من القضايا الملحة الحقيقية التي تدعو ألمع العقول إلى التعامل معها؛ وعلى العكس من ذلك، أرى بضرورة التشخيص الصحيح للمسببات ووصف العلاجات المناسبة.
لقد تسارعت الدعوة إلى “الإصلاح الإسلامي” على فترة تتراوح بين 20 إلى 30 سنة الماضية عبر عدد من المؤتمرات والأبحاث المقدمة من قبل مراكز الفكر، والتدخلات الحكومية، واستخدام القوة، والوسائط المرئية، وكتب الأطفال، وتأثير الشخصيات الإعلاميةـ كل تلك المساعي من أجل توليد “المسلم الجديد”.
من وجهة نظري، كانت الجهود موجهة نحو خلق شخصية مسلمة – أقل شأناً في المكانة – ومطابقة لصورة الإنسان الأوروبي الناجح الذي تمكن من إزاحة تأثير الدين عن المجتمع وأصبح سيد مصيره. إن التوفيق بين الإسلام ومكانته مقابل الأوروبي العلماني الناجح يأتي في طليعة هذا الاشتباك المستمر وجعله موضع الإشكال في المناقشات المعاصرة. الفرضية هنا تقوم على أساس أن القراءة التقدمية لتاريخ تطور الفكر الأوروبي باعتباره محور الاهتمام وقمة المشروع البشري، يوجب اعتماده كأساس للمحاكاة.
لقد توجهت جهود العديد من المفكرين المسلمين نحو التوفيق بين الإسلام و”الفكر الغربي”، وهو مصطلح واسع يشير أن هناك ثنائية في الوجود مع قبول التقسيم الأساسي المستنتج من التقدم التاريخي للعلاقة. لقد وجدت عملية الترويج “للإصلاح الإسلامي” وفق قائمة محددة من المصالح فئة مستعدة للقيام بهذا الدور من الكتاب والشخصيات الإعلامية والمفكرين، تتحدث وتكتب إلى جمهور واع؛ وبالتالي تمنح هذا الجهد مزيدا من الأساسات المنطقية، ثم توجه الإنتاج الفكري إلى جمهور معين يعالج مجموعة من القضايا التي ليست في دائرة اهتمام المسلمين في العالم أو لها تأثير محدود عليهم.
ما هو الحيز الذي يشغله النقاش في قضايا العسكرة، والفقر، والحقوق الاقتصادية، وحقوق الإنسان، وتداول السلطة، وتأثير الشركات العابرة للقارات، وفقدان المعنى بالنسبة للإنسان؟ “الإصلاح الإسلامي” مصطلح أجوف إذا لم يواجه كل هذه القضايا مباشرة من منظور روحي نابع من صميم الإسلام.
ما هي نقطة الانطلاق لمعالجة دور الإسلام في المجتمع؟ ما هي الآليات الخاصة والمستفادة من التاريخ الإسلامي التي يمكن لها تعريف وتوجيه العلاقة بالنص مما يجعلها تشترك في عمليات “الإصلاح” و “التجديد” و “الابتكار” من غير أن تقع في فخ التقليد ولا تتأثر بعقد النقص، أو في أسوأ الاحتمالات هل نجعل المجتمع الإسلامي سلعة أخرى لجشع الشركات التجارية؟ إذا تعامل المرء مع الموضوع بفكرة أن الإسلام أدنى شأنا، وغير قابل للتطبيق العملي، وليس منفتحا على عمليات فحص جديدة، فإن النتيجة النهائية ما هي إلا تكرار للنتائج السابقة.
هناك حاجة إلى النظر بمزيد من النقد حول أسباب شعور المسلمين اليوم بمثل هذه المشاعر المتجذرة فيها عقد النقص والدونية، مما يجعلهم يتصرفون ويفكرون بشكل جماعي من خلال “الغرب” باعتباره المعيار الذي يقيسون به كل شيء؟ لماذا هذا الاستعداد لتأدية دور “إسلامهم” من خلال عدسة أساسها يعتمد على “الوعي المزدوج” الذي ينفي مركزية الذات في السعي وراء المعنى؟
أرى بتجديد التركيز على إعادة اكتشاف الذات الإسلامية، المستندة إلى المعنى المتوصل إليه من داخل “الإبستمولوجيا” الإسلامية والتي تتواصل مع كل تقليد وإرث وحضارة مجتمع، لأننا ننتمي إلى المحيط البشري الواسع الذي أنتج وجهات نظر متعددة لمعالجة تعقيدات أوضاعنا.
أدعو إلى إجراء عملية إحياء دقيقة تتحرر من الاستعمار وتقوم بالإصلاح وتتصف بالشمولية والعالمية في حواراتها، ولا تتمحور على رؤية “الغرب” الكامنة في عقلنا الجمعي.
الكاتب : البروفيسور حاتم بازيان – كبير المحاضرين في قسم الشرق الأدنى والدراسات العرقية في جامعة كاليفورنيا، بيركلي. ورئيس الشؤون الأكاديمية في كلية الزيتونة في كاليفورنيا

