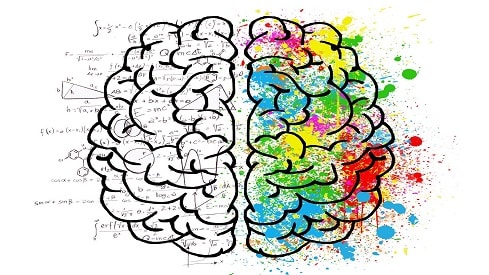يعد تعريف العقل وحدوده (العقل) هما مناط الخلاف الحقيقي بين العلمانيين والإسلاميين في ساحاتنا الثقافية اليوم، وللأمانة فإن الخلاف حول العقل قديم قدم الفلسفة ذاتها والنظر الإنساني في مباحث الوجود والمعرفة والألوهية؛ فقد اختلف النظر للمفهوم وطبيعته وتشكله ووظيفته باختلاف رؤية الفلاسفة للعقل، وما إذا كانت المفاهيم –وبالتالي العقل الذي يحملها- هي وحدات مجردة فطرية يطورها الواقع عند أفلاطون وسقراط، أو أدوات تشكلها التجربة عند أرسطو، أو لبنات كامنة في العقل يدرك بها الوجود عند ديكارت، أو تجريدات من الواقع عبر الحواس لدى لوك ورايلي وهيوم وميل، أو مزيج بين أفكار قبلية وتجريد للتجربة الواقعية لدى كانط، أو أدوات يفهم بها العقل جدلية الأفكار في الواقع عند هيجل، أو تصورات ذهنية مستمدة من التجربة لها وظيفة في إدراك الواقع بشكل منطقي عند كارناب وراسيل وفريج.. وأخيرًا هي أدوات لغوية اتصالية عند فتجنشتين.
باختصار: هل العقل مرآة الواقع وبالتالي معيار التقدم هو التجريب، أم أن هناك “ما وراء” لا يدركه العقل وبالتالي العقل عليه الاعتراف بحدوده وقيوده وقصوره، والأهم: كيف يمكن توظيفه لأقصى مدى حتى لا يُقيّد فيما دون قدراته الحقيقية ويعوق تطويره وازدهاره وإبداعه.
ورغم أن هذا الخلاف حول العقل وطبيعته والمفاهيم وماهيتها كان أحد مباحث الفلسفة الغربية عبر تاريخها، فإن الذي يهمنا في هذا السياق هو الجدل الجاري حول “العقلانية” تحديداً، والذي مثَّل انطلاقة الفكر الليبرالي تاريخيًا في مرحلة الاستنارة ثم في مشروع الحداثة، والسعي لتغليب العقلانية، وهو ما ارتبط بعلمنة العقل الأوروبي، فالعلمانية ليست فصل الدين عن الدولة بل هي بالأساس قضية عقلية- مفاهيمية مرتبطة بالتصورات الذهنية الفكرية والمناخ العلمي والثقافي، وكان هذا النقاش هو الذي أثمر بلورة الأطروحات الليبرالية بشأن الفرد والدولة وقيم الحرية، وبلور مفاهيم الحقوق والمواطنة.
لذا لم يكن غريبًا أنّ أبرز تعريفات العلمانية تجعلها قرينة العِلْمية والعقلانية، وأن يكون وصف مراحل العلمنة متطابقًا مع خصائص الدولة الحديثة ومراحل نموها وتطورها، من تقسيم مؤسسي، وتباين وظيفي، وتمدين، وتصنيع، وتحديث.
وقد أدى اقتران العقلانية بالعلمانية والليبرالية بنظريات التحديث، إلى التوجه نحو الضبط للمفاهيم تأسيسًا على الواقع؛ وذلك نفيًا لأية “لاعقلانية” للمنهج والمفاهيم، وتحوّل “العلم” مع الوقت إلى مذهب ومعتقد في ذاته، وصارت العلوم الطبيعية هي علوم سيطرة الإنسان على الكون والطبيعة، وهذا جوهر وغاية العقلانية والعلمنة، فقد مثَّلت تلك العلوم النموذج للضبط والدقة التي بدأت مناهج الدراسة الاجتماعية والإنسانية والسياسية تحتذي بها، وهكذا بدأ الاهتمام من جانب تلك الحقول المعرفية لتقديم تعريفات دقيقة للمفاهيم، والسعي لتحويلها إلى مصطلحات بالغة الدقة، فظهرت قواميس المصطلحات الاجتماعية.
الإنسان والمادة .. هناك فرق
وفي إطار ترسيم العقل بين الدين والعلمانية، فإن محاولات فهم العقلانية والعلمنة تستلزم إطلالة على النظرية الاجتماعية، وبحثًا في كتابات علم الاجتماع الديني؛ لأن النظرية الاجتماعية اعتبرت العلمنة “معلومًا من العلم بالضرورة” فلم تحاول الإطناب في التنظير لها أو حتى تعريفها بدقة خارج مسلمات فصل الدين عن الدولة والمجتمع –كذلك فإن تطوير المفاهيم باتجاه المعيارية كان يسير متلازمًا مع ضبط مفاهيم علم الاجتماع بالتجريب في المرحلة السلوكية، وهو ما أشار كولمان- أبرز أساطين هذا العلم- لخطورته؛ فالفارق بين المفاهيم التي تتعامل مع المادة وتلك التي تتعامل مع الظواهر الإنسانية والاجتماعية يحتّم التمييز بين أنواع المفاهيم، واختلاف حدود العقل وقدراته في فهم الظواهر باختلاف الظواهر ذاتها، بل وباختلاف غاية ومقصود العلم ذاته.. فهل هدف البحث الاجتماعي هو التحكم في إدارة السلوك الاجتماعي (الهندسة الاجتماعية) عبر دراسة سلوك الفرد، وأي خلل في فهم سلوك الفرد يعكس قصور في المنهج، أم أن النظرية لها آفاق قيمية كلية لا تصلح للقياس على هذا الهدف للنظرية الاجتماعية، بل تدخل ضمن رسالة العلم ودوره التقويمي لمسيرة المجتمع وفق غايات المجتمع وقيمه ومساره التاريخي المتطور؟
عودة الأسطورة لفهم الواقع
وفي إطار ترسيم العقل بين الدين والعلمانية، نلاحظ أن العقلانية قد صارت مع ربطها بالتجريب والواقع ونفي الـ”ما وراءية” و”التجاوز” عنها مرادفًا للإمبريقية وعدم السماح بأي خلاف أو غموض؛ بهدف الوصول إلى الدقة المعيارية، لكن هذه العقلانية التي تحاول إدراك “موضوعية” المفاهيم ودقتها تعرضت لانتقادات أعادت فتح النقاش بشأن حدود “العقلانية” و”اللاعقلانية”؛ فإذا كان معيار عقلانية أمر ما هو القياس، وأن العقلانية هي الوضوح والوعي الكامل والواقعية الصارمة، وما يناقض ذلك هو بالضرورة “لاعقلانية” -فقد بدأت مراجعة هذه الافتراضية بشكل جاد في العديد من الحقول الدراسية، عبر بحث علاقة العقلانية بعدة مفاهيم أبرزها: مفهوم الأسطورة؛ فقد اعتبرت العقلانية أن مساحة الأساطير هي مساحة غير واقعية ولاعقلانية، وربطت العقل بالواقع والتجريب والضبط والموضوعية، لكن علم الاجتماع شهد عودة الاهتمام بالأسطورة، باعتبارها أداة لفهم الواقع وتفسيره عبر نسق أفكار جماعي في ثقافة ما، باعتبارها ليست نقيض العقل، بل هي قصص كبرى لها وظيفة تفسيرية هامة ودور محوري في دعم الرابطة الاجتماعية، وأنها تعبير عن اللاوعي الجماعي، هذا اللاوعي الذي هو بدوره ليس مناقضاً للعقلانية، بل هو مساحة من مساحات العقل الإنساني.
وقد بدأ علماء الاجتماع في إعادة اكتشاف الوظائف الاجتماعية المختلفة للأسطورة، بل وذهب بعضهم لاستخدام المفهوم ذاته في مواجهة بعض المسلمات في الدوائر العلمية ذاتها، وتوسيع دلالات مفهوم الأسطورة لتشمل مسلمات العلمانية ذاتها التي استقر الظن طويلاً على أنها يقين علمي. وفايتس في دراسته لمفاهيم العلوم الإنسانية يذهب إلى أن الزعم بأن المفاهيم الاجتماعية والإنسانية يمكن ضبطها مثل المفاهيم العلمية للعلوم الطبيعية هو ذاته “أسطورة”.
وبرز أيضاً الاهتمام بمفهوم المجاز؛ فقد زاد الاهتمام في دوائر النقد الأدبي بمفهوم المجاز؛ باعتباره يمثل مسافة بين الواقع والعقل، وقدرة للعقل على الإضافة والحذف من مكونات المفاهيم، وأن النظر للواقع بشكل موضوعي صارم هو قول غير صحيح، وأن المجاز والاستعارة لا يخلو منهما أغلب المفاهيم الاجتماعية في المعاجم والقواميس. كما أشار البعض إلى تواتر الاستعارة المفاهيمية من حقل لحقل ومن مجال لآخر، سواءً في العلوم أو في الحياة اليومية. وأكدوا أنها تتكرر بشكل مطّرد، وأن المجاز أو الاستعارة ليست فقط أسلوبا بلاغيا، لكنها طريقة تفكير يتم بها إعادة تشكيل الخرائط الذهنية والمفاهيمية، وكسر دوائر الإدراك الجامدة، أي أنها أداة لتطوير المفاهيم والنقلات المعرفية، وأبرز أمثلة ذكروها هو الاستخدام المتكرر في الخطاب السياسي لاستعارة الوطن الأم، أو الدولة الصديقة وغيرها من الأمثلة.
كذلك عاد الاهتمام في مجال علم النفس باللاوعي، بعد أن غلب الاهتمام بالإدراك وقياسه سنوات طويلة، وهو ما انعكس بدوره على نظريات اللغة وعلاقتها بالعقلانية: بين القصد والدافعية وراء المعنى من ناحية، وقضايا الذاتية والموضوعية من ناحية أخرى، وذهب البعض إلى أن القصد لا يعني الذاتية، بل هو جزء من الوعي، وأكدوا أن القصد مرتبط بغائية الفعل الإنساني، وإلا لصار هذا الفعل عبثيًا، وهذه الغائية الذاتية هي جوهر العقلانية والرشد، وأنها لا تتناقض مع الخيال والاستشراف والحدس، بل كلها من العقل، وأكدوا على فكرة “الذاتية المشتركة” بدلاً من الموضوعية الجامدة.
وقد أدت هذه المراجعات إلى دعم مناقشة النظرية الاجتماعية لفكرة العقلانية ودلالاتها، وأنها لا تعني وحدة الرؤى أو الواحدية في تقدير المصلحة وتحديد الخيارات المجتمعية، وأن هذه التعددية في علاقة العقل بالواقع هي التي تخلق عدم اليقين في المجتمع، وتسمح بتعدد الرؤى، وهو جوهر الديمقراطية، بل وأكدوا على الحاجة إلى دراسة اللاعقلانية في النظرية والواقع، وأن الرموز والإشارات وأثرها في اللاوعي أهم بكثير من دراسة القوانين لفهم الوقائع وسلوك الفاعلين، وأنه حين يصعب تحكيم العقلانية الصلبة في الحياة الاجتماعية يزداد دور القيم والرؤى الأيدلوجية في صنع القرار السياسي على حساب الحسابات الصارمة.
ويجد الباحث في كتابات نقاد الحداثة هذا التوجه لعودة الاهتمام باللاوعي، وأنه هو الذي يحقق التجاوز للحظة الآنية، ويفرقون في هذا السياق بين الزمن العقلاني والزمن الاجتماعي، في إشارة لتركيب العقل الاجتماعي وربطه من خلال اللاوعي والذاكرة بين الماضي والحاضر، بافتراض القبول لمنطلق ورؤية الحداثة للتقدم من منظور خطي.
الإخفاق أدى للمراجعة
وأخيراً وليس آخِراً كان من أهم المفاهيم التي شهدت مراجعة في ارتباطها بالعقلانية مفهوما الدين والعلمنة؛ باعتبارهما مفهومين أساسيين في الفكر الغربي، يحمل أولهما دلالات سلبية في فكر الحداثة؛ باعتباره مناقضًا للعقل وقيم الحرية، في حين حظي الثاني بالدلالات الإيجابية؛ باعتباره قرين العقلانية وهو ما جعله مفهومًا محورياً في فكر الاستنارة والحداثة في مباحثها المختلفة وأطروحتها بشأن النظام السياسي والرابطة الاجتماعية، ومساحات العام والخاص، وطبيعة الدولة، وتشكيل المجتمع المدني.
وقد رأى برتراند راسيل مبكراً أن النسق الفلسفي لليبرالية كان هو النسق الديني معكوسًا: ففي مقابل الله كمطلق تمّ وضع الدولة القومية، أي أن نسقا ثقافيا حلّ محل النسق الثقافي ما قبل الحداثي، وهو التغيير الثقافي الذي وصفه بعض علماء الاجتماع بأنه كان بمثابة “إعادة توطين” للعقل الغربي في مساحات مفاهيمية جديدة خالية من الغيب والقيم المطلقة، وتزامن مع هذا الانتقال المفاهيمي تغير دلالات مفهوم العلمانية وإيحاءاته، فبعد أن كان في القرون السابقة قبل الاستنارة سلبيًا ومناقضًا للكنيسة والدين، صار مفهومًا وصفيًا محايدًا إبّان عصور الاستنارة، ثم مع تطور الحداثة تحولت العلمانية لمفهوم إيجابي، بل وعملية العلمنة ذات صورة تحمل مضمونًا حتميًا تاريخيًا.
وقد قدمت النظرية الاجتماعية في الستينيات تعريفاً للدين باعتباره تصورا ذهنيا “مصنوعا اجتماعيًا” وهكذا فإن الدين يُدرس في سياقاته الاجتماعية وتطوره التاريخي، ويخضع للتحليل الاجتماعي باعتباره ظاهرة اجتماعية، لكن بعض رواد علم الاجتماع الديني أدركوا أن الاشتباك مع الدين لا بد أن يستدعي إشكاليات نظرية مرتبطة بعلاقة العلمنة بالعقلانية؛ لذا تحدثوا عن وراثة علم الاجتماع للفلسفة، وتحفّظوا على الدراسة الوضعية المحضة للدين، وأكدوا على أهمية التاريخ في فهم الظاهرة الدينية، وأن فهم الدين يجب أن يتم في إطار علم اجتماع يحتفظ بمنطلقات “إنسانية”، تدرك أن الإنسان له جوانب مطلقة لا يمكن اختزالها في الطبيعة وحدها، وهو إدراك يعكس تردد علم الاجتماع في إطلاق أحكام نسبية بشأن الدين، مع تردده في نفس الوقت في الستينيات في العودة لجدل الإطلاق والنسبية من منظور فلسفي.
وقد بدأت الكتابات الاجتماعية -مع تنامي دور الدين في الحياة الاجتماعية، ثم إخفاقات العلمنة في الكثير من وعودها بتحقيق العدل والحرية، والأزمة النظرية التي بدأ مشروع الاستنارة يواجهها في أهم مفاهيمه النظرية وأبرزها مفهوم الحقوق- بدأت بعض هذه الكتابات تدعو لمراجعة مفهوم العلمانية، بل والحذر في استخدامه؛ لغموضه ولأنه تمّ تحميله بمواقف أيدلوجية وأساطير، بل وذهب البعض إلى حد الدعوة لإسقاطه من الاستخدام بالكلية.
تفاوض على أرضية العقلانية
وكان نمو الحركات الاجتماعية والاحتجاجية الدينية في الثمانينيات والتسعينيات مدعاة لتقوية هذا التيار في النظرية الاجتماعية وعلم الاجتماع الديني والناقد لمسلمات العلمنة ونقض الدين، والذي شكل تحولاً في النظرية كي تتمكن من التعامل مع متغيرات عودة الدين للمجال العام، وعودة القيم إلى المجال السياسي والاقتصادي؛ وهو ما مثَّل نقضاً لمسيرة الحداثة.
ولعل التطور الأحدث في مجال عودة الانشغال بعلاقة الدين بالعقلانية هو عودة هذا الانشغال للفلسفة ذاتها؛ إذ بعد أن تغافلت الفلسفة طويلاً عن هذا الإشكال عاد مرة أخرى ليتم كما يصف دوفريس Hent De Vries “إعادة ترسيم الحدود” بين الدين والعلمانية على أرضية العقلانية ، ومراجعة العلاقة بين الدنيوي والمقدس، والعقل والوحي، والفلسفة وعلوم الدين، وأكد دوفريس على الحاجة لإعادة صياغة تلك المفاهيم، و”التفاوض المفاهيمي” حول حدودها؛ لأنها بالغة الدلالة في أبرز قضايا وانشغالات العقل المعاصر الآن، كقضايا الديمقراطية والعولمة والتسامح والهوية، وتحديات الواقع الافتراضي المتخيل الذي خلقته وسائل الاتصال وشبكة الإنترنت وأثرها على الذات والهوية، كما أن تلك المراجعة لازمة لتطوير النظرية الثقافية.
ويذهب دوفريس إلى أن الواقع المتغير وتداخل الدين مع العلم وتوظيف الحركات الدينية الاجتماعية لأعلى مستويات التقنية كل ذلك جعل التقسيم التقليدي بين العقل والعلمانية من ناحية، والدين واللاعقلانية من ناحية أخرى يتهاوى؛ ولذلك فإن مفاهيم الدين والعولمة والعقلانية تستلزم مراجعة وإعادة بناء لتستوعب تلك التحولات الكبرى، فضلاً عن دخول الدين في مبحث ومساحة المطلق/ المتجاوز/ المقدس التي تشغل الفلاسفة، سواءً في قبولهم بها أو محاولتهم استبدال مضمونها بمضمون “إنساني”، لا “ديني”.
مراجعات أكثر ترتيبا
وختاماً فإن العولمة التي نُظر إليها على أنها تمثل تحدياً لقيم الدين بنشر ثقافات عديدة تنحو للنسبية.. هذه العولمة هي أيضاً التي أتاحت للدين توظيف الأدوات التقنية، وشهدت انفتاح الدين ذاته على الفلسفة والعلوم؛ لأن الرؤية الدينية لا تستطيع التواصل مع هذا الواقع دون أن تشتبك معه بالتفاعل الإيجابي، وعلاقة العقلانية بالدين والعلمنة؛ لذا صارت موضع مراجعات لجعلها أكثر تركيبًا من الرؤية البسيطة الثنائية المتنافرة التي سادت طويلا.
إننا نشهد صعوداً لتصور للعقل الإنساني، يتأسس على أنه مركب ومتجاوز للمادة ويستعصي على المعيارية والضبط، سواء أكان مصدر هذا التجاوز مستويات العقل الداخلية (وعي/ لا وعي) أو قدرة العقل على التجريد والإبداع والإضافة (المجاز/ الأسطورة)، أو تفاعل العقل مع المطلق والمقدس (الدين).
ولعل هذه الرؤية المتجاوزة للعقل الإنساني هي التي نحتاج في الفكر الإسلامي الآن للنظر والاجتهاد فيها؛ لإعادة بناء تصورات عميقة لإشكالية حقيقية تواجه الإنسان ومستقبله على هذا الكوكب.. تصورات تنطلق من الربط بين العقل والوحي والسنن، وتخاطب العالمين.