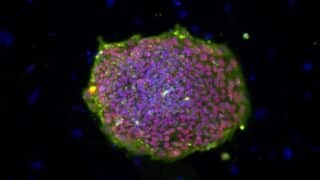تعمدت وضع كلمة الافتراس في عنوان هذا المقال، وقلت “حتى لا تفترسنا الحياة” لأن هذا هو ما تفعله بنا الحياة فكثيرا ما تفترسنا قبل أن تجهز علينا وإن بقينا على قيد الحياة، والافتراس يحدث عادة من كائن متوحش يتسلل بمهارة فائقة ليتمكن من الفريسة الغافلة.
وإذا وقفنا مع أنفسنا بأمانة تامة لتأكدنا أننا جميعا نتعرض للافتراس من الحياة من آن لآخر، وأن القلة القليلة منا هي التي تتنبه لهذا الافتراس، وتناضل بحزم متنام وإرادة حقيقية لتطرد عن نفسها صفات الفريسة، ولتزرع مكانها الجدارة بأنها إنسان كرمه الرحمن عز وجل، لا يليق به أن يسمح لأحد، أو لتفاصيل الحياة وإغراءاتها المتنوعة وانتهاكاتها المتواصلة أن تفترسه لتلتهم عقله وروحه ثم تلقي بالباقي في عرض الطريق.
أدوات القبطان الماهر
وحتى لا تفترسنا الحياة، نقول إن حياة كل واحد منا أشبه بالسفينة التي تبحر في البحار والمحيطات، ولا بد أن يكون لدى القبطان الخرائط الكافية ليبحر بكفاءة ليس في أوقات الأمان فقط، فهي لا تبرز مهارة القبطان، فالأمور تسير على ما يرام وربما أغرته الطمأنينة الزائدة إلى الاستهانة بالاستعداد للأخطار التي لا ينجو منها أي بحار، مما يفقده وسائله الدفاعية ويجعله يضعف نفسه بأيديه.
والواقع يؤكد لنا أن ما لا يزيد ينقص، وأننا إذا لم ننتبه دائما لزيادة قوانا الدفاعية ومراقبة حصوننا النفسية والذهنية فإننا نباغت بهجوم يلقينا أرضًا، ويفقدنا ميزة الثبات عند مواجهة الأزمات وهو أمر لا غنى عنه للانتصار في كل المعارك.
تعلمنا أن الحياة سلسلة من المعارك المتصلة تتخللها استراحات للمحاربين، ينعمون فيها بالاحتفال بثمار انتصاراتهم بتعقل وحكمة، ولا يسمحون للغرور بالتسلل إليهم ولا يبالغون في الحياة الناعمة؛ لأنها تغري المحارب بإلقاء أسلحته متوهما أن المعارك انتهت، وأن عليه مواصلة الاحتفالات ليلا ونهارا بما أنجزه.
ومن يفكر بهذا الأسلوب يهزم نفسه ويتعذب وحده ولا يحق له لوم غيره، كما يظلم نفسه من يواصل المعارك ليلا ونهارًا ويشيع حالة الاستنفار القصوى، مما يبدد طاقاته بدون جدوى ويعرضه للإنهاك مما يلقي به إلى الهزائم التي لا يدرك أنه تسبب فيها بحرمان نفسه من استراحة المحارب الذكية بلا إفراط ولا تفريط.
والمحارب الذكي عندما يقود سفينته يستعد نفسيا لإمكانية تعرضه للمخاطر، فالمؤكد أن الإنسان المفاجأ نصف مهزوم.
وهذا لا يعني بالطبع انتظار وقوع المحن؛ لأن الاستغراق في انتظار الأزمات يسلب من القبطان الذكي الفرح، والاستمتاع بالإبحار وبجمال ومتعة التدفق الجميل لسفينته، وبالتأمل الواعي والعذب لدوره في قيادة السفينة ونجاحه في ذلك –بعد الاستعانة بالرحمن بالطبع- مما يضاعف بصورة رائعة من إمكاناته البشرية المحدودة.
والقبطان الذكي هو الذي يكون شعاره في الإبحار الحديث الشريف: (استعن بالله ولا تعجز)، ويثق تماما بالقول الرائع أن استعانة المخلوق بالمخلوق أشبه باستعانة المسجون بالمسجون، وهذا لا يتعارض إطلاقا مع الأخذ بالأسباب؛ أي أن يسعى الإنسان بمثابرة (مطمئنة) إلى امتلاك أفضل المهارات في مجاله، ولا بأس من استشارة ذوي الخبرة، والاستفادة من تجارب غيره، ثم يتنبه إلى أهمية ألا يتوكل إلا على الخالق، فكما قيل عن حق: ترك الأخذ بالأسباب معصية والاعتماد عليها شرك.
فنون المواجهة
والقبطان الماهر هو الذي يواجه الشدائد بالمسارعة إلى التهدئة الداخلية، والتشبث بالاستعانة بالرحمن ويتذكر أنه “عابر سبيل” في الحياة، وبأن أمره موكول إلى الرحمن وحده وبأن أي خسائر دنيوية قد يتعرض لها يمكن تعويضها بمشيئة الخالق ولو بعد بذل مجهود مضاعف ومضي بعض الوقت طال أو قصر.
أما الخسائر الدينية فقد يصعب عليه تعويضها أو لا يدرك حدوثها وسط انهماكه في الشئون الدنيوية وتفاصيلها المتنوعة.
يناضل القبطان الذكي لزيادة مكاسبه الدينية بدلا من أن يخسر بعضها ويبدد عمره في محاولة تعويضها، وما كان أغناه عن ذلك لو تذكر أهمية الثبات في وجه الشدائد، فالقبطان الماهر لا يسمح للجزع بأن يفترسه ويلقى به إلى تصرفات متسرعة تجعل سفينته تتحطم على الصخور أو تغرق في البحار الهائجة.
بل يسارع بطمأنة نفسه بأن أمر المؤمن كله خير، ثم يبتسم ويهدئ نفسه، وسبحان الرحمن الذي جعل الابتسامة تفرز هرمونات تهدئ الإنسان، وقد أثبت العلم أنه حتى تصنع الإنسان للابتسام يحدث نفس المفعول.
وعندما نتأمل في حياتنا اليومية نجد الكثيرين ممن يظلمون أنفسهم بالاستسلام للمخاوف عند حدوث ما يكرهون، وتنمية الشعور بالرثاء للنفس والعيش في سجن الضحية، ويتنفسون المرارات المتتالية، ويسمحون باختلال قيادة سفنهم الخاصة وتسربها من أيديهم.
عندما يتنازل القبطان عن قيادة سفينته؛ فإنه لا يفقد فقط هيبته ومكانته وأحيانا وظيفته، ولكنه يفقد أيضا ثقته بنفسه، ويتحول إلى فريسة يسهل على أصغر كائن النيل منها.
وإن من الذكاء الإكثار من الحمد الحقيقي للتمتع بالنهوض من الأزمة وتنفس الفرح الناعم به وطرد الألم بعد الاستفادة من خبراته ولفظ أوجاعه.
وبذا يتحول الألم إلى مصدر للخبرة وهو ما يعده؛ ليكون منبعا للمتعة المستقبلية، سواء استفدنا نحن من هذه التجربة المؤلمة ولم نكررها، أو قمنا بإهدائها لمن نحب وساهمنا في تقليل مساحة الألم في الإبحار الدنيوي، وبذا تتضاعف متعتنا في الحياة.
انتبه للثقوب!
والقبطان الماهر هو وحده الذي لا يكتفي بالإبحار الآمن، ولكنه يعود لخرائطه؛ أي أهدافه الحقيقية من الإبحار من آن لآخر؛ ليتأكد أنه يسير في الطريق الصحيح، وأنه لم ينجرف إلى طريق خاطئ بدعوى البحث عن الأمان، أو للابتعاد عن بعض الصعاب.
وهذا ما يحدث كثيرا مع الأسف البالغ، حيث نؤذي أنفسنا (بتزيين) التراجع عن أحلامنا وطموحاتنا والسماح بتزييفها، فليس من الذكاء مواصلة الإبحار دون التأكد من أنه يقودنا إلى أهدافنا الحقيقية التي أبحرنا من أجلها.
والمؤلم أن معظم الناس يتجاهلون هذه الحقيقة البسيطة، ويسمحون لتفاصيل الحياة اليومية بافتراسهم، بل وتغيير مساراتهم في الإبحار، ويتحولون إلى أدوات لتحقيق رغبات غيرهم، ويخدعون أنفسهم بمحاولة تبرير ذلك بأن الواقع كان أكبر من إصرارهم، وأن الظروف دفعتهم إلى تغيير مساراتهم، ويقومون بدفن المرارة التي اكتسحت أحلامهم بالاستغراق إما في التهام الطعام أو أية متع دنيوية عابرة، ولا يعلمون أنهم يسرقون أنفسهم.
وأن القبطان الذكي وحده هو الذي يتنبه إلى أية ثقوب في سفينته مبكرا، ويسارع بثقة وبمثابرة إلى إغلاق هذه الثقوب؛ للانتصار واكتشاف الأسباب التي أدت إليها؛ حتى لا تتكرر في أماكن أخرى، فيهدر الطاقة والجهد والوقت في إصلاحها ويتأخر في إبحاره، وقد تتكاثر عليه الثقوب فييأس من إصلاحها ويتغافل عن الغرق المؤكد بالانهماك في التفاصيل اليومية للحياة على السفينة.
القبطان الماهر يفرح بصدق لنجاح الآخرين، فيضاعف من حيويته وحماسه للوصول إلى شاطئه الخاص، ويلفظ الانغماس في الغيرة والحسد، ومحاولة النيل من أي نجاح، وإلصاق التهم به مما يسرق وقوده الداخلي بعد بعثرته عليهم.
والأذكى ادخار كل طاقاته لتحسين نفسه على كل المستويات، وذلك ينجو من الغرق المحتم، وهو المصير المؤكد لمن يراقب نجاح غيره بحسرة بدلا من التعلم منه، وأن يقول لنفسه: “كلما وصل بحار إلى شاطئ النجاة تضاعفت فرصي أنا أيضا فرزق ربي واسع للغاية، ويهنأ بذلك ويواصل انطلاقاته نحو النجاح بخطى أكثر ثباتا.
وقفة مع النفس
حتى لا تفترسنا الحياة علينا أن نقوم بإهداء أنفسنا بضعة دقائق يومية ننفرد مع النفس لنخاطبها بود وبحب وباحترام، ونتنفس بعمق بالغ المتعة أننا ما زلنا على قيد الحياة، وأن أمامنا فرصا متنامية لصنع أفضل حياة ممكنة لنا، ولكل من نحب، وأننا في الطريق الصحيح، وإذا أخطأنا فلنترفق بأنفسنا، فإن لم نرحم أنفسنا فهل نتوقع من الآخرين أن يعاملوننا بأفضل مما نعامل أنفسنا.
ليقل كل واحد منا لنفسه يوميا وهو مسترخٍ ومغمض العينين: أنا أحبني بعمق، وأنا جيد وأتحسن، ولقد كرمني ربي، ولن أسمح بإهانة نفسي، سواء بترديد الكلام السيئ لها، أو قبول ما ينتقص ولو بمقدار ذرة من احترامي لها، وسأهدي الآخرين البشاشة والسماحة، ليس لأنهم يستحقونها بأفعالهم، ولكن لأن ربي خلقهم وكرمهم، فكيف أسمح لنفسي بإهانة مخلوق كرمه ربي؟.
ولماذا أبدد ولو ثانية من عمري في الالتفات للصغار من البشر ألا يكفيهم عذابهم لكونهم صغارا؟!.
وهذا لا يتنافى بالطبع مع إتقان مهارات الردع عند اللزوم، ثم تناسيهم بعد ذلك، فالعمر غال ومهما طال فهو قصير، ومن الذكاء ادخاره لما يفيدنا ومن نحب، والبخل بأي ثانية منه على من (يتعمدون) مضايقتنا.
حتى لا تفترسنا الحياة أدعو أن نتنفس –جميعا- الاعتزاز بالعبودية للرحمن فقط فلا نسمح لأي رغبة حتى لو كانت مشروعة، ولا لأي مخلوق بأن يبعدنا عن الغايات الحقيقية في إبحارنا في الحياة، وهي أن نفوز بحياة دنيوية ناجحة ومطمئنة وسعيدة؛ لنكون المعبر (الرائع) للمستقر الدائم في الفردوس الأعلى.
وبذا فقط لا يمكن للحياة أن تفترسنا، ولا لكل بحار ومحيطات الكون أن تنال منا.
نجلاء محفوظ – كاتبة وفنانة تشكيلية مصرية