في أغسطس عام 1954 صدر بالولايات المتحدة كتابًا يحمل عنوانا لافتا هو (الطريق إلى مكة) كتبه ليوبولد فايس أو محمد أسد ، سرد من خلاله قصة تحوله عن اليهودية واعتناقه الإسلام.
وفور صدوره تناولته الصحف بالنقد والتفنيد فقد كان برهانًا على أن الإسلام بات يجتذب منذ أوائل القرن أعدادا متزايدة من الشباب الأوربي الباحث عن مخرج من أزمته الروحية والفكرية، ومنهم: عبد الواحد يحيى وعبد الكريم جرمانوس، وليوبولد فايس (محمد أسد) الذي نعرض فيما يلي لرحلته في اكتشاف الإسلام والتعرف على جوهره.
ولد محمد أسد في مطلع القرن الماضي (1900م) في مدينة ليمبورغ الواقعة ضمن إمبراطورية النمسا المجر، لأسرة ذات جذور يهودية مهاجرة، تطلع والده أن يجعل منه عالما رياضيا، لكن العلوم الرياضية والطبيعية كانت تجلب له الملل والسأم فانصرف عنها إلى الفنون والآداب ولم يستطع تحقيق رغبة والده، أما والدته فكانت تطمح أن تراه حاخاما دينيا مثل جده لكنه خيب أملها بالانصراف عن دراسة العلوم الدينية، وفي عام 1914 نشبت الحرب العالمية الأولى وارتحلت أسرته إلى النمسا، وهناك هرب من المدرسة والتحق بالجيش النمساوي بعد أن انتحل اسما مزورا، ويبدو أن بنيته الجسدية الضخمة خدعت رجال الجيش، وسرعان ما تعقب والده أثره، وأعاده إلى المدرسة، وعقب انتهاء الحرب التحق بجامعة فيينا ودرس تاريخ الفنون والفلسفة، ثم عمل مراسلا صحفيا في عدة مدن شرقية كالقدس والقاهرة وبغداد وحلب وأفغانستان، وهناك أتيحت له الفرصة للاطلاع المباشر على تعاليم الإسلام الذي اعتنقه عام 1926.
في العام التالي مباشرة أدى محمد أسد مناسك الحج ومكث بعدها بضع سنين في الحجاز خبر فيها حياة البادية، ومنها اتجه إلى القارة الهندية وأقام بها بعض الوقت، وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية شهد تأسيس دولة باكستان ونال جنسية الدولة الوليدة وأصبح مندوبها لدى الأمم المتحدة، وفي السنوات الأخيرة من حياته تفرغ للكتابة للتأليف إلى أن توفي بإسبانيا عام 1992.
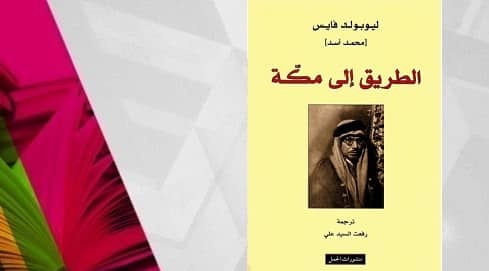
ترجمت بعض مؤلفاته إلى العربية وحققت له شهرة ومنها: “الإسلام على مفترق الطرق”(1932) و”الطريق إلى مكة” (1954)، ولمحمد أسد إنجازان معرفيان كبيران:
الأول: ترجمة وشرح الجزء الأول من صحيح البخاري الذي نشره عام 1938 في بداية اعتناقه للإسلام.
والثاني: ترجمته لمعاني القرآن المعروفة باسم (رسالة القرآن)، واستغرقت سنوات من الجهد إلى أن صدرت بتمامها عام 1980 في قرابة ألف صفحة، ويعترف محمد أسد بأنه يدين بالفضل فيها للشيخ محمد عبده في (رسالة التوحيد) فقد قلده في منهجه وكان عقلانيًا ولم يستنكف أن ينبه إلى الإسرائيليات التي توجد في كتب التفسير، وقد استعان كذلك بثقافته الأوروبية في التفسير ولم يقطع معها،[1]. ورغم هذا فإن ترجمته لم يتم تعريبها وواجها بعض الدارسين بانتقادات واسعة بعضها يتعلق بترجمة بعض المصطلحات القرآنية إلى اللغة الإنجليزية كإيثاره لفظ GOD” ” على “الله”، وبعضها الآخر حول تأكيده على بشرية الأنبياء وترجيحه عدم عصمتهم، وميله لتأويل المعجزات القرآنية تأويلا ماديًا[2].
التجربة الإيمانية
يمثل اعتناق الإسلام المنعطف الأهم في حياة محمد أسد الفكرية والإيمانية، وقد سرد في كتابه (الطريق إلى الإسلام) الدواعي التي قادته إلى ذلك، ويمكن أن نستخلص مما ذكره أن هناك عاملان دفعاه إلى ذلك:
العامل الأول: ويتعلق بطبيعة العقيدة اليهودية، وكان أسد قد درس في صباه العلوم الدينية اليهودية على يد بعض رجال الدين، ولكن هذه الدراسات المبكرة كما يقول أدت إلى عكس المقصود منها فأبعدته عن دين الآباء والأجداد بدلا من أن تقربه منها، وحول هذا المعنى يقول: كنت أوافق على مبدأ الصلاح الخلقي الذي تنشده اليهودية ويدعو إليه أنبياء اليهود، ولكن كان يبدو لي أن الله في العهد القديم والتلمود كان مهتما بالطقوس أكثر مما ينبغي، ومنشغل البال بمصائر أمة واحدة فقط هي العبرانيين، بل “إن تكوين العهد القديم نفسه كتاريخ لأحفاد إبراهيم كان يميل أن يجعل الله يبدو لا كخالق الناس أجمعين وربهم، ولكن كإله قبلي يكيف الخلق كله حسب حاجات شعب الله المختار، يكافئهم بالفتوح إذا كانوا صالحين ويعذبهم على أيدي الكفرة كلما انحرفوا عن الطريق”[3]
العامل الثاني: ويتمثل في الفراغ الروحي الذي شهدته القارة الأوروبية في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، فقد خلخلت وقائعها ومذابحها القيم الأخلاقية والروحية التي ألفتها أوروبا عبر قرون، وكان واضحًا أن قيما بديلة ستحل محلها، وبالفعل أخذ العلم يحل محل الدين والأخلاق، وظهر علم “التحليل النفسي” وكان يؤمل أن يقود إلى فهم أفضل للإنسان ودوافعه وسلوكه، ويذكر أسد أن تأثير التحليل النفسي كان “كالخمر القوية” بالنسبة له ولأقرانه وأنه كان مشدوها إلى مناقشات رواده، لكن ما لبث أن أعتراه القلق من “تكبره العقلي الذي كان يحاول أن يصغر أعاجيب النفس الإنسانية إلى سلسلة من الإرجاعات العصبية التناسلية، وكانت النتائج الفلسفية التي توصل إليها مؤسسه [فرويد] تبدو خفيفة ومبسطة بأكثر مما ينبغي، بحيث لا يمكن وضعها بجوار أي من الحقائق النهائية، ولا ريب أنها لم تكن تدل على أي طريق جديد إلى الحياة الخيرة”[4]. وهكذا كان عليه أن يجد طريقا ثالثا بعيدا عن اليهودية والعلم ولم يكن سوى الإسلام الذي تعرف عليه في الشرق.
ثنائية المادة والروح
حين أعلن محمد أسد إسلامه في عام 1926 لم يكن يرى في الإسلام سوى دين قادر على أن ينتشله من أزمته الروحية، لكن لم تكد تمضي سنوات معدودات حتى ارتسمت أمام ناظريه -كما يقول- صورة تشبه بناء هندسيا كاملا، تتمم عناصره بعضها بطريقه متناسقة لا ينقصه شيء ولا يعوزه شيء، إتزان وسكينة يضفيان على المرء شعورا بأن “كل ما في الإسلام هو في محله”، الروح في محله والجسد في محله، “فالإنسان في الإسلام غير مجبر على أن يرفض الدنيا، وليس ثمة حاجة إلى تقشف يفتح عليه بابا سريا إلى التطهير الروحي. ذلك أمر غريب كل الغرابة عن الإسلام، فالإسلام ليس عقيدة صوفية ولا هو فلسفة، ولكنه نهج من الحياة حسب قوانين الطبيعة التي سنها الله لخلقه، وما عمله الأسمى سوى التوفيق التام بين الوجهتين الروحية والمادية في الحياة الإنسانية. وإنك لترى هاتين الوجهتين في تعاليم الإسلام تتفقان في أنهما لا تدعان تناقضا أساسيا بين حياة الإنسان الجسدية وحياته الروحية فحسب، ولكن تلازمهما هذا، وعدم افتراقهما فعلا، أمر يؤكده الإسلام؛ إذ يراه الأساس الطبيعي للحياة”.
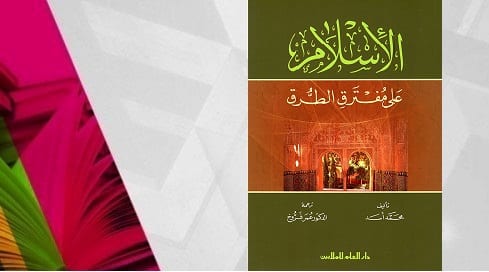
واستنادا إلى هذا يصف محمد أسد الإسلام بأنه “أعظم دين مؤكد لحياة الإنسان في تاريخ الإنسان”، وأنه من بين سائر النظم الدينية يعلن “أن الكمال الفردي ممكن في الحياة الدنيا ولا يؤجل هذا الكمال إلى ما بعد إماتة الشهوات (الجسدية)، ولا هو يعدنا بسلسلة متلاحقة الحلقات من تناسخ الأرواح على مراتب متدرجة، كما هي الحال في الهندوكية، ولا هو يوافق البوذية التي تقول بأن الكمال والنجاة لا يتمان إلا بعد انعدام النفس الجزئية وانفصام علاقاتها الشعورية من العالم، كلا إن الإسلام يؤكد في إعلانه أن الإنسان يستطيع بلوغ الكمال في حياته الدنيا الفردية، وذلك بأن يستفيد استفادة تامة من وجوه الإمكان الدنيوي في حياته”[5].
ومعنى هذا أن الإسلام وحده، كما يستخلص أسد، الذي “يتيح للإنسان أن يتمتع بحياته الدنيا إلى أقصى حد، من غير أن يضيع اتجاهه الروحي دقيقة واحدة. وهذا يختلف كثيرا عن وجهة النظر المسيحية حيث يتعثر الإنسان في الخطيئة الموروثة التي ارتكبها آدم وحواء، وتعد الحياة كلها واديا مظلما للاحزان، وعلى هذا ليس في الإسلام أي ذكر لحاجة الإنسان إلى (الخلاص) طالما ليست هناك أي خطيئة موروثة تقف بين الإنسان ومصيره.
وبالجملة، فإن محمد أسد هو واحد من المفكرين الغربيين الذين أسلموا واستطاعوا الوصول إلى لب هذا الدين وحقيقته الذي يؤلف في انسجام بين الثنائيات التي يتوهم تعارضها، الدنيا والآخرة والمادة والروح.
[1] عبد المنعم الحفني، موسوعة الفلسفة والفلاسفة، القاهرة: مكتبة مدبولي، د/ت، ج2،ص 1239.
[2] فصل الدكتور إبراهيم عوض هذه الانتقادات في بحث شامل على موقع شبكة تفسير.
https://vb.tafsir.net/tafsir4505/
[3] محمد أسد، الطريق إلى الإسلام، ترجمة: عفيف البعلبكي، الرياض، مكتبة العبيكان، ط9، 1997، ص68.
[4] محمد أسد، نفس المرجع السابق، ص 71-72.
[5] عماد الدين خليل، قراءة في بعض كتابات المفكر النمساوي ليوبولد فايس (محمد أسد)،إسلامية المعرفة، مج 15، ع 60، 2010، ص 180-181.

