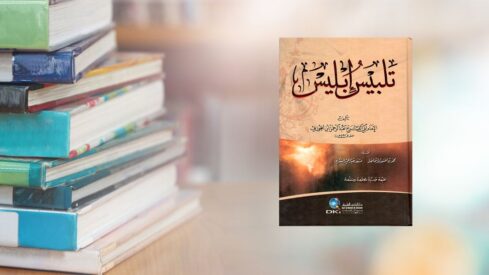تلبيس إبليس ” عنوان كتاب قيّم لابن الجوزي، والذي سبقه إلى فكرة الكتاب الإمام أبو حامد الغزالي – رحمهما الله – الذي عزم على تأليف كتاب يحمل العنوان ذاته، من بعد أن رأى ما يستدعي ذلك «وانتشار تلبيسات إبليس في البلاد والعباد؛ لا سيما في المذاهب والاعتقادات، حتى لم يبق من الخيرات إلا رسمها، كل ذلك إذعاناً لتلبيسات الشيطان ومكايده». ثم جاء ابن الجوزي وأفاض وفصّل في هذا الأمر ووضع فصولاً كثيرة من تلبيسات إبليس على بني آدم من العلماء والسلاطين والعبّاد والمتدينين والزهّاد وصولاً إلى عوام الناس.
التلبيس كما في لسان العرب، هو اختلاط الأمر. نقول: لبس عليه الأمر، أي إذا خلطه عليه حتى لا يعرف جهته، فالتلبيس لا يختلف عن التدليس. وقد شرح ابن الجوزي – رحمه الله – في كتابه تلبيس إبليس معنى الكلمة، فقال: «التلبيس إظهار الباطل في صورة الحق».
لاحظ أن إبليس وأتباعه لا يملون ولا يكلون في خلط الحق بالباطل، ومحاولة تعطيل أو تأجيل قوافل الخير والحق من المسير. ففي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: «إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك فعصاه فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل وتقتل فتُنكح المرأة ويُقسم المال؟ فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقاً على الله أن يدخله الجنة، ومن قُتل كان حقاً على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقاً على الله أن يدخله الجنة، وإن وَقَصَتْهُ دابته كان حقاً على الله أن يدخله الجنة» (1).
إذن إظهار الباطل على أنه هو الحق، هو عمل كل مدلس أو غارق في التلبيس لأجل مكاسب دنيوية محددة، قد يستمتع بها حيناً من الدهر، لكنه لن يستمر طويلا، ولا ريب في ذلك. والتلبيس قد يكون على يد مشتغلين بالدين، أو مفكرين أو مثقفين أو من على شاكلتهم. كلٌ يعمل في مجاله لتحقيق أهدافه أو أهداف وغايات غيره. والقرآن أشار إلى علماء يهود، كمثال في التلبيس والتدليس، وهم يحاولون إخفاء حقائق الدين الجديد وهو ينتشر بالمدينة المنورة، فكشفهم الله.
لا يهمنا أحد من أولئك المدلسين من الأمم الأخرى، فلهم دينهم ولنا دين. يكفي أن نتأمل القرآن وهو يتحدث عنهم، لنتعظ ونتعلم مآلات الانغماس في التلبيس والتدليس. ذلك أن ما يحدث في السنوات العشر الأخيرة في عالمنا العربي المسلم، هو ظهور العشرات، بل ربما المئات من المدلسين، على شكل علماء دين أو – إن صح التعبير – مشتغلين بالدين، ومثلهم كثير على شكل نخب مثقفة أو مفكرة وغيرهم، وقد ألبسوا على الناس دينهم ومبادئهم وقيمهم، وبثوا في نفوسهم كثيرا من الشكوك، حتى صاروا من أسباب الاضطرابات الفكرية والدينية عند كثير من العامة.
مجتمعاتنا ولأنها عاطفية، يتكاثر وينتشر المدلسون في أرجائها، يُلبسون الحق بالباطل بصور ربما أذكى وأكثر براعة من تلبيسات إبليس نفسه، فننخدع بأشكالهم وهيئاتهم حيناً من الزمن، كما قال تعالى { وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم} (المنافقون: 4). ننخدع بجمال ووسامة صورهم، وفصاحة ألسنتهم، وتأثيرهم على السامعين – هكذا يصفهم القرآن – وما هم في حقيقة الأمر، كما في التعريف القرآني لهم، سوى {خُشب مسنّدة} (المنافقون : 4) أي قطع أخشاب مفرغة من الداخل متآكلة، مسنودة إلى بعضها البعض، لا حياة فيها، كما هم هؤلاء المدلسين أو المنافقين، الذين يستندون إلى إظهار الإيمان للناس، حماية لأنفسهم وتغطية ما في أجوافهم من علم لا ينفع، وأهواء لا تتوافق مع الحق وأهله.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان عبد الله بن أُبَي – رأس وزعيم المنافقين بالمدينة – وسيماً جسيماً صحيحاً صبيحاً ذلق اللسان. فإذا قال، سمع النبي – ﷺ – مقالته. وصفه الله بتمام الصورة وحسن الإبانة. (2)
لكنه مع ذلك كان رأس النفاق في المدينة، شديد التأثير في الحالة المعنوية للمسلمين، وصاحب مهارة في تفريق الصفوف، بل نجح مرات عديدة في خلخلة المجتمع المسلم الناشئ يومها. لكن الله حفظ ذلك المجتمع باستمرار نزول الوحي ووجود النبي الكريم، وتعاضد الصحابة مع بعضهم البعض خشية الوقوع في حبائله وفتنه.
خلاصة الحديث أن الحكمة تبدو لنا الآن جلية واضحة من نزول سورة كاملة في القرآن خاصة بالمنافقين، تصف وتبين دواخلهم وطبائعهم، من أجل أن يكون المجتمع المسلم في كل زمان ومكان على بينة من أمر هذه الفئة التي لا تندثر، والمستمرة باستمرار الحق في صراعه مع الباطل، والذي إن تعاظم وتجبر وتعملق هنا أو هناك، في هذا الزمن أو أزمان قادمة، إلا أنه لا شك منهزم هالك {وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا} (الإسراء :81). فتلك هي قوانين ونواميس الكون لا تتبدل ولا تتغير { سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا } (الأحزاب : 62).