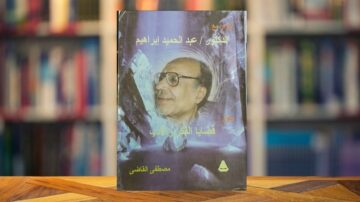الدكتور عبد الحميد إبراهيم (1935- 2012م) أكاديمي وناقد ومفكر مصري، له إسهامات عديدة في مجال الأدب والنقد والفكر، ومشروعه الأكبر يتجلى في موسوعته “الوسطية العربية” التي حاول فيها أن يقدم نظرية، أو بالأدق حسب تعبيره: مذهبًا في الأدب، نابع من بيئتنا الفكرية وذاتيتنا الحضارية.
ود. عبد الحميد إبراهيم هو العميد الأسبق لكلية الدراسات العربية بجامعة المنيا، عمِل مدرسًا للأدب العربي لمدة عامين في كلية الدراسات الأفريقية والشرقية بجامعة لندن، وأسس مركز المخطوطات العربية بجامعة المنيا، وأسهم في تأسيس كلية الآداب بالمنيا وكلية دار العلوم بالمنيا وكلية الآداب بصنعاء، وقسم اللغة العربية بجامعة سوكوتو بنيجيريا، وكان من أوائل المؤسسين لمؤتمر أدباء مصر. وترأس وأشرف على “مهرجان طه حسين”، الذي تقيمه جامعة المنيا لأكثر من ثلاثة عشر عامًا، وكان أول من فاز بجائزة “رجاء النقاش للنقد الأدبي” في دورتها الأولى.
قدّم د. عبد الحميد إبراهيم عبر مسيرته العلمية الرائدة المئات من الكتب والأبحاث والمقالات، ومن أهم كتبه: موسوعة الوسطية العربية- مذهب وتطبيق. نقاد الحداثة وموت القارئ. القصة اليمنية المعاصرة. الأدب المقارن من منظور الأدب العربي- مقدمة وتطبيق.
وقد اخترتُ أن أطلّ على بعض آراء د. عبد الحميد إبراهيم في النقد والأدب والفكر، من خلال مختارات من الكتاب الضخم (680 صفحة) الذي ضم حوارات عديدة مع الراحل الكبير، أجراها معه نخبة من الأدباء والصحفيين في مصر والعالم العربي، وجمعها الأستاذ مصطفى القاضي (ط الهيئة العامة للكتاب، عام 2005م).. فاخترت بعض الأسئلة وإجاباتها، بما يدور حول قضية الوسطية بالأساس، وبعض الآراء المهمة لناقدنا ومفكرنا الكبير.. ولم أتصرف في العبارة إلا في صياغة بعض الأسئلة باختصار يسير.
نريد أن نتعرف على بدايات مشروعكم “الوسطية العربية”.
مشروع الوسطية بدأ معي منذ أن كنت طالبًا في الجامعة، وبالتحديد عندما درسنا المذاهب الأدبية المتعددة على يد رائد الأدب المقارن في العالم العربي الدكتور محمد غنيمي هلال، وأحسست من كتاباته، وخاصة عن الرومانتيكية، أنه ينقل عن الغرب فلسفته وأسماء أساتذته وكذلك تطبيقاته في المذهب، ووجدت أننا عالة عليهم؛ فبدأت أفكر في البحث عن مذهب أدبي خالص، خاص بنا، واستشرت في ذلك الوقت صديقي الأديب الكبير الأستاذ يحيى حقي، وكان رئيسًا لتحرير مجلة “المجلة” آنذاك”، وقلت له إنني أبحث عن مذهب أدبي عربي أصيل، فسخر من الفكرة، ولم أيأس؛ فشرعت في البحث عن نظرية أسميتها في البداية “عبقرية الصحراء”، ومع كثرة القراءات تكشفت لي فكرة الوسطية، فعدلت عن العنوان الأول إلى الآخر وهو “الوسطية العربية”.
“الوسطية العربية” تختلف عن “وسطية أرسطو” و”تعادلية الحكيم”
وقد وجدت أن بذور الوسطية موجودة في الجزيرة العربية قبل الإسلام؛ لأن المناخ العربي يقدم الوجهين المتقابلين في الحر في القيلولة والبرودة في الليل، ويوجد تطرف في الحالتين يعيشهما الإنسان، فجاء الإسلام بعد ذلك وأضاف فكرة التوازن بين الحالتين، وأنهى فكرة الجاهلية، على أساس أنها حمق وغضب وتطرف في الأهواء، ودعا الإسلام إلى ضبط الإرادة والقوة. وبدأ المفسرون، كما عند الطبري، يفسرون الآية {وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} على أساس أنها في العدل، ثم يفسر الطبري العدل بمعنى التوازن؛ وأشار إلى مثل عِدْلي البعير- أي الحملين على جانبي ظهر البعير- كلّ حمل يتوازن مع الآخر، ولو حدث أن أحدهما أثقل من الآخر أو أخف لضاع التوازن.

فالإسلام نقل الوسطية من المناخ أو الرتوش البسيطة إلى التاريخ، وأعطاها الضبط والإرادة، ثم جعلها مذهبًا للأمة العربية والإسلامية بعد ذلك؛ فنقلها من المحلية إلى العالمية، فأصبحت تؤتي ثمارها. وقد وضحت في الجزء الأول من الموسوعة الفرق بين وسطية أرسطو والوسطية الإسلامية، وهذا أول تفريق يقوم به كاتب عربي؛ لأننا نقرأ في الكتب القديمة فنجد اختلاطًا بين المفهومين كما في كتاب (تهذيب الأخلاق) لابن مسكويه، وكذا في كتابات الذين جاءوا بعده حتى معاصرينا.
أرفض القول بـ”موت المؤلف” وأدعو إلى موت القارئ المستبد!
لذلك قدمتُ فروقًا كثيرة وطويلة، وهذا إنجاز مهم في حد ذاته؛ فكلمة الوسطية إن أردنا أن نحددها هي: تراث الأمة الديني الشرقي النابع من بيئتها ومسيرتها. هذا ما أوضحته في دراساتي التطبيقية لكي أؤكد وأؤصل لهذا الأمر.
ما أهم ملامح مذهب الوسطية؟
وصفتُ الوسطية بأنها “مذهب”، ولم أقل إنها “نظرية”؛ وذلك لأنها ليست “نظرية” تقوم على العقل والاستنتاج وبناء المقدمات المنطقية، بل هي “مذهب” يقوم على السلوك والعمل، ويعتمد على مصادر تختلف عن المصادر الفلسفية. وأهم ملامح هذا المذهب: 1) الجمع بين الشيئين. 2) التوازن بين الشيئين. 3) الحركة بين الشيئين. 4) السكينة.
وهذا المذهب لم أخترعه، بل قمت فقط بدور المستكشف لأجزائه المبعثرة في كتب التراث؛ وكان أهم ملمح هو: عنصر الحركة؛ فحين نزل القرآن الكريم لفت العربي إلى حركة الظواهر الطبيعية حوله، وإلى هذا التطارد بين الليل والنهار، والظل والشمس، وإلى حركة الأرض تكون هامدة ميتة ثم ينزل عليها الماء فتهتز وتحيا.. ثم نقل القرآن تلك الحركة إلى قلب المسلم، واعترف بواقعية الصراع بين الخير والشر، وبصعوبة التحكم في هذا الصراع، والاهتداء إلى الحقيقة من خلال هذا الصراع، والتي يسميها “الصراط المستقيم“.
نريد رؤية إسلامية في القصة والمسرح كما في العمارة والخط
إن الصلة بين الله والإنسان في الحضارة الإسلامية إنما هي تعبر عن تلك الحركة؛ فهي تقوم على الشد والجذب، والأخذ والرد، وتجعل المرء في حالة من التوتر الصحي؛ فهو ليس بعيدًا عن الله بُعدًا يؤيسه، ويجعله يعيش في كون معادٍ خالٍ من الروح القدسي، وهو في الوقت نفسه ليس قريبًا منه قرب اتحاد أو حلول، ينسيه الفرق بين العالَمين، وينتهي إلى سديمية فارغة؛ بل هو قريب بعيد في حالة تجمع بين الخشية والرجاء، وتعمر القلب بحركة متواصلة ومتراوحة بين الإنسان والمطلق؛ كالصورة في المرآة- على حد تشبيه الغزالي- ليست هي المرآة، وليست هي مفارقة لها.
وأخذ المفكرون يعبرون عن روح الحضارة العربية، ويكشفون عن دور تلك الحركة؛ فابن تيمية يرى أن الأصل في النفس أن تكون متحركة، مثل كرة على مستوى أملس. والغزالي يرى أن القلب هدف يصاب على الدوام من كل جانب، ولا يكون قط مهملاً؛ مثله مثل عصفور يتقلب، أو قِدْر يغلي، أو ريشة في فلاة تقلبها الريح. والجنيد يرى أن الصادق يتقلب في اليوم أربعين مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة أربعين سنة. وابن القيم يرى أن الأحوال والأسباب تتقلب بالمسلم وتقيمه وتقعده.
ثم هي حركة من نوع خاص تكشف عن طبيعة الحضارة الإسلامية؛ فهي ليست انزعاجًا أو تمردًا أو قلقًا مَرضيًّا؛ إذ هي تدور تحت عناية الله، وفي جو من التوكل والرضا بالقضاء والقدر، مما جعلها تتسم بما يسمى “السكينة”؛ وهي حالة وسطى بين السكون والانزعاج، يتحقق فيها وفي معترك الحياة برد القلب، وإحساسه بالرضا، الذي لا يصل إلى حد جمود الحركة.
ألا يجعلنا هذا نحس بأن هناك فارقًا بين الوسطية العربية ووسطية أرسطو؟
بلى.. وهو فارق بعيد؛ فوسطية أرسطو تنتمي إلى تراث يشيد بالنظام العقلي، ويرى في الرياضيات مثله الأعلى؛ ومن ثم، فالوسط عنده عقلاني، ويخضع للنظام المنطقي الرهيب. وكثيرًا ما كان أرسطو يستخدم اصطلاحات رياضية؛ مثل مركز الدائرة، والنقطة، والكم، والمدار، والنسبة، والقسمة. والوسط عنده مهارة ذهنية يصعب تحقيقها كما يقول، وهي مثل نظرية يلزم المرء أن يتعلم حلها.
وقد انتهى هذا الموقف العقلاني بأرسطو إلى حالة سكونية، تليق بالفكر العقلي المجرد، الذي يعزل الأشياء عن مواقفها، ويحللها ويصنفها كأنه في معمل وأمام زجاجات وعينات وبطاقات؛ فتصاب العلاقات المتشابكة باليبوسة، وتتحول إلى أجزاء معزولة باردة! إن الإغراق في العقل النظري ينتهي بصاحبه إلى السكون الجامد، وإلى تلك البرودة التي تبتعد عن مواقف الحياة.
لكل فن أدبي خصائصه وجمهوره والأفضل أن تتفاعل الأنماط الأدبية
فالإله عند أسطو هو صورة الكمال، وهو السكون المطلق، ولا عمل له إلا أن يعقل ذاته في نعيم سرمدي. أما الوسطية العربية فهي تختلف عن ذلك؛ فهي وسطية يعيشها العربي، وموقف يجابهه ليل نهار، وقد انتهت إلى عنصر الحركة كما ذكرنا.
وهل هذه “الوسطية” وجه آخر لـ”التعادلية” عند توفيق الحكيم؟
الوسطية تختلف عن التعادلية.. تعادلية الحكيم تنبع من آرائه الفلسفية ونظرته الشخصية. وقد قال عنها الدكتور زكي نجيب محمود في مقدمة كتاب التعادلية إنها تخرج من عبادة الفكر الإغريقي. أما الوسطية فهي ليست اجتهادًا شخصيًّا وليست آراء شخصية، بل هي تعبير عن رؤية الحضارة العربية الإسلامية، وكل دوري فيها هو اكتشاف هذا المذهب، وبلورته، ونفض الغبار عنه. إنها تنبع في الدرجة الأولى من الرؤية الدينية، ومن الخصوصية العربية الإسلامية.
وماذا عن التطور والمراحل التي مر بها مشروعكم في الوسطية؟
لقد وضعت مشروع “الوسطية العربية” في ستة أجزاء ، هي: المذهب، التطبيق، نحو وسطية معاصرة، نحو رواية عربية، حلم ليلة القدر: رواية عربية، القرآن الكريم ومذهب الوسطية.
في الجزء الأول حددتُ ملامح هذا المذهب في الحفاظ على الأصالة العربية القديمة، ووجدت أنه مذهب له خصوصيته الكاملة التي تفصله تمامًا عن وسطية أرسطو، وعن عدالة أفلاطون، وعن ثنائية الفرس، وأفكار الصينيين.
ويتابع الجزء الثاني تطبيقات هذا المذهب في سبعة فصول، هي: الإسلام، الأخلاق، الجمال، الفن، الأدب، اللغة، المنهج. أما بقية الأجزاء فهي تتابع رحلة هذا المذهب في العصر الحديث بعد أن انكمش الدور العربي، وابتعد عن الحياة الواقعية بسبب نفوذ الاستعمار الغربي وغلبة الثقافة الأوروبية. وقد كتبت في هذا المشروع وراية تحت عنوان حلم ليلة القدر، تبشِّر بأفكار الوسطية، وتقدم نموذجًا لفن روائي أصيل يوظف الأشكال التراثية التاريخية؛ وبهذا نكون قد استطعنا أن نؤصل مذهب الوسطية تطبيقًا.
هل ترفضون “الحداثة” لأنها جاءت من جذور غربية؟
أنا أوافق على فكرة الحداثة كفكرة مجردة، لكن كواقع نتعامل معه أو مجموعة من الحداثيين أعرفهم بالاسم وأعرف كتبهم، هم غريبون عن البيئة، وعلى رأسهم أدونيس في كتابه (الثابت والمتحول) الذي يرى أن لا تقدم للعالم العربي إلا إذا طرح الدين وبدأ خطوة جديدة. فهذا زعيم الحداثيين كيف أتقبله وهو يرفض تاريخ منطقة منذ آلاف السنين!
وفي الوقت نفسه، أتقبل الحداثة إذا كانت بمعنى الشيء الحديث الذي يناسب الإنسان المعاصر ويخرج من واقع التاريخ والثقافة.. وما أريده هو سحب البساط من تحتهم لكي لا أجعلهم يتمتعون بكلمة حداثة وحدهم؛ فالكلمة والفكرة قيمة ويقوم بها بعض الصادقين بلا ضجيج.. ولكن أن تصدر منهم بتلك الطريقة المبالغ فيها، والتي ترفض تراث المنطقة؛ فإني أرفضها.
ماذا تقصدون من تعبيركم “موت القارئ” الذي جعلتموه عنوانًا ثانيًا لكتابكم (نقاد الحداثة)، خاصة وأننا نعرف أن من أهم قضايا ومصطلحات النقد الحداثي: “موت المؤلف”. فما العلاقة بينهما؟
هذا العنوان الجانبي تهكمي.. فهم قالوا يجب أن يموت المؤلف ليحيا القارئ بمشاركته في النص، وبالغوا في ذلك حتى هيمن القارئ واستبد بالنص ليعطي معاني بعيدة عن النص.
هذا أدى إلى أن النص يتحول إلى قراءة أولى وثانية وثالثة.. فتحولت المسألة إلى اجتهاد مبالغ فيه، وإلى أن فقدت العملية الأدبية مغزاها، وفقد النقد جدواه، وأصبح العمل الأدبي مجرد عجينة في يد أطفال، كل واحد يشكّلها بنفسه.
فأنا أقول من خلال هذا العنوان: إن دعوتكم يا نقاد الحداثة إلى موت المؤلف وإحياء القارئ والمبالغة في ذلك، أدت إلى استبداد القارئ بالساحة؛ ومن ثم، أنا أدعو إلى موت القارئ المستبد، وأنا منطقي أكثر منكم لأننا إذا فاضلنا بين المؤلف والقارئ بالنسبة للنص فالمؤلف أولى لأن النص أولى به، فهو يقدم الاقتراح الذي يقدمه للقارئ الذي له أن يرفضه أو يتحاور معه.. لكن أن يأتي القارئ ويقتل المؤلف ويغتصب النص تمامًا ويصبح هو صاحبه، فهذه عملية سطو وقتل واغتصاب! وهذا أرفضه.. ومن هنا، أدعو إلى موت القارئ!
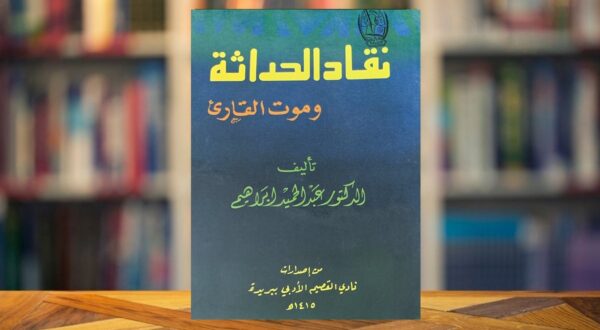
لكن كما نعرف أن في النقد الحداثي لا يستطيع أي قارئ أن يفهم النصوص- خاصة الحديثة- أو يشارك في قراءتها إلا إذا اتصف بالثقافة العالية التي تؤهله لشرح النص.. فما رأيكم؟
يا سيدي.. النص يحتاج إلى قارئ يتصف بالثقافة العالية.. هذه مقولة خاطئة، وتعني أن النص الأدبي لم ينجح فيه صاحبه. الأديب الناجح يقدم نفسه ويؤثر على الآخرين بوضوح. وقد قال ديكارت: إذا كان المعنى واضحًا في نفس الأديب وداخله فإنه سيكون واضحًا أمام القارئ. أما أن يأتي الأديب ويقدم لنا نصًّا مغلقًا مستبهمًا، فهذا من الكلمات المتقاطعة أو لعبة شطرنج، نحن في مجال الأدب (الجمال) يجب أن يكون النص جميلاً وكالوردة الجميلة ما إن يراها الشخص حتى يقبل عليها ويقطفها ويتذوقها.
ففكرة أن النص يحتاج إلى قارئ من مستوى عال، والتي يرددها الحداثيون كثيرًا- ويقولون نحن لا نُفهم لأننا نحتاج إلى القارئ الذي يفهمنا- هي تعمية وكهنوتية؛ بدلاً من أن يعترفوا بالواقع، وبأن مواهبهم ضامرة، وبأنهم لا يستطيعون أن يتنبهوا للنص ولديناميكيته.. يقولون نحن نحتاج إلى قارئ يفهمنا؛ في حين أن المطلوب منك أن تثير أحاسيس القارئ، وأن تحسسه بالعمل الأدبي.
أما مشاركة القارئ كفكرة في حد ذاتها فهذا في أي عصر موجود، وموجود في زمن امرئ القيس؛ بل أي عمل فني يستثير القارئ ويدعوه إلى المشاركة، وأي أديب يكتب لقارئ، لا يكتب لنفسه.. وهو يريد من القارئ أن يشاركه المتعة؛ فمشاركة القارئ في حد ذاتها متعة.
ما رأيكم في الدعوة إلى منهج إسلامي في الفنون الحديثة، وخاصة في مجال القصة والرواية والمسرحية؟
السؤل يجب أن يكون: ما رأيكم في رؤية إسلامية للفنون الحديثة؟ بدلاً من منهج إسلامي؛ لأن المنهج أداة يمكن أن نستعيرها من الآخرين، أما الرؤية الإسلامية فهي مطلوبة وضرورية ويجب أن نجدّ في الكشف عنها، إذا كنا صادقين في التعبير عن شخصية متميزة للأمة؛ لأنه بدون رؤية عربية إسلامية لن تكون لنا شخصية.
وغير معقول أن حضارة عريضة ومترامية جغرافيًّا وتاريخيًّا يمكن ألا تكون لها رؤية، وهي في القديم كانت لها رؤية، وقد كشفت عن هذه الرؤية في كتابي الوسطية العربية، في الأدب وحتى في الفنون وفي الشعور وفي الأخلاق. ومن ثم، يجب أن نلون هذه الرؤية في الوقت المعاصر برؤية إسلامية؛ فالذي حدث أننا في العصر الحديث حدث لنا استلاب في الشخصية العربية والإسلامية؛ فحينما ضغط الاستعمار على المنطقة وجعلها تترك جذورها وتتجه نحوه، أصبحنا نرى أن تاريخ الإنسان العربي لا يتعدى عشرات السنين حينما اتصل بأوروبا.
القصة نبدؤها بعد اتصالنا بأوروبا، المسرح بعد اتصالنا بأوروبا، الشعر يتغير إلى الشعر الحر بعد اتصالنا بأوروبا. حصلت نقلة مفاجئة، وكأن تاريخنا الطويل أصبح في الظل، وكأننا مثل الشعوب المتخلفة التي ليس لا جذور!
فالرؤية لا بد من أن نحتفي بها، ولا بد أن تكون لنا رؤية في الأدب الإسلامي كما لنا رؤية في الفن الإسلامي تدرس في الجامعات وفي المراكز وفي المؤتمرات وفي المعارض فيما يسمونه باسم Art Islamic، أو ما يسمونه بالأرابيسك في مجالي النحت والرسم، وفي مجال العمارة الإسلامية التي عرفها العالم عن طريق إسبانيا، وحتى الآن في أوروبا يوجد طراز من العمارات يعرفونها بأنها طراز إسلامي، وفي مجال الخط والفن التجريدي، وذلك موجود على مستوى العالم؛ فلا بد أن يكون لنا أدب إسلامي ورؤية إسلامية في القصة وفي المسرح وفي سائر الفنون.
وصدقني.. لن نصل إلى العالمية إلا إذا كانت لنا رؤية إسلامية في أدبنا؛ لأن العالمية تبدأ من المحلية، ومن التعبير عن الخصائص الحضارية المميزة؛ فإذا استطعنا أن نعبر عن هذه الخصائص الحضارية المميزة، فإنه يمكن أن يكون لنا مكان في الحضارات الغربية.. وإلا فإنهم سيقولون: إن هذه بضاعتنا رُدّت إلينا. وستكون هذه البضاعة مشوّهة.
وماذا عن مصطلح “الأدب الإسلامي” الذي شاع مؤخرًا وأصبحت له تنظيراته داخل بعض أقسام الأدب بالجامعات؟
“الأدب الإسلامي” حقيقة تاريخية لا يستطيع منصف إنكارها؛ إذ كان هذا الأدب ولا يزال نتاج حضارة إسلامية عريقة، لها حضورها المميز والملموس في الحضارة البشرية بشكل عام.
فحينما نقول الأدب الإسلامي فإننا نقصد به ذلك الأدب المعبر عن هذه الحضارة. وإذا كنا نعترف بالأدب المسيحي المقاتل- وخير ما يمثله أدب كازانتراكيس مثلاً- وبالأدب الماركسي، والآخر الوجودي؛ فلماذا ننكر على الحضارة الإسلامية عبر عصورها الزاهية إنتاج أدب يعبر عنها؟
أما وجود شواهد دالة على هذا الأدب الإسلامي من الإبداع المعاصر، فهذا لم يصل إلى حد النضج بعد، وإن كانت بشائره موجودة في أدب نجيب الكيلاني وقصائد إقبال والتهامي وغيرهم. بالإضافة إلى أن الكثير من هذا الأدب دخل فيما يشبه المواعظ والحكم، فابتعد عن الإبداع بشكل أو بآخر.
تسمية “قصيدة النثر” بـ”النثر الفني” تجعلنا أكثر موضوعية وتواضعًا
ونحن نبحث عن ذلك الأدب الذي يدخل في دائرة الفن في المقام الأول، ثم يدخل في دائرة الالتزام الخلقي.. وليس العكس. فلو تخلص أدب نجيب الكيلاني مثلاً من الصوت العالي والجهوري، وبحث عن فنيات الرواية من حبكة وصراع وغير ذلك من لوازم الفن، لوصلت أفكاره بشكل أفضل من أن تكون في المقام الأول روايات دعوة ثم يأتي الفن بعد ذلك.
يتردد بين حين وآخر أن الرواية أصبحت ديوان العرب بديلاً عن الشعر.. ما نظرتكم إلى هذه المقولة؟
هذا دليل تعصب بعض النقاد لأعمال بعينها أو لكُتّاب بأعينهم. والسؤال مغلوط منذ البداية، وبالتالي المقولة التي ذكرت.. فلا يوجد جنس أدبي يتسيَّد الساحة الأدبية على حساب جنس أدبي آخر؛ لأن لكل فن أدبي خصائصه وجمهوره، والأفضل للأدب وللأدباء وللجمهور بشكل عام أن تتفاعل الأنماط الأدبية مع بعضها: القصة مع الشعر مع الرواية مع المسرح مع المقالة.. في آن واحد. وكلما تعايشت هذه الأنماط مع بعضها، ازدهر الإبداع بشكل عام، وأورقت حدائقه إبداعًا جميلاً.
وما تقييمكم لما يسمَّى “قصيدة النثر” التي دخل مجالها حتى بعض من لا يحسنون قراءة الشعر، وليس إبداعه؟!
بداية أقول: إن أي تجديد لا يقوم على ذوق الإنسان العربي فهو يتصادم معه. وإذا كان ذلك اللون من الإبداع يطلقون عليه “قصيدة النثر”، فلماذا لا نسميه “النثر الفني” ليكون ذلك أكثر موضوعية وأكثر تواضعًا؟

وأتصور أن الخروج على الذوق المألوف يعتبر مراهقة لا تفهم ما حولها، ومحكوم على صاحبها في النهاية بأن يغير من موقفه.. وإلا فماذا نقول عن كتابات الرافعي التي تحمل الكثير من خصائص الشعر؟ أو كتابات طه حسين التي تحمل الكثير من الأسلوب الموسيقي؟ ومع ذلك لا نقول إن الرافعي وطه حسين من الشعراء المجددين، ولم يزعم أحدهما أنه شاعر. فليس العيب ألا يكتب المرء شعرًا، وإنما العيب أن يذكر أنه يكتب الشعر وما هو بشعرٍ في شيء!