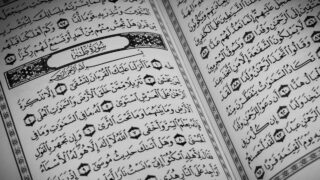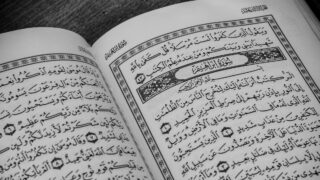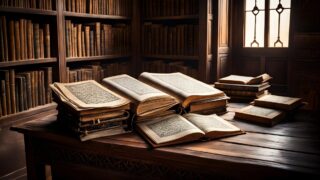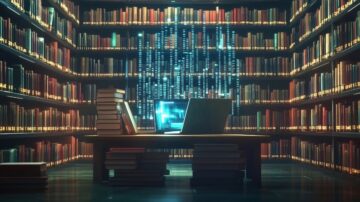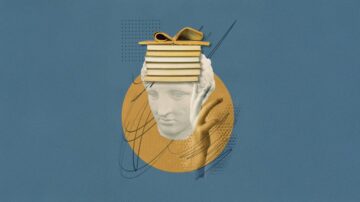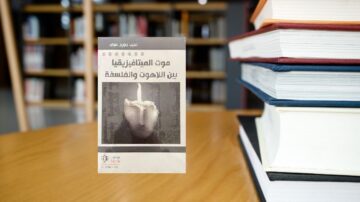تمثل مادة “التفكر” في الإسلام، قرآنًا وسنة، مادة مدهشة ثرية.. ومع هذا لم تسلم من التشغيب والافتراء، حتى رُمِيَ الإسلام بنقيضِ أبرز ما يُميزه وهو أنه دين يجعل “التفكير” فريضة من فرائضه الحضارية، كما أوضح الأستاذ العقاد في كتابه المهم (التفكير فريضة إسلامية)!
فالإسلام يرتفع بالتفكر إلى مرتبة أنه أمر به، وجعله مصدرًا من مصادر التعرف على الله تعالى ومشاهدةِ آثار قدرته، كما جعله مدخلاً للتعرف على كتابَيْ الله المقروء والمنظور، أي القرآن الكريم والكون الفسيح؛ فهو- أي التفكر- سبيل لاستجلاءِ معاني “الكتاب المنزَّل”، ولاستشكاف حقائق “الكتاب المبسوط”.
التفكر في القرآن الكريم
وحينما نتدبر مادة التفكر في القرآن الكريم تستوقفنا عدة ملاحظات مهمة تشير إلى احتفاء الكتاب المعجز بهذه الخصيصة، التي تميز الإنسانَ عن غيره من سائر المخلوقات، وتمنحه سر التجدد والإبداع..
– وأول ما يستوقفنا أن القرآن الكريم يعبر عن التفكر في ثمانية عشر موضعًا وبصيغة المضارع، للدلالة على أنه فعل مطلوب باستمرار، مثل قوله تعالى: {كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (يونس: 24). وفي موضع واحد فقط عبَّر بصيغة الماضي، ولم يكن ذلك للحضِّ على الفعل وإنما لذمه، إذ كان للافتراء والكذب، قال تعالى عن الوليد بن المغيرة: {إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ} (المدثر: 18).
– أن القرآن جعل التفكر من صفات أولي الألباب: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ . الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (آل عمران: 190، 191). جاء في تفسير ابن كثير: {لأولِي الألْبَابِ} أَيِ: الْعُقُولِ التَّامَّةِ الذَّكِيَّةِ الَّتِي تُدْرِكُ الْأَشْيَاءَ بِحَقَائِقِهَا عَلَى جَلِيَّاتِهَا، وَلَيْسُوا كَالصُّمِّ البُكْم الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ: {وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ . وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ} (يوسف: 105، 106)([1]).
– أن تشجيع القرآن على التفكر يشمل تعبيره بمواد أخرى تشترك مع التفكر في الحض على الفهم والنفاذ للحقائق؛ مثل: النظر، التدبر، التعقل، وغيرها([2])؛ كما في قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ} (الأعراف: 185)، وقوله: {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} (ص: 29)، وقوله: {وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} (النحل: 12)، مما يؤكد أن احتفاء القرآن بالتفكر ليس احتفاءً عارضًا، وإنما هو موقف أصيل ومتنوع التعبيرات.
– أن دعوة القرآن إلى التفكر في الإسلام تشمل الدعوة إلى التفكر في كتابَيْ الله المقروء والمنظور، كما أشرنا.. مما يدل على إِحْكام التنزل في القرآن، والخَلْق في الكون؛ فلولا هذا الإِحْكام ما جعلهما القرآنُ موضعًا للتفكر.. ويدل أيضًا على أن نجاح الإنسان في مهمته في الحياة مرتبط باستجلاء حقائق الكتابين والعمل بمقتضى هذه الحقائق. فعن القرآن ورد قوله تعالى: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} (النحل: 44). وعن الكون ورد قوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ . وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (الجاثية: 12، 13).
– أن مجالات التفكر في القرآن شملت أمورًا متعددة؛ مثل التفكر في حال النبي ﷺ ورسالته: {قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ} (سبأ: 46). والتفكر في قصص السابقين: {فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} (الأعراف: 176). والتفكر في علاقة الزوجية وما فيها من سكن وتآلف: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (الروم: 21).
وهكذا نرى تنوع أن مادة التفكر في الإسلام وثراءها في القرآنِ الكريم، كتابِ التفكر والتعقل والتدبر!
التفكر في السنة النبوية
وجاءت السنة النبوية معضدةً دعوة القرآن الكريم إلى التفكر، ومُبيِّنةً ضابطًا مهمًّا من ضوابط التفكر في الإسلام .. ويتضح ذلك مما يلي:
– أن النبي ﷺ مارس التفكر عملاً، ولم يجعله أمرًا معرفيًّا فحسب: فحينما نزلت عليه آية سورة آل عمران، قام يصلي ويبكي، ولما جاءه “بلالٌ يُؤذِنُه بالصَّلاةِ فلمَّا رآه يبكي قال: يا رسولَ اللهِ لِمَ تَبكي وقد غفَر اللهُ لك ما تقدَّم وما تأخَّر؟ قال: “أفلا أكونُ عبدًا شكورًا. لقد نزَلَتْ علَيَّ اللَّيلةَ آيةٌ، ويلٌ لِمَن قرَأها ولم يتفكَّرْ فيها: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ}([3]).
– أن النبي ﷺ أرشدنا إلى ما يجوز أن يكون محلاً للتفكر وما لا يجوز: فجاء عنه: “لا تتفكروا في اللَّه، وتفكروا في خلق اللَّه”، وفي رواية: “تفكروا في خلق اللَّه، ولا تفكروا في اللَّه؛ فإنكم لن تَقْدِرُوا قَدْرَهُ”، وفي رواية: “تفكروا في آلاء اللَّه، ولا تتفكروا في اللَّه”([4]). فالتفكر في خلق الله أو في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، أمر محمود ومطلوب؛ لأنه سبيل إلى معرفة الله وخشيته؛ أما التفكر في ذات الله تعالى فهو يحمِّل العقل ما لا طاقة له به، ويجعله عرضة لمسالك الردى والزيغ!
انحراف عن الجادة!
وإذا كان هذا هو احتفاء القرآن الكريم والسنة النبوية بالتفكر، معرفةً وممارسةً، أو علمًا وخشيةً؛ فلنا أن نتساءل:
– كيف انتشرت دعوى مناقضة الإسلام للعقل.. هذه الدعوى التي يروِّجها أعداء الإسلام، وبعضُ أتباعه أيضًا..!
– وكيف انفصلت المعرفة عن العمل، أو العلم عن الخشية، في عملية التفكر؛ بحيث تحولت إلى معلومات مجردة لا ظل لها في الواقع!
– وكيف وقع الفكر الإسلامي في وهدة الانشغال بالتفكر في ذات الله تعالى، وتحمَّل ما لا يطيق!
– ولماذا انحسر فكرنا عن كتاب الله المنظور (الكون).. بل حتى عن حسن التدبر في كتاب الله المقروء (القرآن)!
أسئلة كثيرة تكشف عن مدى الانحراف الذي أصابنا، وعن الهوة التي تفصلنا عن حقائق الإسلام؛ التي ينبغي أن نفهمها على أصلها المقرَّر في القرآن الكريم والسنة النبوية، وأن نحاكم تاريخنا وواقعنا طبقًا لهذا النبع الخالد!
([1]) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 2/ 184.
([2]) يقول الأستاذ العقاد: العقل الذي يفكر ويستخلص من تفكيره زبدة الرأي والروية، فالقرآن الكريم يعبر عنه بكلمات متعددة تشترك في المعنى أحيانًا وينفرد بعضها بمعناه على حسب السياق في أحيان أخرى؛ فهو الفكر والنظر والبصر والتدبر والاعتبار والذكر والعلم، وسائر هذه الملكات الذهنية التي تتفق أحيانًا في المدلول ولكنها لا تستفيد من كلمة واحدة تغني عن سائر الكلمات الأخرى: (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ)، (وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ)، (كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ)، (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا)، (وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ)… بهذه الآيات- وما جرى مجراها- تقررت ولا جرم فريضة التفكير في الإسلام. انظر: التفكير فريضة إسلامية، العقاد، ص: 15.
([3]) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، 2/ 386.
([4]) جاء في المقاصد الحسنة: حَدِيث: “تَفَكَّرُوا فِي كُلِّ شَيْءٍ وَلا تَفَكَّرُوا فِي الله”، ابن أبي شيبة في العرش من حديث سعيد بن جبير، عن ابن عباس به قوله، ورواه الأصبهاني في ترغيبه، ثم أبو نُعيم في الحلية من حديث عبد الجليل بن عطية عن شهر عن عبد الله بن سلام، قال: خرج رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أناس من أصحابه، وهم يتفكرون في خلق الله، فقال لهم: فيما كنتم تفكرون، قالوا: نتفكر في خلق الله قال: لا تتفكروا في الله وتفكروا في خلق الله، فإن ربنا خلق ملكا قدماه في الأرض السابعة السفلى، ورأسه قد جاوز السماء العليا من بين قدميه إلى كعبيه مسيرة ستمائة عام، وما بين كعبه إلى أخمص قدميه مسيرة ستمائة عام، الخالق أعظم من الخلق. ولأبي نُعيم فقط من حديث إسماعيل بن عياش عن الأحوص بن حكيم عن شهر عن ابن عباس أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج على أصحابه، فقال: ما جمعكم؟ فقالوا: اجتمعنا نذكر ربنا ونتفكر في عظمته، فقال: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله، فإنكم لن تقدروا قدره. الحديث، وفيه ذكر إسرافيل، وللطبراني في الأوسط، والبيهقي في الشعب، من حديث ابن عمر مرفوعا: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله. وأسانيدها ضعيفة، لكن اجتماعها يكتسب قوة، والمعنى صحيح، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا: “لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خَلَقَ اللهُ الخلقَ، فمن خلق الله، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله”. انظر: المقاصد الحسنة، السخاوي، 260، 261.
تنزيل PDF