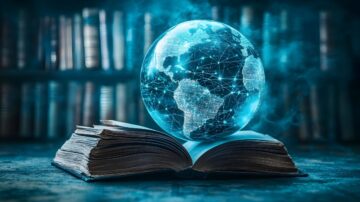مما يجابه الإنسان في عصرنا كما يقول المسيري (المسيري، فقه التحيز، 1995) أن النموذج الحضاري الغربي أصبح يشغل مكانا مركزيا في وجدان معظم المفكرين والشعوب، وليس من المستغرب أن يحقق نموذج حضاري له مقدرات تعبوية وتنظيمية مرتفعة انتصارات باهرة، على المستويين المعنوي والمادي.
كما أن التعامل مع الحضارة الغربية الغالبة أخذ صيغة الانبهار الذي دفع كثيرا من قيادات أمتنا ونخبها وعلمائها، وأبنائها عموما، إلى الأخذ غير المتبصر عن هذه الحضارة، أو ما سماه مالك بن نبي “التكديس” (بن نبي، شروط النهضة، 1986)، الذي يستورد ويراكم الخبرات والأشياء، ولكنه لا يصنع حضارة، أو يعيد نهوضها من جديد!
مع ما يصحب ذلك من خلط بين “عالم الأشياء” و”عالم الأفكار”، إذ أن التعامل مع الأفكار بذهنية التعامل مع الأشياء يؤدي إلى اقتحام “أفكار مميتة” عقل الأمة وعقيدتها وثوابتها التصورية وخصائصها الأساسية، والتشويش عليها بجملة من المفردات، التي تلحق الدمار بمقومات الشخصية الإسلامية، وتقودها إلى الخروج من ساحة الاحتكاك الحضاري، وقد فقدت ذاتها، وأصبحت – في نهاية الأمر – تابعا يدور في فلك الآخر.
وهذا النموذج الحضاري الغربي يقوم على نموذج معرفي صار يؤطر المعرفة ويثريها بمقولاته. والرؤية الغربية لله عز وجل والكون والحياة، صارت تسيطر على توجهات أغلبية شعوب الأرض الآن، وتحاصر ثمرات هذا المنهج وعي الإنسان وفكره وسلوكه ورغباته، حتى تكاد تأسر رؤية الإنسانية للوجود، فصارت الحضارة الغربية “قانون العصر” المهيمن (بن لحسن، 1996).
وعندما تنظر إلى هيمنة النموذج المعرفي الغربي تظن لأول وهلة أنه أحاط بالإنسانية وأنه أعظم ما يمكن للبشرية بلوغه والوصول إليه. وذلك لأنه – كما قلنا في المقال السابق– قد مكن لنفسه بترسانة من الوسائل التكنولوجية والتقنيات المتطورة، التي استبدت بحياة الإنسان في شتى جوانبها، داخل بيته وخارجه؛ سيارة يمتطيها، وهاتف يحدد به المواعيد، وجهاز حاسوب يكتب فيه ما يشاء ويخط فيه سائر خطاباته ويتصل به ويقرب الأبعاد، فيظهر لك زيادة إلى ما سبق، كأن الغرب قد امتلك ناصية الحقيقة المطلقة التي لا يساورها شك ولا يعتريها نقص (بن لحسن، العولمة، 2007).
والعالم الإسلامي الذي يحاول استكمال تحرره من الهيمنة الغربية، على نخبه أن تركز على استكمال التحرر من هيمنة نموذجها المعرفي، لأنه يحتوي بعض العناصر المخالفة للرؤية الإسلامية للحياة، من استبطان الأبعاد العَلمانية، والوضعية، والنسبية، والمادية، والتطورية، في تحليل الظواهر وقراءة التاريخ. لأن هيمنة النموذج المعرفي الغربي أتلف قداسة الوجود في النفوس والضمائر والثقافة. وبسبب دعوى العلمية أخضع هذا النموذج كل شيء وكل فكرة إلى مقاييس الكم، فصار التكميم معيارا لقياس مدى صحة أو علمية أي فكرة أو شيء في هذا الوجود. (بن نبي، دور المسلم ورسالته، 1992).
فالتطور الهائل الذي عرفته العلوم الطبيعية والتكنولوجية وحتى الإنسانية والاجتماعية، قائم على الفكر المادي، والفلسفة المادية التي طغت على الحضارة المعاصرة سواء في أصولها النظرية أو في تطبيقاتها الاجتماعية والسياسية. وصار المجال العقائدي وفق النظرة المادية الوضعية من قبيل الشأن الشخصي الذي لا يخضع لمنطق البرهان الاستدلالي العقلي، ولا يمكن اعتباره علما حسب هذه النظرة الوضعانية. وحتى لو أعطي للدين والإيمان مجال، فهو مجال يحدده العقل العلماني الدهراني، توظيفا للإيمان وليس احتكاما إليه واستمداداً منه.
فالنموذج المعرفي الغربي مادي في أساسه، متمركز على المادة، وينكر الغيب وما يتصل به من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وترفض الحضارة الغربية وفق منهجها العلمي أي مصدر آخر للمعرفة خارج عن نطاق الفحص الحسي المادي، الخاضع للتجربة المخبرية أو المشاهدة (المسيري، الفلسفة المادية وتفكيك الانسان، 2010).
وبما أنها مادية فإنها تخضع كل شيء لقوانين المادة من تحول وتغير، ولا يوجد هناك ما يسمى ثابت مثل القيم والأخلاق، لأنها ليست أشياء يمكن تقديرها بالكم، فالصدق بما أنه لا يمكن وزنه ولا قياسه بالكمية أو بالأرقام فهو – في المفهوم الغربي – شيء مفتعل وغير موجود، ولا ثمرة من ورائه.
وفي ظل هذا الفصل بين العلم والإيمان تطورت نظريات العلوم الإنسانية والاجتماعية والفنون والآداب، مبنية على رؤية ووجهات نظر مادية للإنسان ونفسيته، ومحاكمة طبيعته وتصرفاته وميوله، وتقويمها من خلال مقاييس المادة وحدها. وأدى ذلك إلى متاهات عقائدية وأخلاقية وروحية وإنسانية. إذ أنها جردت الإنسان من مكوناته الأساس التي ترتفع بها فطرته البشرية، وتعتدل بها نفسه، وتتزكى بها روحه، ويرشد بها عقله ويتسامى بها ضميره.
وهذا ما يحتم على المثقف والباحث المسلم أن ينتبه بشدة إلى محاولات تجريد الإنسان المسلم فردا وجماعة من مصادر قوته، وافتكاك مرجعيته في تحديد تصوراته وأفكاره وفهمه للعالم ولحركة التاريخ، ولوظيفته في تحقيق العبودية لله تعالى، ودعوة الناس إلى أن يتحرروا من العبودية لغيره سبحانه.
كما يحتم عليه الرجوع إلى القرآن والسنة في تحديد تصوراتنا ومفاهيمنا المركزية (بن لحسن، مركزية القرآن، 2015)، وبخاصة ما يتعلق بفهمنا للدين، ودوره ووظيفته في حياتنا، ولبناء وعي أصيل مرتكز على نصوص القرآن والسنة، وعلى ما أنجزه علماء الأمة الأعلام، حتى لا نقع في فهم اختزالي أو مشوه أو متناقض، ولكي نحمي فهمنا الديني ووعينا الإسلامي من انتحالات المبطلين، وتأويلات الغالين، وتحريفات الجاهلين (مسند أحمد)، وبخاصة في موضوع صلة الدين بالعلم، التي تشوشت بفعل هذا النموذج الغربي.
تنزيل PDF