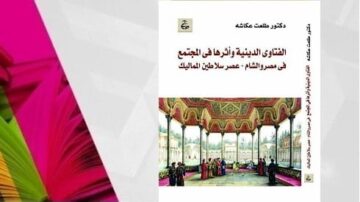اهتم سلاطين المماليك[1] بصبغ كثير من الممارسات السياسية بالصبغة الدينية، ليؤكدوا لرعيتهم أن حكمهم يستند لشرعية دينية، لذا احتلت الفتوى مكانها في دولتهم، فكان لها حضور في تولية السلاطين وعزلهم، وحل المشكلات الاقتصادية، ومعالجة أمراض المجتمع، ومن يراجع مصادر التاريخ المملوكي سيلحظ العدد الكبير من الكتب التي اختصت بالفتوى وغطت العصر المملوكي كله، بدءا من فتاوى “العز بن عبد السلام” (المتوفى 660هـ) المسماة “الفتاوى الموصلية” والتي عاصرت بداية نشأة دولة المماليك، وانتهاء بفتاوى “زكريا الأنصاري” (المتوفى:926هـ) والذي عاصر نهاية الدولة.
وفي كتاب “الفتاوى الدينية وأثرها في المجتمع:مصر والشام –عصر سلاطين المماليك” للدكتور طلعت عكاشة، والصادر عن دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية بالقاهرة، في طبعته الأولى عام 2018، في (363) صفحة، دراسة شاملة عن الفتوى، ومجالاتها، وتأثيرها، وتقاليد الإفتاء، وأبرز المفتين في العصر المملوكي.
تنوع الإفتاء
تنوع الإفتاء في دولة المماليك بين الرسمي الممثل في (مفتي دار العدل) وهي وظيفة رسمية ظهرت في عدد المدن، كالقاهرة ودمشق وحلب، فكان لكل مذهب مفت خاص يعين بمرسوم صادر من السلطان نفسه، ويشير الكتاب أن المفتين كانوا يتقاضون أجرا لا بأس به، وتصرف رواتبهم من ريع الأوقاف، هذا الدخل المستقر والجيد أوجد لهم قدرا من الاستقلال للمفتي في مواجهة السلطة، ومن أشهر من تولى الإفتاء الرسمي “ابن حجر العسقلاني” (المتوفى:852هـ) حيث ولي الإفتاء (41) عاما.
كان للمذهب الشافعي حضور وشهرة في أوساط الإفتاء في الدولة المملوكية، فمن بين (86) مفتيا تولوا الإفتاء في دار العدل، كان منهم (48) شافعيا، ويرجع اهتمام الدولة بالمذهب الشافعي إلى أن الناصر صلاح الدين الأيوبي كان يميل إلى الشافعية، وهذا أعطى فرصة واسعة لإنشاء المدارس التي توفرت على تدريس المذهب الشافعي، كما أن كافة سلاطين المماليك كانوا شافعي المذهب باستثناء “سيف الدين قطز” الذي كان حنفيا، ويلاحظ أن غالب من تولى الإفتاء كان ينتمي إلى أسرة “السبكي” و”البلقيني” الشافعيتين.
ومن أشهر من تولى الإفتاء ، “العز بن عبد السلام” صاحب أشهر فتوى في الدولة المملوكية، حيث أفتى أنه لا يجوز أخذ أموال الرعية بغير حق، و”شمس الدين بن عطاء” (المتوفى:673هـ) والذي تصدى بفتواه للسلطان الظاهر بيبرس، رافضا أن يستولي السلطان على الأراضي من أصحابها في منطقة “بانياس” بالقرب من دمشق بعد خروج الصليبيين منها، والإمام “محي الدين النووي” (المتوفى:676هـ) الذي دافع عن حقوق العامة في المجتمع ضد رفع الضرائب[2] وسياسة الجور، كذلك موقفه الحاسم والرافض لتغيير الوقف، عندما لمح نوايا من أصحاب السلطة للاستيلاء على الأوقاف[3]، كذلك “ابن دقيق العيد” (المتوفى:685هـ) والذي رفض بحسم أخذ أموال المواطنين للإنفاق على العساكر، وكتب “بلغني أن من الأمراء من له مال جزيل، وفيهم من يجهز بناته بالجواهر واللآليء، ويعمل الإناء الذي يستنجي منه في الخلاء من فضة، ويرصع مداس (حذاء) زوجته بأصناف الجواهر”، فكانت فتواه مسكتة للسلطة التي أرادت أن تتغول على أموال الرعية، كذلك الإمام “ابن تيمية” (المتوفى:728هـ) الذي أراد السلطان الناصر قلاوون أن يستصدر منه فتوى في قتل بعض العلماء الذين أفتوا بقتل “ابن تيمية” فرفض الشيخ قائلا:”وأما أنا فهم في حل من حقي ومن جهتي” وقد تفطن ابن تيمية أن السلطان قلاوون أراد أن يقتل هؤلاء العلماء لأنهم بايعوا منافسه “بيبرس الجاشنكير” ضده، مستغلا عداوتهم لابن تيمية لاستصدار فتوى تُحل سفك دمائهم.
وقد جلس للإفتاء بعض الأمراء، مثل: ركن الدين المنصوري (المتوفى:725هـ)، و”سيف الدين أرغون” (المتوفى:731هـ)، نائب السلطان في حلب، والذي وصفه “ابن حجر العسقلاني بقوله:”صار يعد من أهل الإفتاء”، و”سنجر الأمير علم الدين الجاولي، (المتوفى:745هـ)، لكن لم يعرف ذلك العصر إلا مفتية واحدة شهيرة هي “عائشة الباعونية” (المتوفاة:922هـ) الذي صنفت بعض الكتب كـ”الفتح الحنفي” و”الملامح الشريفة والآثار المنيفة”، واستطاع الكتاب أن يُحصي أسماء (447) مفتيا غير رسمي في دولة المماليك، منهم (230) من الشافعية.
الفتوى والسياسة
لعبت الفتوى دورا سياسيا في دولة المماليك، تلك الدولة التي قامت النظرية السياسية فيها على أساس أن جميع الأمراء متساوون في أحقيتهم بعرش البلاد، وهو ما خلق تنافسا بين الأمراء للسيطرة على الحكم، وهذا ما جعل للفتوى تأثير سياسي كبير، وتجلى ذلك منذ البدايات الأولى لدولة المماليك، في عام (657هـ) مع صدور فتوى عزل “المنصور علي ابن عز الدين أيبك” والذي كان طفلا صغيرا ، وتنصيب “سيف الدين قظز” مكانه، كذلك فتوى خلع الملك الصالح حاجي عام (784هـ) لصغر سنة ، وفتوى الشيخ “سراج الدين البلقيني” (المتوفى:805هـ) بعزل نائب دمشق “صدر الدين الكفيري” لأنه أراد أن يتقدم في المجلس على شيخ الشافعية بالشام “شهاب الدين الملكاوي”، وفتوى الشيخ “علم الدين صالح البلقيني” بخلع الخليفة العباسي “القائم بأمر الله” فأعطي المفتي للسلطان الحق في عزل الخليفة.
لعبت الفتاوى دورا سياسيا في قتال بعض الحكام في العصر المملوكي وقتلهم، ومنها فتوى “شمس الدين أحمد بن خلكان” قاضي القضاة بدمشق عام (678هـ) للأمير “شمس الدين سنجر” بجواز قتال السلطان المنصور قلاوون في مصر، ومنها فتوى قتل السلطان “الأشرف خليل بن قلاوون”[4] عام (693هـ)، وفتوى عام (791هـ) بجواز قتال السلطان الظاهر برقوق لعزله الخليفة العباسي المتوكل، أفتى بها الشيخ “سراج الدين البلقيني” وآخرون، وفتوى “ناصر الدين بن العديم” عام (815هـ) بقتل السلطان الناصر فرج بن برقوق[5].
لجأ سلاطين المماليك إلى العلماء للحصول على فتاوى بقتال العربان (قبائل البدو العربية) الذين رفضوا الخضوع لسلطة المماليك، حيث رأت تلك القبائل أن المماليك ليسوا أحرار لذا لا يجوز أن يحوذوا السلطة، ومنها ما جرى عام (701هـ) حيث أفتى العلماء بجواز قتال العربان لفسادهم وقطعهم الطريق.
الفتاوى الاقتصادية
لعبت الفتوى دورا في المجال الاقتصادي، إذ تسلل الترف والبذخ إلى الطبقة الحاكمة والعسكرية المملوكية، وأفاضت كتب التاريخ في الحديث عن ترف الأمراء، فمثلا أحد أبناء السلطان الناصر محمد بن قلاوون حمل جهازه للزواج على (800) جمل، وأنفق ما يقرب من ثمانين قنطارا من لذهب، ورغم ذلك استصغر أبوه ذلك الجهاز، كما بلغت تكاليف زواج إحدى بناته (800) ألف دينار من الذهب، لذا تصدت الفتوى لهذا الترف، ورفض كثير من الفقهاء إفتاء السلطة برفع الضرائب أو أخذ أموال الناس، وزاد غضب الفقهاء عندما امتدت أيادي السلاطين إلى أموال الأوقاف، ومن ذلك ما لعبه قضاة الشام وعلى رأسهم “شمس الدين الشهرزوري” الذي تصدى للسلطان الظاهر بيبرس وأغلظ له الكلام حتى لا يقترب من أموال الرعية، ووصول الأمر إلى التهديد بتكفيره، فغضب بيبرس وقال:”أنا أُكفر.انظروا لكم سلطانا غيري”، ثم لم يجد أمامه إلا انصياع للفتوى.
لعبت الفتاوى دورا في مقاومة الأوبئة، ومنها الطاعون الذي كان منتشرا في ذلك العصر، ومنها فتوى عام (841هـ) حيث استفتي السلطان الأشرف برسباي العلماء فيما يتوجب فعله لمقاومة الطاعون، فأفتى العلماء بضرورة أن يكف السلطان عن المظالم وأن تكف الرعية عن المعاصي، وفي العام (683هـ) أفتى العلماء فتوى حضارية وإنسانية تتعلق بعدم جواز تسخير (العمل بدون أجر) السلطة للأفراد حتى ولو كان في بناء المساجد، بل ذهبوا أبعد من ذلك في فتواهم ورأوا عدم جواز الصلاة في تلك الأماكن التي شهدت السخرة، فقال الشيخ محمد المرجاني (المتوفى:713هـ) بأنه لا يجوز الصلاة فيها، بل يكره الدخول من بابها، ومن الطريف أن “المدرسة المنصورية” شهدت نفورا من الناس بسبب تلك الفتاوى.
[1] امتدّ عصر المماليك بين عامي 648- 923هـ/1250-1517م، حكم المماليك خلالها مصر والشام أكثر من 275 عامًا انقسموا خلالها إلى دولتين: الأولى: هي دولة المماليك البحرية ومؤسّسها عزّ الدين أيبك، وحكمت نحو 135 عامًا بين سنتي( 648-784 هـ/1250-1382 م )؛ وكلمة البحرية أطلقت على طائفة من المماليك أسكنها الملك الصالح نجم الدين الأيّوبي في قلعة الروضة في نهر النيل فعُرفوا بالبحرية، استطاعت هذه الدولة تحقيق انتصارات على التتار، والثانية: هي دولة المماليك البرجية، ومؤسّسها الظاهر هو برقوق العثماني الجركسي وقد استمرّت هذه الدولة قرابة 139عامًا.
[2] رفض الإمام النووي عام (666هـ) فرض الضرائب على أصحاب البساتين في دمشق بعدما تعرضت أراضيهم لموجة من الصقيع أتلفت محصولهم، فغضب منه السلطان الظاهر بيبرس ونفاه من دمشق.
[3] أفتى الإمام النووي بأنه “لا يجوز تغير الوقف عن هيئته، فلا تُجعل الدار بستانا ولا حماما، ولا بالعكس، إلا إذا جُعل الوقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة للوقف”.
[4] أرسل بعض الأمراء الغاضبين من السلطان، فتوى إلى العلماء يستفتونهم “هل من إثم على من قتل رجلا يشرب الخمر، ويفطر في رمضان، ويفسق” فأجاب العلماء بأنه لا إثم على القاتل، فاستغلها الأمراء في قتل السلطان الأشرف خليل بن قلاوون.
[5] عُرف عن السلطان الناصر فرج بن برقوق سوء تدبيره وضعف إدارته للحكم مما أرهق الناس بكثرة الضرائب وارتفاع الأسعار وتنامي الاحتكارات حتى قالوا:”وصار الغلاء لا يُرجى زواله” فوجد الفقيه أن التخلص من السلطان الفاسد الضعيف فرصة للإنقاذ المجتمع.