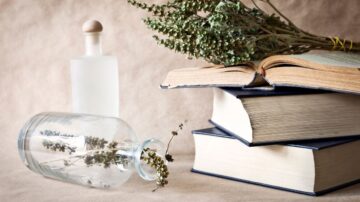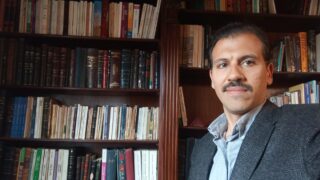قبل التطرق لتاريخ العرب والصيدلة ، عرف الإنسان صناعة الدواء منذ وجد على سطح الأرض، إذ كان عليه أن يبحث عن طعامه وشرابه وأن يتطبب، وكان الطب والصيدلة متلازمان إذ كان الطبيب يفحص المريض ويشخص علته ثم يقوم بتحضير الدواء اللازم له، إلا أنه لوحظ في بعض الحضارات القديمة أن هناك فصلا بين العشاب وبين الطبيب كما هو الحال في مصر الفرعونية وبابل لكن الفصل لم يكن شائعا ولا معترفا به في العصور اللاحقة فلم تنفصل الصيدلة عن الطب إلا في العصور الحديثة.
العرب والصيدلة
لم يختلف الحال عند العرب قبل الإسلام الذين لم يعرفوا التخصيص وكان لديهم نوع خاص من الطب وصفه ابن خلدون بأنه مبني “على تجربة قاصرة على بعض الأشخاص متوارثًا عن مشايخ الحي وعجائزه، وربما يصح منه البعض إلا أنه ليس على قانون طبيعي ولا على موافقة المزاج”، وظل الحال على ذلك حتى مفتتح العصر العباسي بفضل الاهتمام الذي لقيه إحياء العلوم من الخلفاء وتشجيعهم العلماء على التفنن في تحضير الأدوية وتجهيزها، وهو ما أزكى الاهتمام بالصيدلة ودراساتها فأنشئت المدارس لتعليم الصيدلة في بغداد والبصرة ودمشق والقاهرة والأندلس وطليطلة، وأنشئت البيمارستانات وكان بكل منها صيدلية يتولاها صيدني أو صيدلي، وكان بجانب إشرافه على تحضير الأدوية يقوم بتدريب الدارسين في مجال الدواء، وكانت هذه الصيدليات مملوءة بأنواع الأدوية والأشربة والمعاجين وموضوعة في أواني مرتبة وكانت تقدم للمرضى مجانا، وإلى جوار هذه الصيدليات العامة كان هناك صيدليات أقيمت خارج البيمارستانات وهي مملوكة لأفراد وكانت تقدم خدماتها بأجر.
ويذكر المؤرخون أنه منذ القرن الثالث كان هناك أشخاص متعلمون موثوق في كفايتهم صاروا مختصين بإعداد الأدوية وحصلوا على تراخيص تجيز لهم حق ممارسة المهنة، ويقص علينا القفطي في (أخبار الحكماء) أن يوحنا بن ماسويه الطبيب المعروف كان لديه في بيمارستان بغداد واحدا من هؤلاء التحق به وهو صبي ومكث به أربعين عاما حتى “عرف الأدواء داء فداء وما يعالج به أهل كل داء، وهو أعلم خلق الله بانتقاء الأدوية واختيار جيدها وتقى رديها”.
ويبدو أنه كان هناك إشراف حكومي على عمل الصيادلة، فقد سنت القوانين التي تٌنظم عملهم، فقد تعين في كل مدينة كبيرة (عريف) أو موظف كان بمثابة كبير للصيادلة، وكان يضطلع بمهمتين: الأولى تنفيذ القوانين التي تقضي ألا يمارس الشخص المهنة دون ترخيص رسمي أو دون قيد اسمه في سجلات الممارسين للمهنة أو دون اجتياز الاختبارات العلمية التي كان مبدأ تطبيقها في عهد المأمون، والثانية الإشراف على تحضير الأدوية داخل الصيدليات، والتأكد من نقاوة المستحضرات المستخدمة فيها، فإن لم يتمكن من ذلك حُملت إلى مجلسه في طبق ليتأكد من أنها أعدت بالكيفية الصحيحة، على نحو ما أشار ابن بسام في كتابه (نهاية الرتبة).
استنادا إلى هذا ذهب كثير من الدارسين إلى أن الحضارة العربية أسهمت بنصيب وافر في وضع قواعد علم الصيدلة، ويمكن تلخيص هذه الإسهامات في الآتي:
- التمييز بين العاملين في المجال الطبي: فصل العرب بين عمل الطبيب وعمل الصيدلي، حيث حظرت القوانين المعمول بها ودساتير الأدوية على الطبيب امتلاك صيدلية أو بيع العقاقير والتكسب منها، وألزمت الصيدلي بعدم ممارسة الطب بأي صورة كانت، وكرس هذا التمييز لظهور التخصص العلمي الدقيق ومكن كل منهما من التمكن في مجاله.
- وضع قواعد لممارسة المهنة: لم يقف تنظيم الصيدلة عند هذا الحد بل وضع العرب قواعد لتنظيم ممارسة المهنة من مثل: اشتراط كتابة الطبيب لتذكرة طبية مكتوب عليها الأدوية سميت في الشام (الدستور) وفي بلاد المغرب (النسخة) وفي العراق (الوصفة)، كما سنوا تشريعات تضمن مراقبة الصيدليات والأدوية المتداولة، حيث خضعت لرقابة المحتسب، وتم تسعير الدواء، وحظر بيع السموم والعقاقير الضارة.
- العناية بالصيدلة الكيماوية: لعب الكيميائيون المسلمون كابن حيان والرازي دورا في تأسيس “الصيدلة الكيماوية” حيث أدخلوا الكيمياء وتطبيقاتها العملية في مجال الدواء ويعود لهم فضل إدخال كثير من العلاجات النباتية والمعدنية والحيوانية في الطب، ومن هذه العلاجات أمكن تحسين طعم الدواء وسرعة ذوبانه، وتغليف الأدوية وطلائها بالورق.
- الاهتمام بالصيدلة النباتية: أسهم العرب كذلك في إرساء قواعد وأصول ما يسمى ب” الصيدلة النباتية” حيث كانوا يصفون النبات وصفا علميا دقيقا، كيف يؤخذ ومتى ومقاديره وكيف يتعاطى، كما أدخلوا نباتات لا حصر لها ضمن الاستخدام الطبي ولم يسبقهم لذلك أحد، ولذلك ذهب حاجي خليفة في (كشف الظنون) إلى أن علم النبات وثيق الصلة بعلم الصيدلة، وأن الفرق بينهما أن الأول نظري على حين أن الثاني عملي.
- اعتماد التجربة: يمكن اعتبار قيام الصيادلة العرب بتجربة الدواء قبل وصفه أبرز إسهاماتهم في مجال الصيدلة، إذ قاموا بتجريب الدواء على الحيوان أولا لبيان نجاعته ثم تجريبه ثانية على بني الإنسان ومراقبة تأثيراته على المدى الطويل، وفي هذا الصدد يُذكر أن ابن سينا أشار في كتابه (القانون) إلى أن هناك طريقتين لمعرفة مفعول وتأثير الدواء: الأولى التجربة والثانية: القياس على هذه التجربة، وقد وضع شرائط لاختبار الأدوية لا مجال لذكرها لكنها تفيد أن علم الصيدلة بلغ أوج نضجه في العصر الإسلامي.
الصيادلة العرب ومصنفاتهم
شهدت الحضارة العربية عددا كبيرا من الأطباء والصيادلة الذين أخذت المصادر التاريخية وكتب التراجم تقص أخبارهم منذ القرن الثاني، ومن هؤلاء: الكندي و حنين بن إسحاق وعلي بن عباس المجوسي وعلي بن سهل بن ربن الطبري والرازي وابن سينا والزهراوي وابن البيطار وداود الأنطاكي وغيرهم كثير، ونورد فيما يلي طرفا من سيرة بعضهم مع الإشارة لأهم مصنفاتهم.
– كامل الصناعة في الطب: المسمى بالمُلكي لواضعه علي بن عباس المجوسي، وهو مسلم من أصول زرادشتية، ولد في الثلث الأول من القرن الثالث في الأهواز بفارس، وعاش بعض الوقت في كنف البويهيين، وكان من أمهر أطباء زمانه، وقد حقق كتابه شهرة كبيرة وصار المرجع الأول في الصيدلة، إلا أنه بعد صدور كتاب (القانون) لابن سينا مال الناس إليه وتركوا الملكي، والكتاب يقع في جزئين، يضم الجزء الأول عشر مقالات تتناول الأمور الطبيعية أي الأعضاء والأجزاء التي يتكون منها الجسد، والأشياء التي ليست بطبيعية من مثل الهواء والرياضة والأشياء الخارجة عن الطبيعة كالأمراض والأعراض والأسباب المحفزة، وهو يسمي بالجزء النظري، وأما الجزء الثاني فيذكر فيه حفظ الصحة على الأصحاء، ومداواة المرضى التي تكون بالتدبير أو بالأدوية ويقال له الجزء العملي.
– الاعتماد في الأدوية المفردة: وهو من تأليف أحمد بن الجزار القيرواني الذي ولد بأفريقية أو تونس أواخر القرن الثالث، شُغل بالطب ممارسة وتدريسا وتأليفا حيث جمع بين ممارسة الطب وتحضير الأدوية والتدريس للطلاب، وشاع عنه قيامه بجولات في الصحاري والبراري لانتقاء النباتات العشبية التي يستخدمها، وهو يشير في مقدمة كتابه إلى سبب تأليفه فيقول: “ما حملنا على العناية بتأليف كتاب أذكر فيه الأدوية التي عليها اعتماد الأطباء في معالجة الأدواء إلا الرغبة في طاعة الله، والحرص على مرضاته، والتقرب إليه بالمناصحة لأنهاء دولة الإمام التقي والخليفة المرضي القائم بأمر الله”، وأهمية الكتاب تكمن في أنه أول كتاب أُلف في العربية للأدوية المفردة، وهو موضوع لم يٌفرد بالتأليف قبل ابن الجزار إذ عد من مواضيع علم الطب الفرعية، وقد أشار المصنف إلى ذلك في مقدمة كتابه وذكر أنه بحث في مصنفات الأقدمين والمحدثين فلم يجد كتابا جامعا في هذا الباب العظيم المنفعة، ومن باب الأمانة ذكر أن كلا من دياسقوديس وجالينوس اليونانيين تناولاه من قبل إلا أن عملهما شابه التقصير من بضع أمور، فلم يتناولا طبائع الأدوية ولا كميتها وخواصها، ويبدو أن الكتاب حظي بتقدير إذ ترجم إلى اللاتينية والعبرية كما قام مؤلف مجهول بتلخيصه إلى العربية.
– التصريف لمن عجز عن التأليف: وضعه أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي، ولد بالزهراء بالقرب من قرطبة بالأندلس في القرن الرابع وكان طبيبا وجراحا، وهو أشهر من ألف في الجراحة عند العرب وأول من استعمل ربط الشرايين لوقف النزيف، وأهم مصنفاته كتاب التصريف وقد ترجم إلى اللاتينية والعبرية، وهو يقع في ثلاثين مقالة ورغم أنه يصنف كأحد الكتب في الطب إلا أنه لا يضم سوى مقالتين افتتاحيتين في الجراحة أما باقي المقالات فهي تتعلق بالأدوية، وهو يفتتح بذكر أنواع الأدوية التي تعالج الأمراض المختلفة تباعا، ثم يتحدث عن صناعة المعاجين والمراهم والأدهان، ثم أطعمة المرضى مرتبة على الأمراض، ويختتم بذكر طبائع الأدوية وقواها وخصائصها، وفي إصلاحها وكيفية حرقها، وفي تسمية العقاقير باختلاف اللغات وبدائلها، وأعمار العقاقير المفردة والمركبة.
- الجامع لمفردات الأغذية والأدوية: وهو من وضع ابن العطار الأندلسي إمام النباتيين وعلماء الأعشاب في عصر، ولد بالأندلس في الربع الأخير من القرن السادس، جاب الشرق بحثا عن النباتات النادرة ووصل مصر في عهد الكامل الأيوبي فالتحق بخدمته وصار رئيسا للعشابين، ولما مات دخل في خدمة ولده الصالح أيوب، ولابن العطار كتابان في الصيدلة: الأول كتاب المغني في الأدوية المفردة في العقاقير تناول فيه علاج الأعضاء عضوا عضوا خدمة للأطباء، والثاني الجامع لمفردات الأغذية والأدوية، وهو كتاب ذائع الصيت يقع في مقدمة وأربعة أقسام، ويعد من أشهر الكتب الصيدلانية حتى يومنا هذا، وهو عبارة عن مجموعة من العلاجات المستمدة من الحيوان والنبات والمعادن استمدها من مؤلفات اليونان والعرب وتجاربه وأبحاثه الخاصة، وبهذا المعنى يعد الكتاب سجلا للنباتات والعقاقير منذ أقدم العصور حتى عصر مؤلفه.
- تذكرة أولي الألباب: (تذكرة الأنطاكي الطبية ) وهو من وضع داود الأنطاكي الملقب بجالينوس عصره، عاش في مدينة أنطاكية السورية خلال القرن العاشر، ويقع الكتاب في سبعمائة صفحة ويناهز عدد الأدوية المذكورة فيه نحو ألف وسبعمائة دواء، وقسمه صاحبه إلى مقدمة وأربعة أبواب، خص المقدمة بتعداد العلوم الواردة في الكتاب والطب ومكانته وما يلزم متعاطيه وممارسه، وتحدث في الباب الأول عن علم الصيدلة وقواعده، وفي الثاني عن أنواع الأدوية المفردة والمركبة وقوانينها من حيث السحق والغلي وما إلى ذلك، وفي الثالث ذكر أسماء المفردات والمركبات مرتبة حسب حروف المعجم، وفي الرابع الأمراض المختلفة وكيفية مداواتها.
وبالجملة أسهم الصيادلة العرب في إرساء قواعد علم الصيدلة على أسس علمية، واستطاعوا من خلال مصنفاتهم أن يحفظوا لنا التراث اليوناني وأن يضيفوا إليه ويتجاوزوه.
تنزيل PDF