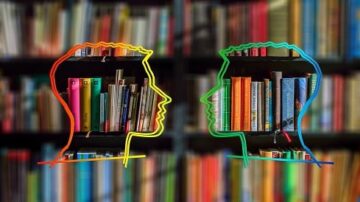الإنصاف لغة : مأخوذ من ( النِّـصْـف ) . وأصل استعماله من الشيئ يكون مشتركا على التساوي بين اثنين ، فمن أخذ نصفه بلا زيادة فقد أنصف ، ومن أعطى شريكه نصفه بلا نقصان فقد أنصف . ومن حَكمَ أو قَسَم بين شريكـين ، فأعطى كل واحد نصفه بلا زيادة ولا نقصان فقد أنصف . ثم اتسع استعمال اللفظ ومشتقاته ، للدلالة على السَّوِية بين الناس ، فيما لهم وما عليهم ، سواء كان النصفَ أو غيرَه مما هو مستحق ، وسواء كان ذلك في الأشياء ، أوفي الأفعال ، أوفي الأقوال .
والعلاقة اللغوية بين الإنصاف والوسطية ، تظهر في مثل قولهم : انتصفَ النهار، أو مُنتصفُ النهار، أي وسطُه . وذلك حين يتساوى نصفه الذي مضى ، مع نصفه الذي بقي . فمنتصف النهار وسطه . وكذلك يقال في منتصف الليل ، أو منتصف العمر، أو منتصف الطريق… فكل ذلك يعني نقطة التوسط بين نصفين متساويين.
وأما الإنصاف بمعناه العلمي والخُلقي ـ وهو المقصود الآن ـ فالمراد به إعطاء الناس ما يستحقونه كاملا ، بلا بخس ولا ولا تحيز ولا محاباة . وقد يكون ذلك بالأقوال ، وقد يكون بالأفعال ، أو بهما معا في آن واحد . ولا شك أن هذا المفهوم يتشابه ـ ويكاد يتطابق ـ مع مفهوم العدل. ولذلك قال بعض العلماء : العدل والإنصاف توأمان (التوقيف على مهمات التعاريف ، للمناوي ، ص 64 ، تحقيق عبد الحميد حمدان ـ القاهرة 1410).
وعلى الرغم من كون العدل والإنصاف من معدن واحد ، فالظاهر أن بينهما عموما وخصوصا في الاستعمال . فالعدل يستعمل في مواطن التنازع والتخاصم ، ويكون ممن له صلاحية الحكم والتصرف في الأمر. وأما الإنصاف فأعم من هذا وأوسع ، حتى إن العلماء يتحدثون عن إنصاف العبد مع ربه ، وعن إنصافـه مع نفسه ، وعن إنصاف غيره من نفسه ، وعن الإنصاف بين الناس . كما أن استعمال الإنصاف دخل كثيرا في المسائل والخلافات العلمية والفكرية ، كما سنرى قريبا .
ولعل الإنصاف يكون أخص من العدل ، من حيث يجري استعماله خاصة في مواطن تكون عادة مَظِنَّةً للميل والتحيز . فالفعل أو القول يوصف بالإنصاف ، إذا وقع حيث كان يُخشى أو يفترض عدمه ، كأن يعطي الإنسان الحق لغيره على حساب نفسه ، أو ينصف البعيد على القريب ، أو ينصف المخالف على الموافق . بينما العدل يكون في هذه الأحوال وفي غيرها . ولعل هذا ما عناه الراغب الأصفهاني بقوله : ” والإنصاف من العدل “( المفردات 1/160ـ نشر مكتبة نزار الباز بمكة المكرمة ـ ط1 ـ 1418/1997)
الإنصاف والاختلاف
وجود الاختلاف بين الناس ـ عامتهم وخاصتهم ـ هو غالبا مظنةٌ للخصومات والحزازات وإفراط المتخالفين بعضهم على بعض ، مما يفقدهم الإنصاف ، وحتى القدرة على الإنصاف . ويشتد هذا كله ، بقدر شدة الاختلاف وحساسيته عند المختلفين ، وبقدر ما تسوء أخلاق المتخالفين وأخلاق أتباعهم وأنصارهم . وها هنا تشتد الحاجة إلى الإنصاف والمنصفين . وتشتد هذه الحاجة أكثر، حين يتحول الاختلاف إلى عداوة وصراع . وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر.
ومن هنا احتاج العلماء إلى كثرة التذكير بالحاجة إلى الإنصاف ، عند تطرقهم لمواطن الاختلاف بين الطوائف والمذاهب . ويظهر هذا بجلاء لافت للانتباه ، في كثرة الكتب التي جمعت في عناوينها بين الإنصاف والاختلاف. وهذه جملة منها :
• الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف لابن عبد البر النمري (مالكي ت 463)
• الإنصاف في مسائل الخلاف لابن العربي المعافري (مالكي ت 543)
• الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف ، لابن السيد البطليوسي ( مالكي ت521)
• الإنصاف في مشاجرة الأسلاف ، لطاش كبري زادة (حنفي ت 968)
• إيثار الإنصاف ، لعلم الدين العراقي ( شافعي ت 704)
• إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ، لسبط ابن الجوزي ( حنبلي ثم حنفي ت 654)
• الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، لعلاء الدين المرداوي (حنبلي ت 885)
• الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي الوفاء بن الأنباري (شافعي ت 577)
• الإنصاف في علم الخلاف ، لمحمد الأسدي المقدسي (شافعي ت 808)
• الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف ، لشاه ولي الله الدهلوي (حنفي ت 1176)
• الإنصاف ، لأبي الحسن بن غازي
• الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف ، للأمير الصنعاني
• إيثار الحق على الخلق ، لابن المرتضى اليماني (زيدي)
وهذا الكتاب الأخير لا يحمل في عنوانه اسم الإنصاف ، ولكن معناه واضح في صيغة عنوانه ( إيثار الحق…) . وكلمة الإيثار موجودة كذلك مع كلمة الإنصاف ، في عناوين أخرى من الكتب المذكورة أعلاه . وذلك يعني أن الإنصاف وقولَ الحق في مواطن الاختلاف ، هو نوع من الإيثار الذي لا تستطيعه ولا تبذله إلا النفوس الكريمة المستقيمة. وفي صحيح البخاري ” باب: إِفْشَاءُ السَّلَامِ من الْإِسلامِ، وقال عَمَّار:ٌ ثَلَاثٌ من جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ: الْإِنْصَافُ من نَفْسِكَ، وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ، وَالْإِنْفَاقُ من الْإِقْتَارِ” . فقد جمع عمار ـ رضي الله عنه ـ في هذا النص بين الإنفاق من المال وهو إيثار مادي، والإنصاف من النفس وهو إيثار معنوي، وقد يكون ماديا أيضا.
وقال ابن رجب في فتحه: ” …الإنصاف من النفس ، وهو من أعز الخصال ، ومعناه : أن يـعرف الإنسان الحق على نفسه ويوفيه من غير طلب . “( فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي: 1/ 68)
دروس قرآنية في الإنصاف
قدم لنا القرآن الكريم دروسا بليغة راقية في الإنصاف بشتى صوره وفي مختلف مجالاته. تارة في صيغة أوامر ونواهٍ ، وتارة من خلال وصفه وإنصافه لأعدائه والمكذبين به ، وتارة من خلال وقائع فعلية تطبيقية .
فمن أوامره ونواهيه في الموضوع :
– قوله تبارك وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَو الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) [النساء/135]
– وقوله سبحانه: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) [المائدة/8]
فقد تضمنت الآيتان الأمر بالتزام القسط والإنصاف ، والنهيَ عن تركه وتنكبه ، وذلك في أشد المواطن على النفس وأدعاها إلى الميل والتحيز.وهي عموما تتمثل في حالات الحب والبغض .
• ففي الآية الأولى: أمرٌ بغاية ما يمكن من القسط الإنصاف، ولو كان ضد نفسك، أو ضد والديك، أو أقربِ الناس إليك . وبمثل هذا جاء قوله تعالى: (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى) [الأنعام/152].
• وفي الآية الثانية: أمرٌ مماثل بالقسط، لكنه مؤكد بالنهي عن الضد. ومحل الأمر والنهي هنا، هي حالات العداوة والكراهية. فكما لا يجوز التحيز لفائدة النفس وذوي القرابة والمودة، فكذلك لا يجوز التحيز ضد ذوي الخصومة والعداوة والبغضاء.
• ومن إنصافه لأعدائه ومناوئيه، إنصافـه في آيات عديدة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، أذكر منها :
• قوله سبحانه (وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ) في حق بني اسرائيل [الأعراف/159] . فالتاريخ المجلل بالسواد لبني إسرائيل، وكونُهم أشدَّ الناس عدواة للإسلام والمسلمين، لم يمنعا من إنصافهم والإشادة بمن أحسن منهم .
• وقوله عن النصارى (وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آَمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ) [المائدة/83-86]
• ومن قواعد الإنصاف المؤصلة في القرآن الكريم، ماجاء حديث أَنَسٍ، عنِ النبي ﷺ “لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ
وفي صحيح مسلم وغيره: ”حتى يحب لِجارِه..
وفي صحيح ابن حبان: “لا يبلغ عبدٌ حقيقة الإيمان، حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير”.
فأصْلُ هذا الحديث في القرآن الكريم، كما يوضح ذلك ابن عاشور بقوله : ” وقد تكرر في القرآن الترويض على قياس المرء حق غيره على حق نفسه. قال تعالى في معرض التحذير من أكل مال اليتيم (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ) [النساء/9] ، وقال: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) [النساء/94].
والمغزى المشترك في الحديث وفي الآيتين الأخيرتين، هو أن من أراد أن ينصف غيره في حالة من الحالات، وفي معاملة من المعاملات، فليتخذ نفسه معياراً لذلك، أي لِيضعْ نفسه في مكانهم وفي حالتهم، ولينظر كيف يحب أن يعامَل وهو، لو كان في مكانهم، ثم ليفعل ذلك وليحكم به على غيره .
ولا شك أن الالتزام الفعلي بهذا المبدإ ليس بالأمر الهين على النفوس ، ولذلك فهو تحتاج فيه إلى ”ترويض“، حسب تعبير ابن عاشور .
ومن الوقائع التطبيقية للإنصاف القرآني ، أذكر هذين النموذجين :
• النموذج الأول من قصة ملكة سبأ مع سليمان عليه السلام . فقد نوه القرآن الكريم بهذه المرأة في مشورتها وحصافة رأيها وحسن تدبيرها، وهي على شركها قبل أن تسلم، وذلك في قوله تعالى (قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ …) [النمل/29-35]
قال العلامة القرطبي عند تفسيره هذه الآيات : “فأخذت في حسن الأدب مع قومها، ومشاورتهم في أمرها، وأعلمتهم أن (مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ) ذلك مُطَّرِد عندها في كل أمر يـعرض، بقولها: فكيف في هذه النازلة الكبرى. فراجعها الملأ بما يُقـر عينها، من إعلامهم إياها بالقوة والبأس، ثم سلموا الأمر إلى نظرها“. قال القرطبي: “وهي محاورة حسنة من الجميع”. (الجامع لأحكام القرآن، 13/194 ـ ط1967 ـ دار إحياء التراث العربي ببيروت).
كما أقر القرآن الكريم قولها حين قالت: (إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً) [النمل: 34]، فعقب، قال ابن عباس: (وكذلك يفعلون) سبحانه مؤيدا كلامها بقوله: هو من قول الله عز وجل، معرِّفاً لمحمد ﷺ وأمته بذلك ومخبرا به .
وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي: ” ألا ترى أن ملكة سبأ، في حال كونها تسجد للشمس من دون الله، هي وقومها، لما قالت كلاما حقا، صدقها الله فيه، ولم يكن كفرها مانعا من تصديقها في الحق الذي قالته، وذلك قولها فيما ذكر الله عنها: (إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً) . فقد قال تعالى مصدقا لها في قولها: (وكذلك يفعلون) ” أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن، 1/5 ـ طبعة عالم الكتب ـ ببيروت ـ د ت ( )
• النموذج الثاني من الإنصاف القرآني ، يتمثل في واقعة شهيرة وقعت بالمدينة أيام رسول الله ﷺ، وملخصها: أن نفراً من الأنصار – قتادة بن النعمان وعمه رفاعة – غزوا مع رسول الله – ﷺ – في بعض غزواته، فسُرقت درع لأحدهم (رفاعة). فحامت الشبهة حول رجل من الأنصار من أهل بيت يقال لهم: بنو أبيرق. فأتى صاحبُ الدرع رسولَ الله – ﷺ – فقال : إن طعمة بن أبيرق سرق درعي. ( وفي رواية : إنه بشير بن أبيرق. وفي هذه الرواية : أن بشيراً هذا كان منافقاً يقول الشعر في ذم الصحابة وينسبه لبعض العرب!). فلما رأى السارقُ أن التهمة قد اتجهت إليه، عمد إلى الدرع فألقاها في بيت رجل يهودي (اسمه زيد ابن السمين) . وقال لنفر من عشيرته إني غيبت الدرع، وألقيتها في بيت فلان. وستوجد عنده. فانطلَقوا إلى رسول الله – ﷺ – فقالوا: يا نبي الله! إن صاحبنا بريء، وإن الذي سرق الدرع فلان. وقد أُحِطنا بذلك علماً. فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس، وجادل عنه، فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك … ولما عرف رسول الله – ﷺ – أن الدرع وجدت ـ فعلا ـ في بيت اليهودي، قام فـبَـرأ ابن أبيرق وعذره على رؤوس الناس. وكان أهله قد قالوا للنبي – ﷺ – قبل ظهور الدرع في بيت اليهودي – إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا، أهلِ إسلام وصلاح، يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت! قال قتادة: فأتيت رسول الله – ﷺ – فكلمته فقال: « عمدتَ إلى أهل بيت يُذكر منهم إسلام وصلاح، وترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة؟ » قال: فرجعت، ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله – ﷺ – في ذلك. فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله – ﷺ – فقال : الله المستعان … انظر تفسير الطبري 9 /182 ـ 184ـ تحقيق أحمد شاكر ـ مؤسسة الرسالة ـ 1420/2000).
فـعندها نزلت آيات الإنصاف والقسطاس المستقيم، الآياتُ التي برَّأت اليهودي الذي لُفقت ضده التهمة الكاذبة، وفضحت الخيانة والتزوير وأهلهما من المسلمين، وتوجهت باللوم والتنبيه إلى رسول الله ﷺ، لكي يحْذَر المبطلين ولا يقع في أحابيلهم، فيدافعَ عنهم ويبرئهم من حيث يظنهم مظلومين. ثم توجهت الآيات بالنكير الشديد إلى من وقعوا في الظلم والزور ضد اليهودي قال الله تعالى: )…إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا).
يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله في شأن هذه الواقعة : ” … إنه في الوقت الذي كان اليهود في المدينة يطلقون كل سهامهم المسمومة التي تحويها جعبتهم اللئيمة على الإسلام والمسلمين؛ والتي حكت هذه السورة وسورة البقرة وسورة آل عمران، جانباً منها ومن فعلها في الصف المسلم . .
في الوقت الذي كانوا فيه ينشرون الأكاذيب؛ ويؤلبون المشركين؛ ويشجعون المنافقين، ويرسمون لهم الطريق؛ ويطلقون الإشاعات؛ ويضللون العقول؛ ويطعنون في القيادة النبوية، ويشككون في الوحي والرسالة؛ ويحاولون تفسيخ المجتمع المسلم من الداخل، في الوقت الذي يؤلبون عليه خصومه ليهاجموه من الخارج . . والإسلام ناشىء في المدينة، ورواسب الجاهلية ما يزال لها آثارها في النفوس؛ ووشائج القربى والمصلحة بين بعض المسلمين وبعض المشركين والمنافقين واليهود أنفسهم، تمثل خطراً حقيقياً على تماسك الصف المسلم وتناسقه . .
في هذا الوقت الحرج، الخطر الشديد الخطورة . . كانت هذه الآيات كلها تتنزل، على رسول الله – ﷺ – وعلى الجماعة المسلمة، لتنصف رجلاً يهودياً، اتهم ظلماً بسرقة؛ ولـتُدين الذين تآمروا على اتهامه، وهم بيت من الأنصار في المدينة. والأنصار يومئذ هم عدة الرسول – ﷺ – وجنده …” (في ظلال القرآن 2 / 231 ( عند تفسير الآيات المذكورة ) ـ
الإنصاف العلمي
لا يختلف الإنصاف ـ في جوهره ـ من مجال لآخر، فلا خصوصية للإنصاف العلمي عن أي إنصاف آخر. فالإنصاف مبدأ ومنهج وخُلُق، سواء كان علميا أو قضائيا أو اجتماعيا أو سياسيا…
وإذا كان هناك مِن خصوصية للإنصاف في المجال العلمي، فهي أنه أوجب فيه وأليق به من أي مجال آخر، وأن الإخلال به في هذا المجال، هو أضر وأشنع منه في أي مجال آخر. فالعلم أولاً ، من طبيعته أن يكون ثمرة للنزاهة والموضوعية في النظر والحكم. وهو يفقد صفته العلمية بقدر ما يفقد من النزاهة والإنصاف ، حتى إذا كثر فيه التحيز والهوى صار مجرد جهل وإنتاج للجهل. وكما قال الإمام الشاطبي: ” وإذا صار الهوى بعضَ مقدمات الدليل لم ينتج إلا ما فيه اتباع الهوى.” (الموافقات 4 /222)
والأسباب التي تمنع الإنصاف وتدفع إلى التحيز والإجحاف في المجال العلمي، قد تكون إعجابا بالنفس وتنزيهاً لها، وقد تكون خوفا من الانتقاص في نظر الناس، قد تكون لمجرد الغيرة والكراهي، وقد تكون تعصبا مذهبيا، أو تحزبا طائفيا، لنصرة “أصحابنا ” والنكاية بـ”خصومنا ” ، وقد تكون منفعة تجتلب، أو مضرة تجتنب …
وكل هذه الأسباب وغيرها، قد شابت قدرا كبيرا من تراثنا وتاريخنا العلم ، وخاصة في العلاقات والانتقادات المتبادلة بين المذاهب والطوائف والفرق؛ كما بين السنة والشيعة، وبين المعتزلة والأشاعرة، وبين أهل النظر وأهل الأثر، وبين المذاهب الفقهية، وبين السلفية والصوفية …
ولست أعني بذلك النقاشات والاعتراضات والردود العلمية والفكرية البريئة والنزيهة، فهذه لا بد منها ومرحب بها، ولكني أعني الانتصار الدائم للنفس والمذهب والطائفة، والمناوأة المطَّردة للمخالف، شخصا كان أو مذهبا أو طائفة. وأعني كذلك تلك النظرة التي لا يرى أصحابها في ذاتهم، ولا يذكرون لأنفسهم ولجهتهم، إلا كل خير وصواب وتنزيه، مع التعظيم والتفخيم. ولا يرون ولا يذكرون للجهة المخالفة أو المخاصمة إلا كل عيب وخلل وزلل، مع تهويله وتشنيعه.
قال ابن القيم رحمه الله : ” وهذه آفة ما نجا منها إلا من أنعم الله عليه وأهَّله لمتابعة الحق أين كان ، ومع من كان. وأما من يرى أن الحق وقفٌ على طائفته وأهل مذهبه ، وحِجْرٌ محجور على مَنْ سواهم، ممن لعله أقرب إلى الحق والصواب منه ، فقد حُرم خيرا كثيرا، وفاته هدى عظيم” (مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة 2/75 ـ دار الكتب العلمية ببيروت ـ د ت) .
ففي مثل هذه الحالات يسود الغلو والتشدد والتشنج، وتضطرب الموازين، وتلتبس الحقائق، ويضيع الاعتدال والوسطية والإنصاف، وتضيع الفائدة والاعتبار بمثل قوله تعالى(أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ) [الرحمن/8، 9]
ومن الأمثلة الشهيرة في هذا الباب، ما ذكره ابن القيم عن مواقف بعض الفئات من الصوفية وما يقع لهم من تعبيرات وأحوال، مما يعرف بشطحات الصوفية، حيث قال : ” وهذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس :
ـ إحداهما حُجبت بها عن محاسن هذه الطائفة ولُطفِ نفوسهم وصدق معاملتهم، فأهدروها لأجل هذه الشطحات ، وأنكروها غاية الإنكار، وأساءوا الظن بهم مطلقا. وهذا عدوان وإسراف؛ فلو كان كل من أخطأ أو غلط تُرك جملة وأهدرت محاسنه، لفسدت العلوم والصناعات والحِكَم وتعطلت معالمها .
ـ والطائفة الثانية حُجبوا بما رأوه من محاسن القوم وصفاء قلوبهم وصحة عزائمهم وحسن معاملاتهم، عن رؤية عيوب شطحاتهم ونقصانها، فسحَبوا عليها ذيل المحاسن، وأجْرَوا عليها حكم القبول والانتصار لها واستظهروا بها في سلوكهم .
وهؤلاء أيضا معتدون مفرطون .
ـ والطائفة الثالثة، وهم أهل العدل والإنصاف، الذين أعطوا كل ذي حق حقه وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته. فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول، ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح، بل قبلوا ما يقبل وردوا ما يرد.” ( مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين 2/39 ـ دار الكتاب العربي ببيروت ـ ط2 ـ 1393/1973).
إن المسلمين عامة، وعلماءهم خاصة، مفروض فيهم ومفروض عليهم، أن يكونوا منصفين في جميع الأحوال، ومع جميع الأصناف: مع القريب والبعيد، ومع الموافق والمخالف، ومع الولي والعدو، ومع الحبيب والبغيض .والإنصاف لا يعني التنازل عما هو حق وصواب وعدل، ولا يعني التخلي عن نصرة من تجب نصرتهم وتأييدهم، ولا مقاومة من تجب مقاومتهم. كما أن الإنصاف لا يعني المداهنة مع ما هو باطل وضلال وظلم. لا ، ليس هذا هو المطلوب في الإنصاف .
الإنصاف مع الموافق والقريب، والولي والحبيب، يكون بعدم الميل معهم، وعدم مجاراتهم، وعدم الانتصار لهم لمجرد قربهم وحبهم .والإنصاف مع المخالف والبعيد، والعدو والبغيض، يكون بعدم التحامل عليهم، وعدم المبالغة فيما يؤخذ عليهم، وعدم بخسهم شيئا من محاسنهم وفضائلهم، ومما لهم في حق وصواب.
وبعبارة أوضح: الإنصاف هو أن ينصف المسلمُ غيرَ المسلمين، وأن ينصف منهم المسالمين والمحاربين. والإنصاف هو أن ينصف السنيُّ الشيعةَ، ويقول لهم أحسنتم وأصبتم، في إحسانهم وإصابتهم، أو يقول لبعض أهل السنة: أخطأتم وأسأتم وظلمتم، حين يصدر عنهم شيئ من ذلك . وهكذا يفعل الشيعيُّ مع السنة .
والإنصاف هو أن ينصف كل ذي مذهب المذهب الآخر، وأن ينصف كل ذي طائفة الطائفة الأخرى، وينصف كل ذي رأي أصحاب الرأي الآخر…
ويحضرني هنا الموقف الجليل لابن تيمية ـ وهو من أساطين المذهب الحنبلي ـ حين سئل عن أصول المذهب المالكي، ومنزلةِ الإمام مالك … فأملى ـ رحمه الله ـ في ذلك كتابا مضمنه ( تفضيل مذهب الإمام مالك وأهل المدينة وصحة أصوله ).
ومثل هذا موقف الإمام الشاطبي ، حين تطرق إلى بعض الاجتهادات الفقهية التي تنتقد على الحنفية ويعابون بها. فقد شرحها شرحا رفيعا، ودافع عنها دفاعا باهرا، ثم ختم ذلك بقوله: ”وهذه جملة مما يمكن أن يقال في الاستدلال على جواز التحيل في المسألة. وأدلة الجهة الأخرى ـ يقصد أصحابه المالكية ـ مقررة واضحة شهيرة ، فطالعها في مواضعها. وإنما قُصِد هنا هذا التقرير الغريب، لقلة الاطلاع عليه من كتب أهله. إذ كتب الحنفية كالمعدومة الوجود في بلاد المغرب، وكذلك كتب الشافعية وغيرهم من أهل المذاهب. ومع أن اعتياد الاستدلال لمذهب واحد، ربما يُكسب الطالبَ نفورا وإنكارا لمذهبٍ غير مذهبه، من غير إطلاع على مأخذه، فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد في الأئمة الذين أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين واضطلاعهم بمقاصد الشارع وفهم أغراضه . وقد وُجد هذا كثيرا.” (الموافقات2 / 390)
فهذا هو الإنصاف الذي يتحقق به العدل والمحبة، والاعتدال والوسطية. وبدونه تفشو المغالاة والكراهية، والإجحاف والعصبية. وتأتي بعد ذلك شرور لا نهاية لها إلا بنبذ مقدماتها وبداياتها ومسالكها .