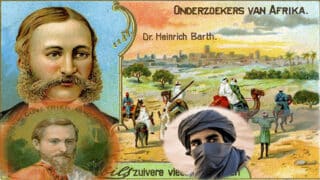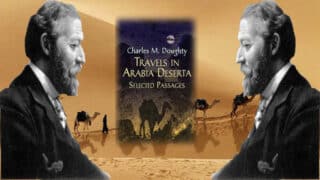على بعد ٤٠ كيلو مترا من أمستردام، عاصمة هولندا، تقع مدينة صغيرة كظيظة بالسكان، تدعى “ليدن”، مدينةٌ جميلةٌ، عتيقة المباني، صغيرة الأزقة، تتعرض بين الحين والحين للفيضانات، وتطل على فرع من فروع نهر الراين.
في تلك المدينة، أسست جامعة سيكون لها دور غير عادي في التاريخ، لأنها كانت مهداً للاستشراق، العملية الطويلة العريضة العميقة الجادة، التي هدفت إلى التعرف على تلك الحضارة القادمة من الشرق، والتي كسرت الكثير من الصلبان، وأخذت من أيدي النصارى كثيراً من البلدان، وقدمت أنموذجاً حضارياً آسراً للخصم قبل الحليف.
ولدت تلك الجامعة سنة ١٦٧١، وتخرّج فيها الكثير من المستشرقين: الباحثين العلميين، والجواسيس، وطلائع الاستعمار، وتنوعت ثمراتها بين طيب وخبيث وبين بين!
وبعد ولادة تلك الجامعة بثلاثة عشر عاماً، وفي مدينة تدعى “جوركوم” تبعد نحو ثمانين كيلاً عن ليدن، وُلد طفلٌ يدعى توماس إربنيوس، وبعد استكمال دراسته الأولية شد الرحال إلى ليدن ليدرس في جامعتها علم اللاهوت.
في تلك الأيام التي التحق فيها إربنيوس بجامعة ليدن، كان ثمة أستاذٌ زائر يدعى سكاليجر، وكان عالماً بالعربية، يعرفها أحسن من كثير من أهلها، وقد تعلمها في فرنسا والأندلس، وكان يدمن قراءة القرآن الكريم، ويؤلف التحقيقات والبحوث مستنداً إلى معرفة واسعة بالعربية ولغات أخرى!
كان لسكاليجر مقدارٌ عظيم في وجدان إربنيوس، واتضح ذلك حين نصحه سكاليجر بأن يتعلم اللغة العربية، فقرر وضع نصيحة أستاذه موضع التنفيذ.
استكمل إربنيوس دراسته في الجامعة، قبل أن يتلفت يمنة ويسرة ليبحث عن معهد أو مدرسة لتعليم العربية في هولندا دون أن يجد لها عيناً ولا أثراً، يبدو أنه لا بد من السفر للخارج! بحث إربنيوس في إنجلترة، ولم يجد بغيته، وأخيراً وجد ضالته في قسم اللغة العربية بجامعة باريس، فشد الرحال إليها وهو في الخامسة والعشرين من عمره، ووجد أساتذة بارعين لم يبخلوا عليه بتعليم ولا توجيه، ولا شحوا عليه بمخطوط ولا مطبوع، وساعدته مثابرته، وأسعفه ذكاؤه اللغوي، فأخذ يتعلم العربية، ويبرع فيها إلى درجة جعلت أساتذته يحملونه على محمل الجد.
أحب إربنيوس اللغة العربية، ولم يكن ليكتفي بما يتلقاه منها في الجامعة، بل أخذ يبحث عن إنسان عربي يمارس معه اللغة العربية حتى يستقيم بها لسانه، وهداه بحثه إلى عالم أكاديمي مرموق، يدعى “يوسف أبو دقن” وهو قبطي من نصارى مصر، يقيم في باريس، وينشر أبحاثه لدى أرقى الجامعات الأوروبية، واتصل حبل الود بين الرجلين، فصارا يلتقيان كثيراً، وبالمران والمراس أخذت لغته العربية تنمو وتتحسن..
“سوميور”، مدينة صغيرة غربي فرنسا، تشتهر بصناعة الخمور، على أرضها تنمو كروم العنب، وفي جوف الأرض تختبئ صناديق يعتّق فيها النبيذ، وغير بعيد تنمو صناعات الخمر المساندة: كصناعة القوارير، والجلود الحاملة لها، وأشياء من هذا القبيل..
في المدينة ذاتها ثمة مبان عتيقة، من بينها الدير الملكي الذي كان أكبر دير في أوروبا.. وكان ديراً مختلفاً، فقد أسس له نظامٌ يقضي بأن تتولى النساء شؤون القيادة، وأن يضم الدير الجنسين معاً، كانت صرعة جديدة سرعان ما انتشرت في أوروبا كما ينتشر اللهب في أعواد القش اليابسة.
إلى “سوميور” ذهب إربنيوس ليواصل دراساته في اللاهوت، وأقام بها عاماً.. وفي ذلك العام قرر أن ينصرف عن اللاهوت إلى اللغة العربية، وأن يسهل تعلمها على من يأتي بعده من المستشرقين فلا يضطر كل راغب في تعلم العربية إلى السفر نحو باريس كي يدرسها.
ولكنه شعر بحاجته إلى تعلم المزيد من لغة العرب؛ فأقبل على الدرس الذاتي لمتون النحو، مثل الآجرومية لمحمد بن داود الصنهاجي، والكافية لجمال الدين ابن الحاجب، ونحو ذلك من الكتب التي أتيحت له.
لم يقتصر جهد اربنيوس على تعلم اللغة العربية وحسب؛ فقد تعلم معها اللغة الإثيوبية، واللغة الفارسية.
وشرع بالعمل على كتاب يضم مئتي مثل عربي مترجم إلى اللاتينية، بالتعاون مع أستاذه سكاليجر، وسافر إلى باريس ثم إلى كونفلانس، المدينة الصغيرة الواقعة على نهر السين، كي يعمل هناك على طبع الكتاب، لكن كما يقول العرب: أردت عمراً وأراد الله خارجة! فقد التقى إربنيوس بتاجر مغربي يسمى “أحمد بن قاسم الأندلسي”، فواعده أن يلتقيا في باريس ويمكثا معاً بضعة أشهر يعينه فيها ذلك المغربي على تعلم العربية باللهجة المغربية، ومن ذلك الرجل المغربي أخذ اربنيوس يتعلم عن الإسلام، وحياة المسلمين.
عاد إربنيوس بعد ذلك التجوال إلى هولندا، وهناك شرع يفاوض إدارة الجامعة على إنشاء كرسي للغة العربية، وبعد شد وجذب أفلحت جهوده، وعين أستاذاً للغة العربية في جامعة ليدن.
أقبل إربنيوس على التدريس بحماسة منقطعة النظير، وألّف كتاباً لتعليم العربية للناطقين باللاتينية، ظل مرجعاً وحيداً لتعليم اللغة العربية في أوروبا أزيد من مئتي سنة.
كما قام بتأليف كتاب للأمثال العربية، انتشر في أوروبا بين دارسي اللغة العربية لقرون، وأصدر كذلك كتاباً حوى سورة يوسف مطبوعةً مضبوطةً بالشكل، مع ترجمة معانيها إلى اللغة اللاتينية، كما نشر الآجرومية، وكتاب العوامل المئة للجرجاني، مترجمين إلى اللاتينية، وعمل على شرح وترجمة كتاب في التاريخ الإسلامي ثم إصداره.
لم يكن إربنيوس معلماً وباحثاً ومترجماً ومحققاً وحسب، بل كان رائداً في الطباعة التي كانت تعتمد في وقته على رصف الحروف في قوالب معينة، في منزله أخذ إربنيوس يصب قوالب للحروف العربية بحجم متوسط، وأنشأ مطبعةً عرفت بمطبعة “برايل” طبع فيها إصداراته التي سلف ذكر أكثرها..
حتى إذا بلغ إربنيوس أشده، وبلغ أربعين سنةً، مات عام ١٦٢٤! بعدما مهد الطريق لمن جاء بعده من المستشرقين، ليقتحموا حمى اللغة العربية، ويشرعوا في التعرف على الإسلام وحضارته.