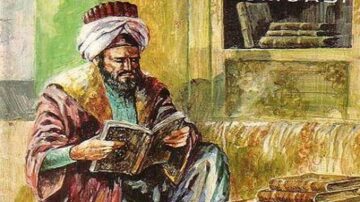يُعَدُّ تتبُّعُ سيرِ السلفِ الصالح من الصحابة ومن تلاهم من الأئمّة الربانيين والعباد والزهاد، من أفضل الوسائل لغرس الخصال الكريمة في النفوس وبعث روح العزائم. ومن أبرز جوانب الفائدة في هذه السير: أنها تحثّ على التخلِّي عن سفاسف الأمور والتحلِّي بمعالي الأخلاق. وقد قال أبو حنيفة رحمه الله: سير الرجال أحب إليَّ من كثير من الفقه”[1]. إذ إنّ في مطالعة أخبارهم واقتفاء آثارهم ما يُنمِّي الخلق، ويبعث الهمّة، ويقرّب الناس من تحقيق مقامات رفيعة في الدين والدنيا.
أهمية ذكر السير والتواريخ
قال ابن الجوزي: واعلم أن في ذكر السير والتواريخ فوائد كثيرة أهمها فائدتان:
أحدهما أنه إذا ذكرت سيرة حازم ووصفت عاقبة حاله، أفادت حسن التدبير واستعمال الحزم.
أو إن ذكرت سيرة مفرط ووصفت عاقبته أفادت الخوف من التفريط، فيتأدب المتسلط ويعتبر المتذكر ويتضمن ذلك شحذ صوارم المعقول، ويكون روضة للمتنزه في المنقول.”[2]
ومن روائع نماذج سير أولئك الأكابر الصالحين ما حدث بين العابد الذي غلب زهده وعبادته على علمه، وبين العالم الرباني المعتدل الذي جمع بين العلم والعمل.
نماذج من سير الأكابر: الإمام مالك والعمري الزاهد
من هو العمري الزاهد؟ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي العُمري المدني[3] وكان معروفا بالزهد والتقشف ولا يذكر إلا بالزهد والعبادة، وكان لا يرى مخالطة الأمراء وإذا ولي أحد من أقاربه أو معارفه منصبا هجره ولا يكلمه، إلى درجة أنه غادر المدينة إلى البادية زاهدا ناسكامترفعاً، وصار نسبته مقرونا بالزهد ويقال فيه: العمري الزاهد.
موقفه من مخالطة الأمراء
وكان أيضا مشهورا بالشدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق، ولا يحابى في ذلك أحدا كائنا من كان، ولا يمالئ أحداً بل يقول الحق ويجهر به، وقيل إنه “لم يكن بالمدينة أهيب منه عند السلطان والعامة[4]
وله في هذا الباب أخبار شهيرة مع أمير المؤمنين هارون الرشيد وخاصة في الحج حتى قال هارون الرشيد: “إني لأحب أن أحج كل سنة، ما يمنعني إلا رجل من ولد عمر ثَمَّ، يُسمعني ما أكره[5] إلى هذا الحد يهابه مثل هارون الرشيد الخليفة، وكذا الجيوش والأمراء.
مكانته بين العلماء
وقد رأى الإمام ابن عيينة أن حديث:” يُوشك أن يضرب الناسُ أكبادَ الإبل، يطلبون العلم، لا يجدون عالمًا أعلمَ من عالم أهل المدينة”[6] يصدق على العمري الزاهد قائلا:” إنما العالم من يخشى الله، ولا نعلم أحدا كان أخشى لله من العمري”[7] وهذا الرأي مرجوح عند أهل العلم وذهبوا إلى أن تأويله في الإمام مالك واضح، لأنه الذي ضرب الناس إليه أكباد الإبل طلبا للعلم خلافا للعمري.
قال ابن عبد البر معقبا على كلام ابن عيينة السابق:” ليس العمري ممن يلحق في العلم والفقه بمالك، وإن كان شريفا سيدا عابدا” [8]
ما جرى بين العمري وبين الإمام مالك وغيره
سبب الخلاف
سلك العمري الزاهد كعادته مسلك الغلطة والشدة في الإنكار على الأئمة المعاصرين له كسفيان بن عيينة وابن أبى ذئب ومالك، فسلط لسانه عليهم في أمور لا تسوغ له الخشونة في الخطاب، بل ليست من المنكر أصلا، ومثلا ما كتبه إلى مالك، وابن أبي ذئب وغيرهما وأغلظ لهم فيها، وقال:” أنتم علماء تميلون إلى الدنيا وتلبسون اللين، وتدعون التقشف، فكتب له ابن أبي ذئب كتابا أغلظ له، وجاوبه مالك جواب فقيه”.[9]
ولما علم الإمام مالك أنه بدى كتب إليه:” إنك بدوت، فلو كنت عند مسجد رسول اللهﷺ؟ فكتب إليه: إني أكره مجاورة مثلك، إن الله لم يرك متغير الوجه فيه ساعة قط[10]. وهل يستحق الإمام مالك مثل هذا التعامل أو مثل هذه العبارة؟
ومن ذلك أيضاما حكاه سفيان بن عيينة:” دخلت على العمري الرجل الصالح، فقال لي: ما أحدٌ يدخل عليَّ أحبّ إليَّ منك، وفيك عيبٌ، قلت: ما هو ؟! قال: تحب الحديث، أما إنه ليس من زاد الموت”[11] ألم تر كيف جعل العمري التفرغ لعلم الحديث من العيب المعيب على ابن عيينة؟ وهذا يدل بعد العمري عن العناية بالعلم ونشره وشدة ولوعه وانشغاله في العبادة حتى اعتبر شرف العناية بالحديث الشريف عيبا.
رد الإمام مالك: منهج العالم الرباني
وفي موقف آخر كتب العمري الزاهد إلى الإمام مالك يحضه على الانفراد والعمل، ويرغب به عن الاجتماع إليه في العلم.
فكتب إليه مالك:” إن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام، وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة، ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلك، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير، ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما قسم له، والسلام[12]
وردّ الإمام مالك ببيانٍ عظيمٍ، مجملُه أنّ الله قسَم الأعمال كما قسم الأرزاق، فمن النّاس مَن فُتح له في بابٍ من الخيرات دون غيره. وأوضح أنّ نشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر، وأنّ كل إنسانٍ يسعه أن يرضى بما فُتح له فيه من العبادات والمنافع.
دروس وعِبر من منهج الإمام مالك في التعامل
يستفاد من تصرفات الإمام مالك مع العمري الزاهد معان منها:
الجمع بين العلم والعبادة
ما أبلغَ نظرَ الإمام مالكٍ العالِمِ الربّاني! وما أقصرَ نظرَ العُمريِّ الزاهد العابد! لقد طلب العُمريُّ اعتزالَ العلم وتعليمه، والإقبالَ على نوافلِ العبادة فحسب، وهي عبادةٌ قاصرة النفع لا تتجاوز صاحبها، ولا تتعدّى حسناتُها إلى المجتمع، فضلًا عن الأجيال القادمة. بينما كانت بصيرةُ الإمام مالكٍ نافذةً في ترتيب مراتبِ الأعمال الصالحة ودرجات العبادات وأولويّاتها: الفرض قبل النفل، والأصول قبل الفروع، والأهمّ قبل المهمّ، وتقديم النفع المتعدّي على القاصر، والجمع بين العلم والعبادة.
وقد مات العُمريُّ العابد، فلا يعرفه إلا الخواصُّ -مع رجاء الثواب الجزيل له عند الله- وأمّا الإمامُ مالكٌ فقد مات وخلَّف من العلم والذكر والعمل ما يدعو له الناس به في المشرق والمغرب ليلًا ونهارًا، وذلك بفضل الله ثمَّ بما نشَر من العلم، فلم يصغِ لنصيحة العابد الزاهد في اعتزاله للعبادة وحدها، فبقي أثرُ علمه النافع ممتدًّا حتى يومنا هذا وإلى ما شاء الله تعال..
الحلم والأناة في مواجهة الإساءة
على الرغم من خشونة تعامل العُمريِّ مع الإمام مالك، ومحاولةِ فرضِ رأيه عليه بأسلوبٍ غليظ:
“أنتم علماء تميلون إلى الدنيا وتلبَسون اللِّين، وتدَّعون التقشُّف”
“إني أكره مجاورةَ مثلك…”
فإنّ الإمام مالكًا واجهه بالهدوء والحِلم، وتحلّى بحُسن الخلق، فجاوبه جوابَ فقيهٍ مربٍّ، وتجاهل الألفاظَ الجارحة تجاهلًا تامًّا، ولم يقابل الإساءةَ بمثلها؛ إذ إنّه إمامٌ يراقبه تلاميذه وينظرون إلى سمته، كما تنظر أجيالٌ بعده إلى سيرته وأخباره. وختم جوابه بقوله:
“وأرجو أن يكون كلانا على خير.”
فهكذا يكون خُلُق العلماء الأخيار الذين أجمعت الأمّة على إمامتهم.
اكتشاف المواهب والطاقات
قال الإمام مالك:
“فَرُبَّ رجلٍ فُتِح له في الصلاة ولم يُفتح له في الصوم…”
فكأنّه يشير إلى معنى الحديث:
اعملوا فكلٌّ ميسَّرٌ لما خُلق له.[13]
فينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه ويكتشف مواهبَه وطاقاتِه، ويختار المجال الأنسب لخدمة النّاس والإفادة منهم. وقد يكتشف المحيطون به تلك المواهب فيرشدونه إلى توظيفها فيما ينفع. ومن النادر أن يقوم شخصٌ واحدٌ بسدّ جميع ثغرات الأمّة؛ فهذه سِيَر الصحابة رضوانُ الله عليهم قد تنوّعت اختصاصاتُهم واهتماماتُهم ما بين عِلمٍ وزهدٍ وجهادٍ وتجارةٍ وغيرها، وهم جميعًا مشتركون في أصول الأعمال الصالحة.
من الصحابة من برز في العلم ونشره كالخلفاء الراشدين وعائشة وأبو هريرة وأين عباس…ومنهم من اشتهر بالزهد مع العلم كأبي ذر وأبي الدرداء وعبد الله بن عمرو… ومنهم من قام بواجب الجهاد في سبيل الله كأبي عبيدة الجراح وخالد بن الوليد … ومنهم من عرف بحسن التجارة كعثمان وابن عوف…ومنهم من تخصص في تعليم القرآن الكريم وتفسيره كابن مسعود وأبي وابن عباس … وفي الحلال والحرام كمعاذ بن جبل .. أو في الميراث كزيد بن ثابت…مع أن جميع هؤلاء الأفاضل مشتركون في جميع الأعمال الصالحة لكن الطاقات متفاوتة.
ولما أراد أبو ذر تقلد الإمارة قال له ﷺ:” يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة[14]“، بينما أمر رسول الله ﷺ زيدا أن يتعلم له كتاب يهود فقال:” إني والله ما آمن يهود على كتابي، قال زيد : فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له، … فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم.[15]
وانظر كيف إلمام رسول الله صلى عليه وسلم بطبائع الصحابة واكتشافه لمواهبهم واستثمارها في أنسب المواضع.
حُسن الظنّ والتعاون على الخير
لا شك أن المجتمع الإسلامي بحاجة لجميع المواهب والطاقات وأصحاب التخصصات النافعة، فأبواب الخير متعددة بكثرة، ولا يتوقع من الجميع أن يكونوا في ذات الاتجاه الواحد فهذا من حجر الواسع، بل لا بد من التكامل والتعاون والدعوة إلى الحث على إتقان العمل في أي مجال أو فن يعمل فيه المسلم، دون التعيير أو التحقير أو الازدراء بالآخرين، فإن من السنن الكونية أنه لا نجاح لأي مجتمع دون تكامل، ولذا كان من مقتضى التعاون على البر الانفتاح وحسن الظن بكل عامل في فنه وتخصصه على أنه عسى أن يسد به ثغرة من ثغرات المجتمع، فهذا الانفتاح والتقدير والاحترام للآخرين في مجالاتهم دون النظرة الدونية هو الذي سيزيد من كفاءة المجتمع الإسلامي ويحقق له المزيد من الإبداعات والابتكارات ويعيد له المجد والريادة كما كان من قبل.
يقول الله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين} [التوبة: 122].
والآية صريحة على أنه لا يمكن أن يصير جميع المؤمنين زهادا عبادا كما يريد العمري الزاهد من الإمام مالك، وإنما على كل أحد أن ينظر إلى حاله وما يجيده من أعمال البر دون التثريب على الغير أو أن ير أحد لنفسه الفضل على الآخر.
ولما قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنك لتُقِلُّ الصوم؟ قال: إنه يُضعفني عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي منه.[16]
نحو جواب الإمام مالك للعمري:” وقد رضيتُ بما فَتح الله لي فيه من ذلك . وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه…ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما قُسم له” وهكذا رتبة بصائر الأئمة الذكية النافذة، الذين يفطنون إلى معاني الأمور الدينية الجلية والدقيقة ومقاصدها الصحيحة، فيضعون الأشياء في موازينها.
ثم تأمل قول الإمام “وأرجو أن يكون كلانا على خير” وفيه منهج التعامل مع أخطاء الناس والتغافل، وإنزال النفس منزلة الخير والتفاؤل، وحسن الظن بكل مسلم، والحرص على رعاية روابط الألفة والأخوة، والتحلي بمعالي الأخلاق وغيرها، مما يوجب تغليب جانب تحصيل العلم النافع على العبادة القاصرة، وقد استطاع الإمام مالك الجمع بين العلم والعمل فرفع الله شأنه وذكره بالخير، وبقيت بصماته الواضحة النافعة في تراث الأمة غربا وشرقا، فرحمة الله على العمري الزاهد وعلى مالك إمام دار الهجرة وإمام المسلمين.