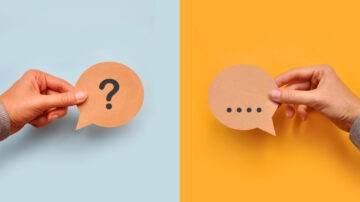في زمن تتسارع فيه وتيرة التحولات الثقافية والاجتماعية والسياسة، تتعاظم الحاجة إلى ترسيخ قيم الحوار كوسيلة حضارية لتجاوز الخلافات، وبناء جسور الفهم المشترك. وفي خضم ذلك، يطرح سؤال مهم: هل الحوار في الإسلام مجرد خُلق رفيع أم إنه ضرورة حضارية أصيلة؟
والاجابة على هذا السؤال، بالتأمل في نصوص الوحي وسيرة النبي الكريم ﷺ، تكشف أن الحوار في الإسلام ليس ترفًا خُلقيًا، بل هو منهج أصيل، ومقوم أساس في بينة المجتمع المسلم. بل إنه ركيزة من ركائز البلاغ والدعوة، ووسيلة للإقناع والتأثير، وضابط للتعايش مع المخالفين.
أولاً: الحوار في القرآن الكريم
فالقرآن الكريم زاخر بمواقف الحوار بين الأنبياء وأقوامهم، وبين المؤمنين والكافرين، وحتى بين الله عزوجل وخلقه، في عرضٍ عجيب يعكس أهميته. يقول الله تعالى: { ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (النحل:125).
وهنا نجد أن الجدال- وهو شكل من أشكال الحوار- لا يرفض مبدئيًا، بل يّهذب ويضبط بقيد ” التي هي أحسن”، مما يعني أن الإسلام لا يرفض المخالفة، بل يوجه أسلوب إدارتها. وفي موضع آخر يقول الله تعالى على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام، وهو يحاور الطرف الاخر الذي ادعى الربوبية: { قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ } (البقرة:258).
إنه حوار منطقي، هادئ، ومؤدب، يسلط الضوء على غاية الحوار: إظهار الحق، ودحض الباطل، بالحجة والبرهان لا بالخصومة.
ثانياً: السيرة النبوية مدرسة في الحوار
كان رسول الله ﷺ مثالاً عمليًا للحوار الهادف. ففي حديثه مع عتبة بن ربيعة، حين جاءه يعرض عليه المال والملك مقابل ترك الدعوة، لم يقاطعه النبي ﷺ، بل أنصت حتى انتهى، ثم تلا عليه صدر سورة فصلت.
وفي ذلك درس في أدب الاستماع، والثقة في الطرح، والرد بالحجة لا بالصوت المرتفع. وكما حاور اليهود والنصارى، والمشركين، بل وحتى المنافقين. لم يقص أحدًا مادام في الحوار منفعة أو كشف للحق. بل إن بيعة العقبة الثانية قامت على حوار شفاف بين ﷺ والانصار، فيه طرح الأسئلة، وتوضيح الالتزامات، واتخاذ القرار عن قناعة، لا إكراه.
ثالثاً: الحوار كوسيلة حضارية
الحوار في الإسلام ليس محصورًا في الدعوة الدينية، بل يتعداها ليشمل شؤون الحياة كلها: الأسرة، العمل، السياسة، العلاقات الدولية. فالحوار سبيل لحل المشكلات، وتجاوز الخلافات، وتخفيف التوترات. ولذا قال الله تعالى: { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَ } (الحجرات: 9). فالصلح الذي يقوم على الحوار هنا ليس مجرد خيار، بل فريضة اجتماعية لحفظ وحدة الأمة. وقد بين النبي ﷺ أن الساعي للإصلاح- بالحوار- بين المتخاصمين ينال أجرًا عظيمًا، ففي الحديث:” ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى، قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة”. (رواه الترمذي).
رابعًا: الحوار مع المخالف ضرورة وليس ترفًا
قد يخطئ البعض فيظن أن الحوار مع المخالفين – خصوصًا العقائديين- خنوع أو مجاملة، بينما الواقع أن الحوار هو الوسيلة الأولى للبان، والدعوة، وكشف المغالطات، إن تم وفق منهج علمي ومنضبط. ولذا حاور النبي نصارى نجران، وأقام معهم حجة التوحيد، دون سب أو إكراه، بل بالحكمة والموعظة.
خامسًا: من أزمة الحوار إلى ثقافته
في عالم اليوم، تتبدى أزمة الحوار في مظاهر كالتعصب، وسرعة التصنيف، ورفض المختلف. ويكفي تصفح وسائل التواصل الاجتماعي لرؤية حجم الإساءة، وسوء الظن، وغياب الإنصاف. ومن هنا تبرز أهمية ترسيخ” ثقافة الحوار” لا مجرد ممارسته لحظيًا. وهذه الثقافة تقوم على أسس:
- احترام الآخر وإن اختلفت معه.
- الاستماع الجاد لا المتربص.
- الاعتراف بالمشترك لا الاقتصار على المختلف.
- التواضع في طرح الرأي، فالصواب ليس حكرًا على أحد.
وختاماً: الحوار من القوة لا من الضعف
إن بناء أمة قادرة على العطاء الحضاري، يبدأ من قدرتها على الحوار، لا على الخصام. والإسلام حين أرشد إلى الحوار، لم يربطه بالضعف، بل بالثقة، والرؤية، وسعة الصدر، وعلو الحجة. وكما قال الله لنبيه: { وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ } (آل عمران: 159). فكلما ازداد الحوار رقياً، ازدادت الدعوة قبولاً، وازدادت الأمة نضجًا. فهل آن لنا أن نعيد للحوار مكانته في بيوتنا، ومدارسنا، ومجالسنا، ومنابرنا؟