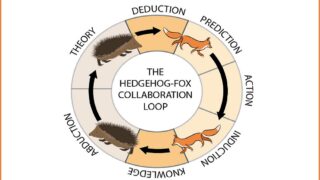ظاهرة الفضول الإنساني لمعرفة الغد أمر مألوف، وكما قال آينشتاين عندما سئل عن سر اهتمامه بالمستقبل قال: ” لأني ذاهب الى هناك”. وقد عرف العالم أشكالا من محاولات الإطلال على الغد ومعرفته، لكن مراحل هذه العلم كانت بداية ذات طبيعة ميتافيزيقية أو اسطورية ثم تحولت إلى مرحلة التخطيط المستقبلي أو التخطيط الاستراتيجي ثم أصبح علم الدراسات المستقبلية علما قائما بذاته.
وتعود محاولات العقل البشري لكشف ما وراء الحاضر”أو الآتي بعد الحال” إلى عصور قديمة جدا، وثمة مشكلة في هذه الناحية هي كيفية الفصل بين التنبؤ المجتمعي وبين التنبؤ الديني أو الكهنوتي وتحديد ” منهجية التنبؤ ” في كل منهما، ولتوضيح هذه النقطة مثلا لناخذ التنبؤ بانتصار الروم في بضع سنين الواردة في القرآن، هي نبوءة لكن كيف تم الوصول لها؟ هنا أمر ديني يخرج عن “العلم البشري” ومن المتعذر تحديد” منهجية الوصول لهذه النبوءة للاستفادة منها وإعادة توظيفها، أما التنبؤات البشرية فهي مما يقع ضمن دائرة الوعي بها وامكانية تطويرها وتوظيفها، وهذه هي محط اهتمامي في هذا المقام. مع الإقرار بالتأثير للأولى على الثانية احيانا.
وقد بذلت جهدا أظنه كافيا في البحث عن أصول التنبؤ “أو الدراسات المستقبلية” في التراث الانساني :
أولا : الصينيون
لعل ” كيان سيما ” (Sima Qian) الذي عاش في القرن الأول قبل الميلاد يمثل محاولة جادة في هذا المجال عندما حاول فهم قوانين التاريخ وافتراض أن هذه القوانين لها طابع الديمومة، وعليه فإن بإمكانه إدراك القادم إذا أدرك القوانين الحاكمة لحركة الأفراد والمجتمعات والطبيعة.
ثانيا: التراث اليوناني
بداية المنهج العلمي: 300 قبل الميلاد مع أرسطو (Meteorologica-meteorology) فقد حاول أن يرى العلاقة بين النار، والتربة، والهواء والماء، ثم تبعه تلميذه ثيوفراستوس( Theophrastus) الذي وضع كتاب(on Signs) وكان يركز على “لون السماء، والهالات (بقع الضوء) ليتنبأ بسقوط المطر، ثم جاء أبقراط، وربط المرض بالحرارة أو الرطوبة أو الماء…أو الهواء.، وكان الكهنة في معبد ” دلفي” يعيدون انتاج تنبؤاتهم استنادا لهذا التراث الذي يربط بين حركة البشر ومظاهر الطبيعة.
ثالثا: المصريون
كان رع (إله الشمس) هو المصدر الرئيسي للمعرفة بالمستقبل، وكان في مصر القديمة معبدا للتنبؤات (القرنين السادس والسابع قبل الميلاد) وما زالت بعض آثاره في واحة سيوه المصرية، وأخذ المعبد مكانته نظرا لأنه مهبط وحي الإله آمون، فكان المصريون إذا اعتزموا القيام بشيء ذهبوا لكهنة المعبد ليخبروهم عن طريق استشارة الإله آمون بما سيحدث.
وكان الإسكندر الأكبر أحد الذين طلبوا من كهنة معبد آمون النبوءة له حول ما إذا كان سيحكم العالم، فقال الكهنة نعم ولكن لفترة قصيرة، وكذلك هناك حكاية جيش قمبيز الفارسي (القرن السادس قبل الميلاد) الذي جاء لهدم المعبد المصري ولكن الجيش ضاع ولم يتم العثور عليه وبقي لغزا (العلماء المعاصرون يميلون لتفسير الضياع بأنه نتيجة لعوامل طبيعية).
والملاحظ أن فترة ما قبل الميلاد والقرون الثلاثة ما بعد الميلاد بقي التنبؤ مرتبطا بقدر كبير بالميتافيزيقيا، مثل رع عند المصريين (اله الشمس) وزيوس عند اليونان، أما في الشمال الأوروبي نجد إله الرعد والبرق(Thor) ، وكان الأزتيك يقدمون أضاحي لكي يرضى الإله وينزل المطر.
لكن الأهم أن هؤلاء المقربين لله كانوا يدعون صلتهم بالآلهة فكانت لهم مرتبة عليا في المجتمع، كما وجدنا أن بعض القبائل كانت تعتقد في استراليا أن الرقص يأتي بالمطر.. ثم بدا بعد ذلك الانفكاك التدريجي والبطيء بين الميتافيزيقيا والتنبؤ لصالح بناء التنبؤ على أساس مظاهر طبيعية شاخصة وهو ما يتضح في العرافة والقيافة وبعض أشكال الكهانة وقراءة الرمل وصولا لفناجين القهوة والتطير (عن اليمين أو الشمال)….وأصبح الصيادون، والمزارعون والمحاربون، والرعاة، والبحارة يركزون على مظاهر المناخ أو مظاهر البحر أو الريح…الخ
رابعا: العرب القدامى
في تتبعي لهذا الجانب في التراث العربي عثرت على ما يمكن تسميته “حكايات” عن التنبؤ كتلك التي رويت عن رجال ونساء مثل شق بن أنمار بن نزار، وسطيح بن غسان، والأشعث بن قيس الكندي، والأسود بن كعب وطليحة بن خويلد، ومسيلمة بن حبيب الحنفي (المسمى لاحقا مسيلمة الكذاب)، وبعض النساء مثل طريفة الكاهنة، وزبراء، وسجاح بنت الحارث …الخ.
وتوقفت عند كتابات فخر الدين الرازي (بخاصة التنبؤ المبني على ما أسماه المزاج الخلقي وتأديب العقل ورياضة الشرع) وبعض إشاراته للتنبؤ بناء على حركة الجسد وهو ما يتضح مدلوله في قوله بأن العين صومعة الأعضاء-أي أنها تشي بما في العقل ، و لفت انتباهي بعض إشارات ابن القيم الجوزية عن الفراسة (ولو أنه حصرها في دور التنبؤ في أحكام القضاة وإشارته لما سماه التعريض.
حاولت الربط بين بعض الإشارات الواردة في كتب التراث –وهي غالبا على شكل حكايات-، وحاولت أن استنبط منها “أدوات التنبؤ عندهم” ، مثل ما ورد في الرسالة القشيرية عن الشافعي ومحمد بن الحسن في حكاية الحداد والنجار، أو حكاية الشافعي مع شخص تبحث الشرطة عنه، وقد عرفه لمجرد معلومات بسيطة مستندا لقاعدة كررها بأن “العبد إذا جاع سرق وإذا شبع نكح.
ويمكن اعتبار بعض التصورات المثالية –كالمدينة الفاضلة للفارابي- محاولة لتوظيف الخيال، لكني أرى أن الفارابي كان يحاكي –بخاصة منهجيا- جمهورية أفلاطون لا أكثر…كما أن موقف ابن رشد من مفهوم الزمن شكل في تقديري نقلة مهمة عندما أكد على موقف تيار في الفلسفة اليونانية من أن الزمن هو “كم الحركة. كما مثلت محاولة بن خلدون وضع قوانين للتاريخ وطرحه فكرة الدورة للدول محاولة جادة قريبة من محاولة الصيني كيان سيما الذي أشرت له.
لكني وبكل أمانة- وفي حدود كفايتي العلمية القاصرة- وجدت أن “أغلب” ما في تراثنا لا يعدو أن يكون في نطاق الفراسة وتفريعاتها مثل : علم الأسارير والأكتاف والعيافة (أو القيافة) والريافة(الخاصة بالماء)، والاستنباط ونزول الغيث وعلم الاختلاج (اختلاج الأعضاء في الجسم بطريقة غير إرادية وربطها بتوقع حدوث شيء ما ) والتطير..الخ، ولو أن الجاحظ قدم شذرات بدا لي أنها الأصلح لتأصيل الموضوع رغم بقائه في دائرة الفراسة، لكنه لفت انتباهي في تناوله لما أسماه فراسة البشر، ثم – وهو الأهم – حديثه عن مسألتين هما : الأولى النصبة (الخصلة الخامسة في آلة البيان وتعني أن كل علامة تشير لعلامة أخرى إلى أن تنتهي لنقطة معينة) والثانية ما أسماه الإشارة التي يبدو أنها تتوارى وراء الكلمات فقيل “رب لحظ أنَمّ من لفظ”.
وقد غلبت التنبؤات على أساس الصفات الجسدية (الطول والقصر والعين والانف..الخ) أو الحدس على كل منهجية أخرى، ولو أن الفراسة الصوفية أخذت منحى مختلف بعض الشيء من خلال ما أسموه “مكاشفة اليقين ومعاينة الغيب”.
كما لفت انتباهي بعض المحاولات للتنبؤ بأحوال الجو، وهنا ليست الأهمية في صدق أو خطأ التنبؤ بل ببداية الربط بين مكونات الظاهرة موضوع البحث (العلاقة بين الحر والبرد والمطر والريح…الخ)، وقد ربط ابن خلدون بعض هذه الجوانب مع السلوك الإنساني، مما يؤصل للعلاقة بين البيئة والسلوك، ولو أن التنجيم أخذ حيزا أيضا في هذا الجانب، وما ورد عن تنبؤات المنجمين لمعركة عمورية والتي سجلها أبو تمام كإشارة على نقده “لسود الصحائف لصالح تمجيده لبيض الصفائح التي في متونها جلاء الشك والريب، هز من مكانة التنجيم كإضافة إلى “كذب المنجمون ولو صدقوا.
وقد عثرت على عدد من الدراسات العربية في مجال التأصيل لموضوع التنبؤ في التراث، لكني لم أجد القدر الكافي من المعلومات في هذا الجانب، ولعل دراسة محمد سهيل طقوش تمثل محاولة جادة لكنها ركزت على الربط بين التنبؤ وادعاءات النبوة كما جرى مع الأسود العنسي في اليمن، ومسيلمة الكذاب في بني حنيفة في اليمامة، وطليحة في بني أسد، وسجاح التميميَّة.
خامسا: النقلة العلمية الابتدائية في التنبؤ
في القرن الخامس عشر بدأت فكرة مراقبة الظواهر وقياسها تأخذ أهمية أكبر،لاففي هذه الفترة صمم ليوناردو دافنشي آلة لقياس الرطوبة (وبالتالي تحديد آلية لتوقع سقوط المطر)، ثم جاءت فكرة دوران الأرض على يد جاليليو الذي اخترع (thermometer) فأصبحت النظرية الأولى له تربط بين دورة الأرض والمواسم الزراعية والمظاهر الأخرى المرتبطة برتابة الحركة، وساعد الثاني على قياس درجات الحرارة لبناء تنبؤات على أساسها، ثم جاء تورشيللي(Torricelli) واخترع آلة قياس ضغط الهواء(barometer)، ولعل ذلك ساهم في تزايد ثقة العقل البشري بقدرته على “الرصد للحركة المنتظمة وللحركة العشوائية، وهي نقلة هامة في مجال رصد التغير الذي يشكل وحدة التحليل في الدراسات المستقبلية.
وتدعم التوجه العلمي بظهور نظريات اليوتوبيا (توماس مور) في بداية القرن السادس عشر، وهو ما مهد المسرح لأدباء الخيال العلميJules Verne الفرنسي و H. G. Wells البريطاني(حيث ركزا على انعكاس التطور التقني على الحياة الإنسانية، وانتقل الأمر للشركات غير العسكرية، ثم ظهرت فكرة الخطة الخمسية لكهربة الاتحاد السوفييتي في عام 1921 مع لينين، ثم التنافس العسكري بين شركات انتاج الأسلحة وتنبؤ كل منهما لما سينتجه الطرف الآخر، وانتقل الأمر بعد نجاح تنبؤات العسكريين إلى الشركات غير العسكرية، ثم أصبح علم الدراسات المستقبلية فرعا علميا أكاديميا في منتصف الستينات من القرن الماضي.
ثم بدأت مناهج الميدان تتطور بتقنيات علمية، وظهرت دراسات مستقبلية متنوعة لكنها مثيرة في هذا المجال مثل دراسة الحرب النووية) التي طرحها الأمريكي هيرمان كان (Herman Kahn) ودراسة جوفنيل الفرنسي(-Bertrand de Jouvenel-) حول المستقبلات الممكنة ودراسة الهنغاري غابور دينيس (Dennis Gabor حول (اختراع المستقبل) ثم (Buckminister Fuller) بخاصة اللعبة العالمية، إلى جانب دراسات الهيئات العلمية مثل نادي روما والجامعات، لنصل إلى طرح الموضوع كتخصص علمي منفصل تطرحه أغلب جامعات العالم المتطور(إلا الجامعات العربية) في مراحل الدراسة الجامعية الثلاث وما بعدها.
تنزيل PDF