في يوم الاثنين 30 سبتمبر الماضي أعلنت (دار نشر جامعة قطر) في مؤتمر صحفي أنها وقعت عقدًا لنشر كتاب (مجالس النور في تدبّر القرآن الكريم وتفسيره)، وخمسة كتب أخرى، ضمن باكورة إصداراتها في افتتاح العام الجامعي الحالي.و(مجالس النور) هو كتاب في أربعة مجلدات، ألفه د. محمد عيّاش الكبيسي بمشاركة عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية د. إبراهيم الأنصاري ود. محمد المصلح و د. وليد السامرائي؛ بهدف تقديم تدبر أو تفسير للقرآن الكريم بطريقة جديدة، تصلح لمخاطبة الإنسان المعاصر.
في هذا الحوار نتعرف من الدكتور الكبيسي على الظروف التي وُلد فيها تفسير (مجالس النور)، والمنهج المتبع فيه، وأهم الضوابط التي تمنع من الانزلاق في هوة القراءات المتعسفة أو المتجاوزة، بجانب التعرف على كيفية مخاطبة القرآن الكريم للإنسان المعاصر.
والدكتور الكبيسي مفكر وأكاديمي عراقي، ولد عام 1962م بمدينة كبيسة غرب العراق، وتخرج في كلية الشريعة بجامعة بغداد عام 1984، ثم حصل على الماجستير عام 1992، والدكتوراه سنة 1995. وحاضر في عدد من الجامعات العربية.
له العديد من الكتب والدراسات والمقالات، ومن أهم كتبه: “العقيدة الإسلامية في القرآن الكريم ومناهج المتكلمين” (رسالة دكتوراه)، “المحكم في العقيدة.. دراسة لأصول العقيدة في القرآن الكريم”، “منهج القرآن في مكافحة الإشاعة”، “أنماط الشخصيه وإشكالات القيادة والتربية في العمل الاسلامي المعاصر”، “الشمولية الإسلامية بين ثوابت العقيدة ومرونة التشريع”، “مصادر المعرفة ووسائلها في القرآن الكريم”، “إمام الحرمين الجويني ومنهجه في الصفات”، “المنظومة العقدية والقيمية ودورها في ضبط معايير الأداء للدولة والمجتمع”.. فإلى الحوار:
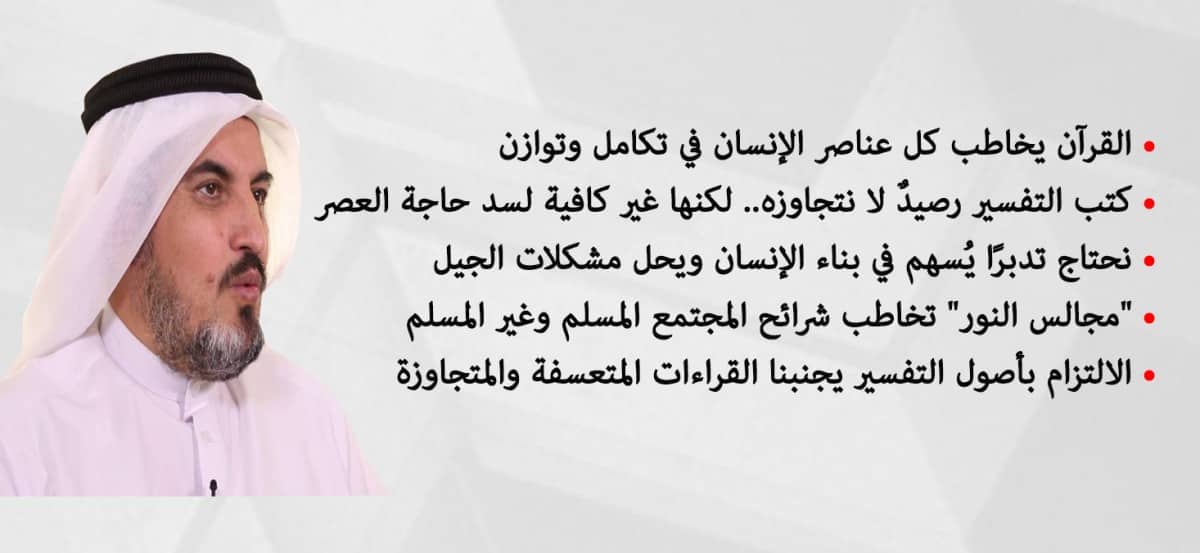
نود أن تطلعنا على الظروف التي نشأت فيها فكرة “مجالس النور”؟
الظروف التي نشأت فيها فكرة “مجالس القرآن” ظروف مركَّبة؛ تبدأ أولاً بحاجتي أنا كإنسان مسلم أعيش هذا الواقع الأليم الذي تمر به أمتنا اليوم، ويمر به هذا الجيل، وأقرأ القرآن الكريم باعتباره المرجعية العليا لي ولكل المسلمين، وأحاول أن أتلمَّس خيوط الحل، وأنسج المشروع الذي يخدم هذا الجيل وتطلعاته وآماله، ويعالج مشكلاته في ضوء هذه المرجعية القرآنية.
وكثيرًا ما أرى الشباب يسألون، وربما يختلفون، ومع ذلك لا يرجعون إلى القرآن الكريم؛ رغم اعتقادهم أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع، وهو المرجعية العليا لهم في كل مشكلاتهم.. وكأن هناك فجوة بين هذا الجيل والقرآن الكريم!
في الغالب، يُقرأ القرآن الكريم للتبرك، والحصول على الأجر، ويقرأ في ليالي رمضان، وهناك اهتمام أيضًا بأحكام التلاوة والتجويد ومسابقات الحفظ.. وبالمستوى الأقل بكثير، يأتي تدبر القرآن الكريم، التدبر العملي الذي يُسهم في بناء شخصية الإنسان المعاصر، ويحل مشكلات هذا الجيل.
والكثير يتساءل عن كتب التفسير: ألا تُغْني؟ وأجيب: بلا شك، كتب التفسير هي رصيدٌ ثرٌّ، ولا ينبغي تجاوزها أبدًا، لكن كل كتب التفسير إنما هي محاولات لـ “ترجمة القرآن الكريم”- إن صح هذا التعبير- بما يناسب الواقع الذي يعيشه المفسِّر.
وفي بعض الأحيان، نجد كتب التفسير عبارة عن علوم إسلامية ضُخَّت في كتب التفسير، ولذلك تجد فيها من الصعوبة بحيث إن تدبر القرآن الكريم مباشرة أسهل بكثير من قراءة التفسير؛ وذلك لأن هذ التفسير ليس تفسيرًا بالمعنى الحقيقي، وإنما هو محاولة لإدخال تخصصات شرعية معمقة فيه.
فكرة “مجالس النور” جاءت أيضًا من تجربة شخصية لي مع مجالس القرآن المننتشرة في قطر وفي بعض دول الخليج؛ وهي مجالس متكررة تختم القرآن الكريم ثم تعود لتبدأ تلاوته من جديد. وقد حضرت كثيرا من هذه المجالس؛ فكانت فيها التلاوة، والتأملات، والأسئلة. ومن خلال هذه المعايشة، لسنوات عديدة، شعرت بالحاجة لتقديم القرآن الكريم أو قراءة القرآن الكريم قراءةً تتناسب مع الواقع الذي نعيش، وتجيب عن تساؤلات هذا الجيل بكل فئاته.
وكيف سار العمل بعد ذلك؟
شاء الله تعالى أن تكون الكلمات الأولى التي وضعتُها في هذا السِّفر بعد صلاة التراويح، في ليلة السابع والعشرين؛ فقد بدأت الكتابة في تلك اللية المباركة، التي هي على رأي كثير من العلماء ليلة القدر، الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم، ولعل ذلك كان فألاً حسنًا بفضل الله، ثم تابعت العمل.. أقرأ في كتب التفسير المختلفة، وأحاول أن أصوغ العبارات التي تتناسب ووسائط الفهم المعاصر ولغة العصر، قدر المستطاع.. حتى أكملت كلَّ التفسير في قرابة ثلاث سنوات، ثم بعد ذلك عرضته على الأساتذة الأفاضل: د. إبراهيم الأنصاري، د. محمد المصلح، و د. وليد السامرائي؛ قرأته معهم كلمة كلمة، من بداية المقدمات ثم سورة الفاتحة إلى سورة الناس، لم نترك كلمة واحدة دون مراجعة، وكانت ملاحظاتهم عونًا لي وموجِّهًا ومسدِّدًا.
بعد ذلك عُرض العمل على لجنة نهائية للمراجعة، مكونة أيضًا من ثلاثة أساتذة أفاضل، ثم ارتأيتُ أن يُعرض العمل على تحكيم خارجي، وبالفعل تبنَّت كلية الشرعية بجامعة قطر هذا الكتاب، وأرسلته إلى محكّمين من خارج دولة قطر، لا نعرفهم.. والحمد لله، كانت تقارير المحكّمين مشجعة وأثنت على الكتاب، مع ملاحظات علمية دقيقة استفدنا منها وأخذنا بها.
ما الشريحة المخاطَبة بـ”مجالس النور”؟
المخاطَب بمجالس النور هم في الحقيقة كل شرائح المجتمع المسلم، وحتى غير المسلم؛ فهذا العمل خطاب للعالمين لأنه محاولة لتقريب القرآن من لغة العصر. وربما يُستثنى من ذلك الباحثون في المجالات التخصصية الشرعية الدقيقة؛ لأن الذي يبحث في الروايات التفسيرية أو ما يُسمَّى “التفسير بالمأثور”، أو يبحث في الترجيحات المذهبية الفقهية، أو غير ذلك من أبواب التفسير المتخصصة لن يجد ضالته في هذا الكتاب؛ إذ هو محاولة لقراءة القرآن الكريم بطريقة تناسب متطلبات الحياة؛ فهي منهج حياة تعم كل المسلمين: الفرد والأسرة والمجتمع، في الجوانب التربوية والسياسية والاقتصادية والحياتية والدعوية… إلخ؛ هي باختصار تيسيرٌ للفهم العملي والسلوكي لآيات القرآن الكريم.
وما المنهج الذي سرتم عليه في هذا العمل؟
المنهجية التي اتبعناها في الكتاب تتمثل في أن كل مجموعة من الآيات خصصناها بدرس مستقل، هذا الدرس هو الذي نسميه “المجلس”، وكل مجلس ينقسم -إضافة إلى الآيات- إلى قسمين؛ الأول: يتناول المعاني العامة التي ربما تلبِّي حاجة أغلب القراء، أي بيان المحاور العامة أو المعاني الرئيسية والمقاصد الكلية، التي تركز عليها الآيات.. ثم ننتقل إلى القسم الثاني وأسميناه “دقائق التفسير”، أي تفسير الآيات تفسيرًا تفصيليًّا.
والقرآن الكريم، كما هو معلوم، مكوَّن من ثلاثين جزءًا، بسوره وآياته المعروفة، وتفسيرنا هو تفسير تسلسلي حسب الترتيب المعروف للقرآن والمعهود في التفاسير؛ لكن ابتكرنا فيه طريقة ربما تكون جديدة، وهي أن نتوقف عند مقطع من مقاطع الآيات بمعنى محوري أو بمجموعة من المعاني المترابطة بحيث تشكل “وحدة موضوعية” للمجلس، فهو في الأصل منهج متسلسل مع ترتيب القرآن الكريم، لكن يراعي في تقسيمه “الوحدة الموضوعية” ابتداءً وانتهاءً لكل مجلس.
وفكرة “مجالس القرآن” هي أن كل جزء من القرآن يقسَّم على عدة مجالس؛ بحيث لو أرادت الأسرة المسلمة أو حتى مجموعة من الشباب أو غيرهم أن تتدارس القرآن الكريم، فيمكنها- من خلال هذا العمل- أن تتدارس القرآن الكريم مجلسًا مجلسًا؛ فالمجلس عبارة عن درس، والدرس يضم عددًا من الآيات، وهذا العدد بالأغلب تجمعه معانٍ مترابطةٌ ومحورية، وموحَّدة إلى حد ما.. فهي محاولة للجمع بين التفسير وفق الترتيب المعهود للقرآن الكريم في كتب التفسير الأصيلة، وأيضًا مراعاة الجانب الموضوعي ومراعاة الآيات المحورية لكل مجلس.
هل نحن بحاجة إلى “قراءة متجددة” للقرآن الكريم؟ ولماذا؟
نعم نحن بحاجة إلى قراءة متجددة للقرآن الكريم؛ لأننا نعتقد أن القرآن- مع أنه نص واحدٌ لا يقبل الزيادة ولا النقصان، إلا أنه أيضًا كتاب يخاطب كل الأجيال؛ وكلُّ جيل يواجه تحديات وإشكاليات، ويسعى لتطلعات مختلفة من جيل إلى جيل؛ ومن ثم كان لكل جيل حاجة تختلف عن الجيل الذي قبله وعن الجيل الذي بعده، في طريقة استعياب القرآن الكريم وتدبره، واستنباط الحلول التفصيلية لمشاكله من القرآن الكريم.
ما أهم ضوابط هذه “القراءة المتجددة”، حتى لا ننزلق في هُوّة التفاسير المتعسِّفة أو المتجاوِزة؟
نحن في الأصل والحمد لله طلاب علم، تخرَّجنا في المدارس الأصيلة للعلم الشرعي، وأعتقد أن علوم الشريعة بوجه عام لها أصولها؛ فلا ينبغي الخروج عن الأصول التي تَفْصِل ما بين العلم الشرعي الذي يُسمَّى علمًا حقيقيًّا، وبين المساحات الأخرى التي ربما تسود فيها حالات من الفوضى والارتباك والخروج عن دائرة هذا العلم.
والتفسيرُ علم كذلك له ضوابط المعروفة؛ ومن ذلك مثلاً:
–تفسير القرآن بالقرآن: بحيث لا يأتي تفسيرٌ ما معارضًا لتفسير آية أخرى؛ فالقرآن يكمِّل بعضه بعضًا، ويفسِّر بعضه بعضًا، ولا يضرب بعضه بعضًا.
–عدم الخروج عن معاني السنة النبوية الصحيحة: لأن السنة مفسِّرة ومفصِّلة للقرآن الكريم، كما قال تعالى: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (النحل: 44).
–الالتزام بقواعد اللغة العربية المعروفة: ونعتمد في البداية ما يُسمَّى “الحقيقة الشرعية” مثل مفردات: الصلاة، والصوم، والزكاة، والحج.. إلخ، ثم “الحقيقة اللغوية” مثل مفردات: الرجل، والمرأة، والليل والنهار.. إلخ، ولا نرجع إلى الجذر الأصلي إلا في حالة عدم وجود أيّ من الحقيقتين.
–عدم مخالفة الحسِّ والواقع والمنطق العقلي السليم.
وأعتقد أن هذه الأصول التي تحافظ على أصالة العلم الشرعي بشكل عام، وأصالة التفسير بشكل خاص.. هي التي تَفْصل بين التفسير المقبول ضمن دائرة العلوم الشرعية، والتخرصات الأخرى التي ظهرت في هذا الزمان: عَبْر دعوات ربما تكون دعوات غير منضبطة، وربما تكون دعوات مشبوهة! والعياذ بالله.
كيف نربط شبابنا بالقرآن الكريم؟
الشباب، من حيث المعتقد والإيمان ومن حيث التعلق القلبي والعاطفة، هم مقتنعون بمصدرية القرآن الكريم؛ فلا يشك مسلم بهذه الحقيقة.. المشكلة هي في وجود فجوة في اللغة؛ بمعنى أن لغة القرآن الكريم أصبحت أرفع بكثير من اللغة التي يفهمها شباب هذا الجيل؛ وحتى عندما يرجع أحدهم إلى كتب التفسير فإنه يعود ليسأل عن معاني التفسير ذاتها؛ أي أن كتب التفسير أصبحت بحاجة لتفسير!
لهذا، فالخطوة الأولى لربط شبابنا بالقرآن الكريم هي تقريب القرآن الكريم لهم من حيث اللغة؛ فلا نستعرض عليهم المصطلحات العلمية التي لا يفهمها إلا العلماء.
الأمر الثاني: الشباب لديهم هموم، وإن لم يجدوا حلاًّ لهمومهم هذه في كتاب التفسير، فسيشعرون كأن هناك فجوة بينهم وبين القرآن الكريم؛ ومن ثم، لا بد أن يجدوا في القرآن الكريم ما يلبِّي طموحاتهم ومتطلباتهم، ويجيبهم عن تساؤلاتهم واستشكالاتهم.
كيف نتجاوز “الرؤية التجزيئية” في التعامل مع القرآن الكريم؛ بحيث لا نتعامل معه من منظور لغوي أو تشريعي فحسب، وإنما باعتباره كتابَ هدايةٍ بالأساس؟
هذه الرؤية التجزيئية لها أسبابها الموضوعية والمعرفية؛ مثل أن أصحاب التخصصات العلمية يحاول كل فريق منهم أن يأخذ من القرآن الكريم ما ينفع تخصصهم؛ فمن يبحث عن الإعجاز العلمي يقرأ القرآن لهذا الغرض، وكذا من يبحث في مسائل الفقه، أو البلاغة والإعجاز البياني.. وهكذا.
فهذه كلها قراءات تلبي حاجات لا نستطيع أن نتجاوزها.. لكن حينما نريد أن نقدم القرآن الكريم للعالمين، لا بد أن ننتهج منهجية أخرى تتجاوز هذه المنهجيات والقراءات التجزيئية. وهذا هو الأصل في رسالة القرآن الكريم: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} (الأنبياء: 107).
الخطاب الإنساني أو الهداية الإنسانية في القرآن الكريم، بمعنى أنه جاء نورًا وهداية للبشر كافَّة.. لماذا لا نرى كتابات تتعامل مع القرآن الكريم بهذا المستوى من العمق والرؤية؟
نعم، القرآن الكريم رسالة الله للعالمين كما ذكرنا آنفًا، والخطاب القرآني للإنسان جاء بهذا الوصف؛ فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ} (الانفطار: 6)، {يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ} (الانشقاق: 6)، وهناك آيات كثيرة بدأت بنداء: {يَا بَنِي آدَمَ}.
وفي كلمتي بالمؤتمر الصحفي لتوقيع الكتاب مع دار النشر، قلت: حقيقةً، نحن لا ندري: هل نحن الذين فسَّرْنا القرآن الكريم، أم القرآن هو الذي فسَّرَنا. وأوضحتُ أن القرآن فسَّرنا؛ لأننا وجدنا أنه يتحدث عنا نحن البشر، يتحدث عن وجودنا ونشأتنا وحياتنا، ويلاحق الإنسانَ من يوم أن كان جنينًا في بطن أمه إلى يوم الوفاة، وما بعد الوفاة: في البيت، التعليم، التربية، السوق، الشركة، في كل مكان..
فالقرآن الكريم جاء منهج حياة، ليخاطب الإنسانَ كلَّ الإنسان.. والفجوة التي نجدها حينما نقدِّم هذا القرآن الكريم للناس، إنما جاءت لأسباب؛ منها: أننا نقدم القرآن بالقراءات التجزيئية، التي تحدثنا عنها من قبل، ونراها تركز مثلاً على الجوانب الفقهية، أو البلاغية.. وفي بعض الأحيان نقدِّم كتب التفسير التي كانت تتناسب مع أجيال سابقة، لكن لا تناسب هذا الجيل؛ فمن الصعوبة أن نقدم مثلاً تفسير الطبري للعالمين اليوم! فماذا يفهمون من هذه الروايات المتعددة، ومن ترجيح رواية على أخرى، ومن أسماء الرواة.. حتى اللغة: ربما تكون أصعب على هذا الجيل من لغة القرآن نفسه!
ومن ثم، نحن بحاجة إلى أن نجسِّر الهوة بين القرآن الكريم وهذا الجيل؛ ولا نقصد جيل المسلمين فقط، بل العالمين جميعًا؛ وذلك بأن نقدم لهم الإسلام؛ الذي يخاطب مشاعرهم من حيث هم أناس، لأن هذه الرسالة جاءت تخاطب الناس جميعا. ولا شك أن القرآن الكريم يهتم بهذا الإنسان؛ فهو يبين له الغايةَ من وجوده، والمقاصدَ الكبرى لهذا الوجود، وماذا ينتظره بعد الموت.. إلخ.
لو أردنا أن نقدم القرآن الكريم للإنسان الآن- مُطْلَق الإنسان- ونعرض عليه ما يقدمه له من آفاق روحية وفكرية.. فماذا نقول؟
أقول باختصار: هذا الإنسان الذي أمامي، ما هو؟ إنه يتكون من عقل وجسد وروح ومن نفس لها تصوراتها ومشاعرها وعواطفها.. وحين نقرأ القرآن الكريم نجد أنه يغذِّي كل هذه العناصر الموجودة في هذا الإنسان:
– فحينما يتكلم القرآن بلغة العقل فإنه يتكلم بما يقنع العقل الإنساني، ويحثه على التفكير والإبداع والاجتهاد والاستنباط والحوار والمجادلة.. فهذه كلها مصطلحات أو مفاهيم تختص بالجانب العقلي.
– وحينما يتكلم القرآن عن النفس وكونها مصدر الإرادة والقرار، يقول مثلا: {إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (يوسف: 53)، ويقول: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا} (الشمس: 7- 10)؛ فيتكلم عن التربية النفسية بشكل واضح.
– وحينما يتكلم عن الجسد، يتكلم عن النظافة والقوة والزينة واللباس والغذاء والدواء والشفاء.
والعجيب أن القرآن يربط بين هذه الجوانب؛ فنراه يقول: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (الأعراف: 31)؛ فلا تناقض بين “المسجد” وهو رمز العبادة، وبين “الزينة” وهي رمز المتاع والجمال. وقد بيَّنا في التفسير هذا المعنى الجمالي في هذه الآية الكريمة، التي لا تتحدث فقط عن ستر العورة، كما يقول بعض المفسرين، وإنما تتناول الزينة بهذا اللفظ وبهذا المعنى.
وقد تُرجِم هذا الربط في سيرة النبي ﷺ وفي السنة النبوية الصحيحة، حينما كان النبي ﷺ يوصي بأَخْذِ الطِّيب والدُّهن.. ويأمر بالوضوء والسواك والغسل ونظافة المكان.. حتى قال ﷺ: “الطهور شطر الإيمان“، أي نصفه.. بجانب الأحاديث النبوية عن الروح وغذائها؛ متمثلاً في الذِّكر، والاستغفار، والتسبيح، وقراءة القرآن، والدعاء.. إلخ.
فنجد أن القرآن يخاطب كل عناصر الإنسان في ذاته وفطرته، ولا يغفل عن عنصر لحساب عنصر.. على خلاف ما نرى في الديانات الأخرى؛ التي يغلِّب بعضها جانبًا على جانب، حتى وصلت بعض الديانات إلى إقرار تعذيب الجسد لصالح الروح، أو العكس.. لكن القرآن الكريم يعالج الجميع معالجة واحدة، ويخاطب الإنسان كإنسان لبناء شخصيته المتكاملة والمتوازنة.

