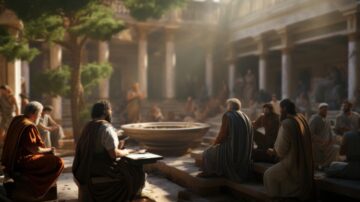كثيرًا ما يختلط على الناس الفهم الدقيق للفلسفة، كمفهوم وممارسة إنسانية، مع مصطلح «الفلسفة» (Philosophy) ذي الأصل اليوناني، المأخوذ من كلمتين: «فيلو» (Philo) بمعنى الحب، و«سوفيا» (Sophia) بمعنى الحكمة. وقد أدى هذا الخلط إلى بروز تصورات وأحكام مبتورة أو خاطئة، سأستعرض بعضًا منها في هذا المقال. لكن بداية، ينبغي أن نتفق على جوهر الفلسفة باعتبارها معنى وتجربة إنسانية أصيلة.
تعرف موسوعة بريتانيكا الفلسفة (Encyclopaedia Britannica) بأنها «التأمل العقلاني، التجريدي، والمنهجي في حقيقة الواقع كله أو في الجوانب الأساسية للوجود والتجربة الإنسانية». ويُقصد بالتأمل العقلاني أن الفلسفة تبنى على التفكير المنطقي، لا على العاطفة أو الحدس وحده. أما التجريدي فدلالته اهتمام الفلسفة بالمفاهيم الكلية كالوجود والمعرفة والزمان والخير، لا بالوقائع الجزئية فقط. والمنهجية تعني اعتماد الفلسفة أساليب منظمة في التفكير والاستدلال، كالجدل والتحليل المنطقي والتأمل المتأني.
يبين هذا التعريف أن الفلسفة ليست مجرد خواطر شخصية، بل نشاط فكري منظّم يهدف إلى تفسير الواقع وفهم عمق الوجود الإنساني.
وتعرف موسوعة ستانفورد للفلسفة (Stanford Encyclopedia of Philosophy) الفلسفة بأنها «حقل معرفي يتناول أسئلة جوهرية تتعلق بالوجود، والمعرفة، والقيم، والعقل، واللغة، والمنطق، عبر التحليل النقدي والتأمل المنهجي».
ومن خلال هذين التعريفين، نرى أن الفلسفة تدور حول دراسة الأسئلة الكبرى المتعلقة بالوجود والمعرفة والقيم والعقل واللغة والحقيقة. وهي بذلك سعي إنساني قديم لاستكناه حقيقة العالم ودور الإنسان فيه، وتحليل نقدي عقلاني لهذه القضايا التي صاحبت الإنسان منذ نشأته، وبحث عميق نحو الفهم والحقيقة.
من هنا يتضح أن الفلسفة، في جوهرها، نشاط إنساني قديم بقدم الإنسان نفسه، فلا يجوز ربط نشأتها بعصر معين، ولا نسبتها إلى حضارة دون غيرها – على خلاف الشائع من إسناد الفلسفة إلى حضارة اليونان.
أولا: النظر الغربي إلى الفلسفة بوصفها منجزا غربيا محضا
غالبا ما يتجاهل الفكر الغربي الفلسفات الشرقية – كالفلسفة الصينية والهندية والإسلامية، بل والفلسفة الإفريقية – رغم قدمها وعمقها. يكفي أن نتأمل كتاب «قصة الفلسفة» للمؤرخ الأمريكي ول ديورانت، الذي خصَّه بفلاسفة الغرب فقط، مبتدئا بأفلاطون منتهيا بجون ديوي، رغم أن عنوانه يوحي بشمولية الطرح. وجزء من ذلك يعود إلى الاستعمار الثقافي والمركزية الأوروبية التي جعلت من الغرب محورًا للعلم والحضارة، فضلًا عن هيمنة جامعاته وأبحاثه التي كرست الاهتمام بالفلسفة اليونانية والغربية، وأغفلت المدارس الفلسفية الأخرى.
ثانيًا: الفلسفة الإسلامية بين التهميش والاختزال
عندما يطرح موضوع الفلسفة الإسلامية، يتجه كثير من الباحثين الغربيين وبعض المفكرين العرب إلى التركيز على الفلاسفة الذين ارتبط فكرهم بالفلسفة اليونانية كالفارابي وابن سينا وابن رشد والكندي. فكلما ذكرت الفلسفة الإسلامية برز الحديث عن هؤلاء، بحكم التأثر الظاهر بالفلسفة اليونانية، خاصة أرسطو. كما يحصر كثيرون الفلسفة الإسلامية في النصوص المترجمة أو الأفكار المستقاة من الفلسفة اليونانية، معرضين عن علوم إسلامية أصيلة تحمل أبعادا فلسفية بارزة، منها:
- علم الكلام: يبحث في أصول العقائد، ويعتمد العقل والمنطق في تناول قضايا الوجود والصفات والحرية والسببية، لكنه يصنف غالبا كعلم ديني لا فلسفي، رغم اشتغاله بمباحث فلسفية.
- علم أصول الفقه: يتناول منهجية الاستنباط، ويناقش قضايا الحكم والدلالة والتعليل، وهو بذلك يستند إلى عمليات فلسفية متصلة بالاستدلال واللغة والمنطق.
- علم التصوف والأخلاق : يُعنى بالبحث في الفضائل والرذائل، وغاية الإنسان وسلوكه، والعلاقة بين العقل والنفس والقلب، وهي قضايا تدخل في صلب الفلسفة الأخلاقية.
ويصح القول إن التاريخ الإسلامي يفيض بعطاءات فلسفية ووجوه فكرية أوسع بكثير مما يصوره الفكر الغربي وبعض المفكرين العرب المتأثرين به. فلو أخذت الفلسفة بمعناها ومضامينها الأصيلة، لأُدرِج ضمن الفلاسفة الكبار كثير من علماء المسلمين، كشيخ الإسلام ابن تيمية، الذي يعد – في ضوء مقاربة الفلسفة بمحتواها لا بتعريفها الغربي – من أعظم فلاسفة المسلمين.
خلاصة الموضوع أن الفلسفة أعرق من أن تختزل نشأتها في اليونان، وأشمل من أن تحصر في نطاق حضاري أو جغرافي بعينه، وأعمق من أن تفسر بمنظار الفئة أو الثقافة الواحدة؛ فهي ملك للإنسانية جمعاء، وميراث عقلاني عريق لا يحسب لشعب أو عصر أو حضارة فقط.