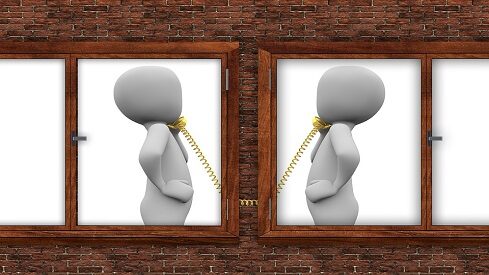تثير عبارة “حظّ النفس” عددًا من الإشكالات؛ تَبَعًا لمسألة (التَّلَقي) التي ينشغل بها حقل اللغويات وتحليل الخطاب؛ ذلك أن الخطاب شيءٌ، وأشكال تَلَقيه شيءٌ آخر، وربما هذا الذي قاد إلى (التداولية) التي تَدرس اللغةَ في استعمالاتها وتنظر في العوامل غير اللغوية التي تؤثر في فهم اللغة. وتَنَوع التلقي يكون بحسب الأشخاص وخلفياتهم، كما يكون بحسب السياقات، وبحسب المُتَحَدَّث عنه.
ومسألة “حظ النفس” تتصل بثلاثة حقول علمية هي: التصوف (علم السلوك أو الباطن)، والفقه (علم الظاهر)، والأخلاق (علم سياسة النفس بتعبير فلاسفة اليونان)، والعلوم الثلاثة تدور حول النفس في الحقيقة وحول تصرفاتها وأفعالها المتنوعة. ولو أضفنا إلى المسألة الأبعادَ الاعتقادية ببعض الأشخاص/النفوس التي يتم تنزيهها عن الحظوظ نكون قد دخلنا في مسائل تتصل بعلم رابع هو “علم الكلام” الذي يناقش العصمة وعدمها، وإمكان وقوع الخطأ من الأنبياء وعدمه.
وإذا كانت العلوم الثلاثة الأولى تبحث في النفس الإنسانية (وكل النفوس سواءٌ من حيث المبدأ وفق قانون كلي)، فإن الاشتغال جرى على فهم هذه النفس أولاً، ثم تهذيبها من مداخل متعددة لتصحيح السلوك وضبط الأفعال بما يحقق الفضائل، وعلى رأسها فضيلة السعادة (سواءٌ كانت دنيوية أم أخروية) .
فالفيلسوف اعتبر العقل (القوة الناطقة) معيار الترقي وضبط شهوات وغرائز النفس، والمتصوف سلك مسلك تزكية النفس لتخليصها من الأبعاد الدنيوية لترتفع إلى مستوى الحضرة القدسية وتكون طاهرة من دَنَس النوازع الشهوية والغرائز؛ لأن الترقي لديه مرتبط بإضعاف الجوانب البشرية وتلاشيها، أما الفقيه فقد سعى إلى ضبط الأفعال الظاهرة للنفس عبر قانون الأمر والنهي الإلهيين وفصَّل علمَه بناء على هذا وقد تحدث القرآن عن قانون النفس الإنسانية كليةً حين قال: “فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا”، كما تناول القرآن الأبعاد النفسية والروحية للرسول ﷺ، وهي المسألة التي لم تُدرَس جيدًا في كتب السيرة النبوية التي انشغلت بالأبعاد النبوية والبطولية عن الأبعاد البشرية والإنسانية والتجارب الروحية لشخص النبي ﷺ، وما أخبارُ نزول الوحي وانقطاعِه وما عاناه النبي جراء ذلك الانقطاع إلا من هذا الباب؛ ولكنّ تَبَدل تصورات الناس عن شخصية النبي هو الذي دفع إلى استنكار بعض الروايات التي كانت مقبولة في الزمن الأول من دون أيّ حرج؛ لأنهم رأوها دليلَ نبوته وكمالِ بشريته ﷺ، ولكنها تحولت إلى مُستنكَرة أو مُستَشكَلَة في العصر الحديث بسبب اختلاف الصورة عن شخص النبي ﷺ أو بسبب سياقات خاصة من التلقي كسياق ردّ الشبهات أو مواجهة الدعاوى.
تَتَبدى الجوانب التي تُحيل إلى بشرية النبي ﷺ من خلال وقائع عديدة، وهي تحيل إلى حظوظ مختلفة، كحادثة الأعمى “عَبَسَ وَتَوَلَّى…”، وحادثة زيد بن حارثة وزوجه زينب ومخاطبة الله لنبيه بقوله: “وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ”، وقد رُوي في هذه الواقعة عن السلف آثارٌ تدل على بشريته ﷺ سَرَدها بعض المفسرين ولكن الإمام ابن كثير (774هـ) رأى أن يَضرب صَفْحًا عن تلك الروايات؛ لأنها لم تصح، ولأنه رأى أنها لا تتناسب مع جلال النبوة رغم أن بعض المفسرين السابقين عليه لم يَرَوا في ذلك أي إشكال.
ومن الحواث كذلك قصة الواهبةِ نفسَها “وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ” التي علق الله فيها الأمر على حظ النبي ورغبته، وكذلك قصة زوجات النبي “تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ” وتحديد عدد زوجات النبي “لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ”.
وهذا الأمر لم يكن خاصًّا بشخص النبي محمد ﷺ، بل تَعَداه إلى الأنبياء الآخرين، فهذا موسى الذي ارتكب جناية القتل الخطأ “فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ”، وأقر بخطئه وأنه ظلم نفسه، ويصفه القرآن بأنه أصبح في المدينة “خَائِفًا يَتَرَقَّبُ”، وفي تفاصيل قصة موسى الكثير من التساؤلات، بعضها يتصل بالتفكير الأخلاقي حول واقعة القتل وهروب موسى ﷺ وإمكان وقوع فعل القتل من نبي إلى غير ذلك، بل إن القرآن يتحدث عن (ظلم النفس) الذي ينطبق على الأنبياء كآدم وموسى، كما ينطبق على باقي المكلفين؛ لأنه يتصل بمبدأ أخلاقي عام ينطبق على الجميع، وهو ما يُحيل إلى هذا المبدأ البشري في النفس الإنسانية التي لم تغادر إنسانيتها حتى لو تَرَقت إلى مرتبة النبوة.
وإذا كان الحديث السابق كله عن أنبياء، فقد تحدث القرآن أيضًا عن رغبات بعض الصحابة يوم أُحُد “حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ” إلى غير ذلك في الخطاب القرآني الثريّ والذي يجب التعامل معه بجدية واستبصار.
ولا حاجة بنا بعد ما سبق إلى إثبات أن الصورة الاستثنائية والمقدسة التي تُضفيها أجزاء من الثقافة الشعبية على آل البيت – مثلاً – هي من تأثيرات الثقافة الشيعية عبر مداخل متعددة من بينها المواريث الفاطمية والفكر الصوفي الذي ابتكر فكرة “السادة الأشراف” التي لم تكن مطروحة في القرون الأولى، دون أن يعني ذلك أي انتقاص أو مواقف مناهضة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو للصحابة أو لآل البيت عليهم رضوان الله تعالى، وعادة ما تخلط الناس بين التوقير والمودة وبين التفكير الموضوعي والتقاط رسالة القرآن المتكررة والمتواترة.
وإذا كان ما سبق يُحيل إلى النفس البشرية وطبائعها وأنها كذلك حتى بالنسبة للأنبياء، فإن فكرة حظوظ النفس تحديدًا تقتضي بعض التفصيل بالنسبة للأفعال الظاهرة. ففكرة مقاصد الشريعة تقوم على مبدأ كلي وهو أن الشريعة مبنية على مصالح العباد في العاجل والآجل، ولكن المصلحة هنا ليست هي حظ النفس بالضرورة؛ لأن المصالح هنا هي مقاصد الشارع سبحانه وتعالى التي وضعها للعباد، ومدارها على الأمر والنهي، والأمر والنهي راجعان إلى حفظ واحد من ثلاثة أمور: إما ما هو ضروري (لا تقوم الحياة إلا به) أو ما هو حاجي (تقوم الحياة من دونه ولكن بمشقة وعَنَت) أو ما هو تكميلي (تحسيني وتزييني)، وكل واحد منها فُهم من الشارع قَصْدُه إليه، أما ما عدا (الأمر والنهي) فهو مجرد نَيْل حظٍّ وقضاء وَطَر.
وعلى ما سبق، فإن المباح الذي ليس أمرًا ولا نهيًا: هو مباحٌ من جهة اعتبار حَظّ المكلف لا غير؛ لأنه لا يُقصد به من جهة الشارع إقدامٌ ولا إحجامٌ، ولا يترتب عليه أمرٌ ضروري ولا حاجيٌّ ولا تحسينيٌّ من حيث هو أمر جزئي، أي أن المباح يرجع إلى نَيل حظٍّ عاجلٍ (دنيوي)، وليس حظًا آجلاً (أخرويًّا).
وقد ابتكر الإمام الشاطبي فكرة مهمة في إطار التمييز بين حظوظ النفس، وهي أن المقاصد الشرعية تكون إما أصلية أو تابعة، ومن خلال هذا التمييز يمكن تَتَبع الحظوظ، وبيانها كالآتي:
– المقاصد الأصلية : وهي تلك التي لا حظَّ فيها للمكلف، وتتمثل في الضروريات المعتبرة في كل دين (حفظ الدين والنفس العقل والنسل والمال)، فهي على الحقيقة قيامٌ بمصالح ضرورية مطلقة لا تَختص بحال دون حال، ولا بصورة دون أخرى، ولا بوقت دون آخر، وتستوي فيها جميع النفوس الإنسانية، وهي تنقسم إلى عينية وكفائية:
ففي المقاصد العينية (الواجب العيني) يُؤمَر المكلف بحفظ دينه ونفسه وعقله ونسله وماله، وفي المقاصد الكفائية (الواجب الكفائي) يكون الواجب مَنُوطًا بالعموم في جميع المكلفين لا بالأفراد، حتى تستقيم المصالح العامة للمجتمع، ومن هنا فإن الواجب الكفائي هو قيامٌ بمصالح عامة لجميع الخلق، وهذا القيام بالشأن العام يجب أن يتجرد عن الحظّ شرعًا؛ ولذلك امتنع على المفتي أن يأخذ الأجرة على فتواه، وامتنع على القاضي أن يأخذ الأجرة – من المتخاصمين – على قضائه وهكذا باقي الوظائف والمناصب العامة؛ لأن استجلاب حظوظ النفس في مسائل الشأن العام من شأنه أن يُخِلَّ بالمصالح العامة وانتظام العدل.
ومن أبرز المسائل التي تَرد هنا طَلَب الولاية/السلطة، وقد أحال الإمام أبو الحسن الأشعري أصل افتراق الأمة إلى مسألة الإمامة، وقال الشهرستاني: “ما سُلَّ سيفٌ في الإسلام كما سُلَّ على الإمامة” السياسية، وما ذلك إلا بسبب الحظوظ النفسية.
والحظوظ وإن كانت تتصل بالباطن من حيث المبدأ، إلا أنها ليست كلها كذلك؛ إذ يمكن الوقوف عليها من خلال القرائن وطبيعة الأفعال وموضوعها، فمن الأفعال ما يتمحض للحظ ومنها ما يختلط بالحظوظ، ومنها ما يُعرَف من خلال النقاشات والخطابات، كما في بعض النقاشات التي دارت بين بعض الصحابة (ابن عباس وابن الزبير والحسين بن علي) رضوان الله تعالى عليهم بخصوص الإمامة مثلاً.
ومن الحظوظ ما وَضع الشرع عليه علامةً تُعرف به كمجرد طلب الولاية/السلطة، قال الإمام الشاطبي: “من المطلوبات الشرعية ما يكون للنفس فيه حظٌّ وإلى جهته مَيْل، فيُمنَع من الدخول تحت مقتضى الطلب؛ فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يُولّي على العمل مَنْ طلَبه”، فرغم أن الولاية مبدأ شرعي إلا أن قَصْد المكلف بنفسه إليها كان مانعًا منها مع كونها مطلوبًا شرعيًّا لإقامة المصالح العامة؛ لأن طلب السلطة يعني القصد إلى حظوظ نفسه ومنافعه المسبَّبة عن الولاية؛ فلا تكون الولايةُ حينئذ مطلوبةً شرعًا, وقال الشيخ عبد الله دراز: “جَعَل الشارعُ من أدلة قَصْد المكلف لحظوظه فيها: طلبُهُ لها, فلذلك مَنَعَ من طلَب الولاية.
– أما المقاصد التابعة : فهي التي رُوعي فيها حَظُّ المكلف، ومن خلالها يحصل للمكلف مقتضى ما جُبِل عليه من نَيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات، وتلبية الحاجات والغرائز والشهوات، لأنه بمقتضى هذا يكون إنسانًا كامل الإنسانية، وإنما يَصلح قيام الدين والدنيا ويستمر بدواعٍ ودوافع نفسية (رغبات وشهوات) من قِبَل الإنسان تحمله على اكتساب ما يحتاج إليه هو وغيره، فالشهوات والغرائز خُلقت لتكون باعثًا إلى التسبّب في تلبيتها؛ ما أمكن.
ومن هنا صارت المقاصد التابعة خادمةً للمقاصد الأصلية ومكمِّلة لها؛ لأن قيام الأصلية لا يَكمُل إلا بالمقاصد التبعية، كما أن وجود المقاصد التبعية لا يكون إلا بعد وجود المقاصد الأصلية، وبهذا المعنى نتحدث عن عمارة الدنيا لأجل الآخرة، وبهذا المعنى اشتغل ابن خلدون بعلم العُمران ونشوء الحضارات، وبهذا المعنى ألح القرآن على “التمتع بالطيبات”، وتم التشنيع على اتجاه الزهد السلبي الذي اعتزل الدنيا بالكلية. وبهذا المعنى قال الله تعالى: “وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا” و”آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً”، فالمقاصد الأصلية تكون على ما يقتضيه مَحض العبودية، والمقاصد التابعة تكون على ما يَقتضيه لُطف الله المالك سبحانه وتعالى بالعباد.
ولكن المسائل (المباحة) التي فيها (حظٌّ محضٌ) للعبد هل يمكن تخليصها من الحظ؟ بمعنى أن يتم إيقاعها بحيث يكون العمل فيها خالصًا لله تعالى وعاريًا عن حظوظ النفس؟ نعم، وذلك إذا تَلقى إذنَ الشارع (الإباحة) بالقبول كَهدية من الله تعالى، بحيث يصير الفعل مجردًا من الحظ النفسي بالنظر إلى الإذن الشرعي ليس إلا، كما لو امتثل للأمر (الطلب) من غير مراعاة لما سواه من مصالح مترتبة عليه، يكون حينها قد تَجَرد عن الحظ (الامتثال المجرد).
وقد حاول الشاطبي الجمع بين النظرين الفقهي والصوفي فجعل الناس في تناولهم لحظوظهم على مراتب هي:
1- من لا يأخذ الحظوظ إلا إذا كانت صادرة بغير إرادته أو بغير طلبٍ منه، كمن لا يدّخر لنفسه شيئًا من عمله؛ يقينًا بما عند الله، أو نسيانًا لنفسه، أو أَنَفَةً من الالتفات إلى حظه مع حق الله، كمن قال الله تعالى فيهم: “وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ”.
2- مَن يعتبر نفسه كالوكيل على مال اليتيم، إن استغنى استعفَّ فلم يأخذ، وإن احتاج أكلَ بالمعروف بما يسد حاجته، وما عدا ذلك يتعفف عنه، ومثال هذا في التجارات والإجارات ألا يأخذ إلا بأقل ما يكون من الربح أو الأجرة.
3- مَن لم يبلغ مبلغ المرتبتين السابقتين، ولكن يأخذ ما أُذِن له فيه من حيث الإذنُ الشرعي، ويمتنع مما مُنعَ منه. وأهل هذه المرتبة (أهل حظوظ)، ولكن لا يسترسلون وراء الحظوظ وإنما يتناولونها من حيث يَصح لهم أَخذُها (المباحات)، فهم لم يأخذوا بمجرد أهدافهم ولكن امتثلوا للأمر والنهي والإذن، كما أنهم لم يتجردوا عن مطلق حظوظهم النفسية فأخذوها من تحت نظر الشارع.
وحصيلة الفكرة هنا أنه يجب تَلَقي الأبعاد البشرية للأنبياء وغيرهم بعين الاعتراف، وإدراك أن كمال النفس الإنسانية في بشريتها، ولذلك امتن الله على الناس أنه بعث رسولاً منهم يأكل ويمشي في الأسواق؛ لأن مفارقته للبشرية تُخلّ بإمكان التأسي به وتنزيل نموذجه على أرض الواقع، فكونه أسوةً متأسس على كونه واحدًا من البشر (إلا أنه يُوحى إليه)، وإذا تقرر هذا وجب الحذر من تقديس الأشخاص مهما عَلَوا، وأن ظاهرة تقديس الأشخاص لمشيخة أو نَسب أو غير ذلك هي مخالفة للخطاب القرآني الذي يشكل المرجعية الحاكمة للتصورات الدينية، وأن الحظوظ النفسية لا يَعرَى عنها أحدٌ من البشر، ولكن الناس يتفاوتون في تناولهم لها واسترسالهم معها ومقاصدهم من تعاطيها.
تنزيل PDF