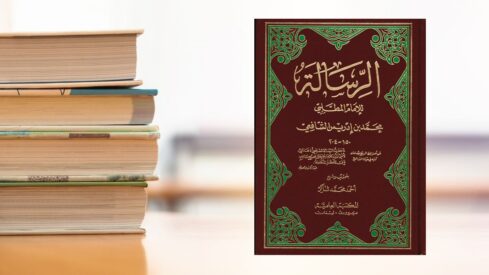الإمام الشافعي بين أهل الرأي وأهل الحديث : من الشائع بين دارسي تاريخ التشريع الإسلامي أن الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت. 204هـ) “جمع” بين مدرستي أهل الحديث وأهل الرأي، وهي مقولة تحتاج -في رأيي- إلى تأمل نقدي؛ على الرغم من وجود بعض الشواهد التي قد تدعمها أو تحمل عليها؛ إذا ما غضضنا الطرف عن معطيات أخرى أوسع وأشمل، وهذا يثير مسألة منهجية هنا تتصل بكيفية التأريخ لفكرة ما، وتكوين تصور أدق عن الواقع التاريخي.
ما أراه هنا أن الشافعي كان من أهل الحديث، ولهذا فإن إطلاق أهل مكة لقب “ناصر الحديث” على الشافعي يصلح ليكون مقولة تفسيرية، في حين أن مقولة “التوفيق” بين أهل الحديث وأهل الرأي تبدو كما لو أنها مقولة صيغت لمحاولة جَسْر الهوة التي تعمقت -في فترة مبكرة- بين الفريقين؛ بدءًا من القرن الثاني الهجري.
ولكن كيف نبرهن على ذلك؟ يتلخص المنهج هنا وفي المقال القادم -بمشيئة الله تعالى- في 3 مسائل رئيسة:
- المسألة الأولى: دراسة السياق. والسياق هنا يحمل معنيين:
- الأول سياق تأليف كتاب الرسالة للشافعي الذي هو نص مركزي هنا، ومن ثم سماه الشافعي “الكتاب”. فتأليف الكتاب -بوصفه حدثًا- لا بد من وضعه في سياق حتى يكون له معنى؛ لأننا نفترض أن مثل هذا الحدث المتميز -في بنيته وتأثيره التاريخي والتشريعي- لا بد له من سياق أوسع من مجرد تأليف كتاب.
- والمعنى الثاني هو السياق التاريخي الأوسع الذي جاء فيه الكتاب أو وقع فيه الحدث.

- المسألة الثانية: تلقي كتاب “الرسالة” (أو “الكتاب”) بعد تأليفه وفي زمن الشافعي أو قريبًا منه، كما تزودنا به كتب التراجم التي هي مصدر مهم من مصادر التاريخ قد يهمله بعض الباحثين في التاريخ؛ خصوصًا أنها سميت “تاريخ” -على الاصطلاح- في لغة الأئمة السابقين، كما أن فتاوى النوازل مصدر آخر مهم في التأريخ قد يغفل عنه بعض المؤرخين.
- المسألة الثالثة: تحليل مضمون كتاب الرسالة؛ لأن المضمون هو المعبر الأصرح عن مراد أو غايات مؤلفه، ويظهر ذلك من خلال المسائل التي ناقشها الشافعي، ومن الاعتراضات التي يفترضها ويرد عليها في الكتاب. في هذا المقال سأكتفي بمناقشة المسألتين الأوليين فقط، على أن أفرد للمسألة الثالثة مقالاً مستقلا بمشيئة الله تعالى.
سياق تأليف كتاب الرسالة
ثمة خبر مركزي يوضح لنا حيثيات تأليف كتاب “الرسالة”، فقد وردت أخبارٌ عديدة -بألفاظ مختلفة- توضح أن الكتاب جاء ثمرة تواصل بين الإمام المحدث المعروف عبد الرحمن بن مهدي (ت. 198هـ) وبين الإمام الشافعي. وكتب ابن مهدي إلى الشافعي يسأله أن يضع له كتابًا يوضح فيه معاني القرآن (أي طرق البيان)، ويجمع فيه قبول الأخبار (أي معايير قبولها والاحتجاج بها)، وحجة الإجماع (أي حجيته)، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، فوضع له الشافعي كتاب “الرسالة”.
ويلخص هذا الخبر -في الواقع- محاور كتاب “الرسالة” أو أصول التشريع التي ترجع إلى القرآن والحديث والإجماع، ولكن الأهم هو أن الطلب جاء من أحد كبار أئمة الحديث في زمنه وهو ابن مهدي. وإذا ما ضممنا هذا إلى أخبار أخرى -سأذكرها لاحقًا- أمكن لنا أن نخلص إلى أن الحاجة إلى مثل ذلك الكتاب لم تكن -فقط- حاجة فردية وُجدت عند ابن مهدي. فهذا الإمام المحدث يحيى بن سعيد القطان (ت. 198هـ) كان من المستفيدين من كتاب “الرسالة” والمتباهين به أيضًا.
ونقف -في بعض الأخبار- على أنه جرت بين الإمام المحدث المعروف إسحاق بن راهويه (ت. 238هـ) والإمام أحمد بن حنبل (ت. 241هـ) مراسلاتٌ بخصوص كتب الشافعي، وخاصة كتاب “الرسالة” الذي انتفعا به انتفاعًا كبيرًا. فهذه الأخبار تجعل -في الواقع- من رسالة الشافعي نصرًا لأهل الحديث على أهل الرأي، من منظور أهل الحديث على الأقل.
طرائق التفكير الفقهي زمن الشافعي
لخص فخر الدين الرازي الشافعي (ت. 606هـ) طرائق التفكير الفقهي زمن الشافعي بالقول: “إن الناس -كانوا قبل الشافعي- فريقان: أصحاب الحديث، وأصحاب الرأي (..) وأصحاب الرأي أظهروا مذاهبهم وكانت الدنيا مملوءة من المحدثين ورواة الأخبار، ولم يَقدر أحد منهم على الطعن في أقاويل أصحاب الرأي”. في القرن الثاني الهجري كان أصحاب الحديث قد برزوا وصاروا طائفة أو جماعة، وصار ذلك الاسم عَلَمًا على صنعة الاشتغال بالحديث، وخاصة بعد الجمع الرسمي لأقوال النبي ﷺ الذي بدأه محمد بن شهاب الزهري (ت. 124هـ) بأمر من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز (ت. 101هـ).
وقد تحولت الأحاديث مع القرآن -أو كادت- إلى مصدر حصري للتشريع في مقابل أصحاب الرأي الذين توسعوا في استعمال الرأي في مسائل التشريع حتى شمل الرأي -عندهم- 3 أصناف من الحجج:
- القياس على وقائع عرف حكمها بالنص بجامع التشابه بينهما أو وجود علة مشتركة بين الأمرين.
- الاجتهاد بمعناه الواسع الذي يحيل إلى إعمال العقل وتحكيم الخبرات.
- الاستحسان الذي شكل خروجًا عن الانضباط الذي فرضه القياس على واقعة أو حكم سابق، لدواعي المصلحة، الأمر الذي قد يخلف ثغرات أو عدم اتساق في التسويغ النظري.
ويوحي نص الرازي السابق ببروز أهل الرأي على أهل الحديث؛ رغم كثرتهم، ويرجع ذلك في تقديري إلى اختلاف طبيعة منهج الفريقين؛ سلطة النقل وسلطة الحِجاج بأدواته المختلفة، أي أنه لم يكن ثم أرضية مشتركة بين الطرفين من ناحية المنهج.
ولكن النقطة التي تستوقفنا هنا في القرن الثاني الهجري، أنه بالرغم من كون الأرض مملوءة بالمحدثين والصنعة الحديثية، فإن الحديث لم يتحول -فيما يبدو من مصادر عديدة- إلى اتجاه عامّ أو حصريّ في التفكير الفقهي؛ مع ظهور أهل الرأي وتوسعهم في استعماله، بل إن الأمر لم يكن قاصرًا على الفقهاء، بل شمل القضاة كذلك؛ فالقاضي لا بد له من الحكم في المسألة، فماذا يفعل إن أعوزه النص مع كثرة الوقائع وقبل تبلور المذاهب الفقهية!
ثم عندما كثرت رواية الحديث برز إشكال الثقة بالمروي؛ فقد أسفر الجمع الواسع وكثرة المرويات عن نتائج وآثار جانبية تتصل بالوضع من جهة، وبالنسخ من جهة ثانية، وبالوقوف على أحاديث متعارضة من جهة ثالثة، خصوصًا أن هذه الأحاديث قد تتعارض مع ما رسخ في العمل (التقليد الحي) الذي عرفه المسلمون الأوائل وجروا عليه، ومن هنا ذهب أهل المدينة النبوية إلى أن ما عرفوه من ممارسة حية (عمل أهل المدينة) هو جزء من السنة النبوية، ولا يقبلون من الأحاديث القولية ما يخالفه، وبذلك أصبح عمل أهل المدينة أحد المعايير في تحديد قبول الأخبار وتحديد ما هو سنة تُحتذى.
ونحو ذلك فعل أهل العراق حين أَوْلَوا “السنة المشتهرة” أو “العمل المتوارَث” أهمية كبيرة، وأضفوا بعدًا عقلانيًّا على فهم الحديث، وخاصة من خلال اعتمادهم على الصحابة الذين غادر كثير منهم الحجاز ليستقر في العراق، ولذلك اعتمد فقهاء العراق على أقوال الصحابة واحتجوا بها؛ ما لم تتعارض فيما بينها؛ لأن اتفاقهم يورث الثقة بما لديهم من السنة. وكذلك اهتم الإمام الأوزاعي في الشام بالسنة النبوية التي تشبه عنده مفهوم أهل المدينة، بمعنى العمل المتوارث. أي أن الرأي بمعناه الواسع، والعمل المتوارَث الذي شكّل معيارًا يُرتكن إليه لتحديد ما هو سنة؛ خصوصًا إذا وقع التعارض بينه وبين الأحاديث القولية، هما سمتان أساسيتان من سمات تاريخ التشريع الإسلامي خلال القرن الثاني الهجري، كما نقف عليه من خلال المصادر المبكرة.

وظهر الشافعي في هذا السياق، وقد رحل وتتلمذ على أعلام من كلتا المدرستين؛ أهل الحديث (وخاصة الإمام مالك بن أنس) وأهل الرأي (وخاصة محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة). ومن النصوص بالغة الدلالة التي توضح لنا طرفًا من تفكير الشافعي ورؤيته لخارطة التفكير الفقهي في زمنه، نصٌّ يُفيد أن الشافعي سأل تلميذه الربيعَ بن سليمان عن أهل مصر، فقال له الربيع: “هم فرقتان: فرقة مالت إلى قول مالك وناضلت عليه، وفرقة مالت إلى قول أبي حنيفة وناضلت عليه. فقال الشافعي: أرجو أن أَقدُم مصر -إن شاء الله- فآتيهم بشيء أشغلهم به عن القولين جميعًا.
قال الربيع: ففعل ذلك والله حين دخل مصر!”. أي أنه ابتكر طريقًا ثالثًا يُقيّد استعمال الرأي في أضيق الحدود من جهة، ويتجاوز مشكلة عدم الاتساق في اتباع الحديث التي ظهرت عند مخالفيه من جهة أخرى؛ ومن ثم انتقد ترك الحديث بحجة معارضته للعمل المتوارث في المدينة النبوية، وبهذا وسع حجية الحديث النبوي الذي هو -عنده- أصل بنفسه.
تلقي كتاب “الرسالة”
في التأريخ لفكرة محددة (أو كتاب) لا غنى عن الوقوف على الشكل الذي تُلُقِّي به ذلك الكتاب في زمن مؤلفه أو قريبًا منه على الأقل؛ لأن التلقي -مضمومًا إلى العنصرين السابقين- يقربنا من الواقعة التاريخية ويعطينا رؤية أدق للحدث. لنتأمل -مثلاً- هذا النص الذي يقول فيه أحمد بن حنبل: “كانت أَقْفِيَتُنَا -يعني أصحابَ الحديث- في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تُنْزَعُ، حتى رَأَيْنَا الشافعي رضي الله عنه، وكان أَفْقَهَ الناس في كتاب الله عز وجل، وفي سنة رسول الله ﷺ؛ ما كان يكفيه قليل الطلب في الحديث”.
ونحو ذلك جاء عن الإمام المحدث أبي بكر الحُمَيْديّ (ت. 219هـ): الذي قال: “كنا نريد أن نَرُدَّ على أصحاب الرأي، فلم نُحْسِنْ كيف نرد عليهم؛ حتى جاءنا الشافعي، فَفَتَحَ لنا”. هذه الأخبار شديدة الأهمية؛ لأنها واردة عن الطبقة الأولى المحيطة بالشافعي من أهل الحديث؛ فأحمد تتلمذ على الشافعي، والحميدي صحب الشافعي، وكلاهما من أصحاب المسانيد، وقد جاءت هذه الأقوال عنهما بسند عال. وهي أخبارٌ غنية الدلالة في وصف صنيع الشافعي؛ الذي نصر أهل الحديث ونفعهم بأمرين:
- أنه زودهم بحجج نظرية يجادلون بها أهل الرأي بعد أن عجزوا عن ذلك قبل كتابه؛ لعدم استعمالهم للرأي وقلة خبرتهم به، وبهذا فتح الشافعي الطريق لأهل الحديث في الحجاج النظري. ومن هنا وصف حسين الكَرابيسيّ الشافعي بقوله: “ورد رجل من أصحاب الحديث يتفقه”، وهذا الوصف من رجل كان يختلف إلى أهل الرأي شديد الأهمية؛ لأنه يصنف الشافعي ضمن أهل الحديث؛ منهجًا، ومن ثم قال الفقيه موسى بن أبي الجارود عن الشافعي: “اجتمع له علمُ أهل الرأي وعلم أهل الحديث، فتصرف في ذلك حتى أصَّل الأصول وقعَّد القواعد، وأذعن له الموافق والمخالف، واشتهر أمره”، أي أنه تسلح بأدوات أهل الرأي لنصرة الحديث كما هو واضح جدًّا في عمله وفي تلقي أهل الحديث لكتابه، لا بمعنى أنه وفق بين الفريقين؛ لأنه إنما قعد وتصرف بناء على طريقة أصحاب الحديث، ونُصرة لمنهجهم.
- أن الشافعي كان يستكثر من الحديث ويضيّق حدود الرأي؛ لأنه يعد الحديث أصلا بنفسه وحجة بنفسه، وهو القائل: “إذا صح الحديث فهو مذهبي”. وهذا معنى قول أحمد: إن الشافعي “ما كان يكفيه قليل الطلب في الحديث”، وقد عبر الإمام إسحاق بن راهويه عن هذا المعنى حين قال: “ما تكلم أحدٌ بالرأي -وذكر الثوري والأوزاعي ومالكًا وأبا حنيفة- إِلا الشَّافِعِيَّ أكثرَ اتِّبَاعًا وأَقَلّ خطأ منه”؛ لأن الشافعي ضيّق مساحة الرأي لصالح حجية الحديث واعتباره أصلاً بنفسه، الأمر الذي حمل آخرين على انتهاج نهجه والانضباط في استعمال الرأي، وهو ما عبر عنه الإمام الفقيه أبو ثَوْر (ت. 240هـ) الذي قال: “كنت أنا وإسحاقُ بن راهويه وحسين الْكَرَابِيسِيُّ -وذكر جماعة من العراقيين- ما تركنا بدعتَنا حتى رأينا الشافعي”. وأبو ثور ممن صحب الشافعي ونقل عنه. ولقد أوجز فخر الدين الرازي، وجمع فأوفى؛ حين قال: “إن الشافعي جاء وأظهر ما كان معه من الدلائل والبينات، فرجع عن قبول قول أصحاب الرأي أكثرُ أنصارهم وأتباعهم”.
الإمام الشافعي وضبط الاجتهاد الفقهي من خلال حجية الحديث
أوضحت أن الشافعي كان من أهل الحديث، ولم يوفق بين أهل الرأي وأهل الحديث كما شاع لدى بعض الدارسين. ولإثبات ذلك ناقشت -في ما سبق- مسألتين: السياق الذي ظهر فيه الشافعي، والسياق الذي ألف فيه كتاب “الرسالة” من جهة، وكيفية تلقي كتاب “الرسالة” في زمن الشافعي من جهة أخرى.
سأضيف مسألة ثالثة للبرهنة على تلك الفكرة، وهي الأهم في الواقع، لأنها المعبر الحقيقي عن عقل الشافعي وفكره، وهي مضمون كتاب الرسالة نفسه الذي شكل ما يشبه الثورة العلمية في زمنه وبعده، والتي يمكن تلخيصها -في رأيي- في الانتقال ضمن دائرة أهل الحديث من مرحلة “السنة” التي كانت تحيل إلى مفهوم واسع للعمل المتوارث إلى مرحلة “الحديث النبوي”، وبهذا لم يخالف فقط أهل الرأي، خاصة من الحنفية، وإنما خالف أيضا من حسبوا على دائرة أهل الحديث كإمام دار الهجرة مالك بن أنس (ت: 179هـ).
يدور كتاب “الرسالة” للشافعي على ضبط الاجتهاد الفقهي من خلال وضع منهجية متماسكة يتحقق لها الانضباط والاتساق، وقد قام الشافعي بذلك من خلال 3 مسائل مركزية تتلخص في:
- البيان.
- تثبيت خبر الآحاد.
- ضبط مفهوم الاجتهاد الذي كان واسعا في زمنه ويفتقر -عند الفقهاء السابقين عليه- إلى الاتساق من منظور الشافعي على الأقل.
ومن خلال هذه المسائل المنهجية أمكن لمنهجية الاجتهاد أن تجري على قانون عام وفق عقلية الشافعي المنظمة. ولكن المسائل الثلاث السابقة تدور -في الواقع- حول هدف مركزي ومحدد هو حجية الحديث النبوي الذي يجب أن يشكل عماد التفكير الفقهي، ومن ثم كان الشافعي -في رأيي- أول من “نظر” للقول بحجية خبر الآحاد، وإن لم يكن أول من قال بذلك، وهذه هي الإضافة التي أضافها لأصحاب الحديث الذين انتفعوا بكتابه أيما انتفاع، وعدوه نصرا لهم، كما سبقت الإشارة في المقال السابق.
يستهل الشافعي مقدمة “الرسالة” للتركيز على الدور المحوري والمركزي لشخصية النبي ﷺ ودوره في هداية البشرية، وكتاب الرسالة يحاجج لإثبات أن الوحي نوعان: وحي متلو هو القرآن، ووحي غير متلو هو الحديث النبوي، وكلاهما يهديان البشرية ويبينان حكم الله في الأفعال والوقائع. ويمكن أن نرصد رؤية الشافعي لتثبيت حجية الحديث من خلال 4 أفكار مركزية مبثوثة في الكتاب، وهي:
الفكرة الأولى: شمولية نصوص الوحي
فالشافعي يبدو حريصا على بيان اشتمال النص على أحكام تستوعب أفعال العباد وما ينزل بهم الآن ومستقبلا، بحيث لا يعزب عن النص شيء. فسلطان النص يطول كل ما يجد من نوازل، وهو يصرح بهذه الفكرة منذ بداية الكتاب فيقول “ليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها”.
وبما أن الحديث -عند الشافعي- وحي مثل الكتاب، “فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه: قبل عن رسول الله سننه، بفرض الله طاعة رسوله على خلقه، وأن ينتهوا إلى حكمه. ومن قبل عن رسول الله فعن الله قبل، لما افترض الله من طاعته”. وقد ساوى الشافعي -بهذا- بين نصي القرآن والحديث في الحجية وكونهما مصدرا للهداية والتقويم من جهة، وأثبت حجية النص الثاني (الحديث) من خلال النص الأول (القرآن) المجمع على مرجعيته من جهة أخرى، وبهذا أغلق دائرة الاحتجاج من خلال مفهوم مركزي هو وجوب طاعة الرسول الثابتة بالنص القرآني، وأن الحديث يمثل شخص النبي ﷺ في غيابه.
هذه الحجة تمثل -في الواقع- حجة أهل الحديث ضد خصومهم، ومن ثم انبنى عليها اتهام المخالفين بمخالفة النبي ﷺ أو مخالفة سنته، وللخروج من هذا الاستدلال المغلق نبه بعض فقهاء الحنفية -في ما بعد- إلى ثغرة في مثل هذا الاستدلال وهي أن قول النبي ﷺ موجب للعلم باعتبار أصله (أي في ما لو سمعناه من فم النبي ﷺ)، وإنما الشبهة في النقل عنه، وأن النقاش كله إنما يدور حول هذه الأحاديث المروية بالأسانيد.
الفكرة الثانية: نظرية البيان عند الشافعي
صحيح أن الشافعي دافع عن كون النصين وحيا وعن الاتساق فيما بينهما بلا تعارض وعن تساويهما في الحجية، فإن الحديث النبوي سيشكل -عمليا- المرجعية الأوفر حظا في الاجتهاد الفقهي، نظرا إلى الإجمال والإيجاز الواقع في النص القرآني، والطبيعة التفصيلية التي اتسمت بها مدونة الحديث النبوي. وسيتضح هذا من خلال نظرية البيان عند الشافعي، فقد حصر البيان الإلهي في 4 أنواع:
- منصوص الكتاب أو القرآن (كالصلاة والزكاة والحج وغيرها).
- الحديث المبين لمجمل منصوص الكتاب (كعدد الصلوات والزكاة وغيرها).
- السنة الزائدة على ما في الكتاب والتي جاءت بما ليس في نص الكتاب.
- ما يجب الاجتهاد في طلبه من خلال النصوص على سبيل الطاعة لله، وليس مطلق الاجتهاد.
ويوضح البيان وفق هذا التصور 3 أمور:
- أن مرجعية الحديث غالبة هنا في وظيفة البيان، بل تتقدم على الكتاب كما هو مذهب بعض الأصوليين في ما بعد، فوظيفة البيان التي تتضمن التفصيل من جهة، والزيادة على نص القرآن من جهة أخرى، جعلت الحاجة إلى الحديث أشد من الحاجة إلى القرآن، ومن ثم قال الأوزاعي “الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب”، وقال يحيى بن أبي كثير “السنة قاضية على الكتاب”. وسئل أحمد بن حنبل عن عبارة “إن السنة قاضية على الكتاب”، فقال “ما أجسر على هذا أن أقوله، ولكن أقول: إن السنة تفسر الكتاب وتبينه”. وفسر الإمام ابن عبد البر (ت: 463هـ) قضاء السنة على الكتاب بالقول “يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه”. ومن الواضح أن هذه المقولات تلتقي مع اتجاه الشافعي هنا، كما أن أصحابها من المحسوبين على اتجاه أهل الحديث، فالإمام الأوزاعي (ت: 159هـ) كان محدثا وفقيها، وعده عبد الرحمن بن مهدي ضمن 4 هم كبار أهل زمانه، وهم حماد بن زيد بالبصرة والثورة بالكوفة ومالك بالحجاز والأوزاعي بالشام. وقال فيه الشافعي نفسه “ما رأيت رجلا أشبه فقهه بحديثه من الأوزاعي”، ويحيى بن أبي كثير (ت: 129هـ) كان من صغار التابعين وهو إمام حافظ.
- محورية “الطاعة” بوصفها قيمة أخلاقية ومعرفية ودينية معا، فالطاعة معناها الامتثال الواجب، وهي حجة متفق على ثبوتها ولا ينازع فيها الخصوم، وهي مسألة تعبدية، لصيقة بفكرة النبوة والقبول عن النبي رسالته.
- أن الاجتهاد الفقهي مداره على مرجعية النص، ونبذ الرأي بمعناه الواسع الذي كان سائدا في زمن الشافعي، وهذا ينقلنا إلى الفكرة الثانية التي تستحق أن تفرد لأنها ركن من أركان أطروحة الشافعي وليست مجرد تفصيل من التفصيلات.
الفكرة الثالثة: أن العقل لا يمكنه أن يسرح خارج سياج النص
وهذه الفكرة تأسست -عند الشافعي- على الفكرة الأولى السابقة، وهي أن النص لا يعزب عنه شيء من أفعال البشر، ولذلك فإن كل ما يستجد من نوازل ففي النص دليل على حكم الله فيه. ولأجل ذلك وضع الشافعي كتاب الرسالة لضبط عملية الاجتهاد في زمنه التي تراوحت بين اجتهاد سرح خارج حدود النص مع عامة أهل الرأي، واجتهاد آخر سرح في مخالفة النص مع بعض المحسوبين على أهل الحديث كالإمام مالك الذي كان يترك الحديث لمخالفة عمل أهل المدينة أو لقول الصحابة أو لمخالفة الأصل القرآني أحيانا.
بهذا ضيق الشافعي مفهوم الرأي الواسع الذي أوضحت في مقال الأسبوع الماضي أنه كان يشمل 3 أمور (الاستحسان، والقياس، وإعمال العقل)، وقيده بآلية منهجية هي “الاستدلال” فقال “ليس لأحد دون رسول الله أن يقول إلا بالاستدلال… ولا يقول بما استحسن، فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق”. والاستدلال هنا معناه طلب الدليل من خلال النصوص بالحمل عليها وهو القياس، ولذلك قال “الاجتهاد القياس”، والقياس عند الشافعي بمنزلة الضرورة، لا يلجأ إليه إلا في حالة انعدام النص الصريح الدال على النازلة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن “الاستدلال” في اصطلاح الشافعي هنا يختلف عنه في اصطلاح أصوليي الشافعية المتأخرين الذين يطلقونه على طلب الدليل من خارج المصادر الأربعة: القرآن والحديث والإجماع والقياس. ولست أرى -كما رأى ابن الرفعة من فقهاء الشافعية الكبار- أن الشافعي أراد هنا التمثيل للاجتهاد بالقياس لا حصره به. والقياس عند الشافعي لا يكون إلا على ظاهر الخبر لا على باطنه، أي هو قياس جزئي وليس قياسا على القواعد الكلية، أو قياس الأصول على طريقة فقهاء الحنفية، وهو قياس لا يقوم على استثناء، ومن ثم فالأحاديث التي تمثل استثناءات ينبغي استبعادها من دائرة القياس، لأنها واردة على الخصوص، ومن ثم كان الشافعي معنيا ببحث مسألة “الخبر الذي يقاس عليه والخبر الذي لا يقاس عليه”.
الفكرة الرابعة: أن الحديث أصل بنفسه
وهذا التعبير يعني 3 أمور:
- أن “الخبر عن رسول الله ﷺ يستغني بنفسه، ولا يحتاج إلى غيره، ولا يزيده غيره -إن وافقه- قوة، ولا يوهنه -إن خالفه- غيره”. فههنا وضع الشافعي أصلا معرفيا ومنهجيا معا. فهو أصل معرفي من جهة أن الحديث -بذاته- مصدر للمعرفة، بوصفه دليلا هاديا إلى حكم الله. وهو أصل منهجي من جهة أن الحديث الحجة لا يفتقر إلى غيره لإثبات حجيته، كما أنه لا يؤثر في حجيته أي معارض خارجي، سواء كان عقليا أو نقليا. قال الشافعي “حكم بعض أصحاب رسول الله إن كان يخالف الخبر فعلى الناس أن يصيروا إلى الخبر عن رسول الله ويتركوا ما يخالفه”. وبهذا خالف الشافعي أبا حنيفة ومالكا معا، ممن يترك الخبر لمخالفته القياس أو لمخالفة العمل أو يتركه لأقوال الصحابة أو غير ذلك.
- “أن بالناس كلهم الحاجة إلى الخبر عن رسول الله ﷺ والخبر عنه” كما قال الشافعي، لأن الحديث مصدر هداية إلى بيان الله لأحكام الواقعات، ومن ثم كان الخبر النبوي متبوعا لا تابعا، ويجب تحريه وتناقله.
- أن الحديث الجزئي المعين أصل بنفسه في الدلالة على حكم المسألة، ولا يؤول في ضوء نص عام أو قانون كلي، ويظهر مصداق هذا في فروع الفقه الشافعي. واعتبار الحديث أصلا بنفسه هو أبلغ دليل على كون الشافعي من أهل الحديث.
وبناء على أطروحة حجية الحديث بأفكارها الأربع السابقة، انشغل الشافعي بمسلكين: مسلك “تثبيت” خبر الآحاد من ناحية التنظير له ولحجيته، وفق أسس نصية وحجج نظرية، ومسلك جدلي يعنى بالرد على الخصوم، والإجابة عن إشكالاتهم المتصلة بحجية الحديث وهو ما أسعف به أصحاب الحديث ولم يكونوا قادرين عليه قبله، ويمكن أن نلتمس مظاهر هذا في 3 نواح تتصل:
- بحجية الحديث.
- ومصطلحه.
- وتأويله.
- في الناحية الأولى: دفع الشافعي كل الاعتراضات الواردة على حجية الحديث، وفي هذا السياق رد على 3 فرق: فرقة أنكرت الحديث جملة، وفرقة ردته إلا إذا كان معه قرآن يؤيده، وهنا طرح فكرة استقلال السنة بالتشريع، وفرقة ثالثة ردت أخبار الآحاد، وهنا أثبت أولوية الحديث على السنة (بمعنى العمل)، كما أنه قسم الأخبار إلى نوعين: خبر عامة، وخبر خاصة.
- وفي الناحية الثانية: كان الشافعي أول من دون رؤوس مسائل علوم الحديث، وعليه عول علماء مصطلح الحديث فيما بعد، وجمهورهم كانوا من الشافعية، فلعله أول من عرف الحديث الذي تقوم به الحجة (استجابة لطلب عبد الرحمن بن مهدي كما سبق)، وتحدث في ضبط الرواة وغلطهم، والرواية بالمعنى، وقوة الإسناد بتعدده، وحكم الاحتجاج بالحديث المرسل والمنقطع والمدلس، والفرق بين الرواية والشهادة إلى غير ذلك من المسائل الاصطلاحية التي أصبحت من صلب علوم الحديث.
- وفي الناحية الثالثة: بحث جملة مسائل تتصل بفهم الحديث وتأويله، كالوظيفة البيانية للسنة، وأنها تحمل على لسان العرب، وأنه يجب حمل الحديث على ظاهره حتى يرد دليل على إرادة غير هذا الظاهر، وأفاض في مقام “السنة مع القرآن” وأنها تبين مجمله، وتقيد مطلقه، وتخصص عامه، وتستقل بالتشريع. وقرر أنه لا يخالف حديث كتاب الله أبدا. وبحث في اختلاف الحديث، وقرر أن كل الأحاديث الثابتة متفقة، وما كان ظاهره التعارض أمكن الجمع بينه.
فأطروحة الشافعي تقوم -إذن- على تثبيت خبر الآحاد وتقديمه على ما سواه من رأي أو قول، وأنه “بيان” للقرآن، وهي وظيفة النبي ﷺ، وأنه لا يمكن معرفة السنة (العمل المتوارث) إلا من خلال الأخبار المنقولة عن رسول الله ﷺ، على خلاف ما شاع في فقه المدينة والشام والعراق في زمنه، يقول “ولم يكن أحد غاب عن رؤية رسول الله ﷺ يعلم أمر رسول الله إلا بالخبر عنه”، ويقول “إذا ثبت عن رسول الله الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه، لا يقويه شيء ولا يوهنه شيء غيره، بل الفرض الذي على الناس اتباعه”.
يمكن القول إن نظرية الشافعي تتلخص في الانتقال من مرحلة “السنة” إلى مرحلة “الحديث” الذي يشتمل على السنة بل ويحددها، فقد تعزز الخلاف قبل الشافعي بين “السنة” و”الحديث”، وقد نقلت في كتابي “رد الحديث” أقوالا كثيرة في هذا المعنى ترجع إلى عصر ما قبل الشافعي، توضح كيف كان سابقوه يقدمون العمل على الحديث (الخبر).