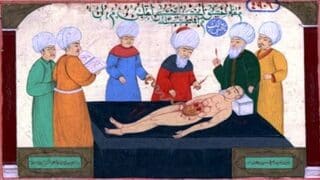شدد المؤرخ والمفكر العراقي د. عماد الدين خليل على ضرورة تفعيل علاقتنا بالخطاب القرآني والنبوي، كما فعل الأجداد زمن تألّقهم الحضاري، وقدرتهم المدهشة على تغيير العالم وإعادة بنائه من جديد. وأوضح أن منظومتنا الفكرية، التي ينطوي عليها كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، تتضمن حشدًا من المفاهيم التأسيسية الضرورية في أية محاولة للتغيير.
ولفت د. خليل إلى أن منظومتنا الفكرية تقوم على (مثلث الفعل الحضاري) والذي يتضمن ثلاثة مبادئ: التسخير، الاستخلاف والاستعمار. بجانب منهجيات: ربط الأسباب بالمسببات، التأكيد على قوانين الحركة التاريخية، منهج البحث الحسّي التجريبي الذي اكتشفه ونفذه الأجداد بقوة الإضاءات القرآنية.
وأكد أن التغيير ليس فعلاً سياسيّا فقط، وإنما هو جملة من الشروط النفسية والسلوكية والاجتماعية والفكرية والأخلاقية، الواجب توافرها في أية جماعة تسعى إلى التغيير.
في هذا الحوار الذي خص به “إسلام أو لاين” يطل المؤرخ والمفكر العراقي المرموق د. عماد الدين خليل، على قضايا عدة تتصل بالشروط اللازمة للتغيير، وبدرس التاريخ الذي ينبغي أن نستلهمه في واقعنا. فإلى تفاصيل الحوار :
– ما الشروط الواجب توافرها من زاوية “السنن الاجتماعية” حتى تُؤتِي حركات الشعوب نحو التغيير ثمارها وتحقّق الآمال المعلقة عليها؟
ما لم يتم الانتباه جيداً لمطالب “السنن الاجتماعية” فلن تجيء الاستجابة المناسبة لهذه التحديات. والسنن الاجتماعية شبكة متداخلة من العوامل والمؤثرات التي يتحتم الإمساك بها جميعًا لاجتياز المحنة والخروج إلى برّ السلام.
ومن بين هذه العوامل والمؤثرات: تجاوز “الأنا” والعمل المتواصل بروح الفريق ونبذ الفرقة والاختلاف، والتحقق بأعلى وتائر الشورية والحرية في التعامل مع المشاكل والتحديات، والتوحّد بين مطالب هذا الدين وبين مفردات السلوك بمفاصلها ومنحنياتها كافة. وتشغيل الطاقات العقلية بأقصى حدود الاحتمال.والارتفاع في التعامل مع القضايا الكبيرة إلى أفق الفقه المقاصدي وفقه الموازين الذي يمنح فضاءً واسعًا للعمل المبدع والوصول إلى نتائج مرضية.
بالإضافة إلى تجاوز كل الأخطاء التي شهدها تاريخنا عبر مجراه الطويل، والتي قادت إلى تحكم الطواغيت في رقاب الشعوب، من مثل الظلم الاجتماعي، والانصياع للاستبداد السياسي، وترك مبادئ الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتشبث بالرؤية الإرجائية التي تفك الارتباط بين الإيمان والعمل، وانتشار تيارات الصوفية المنحرفة عن مسارها الأصيل، ومعها الأضاليل والخرافات. وغياب مفهوم التوحيد وتسلل الشرك والصنمية، والفصام النكد بين القيادتين الفكرية والسياسية، وطغيان القبلية والإقليمية والعرقية على مفهوم الأمة، وانتشار الترف والتكاثر، والتحلل الخلقي والسلوكي، والفساد الإداري، والتمزق المذهبي، وانتشار الغلوّ والتشدد، وغياب الاجتهاد وسيادة التقليد والاتباع، وغياب العلم وانتشار الجهل، والصراع بين الثنائيات، وفوضى التعامل مع خبرات “الآخر” وتضاؤل القدرة على توظيف الزمن والمكان.
هذه كلها، وغيرها كثير، لو تمّ تجاوزها، واعتماد البدائل المناسبة، فإن حركات الشعوب نحو التغيير ستكون قد عرفت اعتماد منظومة السنن الاجتماعية في بناء المستقبل، وقَدَرَت على الاستجابة للتحديات بنجاح.
– البعض يتهم التاريخ الإسلامي بأن دور الشعوب فيه كان عديم الأثر أو قليل الجدوى.. ما رأيكم؟
تاريخنا الإسلامي مُتْرَع بثورات الشعوب وقدرتها على التغيير و على إلغاء هذه السلالة الحاكمة أو تلك وإقامة حكم جديد. وبإلقاء نظرة سريعة عن منظومة الدول والإمارات التي شهدها هذا التاريخ والتي جاوز عمرها المائة والثلاثين، يتبّين ذلك.
هنالك، ما يمكن تسميته بالأممية الإسلامية التي شهدها هذا التاريخ. لقد مُنحت كل الشعوب والجماعات- التي انضوت تحت مظلة هذا الدين- فرصتها في الحياة والتحقق والتعبير عن الذات. لقد كان المجال مفتوحاً بمعنى الكلمة، حيث سُمح حتى للعبيد والمماليك أن يواصلوا الصعود إلى فوق ويشكلوا دولاً، بل إن غير المسلمين أنفسهم مُنحوا حقهم المشروع في المجالين الديني والمدني على السواء. فليس ثمة يهودي أو مسيحي أو مجوسي أو بوذي أو صائبي لم يجد الطريق مفتوحًا أمامه لتعبير عن ذاته وقدراته، وممارسة حرياته الدينية، وأخذ موقعه المناسب في نسيج الحياة الاجتماعية أو دوائر الإدارة والمال.
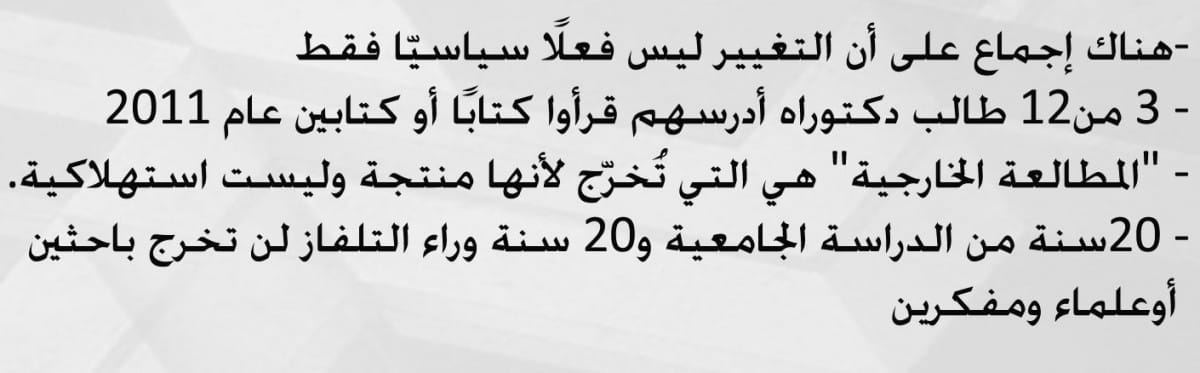
إن هذه الأممية انفتحت على سائر صيغ التعددية العرقية والدينية والمذهبية واللونية والطبقية، فلم تَبنِ إزاء أي منها سدًّا أو تحول بينها وبين الصعود. وهي أممية تختلف في أساسها عن الأممية الماركسية التي سعت- ابتداء- وبحكم قوانين التنظير الصارمة إلى إلغاء التنوع ومصادرته، وإلى تحقيق وحدة قسرية ما لبثت أن تأكد زيفها وعدم القدرة على تنفيذها تاريخياً، فيما حدثتنا عنه ( هيلين كارير دانكوس ) الخبيرة الفرنسية في شؤون الاتحاد السوفييتي في كتابها ( القوميات والدولة السوفياتية ).
وبمجرد إلقاء نظرة على خارطة الاتحاد السوفييتي حتى قبل حركة البريسترويكا، والرفض المتصاعد الذي جوبهت به الأممية الماركسية من قبل حشود الأقوام والشعوب التي تنتمي إلى أصول وبيئات متنوعة، ومقارنة هذا بما شهده التاريخ الإسلامي من تبلور كيانات إقليمية متغايرة في إطار وحدة عالم الإسلام وثوابته وأهدافه المشتركة؛ تتبين مصداقية المعالجة الإسلامية لهذه المعضلة ودور الشعوب الفاعل في ذلك كله.
– “التغيير ليس فعلاً سياسيّا فقط”.. كيف تقرأون تلك العبارة من زاوية “شروط النهضة”؟
تحدّث المفكرون الإسلاميون عبر العقود الأخيرة كثيراً عن هذه المسألة، التي بدأها مالك بن نبي – رحمه الله- في (شروط النهضة) وجملة أعماله الفكرية. ويمكن الرجوع كذلك إلى مؤلفاتي: التفسير الإسلامي للتاريخ. مدخل إلى الحضارة الإسلامية. الوحدة والتنوع في تاريخ المسلمين. ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز. نور الدين محمود: الرجل والتجربة.
فهناك إجماع على أن التغيير ليس فعلاً سياسيّا فقط، وإنما هو جملة من الشروط النفسية والسلوكية والاجتماعية والفكرية والأخلاقية، الواجب توافرها في أية جماعة تسعى إلى التغيير.
لقد بحثت في الفصل الرابع من كتابي (مدخل إلى الحضارة الإسلامية) المعنون بـ (واقع الحضارة الإسلامية ومستقبلها) في جملة من العوامل الضرورية لإحداث النهضة، أو التحقق بالتغيير. في سياقاتها الفكرية والثقافية والإعلامية والتربوية والتعليمية والعلمية والحضارية والإنسانية. وخلصت إلى القول بأن عقيدة الإسلام ومقاصده لهي الإجابة على قلق العالم الحديث الذي يصنعه ويقوده النموذج الغربي. هذا النموذج الذي إن كان له أن يتباهى بما صنعت يداه فليس له إلاّ أن يشير إلى العلم والتقنية اللتين بلغ بهما – والحق يقال- مرتقى صعبًا.
ولكن حتى ها هنا، حيث لا يمكن للعلم أو التقنية أن ينفردا بمصير الإنسان بعيدًا عن ارتباطاتها بفكرة ما، بفلسفة أو عقيدة تؤطر حركتها وتربطها بالإنسان نفسه، وتمنحها المعنى والهدف والمغزى. حتى ها هنا كان الإسلام وحده يمكن أن يمنحنا الجواب. إن رجاء جارودي، المفكر الفرنسي، يتساءل في كتابه المعروف (وعود الإسلام): “ماذا يستطيع الإسلام أن يقدم لنا ليعدنا للإجابة على المسؤوليات التي تفرضها قدرة العلم والتقنية على جميع البشر اليوم؟”، وما يلبث أن يجيب: “أن المشكلة كونية ولا يمكن للجواب إلاّ أن يكون على المستوى الكوني والإسلام هو هذا الجواب”.
حقًّا، إن (الإسلام) والحضارة التي تعبر عنه بالضرورة ليحملان “بذور تغيير جذري على مستوى الإنسانية”.
– لماذا يبدو التاريخ الإسلامي هو الحلقة الأضعف لمن يريد إثارة الشبهات حول الإسلام؟
تاريخنا الإسلامي هو الحلقة الأضعف إذا أحلناه إلى الحلقات الأخرى: العقدية والدعوية والحضارية؛ ولكنه رغم ذلك، وبإحالته إلى تواريخ الأمم الأخرى، فإن كان ينطوي على مساحات بيضاء لا نكاد نجد عشر معشارها لدى (الآخر).
ويكفي أن نقارن بين سلوك حكامنا القدماء وطواغيتنا المعاصرين، ويكفي أن نرى ما فعلناه في الآخر عندما انتصرنا عليه، وما فعله الآخر بنا عندما تغلّب علينا؛ لكي يتأكد لنا هذا من بين عشرات الشواهد ومئاتها.
– كيف نستفيد من عمق تجربتنا الحضارية لتصحيح مسارنا نحو النهضة والتغيير؟
نحن لسنا بحاجة إلى أن نبدأ المحاولة بما يسمى “تجديد” الفكر الإسلامي.. إن هذه خطوة تالية على خطوة تأسيسية تسبقها، وتكون بمثابة حجر الزاوية في محاولة تصحيح المسار نحو النهضة والتغيير.. إنها “تفعيل” علاقتنا بالخطاب القرآني والنبوي، كما فعل الأجداد زمن تألّقهم الحضاري، وقدرتهم المدهشة على تغيير العالم وإعادة بنائه من جديد.
التفعيل أولاً قبل التجديد. بمعنى أن نعيد التحامنا الفعّال بالمطلوب القرآني والنبوي. أن نفتح عقولنا ووجداننا على هذا المطلوب، وأن نردم الخنادق العميقة التي حفرناها زمن تخلفنا الحضاري بيننا وبين الخطاب القرآني والنبوي، الذي إذا أُحسِن التعامل معه وأُصغِي إليه جيدًا؛ فإنه قدير على أن يفعل الأفاعيل.. وهذا يذكرني بمقولة المفكر الفرنسي المعروف (رجاء جارودي): “إن شهادة لا إله إلا الله قديرة، إذا أحسن التعامل معها، على أن تغيّر الجبال عن مواضعها”.
والآن، فإن منظومتنا الفكرية التي ينطوي عليها كتاب الله وسنة رسوله ﷺ تتضمن حشدًا من المفاهيم التأسيسية الضرورية في أية محاولة للتغيير.. فهل انتبهنا إليها وتحققنا بها عبر قرون انكسارنا الحضاري، وحتى الوقت الحاضر؟
ولأضرب بعض الأمثلة من بين عشرات.
منظومتنا الفكرية هي منظومة معرفية تؤكد على المعرفة وتبدأ بكلمة (اقرأ) وبعبارة {وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا} (سورة البقرة: 31).. فهل نفذّنا هذا الذي تتطلبه هذه المسألة؟
هنالك إحصائية حديثة تقول إن المواطن الغربي يقرأ في السنة الواحدة بمعدل مائتي ساعة مقابل 4 دقائق في السنة للمواطن في دول العالم العربي!! وفي تجربة خاصة: من بين 12 طالب دكتوراه أتولّى تدريسهم، ثلاثة منهم فقط قرأ الواحد منهم كتابًا أو كتابين في عام 2011م!!
ولطالما قلت لطلبتي، وردّدت القول بأن عشرين سنة من الدراسة الجامعية الملتصقة بالمقررات التلقينية وعشرين سنة أخرى من الجلوس وراء شاشة التلفاز لن تخرج باحثاً ولا عالماً ولا أديباً ولا مفكراً ولا مبدعاً.. فالذي يخرّج هؤلاء هو (الكتاب).. ما نسميه “بالمطالعة الخارجية”، ولكن أية مطالعة هذه؟ إنها المطالعة المنتجة وليست الاستهلاكية. المطالعة التي تمسك بالقلم والورقة وتدخل في حوار جاد مع الكتاب.. وكما يقول العقاد: فإن قراءة كتاب واحد خمس مرات، أفضل من قراءة خمسة كتب!!
منظومتنا الفكرية تقوم على قاعدة التوحيد. فهل سرت مفاهيم التوحيد في شرايين حياتنا المعاصرة؟
منظومتنا الفكرية تقوم على المنهجية: ربط الأسباب بالمسببات. التأكيد على قوانين الحركة التاريخية. ومنهج البحث الحسّي التجريبي الذي اكتشفه ونفذه الأجداد بقوة الإضاءات القرآنية. فهل التزمنا بهذا كلّه؟
منظومتنا الفكرية تدعو إلى إعمال العقل المسلم في الكتلة.. إلى إدراك أسرار فيزياء العالم والكشف عن طاقاته المذخورة وتوظيفها. إن هناك في كتاب الله سورة بكاملها تحمل اسم (سورة الحديد) تنتهي في مقاطعها الأخيرة بهذه الآية {وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} (سورة الحديد: 25). فهي إذن ضرورات تسخير الحديد لأغراض السلم والحرب، وعندما يتحدث القرآن عن الحديد فإنه يقصد خامات الأرض جميعًا. فلماذا ارتخت أيدينا عن هذا كلّه فأعطينا الفرصة “للآخر” ولم نتحرك نحن ابتداء. فها هو ذا النفط الذي مُنح معظمه لجغرافية عالم الإسلام. ها هو ذا على بعد أمتار قليلة من قشرة الأرض. فلماذا لم نبذل نحن الجهد المطلوب لاستخراجه وتركنا ذلك للغربي الذي قال أحد فجّارهم يومًا، وحاشا لله: “لقد أخطأ الله بوضع النفط في أيدي أمة لا تستحقه وجئنا نحن الغربيون لكي نستخرجه ونستثمره فنصحح الخطأ”!!
منظومتنا الفكرية تقوم على مبادئ التسخير والاستخلاف والاستعمار بدلالته اللغوية وليست الاصطلاحية {هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}(سورة هود: 61) بمعنى أن هذا الدين وضعنا بالضرورة في قلب مثلث الفعل الحضاري: عالم سُخّر لنا، نحن الذين استخلفنا عليه، من أجل أن نبنيه ونعمره ليكون البيئة الصالحة لعبادة الله، بمفهومها الحضاري وليس الطقوسي أو الشعائري المحدود، حيث يصير كل فعل يمارسه المسلم عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه. فأين نحن الآن من هذا كله؟