كيف نفهم التاريخ؟ ” رؤية الإنسان للتاريخ تعبر عن رؤيته للكون، ودراسته هى دراسة لرؤى الكون”[1] التاريخ هو قصة الإنسان على الأرض، تقول الأسطورة: “إنّ الذين يمسحون آثار أقدامهم يموتون مبكّراً ” لذا اهتم القرآن بالتاريخ، وكان القصص أحد محاوره الكبرى، فلم تكن القصة غايتها السرد، وإنما أخذ العبرة والعظة لاصلاح حركة الإنسان في حاضره ومستقبله.
والتاريخ ليس اجترارا للماضي، بقدر ما هو إبصار للمستقبل، يقول “ول ديورانت” في كتابه “قصة الحضارة”:”إن من شاء أن يتنبأ بالمستقبل فعليه أن يرجع إلى الماضي؛ لأن الأحداث البشرية تُشابه دوما أحداث الأزمنة الماضية” ومن ثم فهو مرحلة تمهيدية لفهم علم السياسة، “، وحذر الشاعر “رسول حمزاتوف” من إهمال التاريخ، فقال: “إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك”.
صانع هـوية
في كتابه ” “تناقضات المؤرخين” The Historians’ Paradox لـ”بيتر تشارلز هوفر”، استوقتني مجموعة من الأفكار حول دور التاريخ في صناعة الهوية، منها: أنه لا يوجد بشر بلا تاريخ، وبدون التاريخ لن تكون هناك هوية، وأن مهمة التاريخ هي صنع الحياة، فهو أكبر من تمضية الوقت، والمؤرخ الحقيقي فاعل في الحاضر والمستقبل، وليس شخصيا يرغب في إعادة تشييد الماضي.
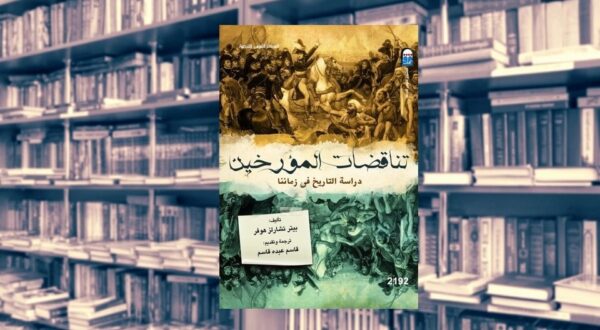
لكن الكتاب أشار إلى مسألة أخرى، وهي قدرة التاريخ على إحداث تأثير في الواقع، وضرب لذلك عدة أمثلة .
من الحكاية إلى التحليل
التاريخ من العلوم الحديثة، إذ كان يُنظر إليه في السابق على أنه غير مرغوب فيه، وانصرف الاهتمام إلى الفسلفة، على اعتبار أن التاريخ يُحيل إلى الذاكرة، أما الفسلفة فتحيل إلى العقل، واستمر التاريخ هامشيا في واقع الإنسان، لكنه أخذ يسترعي أنظار المفكرين والباحثين، وبعض الفلاسفة مثل “نيتشه” الذي كان يعيب على الفلاسفة اهمالهم للتاريخ، واصرارهم على رؤية الثبات في مسار التاريخ الإنساني رغم أن الواقع شديد التغير.
كان “نيتشه” يرى أن التاريخ ضرورة وعقبة في ذات الوقت، وأن بعض الشعوب مصابة بـ”مرض التاريخ”، وحذر من الحضور الطاغي للتاريخ لأنه يضرّ بالحياة، ويضعف الشخصية الفردية والجماعية ، لذا أصدر عام 1874م كتيبا بعنوان ” محاسن التاريخ ومساوئه ” عندما لاحظ أن مفكري عصره أصبحوا أسرى للتاريخ، عندما دفنوا رؤوسهم في الماضي، ورأى أن تلك الحالة تحول كل معرفة حية نضرة إلى كيان ذابل ميت، فـ”تخمة التاريخ تقتل الإنسان”، بل إن “نيتشه” أبدى إعجابه بنص للمسيح عليه السلام:” دع الموتى يدفنون موتاهم..واتبعني”.
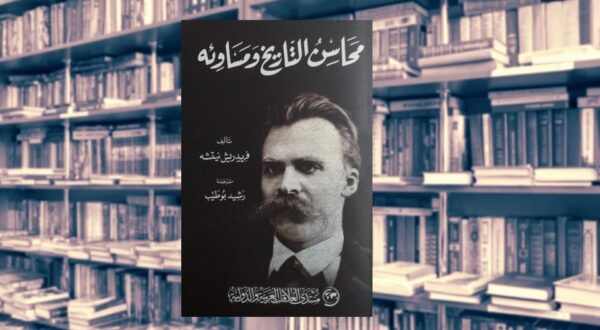
والواقع أن المؤرخ لا ينطلق في تحليله من فراغ ، ولكن تلعب المؤثرات دورا في تشكيل وعيه، ورؤيته للتاريخ، والتاريخ إما أن يخضع للسرد أو التحليل، وإما أن يكون حكاية أو استلهاما، لذا سعى البعض من المؤرخين المحدثين إلى النظر للتاريخ نظرة موضوعية تحليلية وقراءة الحضارات، للوصول إلى محددات يمكن من خلالها فهم المسار الإنساني، ومن ذلك المؤرخ الشهير “أرنولد توينبي” الذي درس بعمق أكثر من عشرين حضارة، وانتهى إلى نظريته “التحدي والاستجابة“، وقال: ” الحضارة تموت بالانتحار، لا بالقتل” أي أن عوامل انهيار الحضارة تنبع من داخلها، حتى ولو كان الخارج شديد القسوة، فقدرة الحضارة على الاستجابة للتحدي الخارجي يكفل لها الاستمرار، لكن الطريف في تلك النظرية أن “توينبي” استلهمها من عالم النفس السويسري ” كارل جوستاف يونج”.
لكن ما يعنينا في الموضوع أن النخبة هي القادرة على الاستجابة للتحدي الذي تواجهه الحضارة ، فإذا استلهمت التاريخ بطريقة خاطئة، فإن استجابتها ستكون خاطئة ومخيفة، بل ومدمرة، والدليل على ذلك النخب التي استلهمت الأفكار العنصرية والنازية والفاشية، فإنها أعادت قراءة التاريخ من منظور عنصري.
وحتى لا يكون التاريخ عائقا للحاضر والمستقبل من الضروري التعامل معه وفق الرؤية السُننية: فالإنسان قادر على تغيير مجتمعه من خلال إدراكه للقوانين والسنن التاريخية، وكذلك تجاوز منهجية السرد والحكي، فالتاريخ ليس حكايات للتسلية، أو فضول لمعرفة أخبار السابقين، ولكن علم تؤخذ منه العبرة ، وهو ما حث عليه القرآن الكريم في قوله تعالى:” لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ [2] ، فالقراءة التحليلية المُعتبرة للتاريخ تتيح التوصل إلى العلل، ومعرفة عوامل القوة والسقوط والتتابع، وتحدد الأخطاء وكيفية تلافيها، وهي تقي من الأمراض الحضارية، وتتيح السير للمستقبل بوعي.
التعامل مع التاريخ يجب أن يشبه تعامل الشخص الذي يعبر الطريق، فهو ينظر خلفه حتى لا تأتي سيارة مسرعة تصدمه، فالتاريخ التفات لا معايشة، نظرة فاحصة سريعة لا استحضار دائم، وكما يقول توفيق الحكيم :”الماضي منصة للقفز لا أريكة للاسترخاء “، ومن يحمل التاريخ فقط دون النظر للمستقبل تتعثر خطاه، ويعيد إنتاج صراعات الماضي وأزماته، أو كما يقول محمد اقبال في قصيدته “حديث الروح” :
أمسيت في الماضي أعيش كأنما** قطع الزمان طريق أمسي عن غدي
[1] عبارة للدكتور عبد الوهاب المسيري
[2] سورة يوسف: الآية 111

