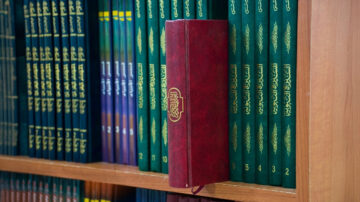“قال الشافعي: فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها، على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها. وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه عن آخره. وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه. وعاما يراد به الخاص. وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره. فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره.
وتبتدئ الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره. وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها فيه عن أوله.
وتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ، كما تعرف الإشارة، ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به، دون أهل جهالتها. وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة”. (الرسالة،51 ـ 52).
افتتح الإمام الشافعي رحمة الله عليه في رسالته القول في أهمية الرجوع إلى اللسان العربي في فهم القرآن الكريم، غير أن من أتوا بعده لم يتابعوا ما أشار إليه كما لاحظ الإمام الشاطبي ذلك وهو بصدد الحديث عن إثراء مفهوم معهود العرب وتسييج القرآن به سورا ينفي عنه تحريف المبطلين يقول الشاطبي :“والذي نبه على هذا المأخذ في المسألة هو الإمام الشافعي في رسالته الموضوعة في أصول الفقه، وكثير ممن أتى بعده لم يأخذها هذا المأخذ فيجب التنبه لذلك”
ما الذي لم ينتبه له العلماء الذين جاءوا بعد الإمام الشافعي واقتضى من الشاطبي أن يتوقف عنده مليا؟
ما فات العلماء في تنبيه الشافعي أنهم قصروا مسألة اللسان العربي، ومعهود العرب على قضايا جزئية، كمسألة الألفاظ الأعجمية في القرآن الكريم، وهذا خطأ جسيم في نظر الشاطبي ذلك أن مسألة اللسان العربي أو معهود العرب في الخطاب لا تقتصر على المفردات وإنما هي إطار عام ينبغي أن تفهم في ضوئه مفردات القرآن الكريم، وأساليبه وطرائقه العامة في النظم والتعبير أو قل هي سياق لغوي يؤطر فهم “ نظام القرآن الكريم” بتعبير الفراهي.
أولا: معهود العرب وأمية الشريعة عند الشاطبي
يقول الشاطبي: إن القرآن أنـزل عربيا وبلسان العرب وكذلك السنة إنما جاءت على ما هو معهود لهم ومعنى ذلك أن القرآن عربي في ألفاظه ومعانيه وأساليبه، وأنه يجب على من أراد أن يفهم القرآن الكريم أن يسلك في الاستنباط منه، والاستدلال به، مسلك كلام العرب في تقرير معانيها ومنازعها في أنواع مخاطباتها، فكما أن لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب، كذلك لا يمكن أن يفهم لسان العرب من جهة لسان العجم.
ولا يكتفي الشاطبي رحمة الله عليه بتقرير معهود العرب بل يعززه بمفهوم آخر هو مفهوم أمية الشريعة يقول: “الشريعة التي بعث بها النبي الأمي، ﷺ، إلى العرب خصوصا وإلى من سواهم عموما إما أن تكون على نسبة ما هم عليه من وصف الأمية، أو لا. فإن كان كذلك فهو معنى كونها أمية أي منسوبة إلى الأميين، وإن لم تكن كذلك لزم أن تكون على غير ما عهدوا، فلم تكن لتنـزل من أنفسهم منـزلة ما تعهد، وذلك خلاف ما وضع عليه الأمر فيها، فلا بد أن تكون على ما يعهدون والعرب لم تعهد إلا ما وصفها الله به من الأمية” ويضيف في ضوء هذه النتيجة “إنه لابد في فهم الشريعة من اتباع الأميين، وهم العرب الذين نـزل القرآن بلسانهم”.
ما الذي جعل الشاطبي يركز على هذين المفهومين ويقف عندهما؟
اهتمام الشاطبي بتقرير هذين المفهومين إنما جاء في مسعاه للرد على منحيين خاطئين في فهم القرآن الكريم:
- الأول: منحى الصوفية الذين يدعون أن بالإمكان فهم مقاصد القرآن الكريم لا من خلال فهم مفرداته وأساليبه وتراكيبه، كما فهمها العرب الذين نزل عليهم أول مرة بل من خلال عملية استبطان وحدس تلبس ظواهر القرآن معاني وتخرصات نفسية لا قبل للغة القرآن الكريم بها. وقد ذكر الشاطبي في كتابه الاعتصام، نماذج من تأويل الصوفية كتأويلهم النهي عن قربان الصلاة أثناء السكر بالقول إن المقصود بالسكر :الغفلة، وبالجنابة :إفشاء الأسرار، وبالاغتسال: التوبة، ونماذج أخرى يجمع بينها الخروج عن استعمال العرب ومعهودهم.
- الثاني: منحى بعض الناس الذين تجاوزا في الدعوى في القرآن الحد فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين والمتأخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق وعلم الحروف وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها”. ويرد الشافعي هذا المنحى بأن السلف الذين كانوا أعرف بالقرآن ما تكلموا سوى عن ما بث فيه من أحكام التكاليف وأحكام الآخرة.
وأمثال الذين كانوا يبالغون في احتواء القرآن على كل العلوم اليوم: أصحاب المبالغة في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم.
ثانيا: معهود العرب ونظام القرآن الكريم عند الفراهي
كيف نعرف معهود العرب والحال أن مئات السنوات تفصلنا عنهم؟
لم يطرح الإمام الشاطبي -على ما يبدو- هذا السؤال على نفسه! ولكن عالما آخر من علماء الهند تناول مفهوم معهود العرب تحت مسمى كلام العرب القديم قد تصدى لهذا السؤال وبين أن معهود العرب اللغوي لا تتأتى معرفته من خلال كتب اللغة المدونة وحدها “لأنها كثيرا ما لا تأتي بحد تام ولا تميز بين العربي القح والمولد، ولا تهديك الى جرثومة المعنى فلا يدري ما الأصل وما الفرع، وما الحقيقة وما المجاز، فمن لم يمارس كلام العرب واقتصر على كتب اللغة ربما لم يهتد لفهم بعض معاني كتاب الله”.
ولا يمكن لعلوم النحو والبيان وحدها أن تسعف كثيرا في فهم القرآن، “فلا ينبغي للمفسر أن يبالغ في تطبيق كلام الله بأصول النحو، فيرممه، ويؤوله، فيظن أنه جائر عن قصد السبيل، بل عليه أن يأتي بشهادة من أشعار العرب وخطبهم، ذلك أن من يجمد على علم البيان يدب في فهم القرآن كالنمل ويخبط كالأعمى.
ما السبيل إذن إلى معرفة معهود العرب أو كلام العرب القديم؟
يذهب عبدالحميد الفراهي إلى أن معرفة معهود العرب اللغوي لا تتأتى إلا من خلال عملية استقراء للقرآن الكريم نفسه، ولما وصل إلينا من كلام العرب بشعره ونثره. أما ضرورة استقراء أساليب القرآن من القرآن الكريم وتراكيبه وطرائقه في التعبير فلأنه” أوثق ما يستند به على أساليب كلام العرب فإنه متواتر نقلا ولا يساويه شيء من كلامهم حتى القصائد المشهورة فإنها قلما نجت من شوب الانتحال.
وقد ” أجمع أهل التأويل من السلف إلى الخلف أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وأنه أوثق تعويلا وأحسن تأويلا، فنقول كما أن القرآن يفسر مطالب آيته بعضها ببعض، فكذلك يدلك على نظام مطالبها ومناسبتها، بما يأتيك بنظائره، فتكثر الشواهد على رباط أمر مع أمر، وبذلك يحثك على التأمل في جامع وصلة بينها، ثم يأتي عليه بأمثلة كثيرة بعضها أوضح من بعض، حتى يتدرج بك على ما كان أدق وأغمض”
القرآن هو المصدر الأول لمعرفة معهود العرب إذن، أما المصدر الثاني لمعرفة معهود العرب المقيد لفهم معاني القرآن الكريم فيتمثل في استقراء ودراسة ما وصل إلينا من كلام العرب القديم في خطبهم وأشعارهم، فمن خلاله يتأتى لنا فهم مفردات القرآن وأساليبه وطرائق نظمه المتعددة، وقد اكد الفراهي أن السبب الرئيسي في التأويل الخاطئ للقرآن من جهة واستشكال نظام بعض آياته وطرائقه في الترتيب والتعبير من جهة أخرى، إنما يعود بالدرجة الأولى إلى الجهل بكلام العرب القديم بمنثوره ومنظومه.
الإضافة التي يقدمها الفراهي لمفهوم معهود العرب عند الشاطبي تتجلى في كونه توسع في شرح هذا المفهوم وأهميته في العصمة من الزيغ في تأويل القرآن الكريم وبين أثره في فهم المفردات والأساليب والتراكيب وقدم عليه أمثلة كثيرة وحاول أن يقوم بتطبيقه في تفسيره نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان الذي وافته المنية قبل أن يكمله.
ثالثا: أهمية معهود العرب في الدرس القرآني المعاصر
أغلب الذين يحرفون القرآن الكريم اليوم من المستشرقين والحداثيين العرب غاية تحريفهم ومآله إنما يرتد في ركن أساسي منه إلى الخروج على سنن العرب ومعهود لغة القرآن الكريم، وإن كان يتوسلون بوسائل تأويلية جديدة يختلف ظاهرها ويتفق باطنها ومغزاها البعيد مع التحريفات التي تصدى لها الشاطبي والفراهي من خلال مفهوم معهود العرب ونظام القرآن الكريم.
ويمكن أن نضرب مثالا لأخطر نظريتين في تحريف القرآن الكريم الأولى: نظرية محمد شحرور المعروف في العالم العربي ، والثانية : نظرية القراءة السريانية الآرامية للكسمبرج المعروفة في نطاق الدراسات الغربية والاستشراقية للقرآن الكريم، وما يجمع بين هاتين النظريتين اللتين تسعيان إلى تحريف فهم القرآن الكريم هو الاتفاق على الخروج على معهود العرب ومحاولة تأسيس فهم (تحريف) جديد للقرآن الكريم لا يتوسل بمعهود العرب، إما من خلال توظيف بعض النظريات اللسانية والأدبية الحديثة كما يفعل شحرور، وإما من خلال توظيف الفيلوجيا التاريخية كما يفعل لوكسمبرج.
وهذا ما يجعل من قراءة مفهوم معهود العرب وفهم نظام القرآن الكريم سدا منيعا ينفي عن القرآن الكريم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين من الحداثيين والمستشرقين.