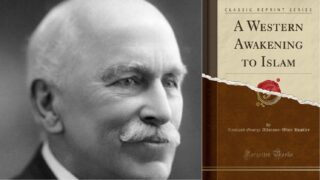اختلفت الصورة المنظورة للنبي ﷺ في العالم الآخر، الغرب البيزنطي واللاتيني، وسادت صورة قاتمة عن الدين الجديد الذي خرج من أعماق الصحراء ليقضُم الأراضي الواحدة تلو الأخرى، وليدخل الناس في دين الله أفواجا.
ومن المقطوع به لدينا بأن البشارات بالنبي الخاتم توالت في الكتب المقدّسة كلها، فكلها بشّر به، ويكفي أن نتلور قوله تعالى : ﴿الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناؤهم وإنّ فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون﴾ [البقرة، 146]، وأخر رسول من بني إسرائيل وهو عيسى بن مريم عليه السلام جاء مبشرا به: ﴿وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدّقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد﴾ [الصف، 6]
وفي الحديث أن هرقل ملك بيزنطة عندما آتاه كتاب النبي ﷺ كاد يسلم لولا خوفه على ملكه، ولكنه راسل صديقه القسيس ضغاطر متبينا جلية الأمر، فأخبره الحقيقية، وقد أسلم ضغاطر وشهد شهادة الحق، ولكنّ سيوف الروم الأرثدوكس لم تتحمل اهتدائه، فقطعوه إربا، وارتفع إلى ربه شهيدا (1).
هكذا كان الرد الدموي الأول من الكنائس الشرقية، فكيف واجهت بقية الكنائس صعود الدين الإسلامي، وصدح مآذنه بالنبي الخاتم؟
الحقيقية أن أغلب المكتوبات والمرويات التي شكلت المخيال الأوروبي في العصور الوسطى والحديثة صنعتها الكتابات المسيحية والتي جافت نقل الواقع، وكانت ركاما من الاتهامات والتقولات والأكاذيب تتغيا بناء سدود نفسية تقف حائلا أمام المعرفة بالنبي الخاتم والإسلام الهادي، ولكن تلك السدود سرعان ما تهاوت بفعل الاحتكاك الواقع في الحروب الصليبية، وفي التثاقف الحاصل في صقلية وحواضر الأندلس الغناء.
من المعلوم أن أولى الافتراءات المسيئة كانت بالشام من بعض الكتابات التي لم ترج أيامها، والتي تنسب ليوحنا الدمشقي، والذي اشتهر بمناظراته للمسلمين في موضوع القدر، وله “رسائل إلى شرقي” اتهم فيها النبي بالكذب والخداع.
ومع الهيمنة الكبرى للإسلام على أراضي الشرق وشمال إفريقيا لم تكن هناك مكتوبات موثقة تنال من النبي الخاتم، نتيجة العدل الإسلامي الذي وجد فيه أهل الذمة من النصارى كل الحياة الكريمة والصون للدماء والأعراض وممارسة الشعائر، ولم يتعدّ الأمر بعض المهارشات التي تندفع بين حين وآخر من بعض العوام، والتي سجلتها بعض المدونات الفقهية والقضائية فيما عرف بانتقاص قدر المصطفى، ومن ذلك ما لابس قضية تأليف ابن تيمية لكتابه” الصارم المسلول على شاتم الرسول” أو السبكي أيضا في “السيف المسلول على من سب الرسول”.
أما الأمر فكان على العكس من ذلك في الديار الأوروبية التي رامت كنائسها القيام بعمل مضاد تجاه الإسلام الذي طوقها شرقا من الأناضول، وغربا من الأندلس، ولذلك فإنه وبعد خسارة أوروبا لحروبها الأولى مع المسلمين أطلقت من عقالها حملة لتشويه الإسلام والمسلمين، وذلك بدفع بعض القساوسة للكتابة ضد الإسلام ونبيه الخاتم.
بدأ الأمر عملا معرفيا مضادّا للأطروحات العقدية الإسلامية كما قال بطرس الجليل (1156م)، (2):” يجب أن نقاوم الإسلام لا في ساحة الحرب، بل في ساحة الثقافة…ولإبطال العقيدة الإسلامية يجب التعرّف عليها، وأنه سواء وصفنا الضلال المحمدي بالنعت المشين (بدعة)، أو بالوصف الكريه (وثنيّة) فإنه لابد من العمل ضدّه، لابد من الكتابة ضدّه”. ومن المعروف أن بطرس الجليل كان راهبا بدير كلوني بفرنسا، وزار لأندلس، وأشرف على أول ترجمة للقرآن الكريم إلى اللاتينية سنة (1143م). قام بها روبرت الرتيني الإنجليزي وهرمان الدلماشي الألماني، وراهب إسباني مستعرب، ونشرت بعد أربعة قرون في مدينة بال السويسرية، وهي أول ترجمة للقرآن الكريم في أوروبا القرون الوسطى.
كما انتشرت في أعقاب الحروب الصليبية وانكسار المشروع البابوي موجة من الكتابات المشينة ضد القوى الإسلامية المنتصرة، وتصاعدت هذه الحملة المليئة بالأكاذيب والافتراءات بعد فتح العثمانيين للقسطنطينية ووصولهم إلى قلب أوروبا بعد حصار فيينا سنة (1529)، وتكاثف في الترويج الدعائي لها الكاثوليك والبروتستانت في المواعظ والمناسبات والأحفال الكنسية، ثم ازدادت انتشارا بظهور الطباعة وشيوع المنشورات، وتزامن ذلك مع اشتداد الغزوات الصليبية البحرية التي أشعل نارها فرسان القديس يوحنا الذين هالتهم فتوحات العثمانيين في رودس والبلقان، وظاهرهم في تلك الغارات والقرصنة وقطع طرق البحر جمهوريات إيطاليا الصاعدة، وكذا الإسبان والبرتغال بعد نجاحهم في حروب الاسترداد وطرد المسلمين من الأندلس.
ففي أواسط القرون الوسطى كان المسلمون يوصفون في المخيال الأوروبي بأنهم: وثنيون، كفار، سراسنة، المور(3) وفي أوائل العصر الحديث برزت ألقاب أخرى: الكفار، الأتراك، الوثنيون، وأما نبينا محمد ﷺ فقد نالته شتى أفانين الافتراء والبهتان من كونه: زنديق، مهرطق، محتال، دجال، وثني، استطاع بدجله أن ينشئ نسخة مشوهة عن المسيحية شأنه شأن الهراطقة والسحرة والمجدفين الذين كانت الكنيسة تتبّعهم بالحرق في كل أوروبا.
واسمه الذائع بينهم هو “ماهوميت” أو ” مماد” كما هو اللقب المستعمل عند القشتاليين الإسبان (4)، ومما شاع أن محمد هو معبود المسلمين، ولذلك كانوا يوصفون بالمحمدين بدل المسلمين في عديد الكتابات الجدلية.
وفي الأدب التصويري نقرأ في الكوميديا الإلهية، لدانتي (1321م) استجابة لتلك التصورات الأوربية الشائنة والشائهة، وذلك عندما يضع دانتي النبي ﷺ والصحابي علي بن أبي طالب في إحدى حفر الجحيم.
وإذا انتقلنا من الحظيرة الكاثوليكية إلى البروتستانتية فالصورة لا تختلف كثيرا، فالإصلاحي مارتن لوتر ورغبة منه في سحب بساط الزعامة من بابا روما فقد غالى في العداء، وانسابت من لسانه كلمات مقذعة في حق المسلمين والنبي ﷺ، وقد زاوج بين خطتين هما:
الأولى: ترجمة القرآن الكريم، فجريا على نزعته في تقريب اللاهوت للناس ترجم الإنجيل إلى الألمانية، والأمر ذاته بالنسبة للقرآن، حيث قال:” لقد استيقنت أنه لا يمكن عمل شيء أكثر إزعاجا لمحمد أو الأتراك، ولا أشد ضررا من ترجمة قرآنهم ونشره بين المسيحيين، عندئذ سيتضح لهم أي كتاب بغيض وفظيع وملعون هذا القرآن المليء بالأكاذيب والخرافات والفظائع”.
وكانت تلك المرافعة من لوثر بعد أن حضرت مدينة بازل ترجمة السويسري يوحنا أوبورين سنة (1542م)، وطبعه لترجمة لاتينية إيطالية للقرآن، فتدخل لوتر وضغط بأذرعه البروتستانتية القوية في سويسرا للسماح بنشر الترجمة.
الثاني: الحملة الممنهجة لتشويه النبي ﷺ، وذلك في عديد من النشريات والمطبوعات، وكانت الغاية هي حشد التأييد لحركته الإصلاحية واعتبارها بديلا للكاثوليكية التي عجزت عن مدافعة الزحف العثماني في البحر المتوسط وشرق أوروبا، حيث اعتبروا اللوثوريون والكالفنيون شتم النبي ﷺ وسيلة لإغاظة الأتراك الذين وقفوا على أسوار فيينا، واقتربت خيولهم من حدود الأمة الجرمانية، حيث كانت المواعظ الكنسية تقول:” بعد ظهور الأتراك على حقيقتهم، أرى أن القساوسة عليهم أن يخطبوا الآن أمام الشعب عن فظائع محمد حتى يزداد المسيحيون عداوة له، وأيضا ليقوي إيمانهم بالمسيحية، ولتتضاعف جسارتهم وبسالتهم في الحرب، ويضحوا بأموالهم وأنفسهم” ومما فاضت به مطبوعاتهم بأن محمدا “خادم العاهرات، وصائد المومسات”، ويأتي فولتير ممثل عصر الأنوار فيؤلف مسرحية” محمد التعصب”، ويخاطب البابا بأنه” كتبها معارضة لمؤسس طائفة دينية كاذبة وبربرية” ويملئها بالأكاذيب في مناقضة غريبة لمنهجية عصر الأنوار، ويؤلف جون بوجيت مسرحية” محمد النبي المزيف” ويزعم بأنه مات وقد أكلته الخنازير ، إضافة إلى عديد الكتابات التي ناهضت الكنيسة، ولكنها بقيت أسيرة لها في مقالتها تجاه الإسلام ونبيه الكريم (5).
إن تلك المغالطات والأكاذيب في المخيال الأوروبي الوسيط والحديث ربما تكون معذورة لارتهانها بحالة العداء وضعف النشر وتراجع مقارنة الأديان في عالم لا يرى الخلاص إلا في الكنيسة أو الإلحاد، ولكن استمرار ذلك في الثقافة الأوروبية ويمينها المتوسط والمتطرف يوجب مسآلة اللياقات العقلية التي خرقت الذرة واكتشفت المجرة، ولكنها عجزت عن معرفة الآخر معرفة عادلة، ولعل الأمر يرجع إلى مسالك نفسية تسدّ المدى والرؤية، أي مسالك الجحود والاستكبار، وتلك محنة أخرى، ﴿ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين﴾[ النمل، 14].
مراجع:
(1) ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ترجمة (2568)
(2) نجيب العقيقي: المستشرقون، ج1 ص112/ الموسوعة العربية الميسّرة، ج2 ص1374.
(3) أصل كلمة المور لاتينية أي سكان شمال إفريقيا، ومنها جاء كلمة الموريسكيين، وكلمة المغرب (maroc)، وعند وصول الإسبان للفليبين في حملة ماجلان (1521م) وجدوا المسلمين فسموهم بالمور. ومنه جبهة مورو المعاصرة.
(4) محمد عبد الله عنان: نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة، 1966، ص 333.
(5) علي الشامي: الحركة الصليبية وأثرها على الاستشراق، مجلة الفكر العربي،ع (31-32)، 1983.