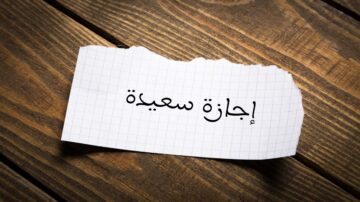إجازة نهاية الأسبوع من الموضوعات المعاصرة التي أصبحت حاضرة في الفكر الإسلامي والمستجدات المتعلقة بالمدنية والحضارة ونظام الحياة العام، بما في ذلك المناسبات الحديثة. وقد أوليت اهتماما خاصا بهذه القضايا، فكتبت عددا من الدراسات والمقالات في هذا المجال، من أبرزها:
- المناسبات وأثرها في التدين
- العلاقة الجدلية بين “الدين والتدين” والحياة المدنية والحضارة
- هل وحدة المسلمين في المناسبات الدينية مطلب شرعي؟
أما هذا البحث الذي بين أيدينا، فيتناول بالتحليل والنقد موضوع إجازة نهاية الأسبوع ، في محاولة لتسليط الضوء على هذه القضية من منظور فكري واجتماعي متوازن.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم إجازة نهاية الأسبوع باعتبارها ممارسة اجتماعية وتنظيمية في المجتمعات المعاصرة، مع استقراء جذورها في النصوص الإسلامية والسيرة النبوية للتأصيل لها. تبيّن النتائج أنّ العطلة الأسبوعية ليست شعيرة دينية محدّدة، وإنما هي نظام إداري مدني يتكيف مع ظروف الزمان والمكان، بينما يبقى البعد التعبّدي متمثلاً في شعائر محدّدة، كصلاة الجمعة. ويؤكد البحث على ضرورة التمييز بين الثابت الشرعي والمتغير التنظيمي، مع إبراز دور الاجتهاد المؤسسي في تطوير أنماط العمل والإجازات بما يحقق المصلحة العامة.
أصبحت إجازة نهاية الأسبوع جزءًا أصيلًا من بنية الحياة اليومية والأنظمة الإدارية في الدول الحديثة، سواء في المجتمعات الإسلامية أو غيرها. ومع ذلك، قد يثور جدل فقهي واجتماعي حول ما إذا كانت هذه الإجازة ممارسة تعبّدية شرعية أو نظامًا تنظيميًا مدنيًا. تكمن أهمية هذا النقاش في أنّ الخلط بين المجالين يؤدي إلى تصورات مغلوطة قد تؤثر في اللوائح التعليمية والاقتصادية.
ينطلق المقال من سؤال محوري: هل إجازة نهاية الأسبوع ممارسة تعبدية تستمد قدسيتها من النصوص، أم أنها تنظيم إداري مدنيّ يخضع للاجتهاد والمصلحة؟
أولا: أصل قدسية ومفهوم الإجازة والعيد في الديانات الثلاثة
- اليهودية ويوم السبت : يحتل يوم السبت مكانة مركزية في اليهودية باعتباره يوم الراحة المقدّس الذي أمر الله به بني إسرائيل. فقد ورد في سفر التكوين (2:2-3) أن الله “استراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمله، فبارك الله اليوم السابع وقدسه”، (سبحانه) وهو أصل تشريع السبت. كما أكّد سفر الخروج (20:8-11) –ضمن الوصايا العشر– ضرورة حفظ هذا اليوم وعدم القيام بأي عمل: “اذكر يوم السبت لتقدسه… لا تعمل عملاً أنت ولا ابنك ولا ابنتك…”، فجُعل السبت عهدًا أبديًا بين الله وشعبه. وبذلك صار السبت يومًا للراحة الكاملة والتفرغ للعبادة والتأمل، ويُعدّ من أهم التشريعات الملزمة في الحياة الدينية اليهودية.
- المسيحية ويوم الأحد: أما المسيحية فقد ورثت فكرة “اليوم المقدس للراحة”، لكنها ربطتها بقيامة المسيح في اليوم الأول من الأسبوع (الأحد). ولذلك اعتبر المسيحيون الأوائل الأحد “يوم الرب”، بديلاً عن السبت اليهودي، يومًا مخصصًا للعبادة والراحة الروحية. ويشير العهد الجديد إلى ذلك في سفر أعمال الرسل (20:7) حين اجتمع التلاميذ “في أول الأسبوع” لكسر الخبز، وكذلك في رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس (16:2) حيث دعا إلى تخصيص اليوم الأول من الأسبوع للعطاء. ومن هنا أصبح الأحد لدى المسيحيين يومًا للراحة والامتناع عن الأعمال الدنيوية، على غرار السبت في اليهودية، لكنه مرتبط بقيامة المسيح وبداية العهد الجديد.
- الإسلام ويوم الجمعة: تجدر الإشارة إلى أن قدسية يوم السبت في الديانة اليهودية واتخاذه يوم راحة، وكذلك قدسية يوم الأحد في المسيحية واتخاذه عيدًا وإجازة، لها إشارات في النصوص القرآنية والحديثية تؤيد ما ورد في الفكر الديني اليهودي والمسيحي، غير أن المجال هنا لا يسمح بالتوسع في بيانها.
هذا، وقد جعل الإسلام يوم الجمعة يومًا عظيمًا مميزًا، له خصوصيته الدينية ومكانته الروحية البارزة. فقد ورد في القرآن الكريم: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ } (الجمعة: 9–10). وقد صح عن النبي ﷺ قوله: “خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها…” (رواه مسلم).
إلا أنّ الفكر الديني الإسلامي لم يشرّع الجمعة كيوم إجازة أو راحة عامة عن العمل كما السبت في اليهودية أو الأحد عند النصارى، وإنما يوم عبادة وعيد وشهود الجمعة والجماعة، تتجلى فيه خطبة الجمعة وصلاة الجماعة، بينما يبقى العمل فيه مشروعًا قبل الصلاة وبعدها. ولذلك فإن اتخاذه يوم عطلة أسبوعية في المجتمعات الإسلامية المعاصرة هو اجتهاد تنظيمي لا نص فيه، بخلاف السبت في اليهودية والأحد في المسيحية.
ثانيا: الإطار الشرعي: قراءة في النصوص وممارسات السلف الأوائل من الصحابة والتابعين والجيل الأول في تعظيم يوم الجمعة
عند تحليل النصوص الشرعية، نجد أن القرآن الكريم والسنة النبوية أكدا على تعظيم يوم الجمعة باعتبار أن يوم الجمعة تفرد به المسلمون، ولأنه يوم صلاة جامعة، ولمزايا الكثيرة الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية، دون أن يفرضا تعطيلًا كاملاً للأعمال. قال تعالى:
“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ…” (الجمعة: 9-10).
إذ تشير هذه الآيات إلى ثلاث نقاط أساسية:
- الانقطاع المؤقت عن العمل والتجارة لحضور الصلاة.
- عودة النشاط الاقتصادي والاجتماعي بعد انتهاء الصلاة مباشرة.
- غياب الإلزام بتعطيل كامل للأعمال طوال اليوم.
وقد كان المجتمع النبوي مجتمعًا منتجًا، يعمل الصحابة في مهنهم قبل الصلاة وبعدها. فالنبي ﷺ، وصحابته، والخلفاء الراشدون لم يضعوا نظام عطلة أسبوعية، بل ظل العمل مستمرًا في جميع الأيام مع مراعاة أوقات العبادة. هذا يعزز فكرة أن تعظيم الجمعة لا يعني تعطيلها إداريًا بالكامل.
ثالثا: الإطار التاريخي والاجتماعي .. نشأة مفهوم الإجازة الأسبوعية
تاريخيًا، يُعتبر مفهوم العطلة الأسبوعية الكامل حديث النشأة. فقد بدأ ظهوره مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي رافقت الثورة الصناعية في أوروبا، ثم انتشر عالميًا نتيجة توسع المؤسسات الاقتصادية والتعليمية وتطور القوانين العمالية.
اعتمدت أوروبا الأحد عطلةً رسميةً متأثرة بالثقافة المسيحية. وانتقلت هذه الممارسة إلى الدول الإسلامية مع نشوء الدولة الحديثة والاحتكاك الحضاري.
يلاحظ أن بعض الدول الإسلامية مثل ماليزيا تعطل يومي السبت والأحد، وتداوم الجمعة. وبعضها تعطل الجمعة والسبت.
ورد في الموسوعة العربية العالمية أنه ليس هناك عطلات خاصة بالبنوك في الدول العربية، عدا عطلات نهاية الأسبوع المعتادة، والتي تختلف بين بعض الدول؛ ففي مصر مثلاً تكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وتونس السبت والأحد، والسودان الجمعة فقط، أما السعودية وبعض دول الخليج فيوم الجمعة.
هذا، وقد أُعيد تنظيم أيام الإجازة في بعض هذه الدول لتصبح الجمعة، أو الجمعة والسبت، أو السبت والأحد، وفق مقتضيات إدارية واقتصادية.
وقد يوضح أن الإجازة الأسبوعية نظام اجتماعي واقتصادي، وليس نظامًا تعبديًا، ويخضع لاجتهاد الدولة وتوافق المجتمع.
رابعا: البعد المدني والتنظيمي
تنظيم أوقات العمل والإجازات يتأثر بالاعتبارات التالية:
1. التشريعات العمالية: حماية حقوق العمال وتحديد ساعات العمل الأسبوعية.
2. الأنظمة التعليمية: تنظيم دوام المدارس والجامعات وفق لوائح دولة ما.
3. التنظيم الاقتصادي: توافق أوقات العمل والإجازة مع مسمى الأسواق العالمية.
4. البنية الاجتماعية: تسهيل التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية.
ولعل هذه العوامل كلها مباحة شرعًا، ما دام لا يترتب عليها تعطيل للعبادات أو إضرار بمصالح الناس. والسمة الكبرى لهذه العوامل هي مسمى التمدن والتحضر أو المدنية وبناء الحضارة.
خامسا: جدلية قدسية يوم الجمعة بين البعد الشرعي والتنظيم الإداري
يرى بعض العلماء أن يوم الجمعة يحمل منزلة شرعية خاصة، وهو ما دفع العديد من المجتمعات الإسلامية إلى اعتماده عطلة رسمية أسبوعية. إلا أن آخرين يؤكدون أن تحديد العطلة أمرٌ مدني تنظيمي بحت، لا يدخل في دائرة التعبد المحض، ومن ثم لا ينبغي إضفاء القداسة على القرار الإداري أو التنظيمي، بل يُنظر إليه من زاوية المصلحة العامة. هذا التوجه ينسجم مع القاعدة الأصولية المعروفة: “الأصل في الأشياء الإباحة“، كما يتفق مع فقه الموازنات الذي يراعي تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، ويوازن بين الثابت والمتغير في حياة الناس.
وقد جاء في موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة عند الحديث عن مظاهر الصحوة الإسلامية في طاجكستان ما نصه: “ومن مظاهر الصحوة الإسلامية في طاجكستان: إعادة يوم الجمعة ليصبح هو العطلة الأسبوعية بدلاً من يوم الأحد.” هذا النص يبين أن ربط الإجازة بالجمعة جاء استجابة لروح الشريعة وإحياءً لخصوصية هذا اليوم في الإسلام، باعتباره يوم اجتماع وعبادة، مما يؤكد رأي من يرى أن له منزلة شرعية خاصة تبرر جعله عطلة.
ويؤيد هذا ما ورد في كتاب المسلم بين الهوية الإسلامية والهوية الجاهلية للدكتور محمود الذوادي، في مقال بعنوان: كيف استهدف العهد البورقيبي الهوية الإسلامية في تونس؟ حيث قال: “لقد ارتبطت أيام العطل بالهوية الدينية للأفراد والجماعات في العديد من الثقافات والشعوب. فيوم الأحد هو يوم الراحة الأسبوعية للشعوب المتدينة بالديانة المسيحية… أما يوم الراحة الأسبوعية بالنسبة للشعب اليهودي فهو يوم السبت.. وإن العديد من اليهود أفرادًا وجماعات يحترمون على الأقل بعض الطقوس الدينية المقترنة بيوم السبت في الديانة اليهودية كالامتناع عن سياقة السيارات والخياطة بالنسبة للنساء اليهوديات والقيام بالتسوق والشراء. أما يوم الجمعة فهو يوم العطلة الأسبوعية الرسمية لكل المجتمعات العربية ذات الأغلبية المسلمة في المشرق والمغرب العربيين.”
النص يؤكد أن اختيار يوم العطلة يعكس هوية الشعوب الدينية والثقافية، فاختيار الجمعة في المجتمعات الإسلامية ينسجم مع الهوية الإسلامية، دون أن يلزم أن يكون له حكم تعبدي محض، بل هو من باب المصلحة العامة والرمزية الحضارية.
ومن الذين لا يرون أن قدسية الجمعة تتنافى مع اتخاذها إجازة، الرئيس الباكستاني الأسبق محمد ضياء الحق، حيث نشر له في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة خطابًا بعنوان: خطوات لتطبيق نظام الإسلام، جاء فيه:
وفي الوقت الذي أفضل فيه شخصيًا أن تكون العطلة الأسبوعية يوم الجمعة؛ فإنني لا أعتقد أنه من الضروري أن تغلق كافة المؤسسات والأقسام الحكومية والمصانع والحوانيت والشركات التجارية يوم الجمعة، وربما يكون من المناسب –بغض النظر عن المكاتب الحكومية– أن تنظم كافة المؤسسات الأخرى أعمالها الأسبوعية بصورة يضمن استمرار نشاطات العمل خلال كافة أيام الأسبوع، وعندما يحين وقت صلاة الجمعة فلا بد أن تغلق كافة الحوانيت ومراكز الأعمال استنادًا إلى التعليمات الإسلامية.
النص يوضح التوازن بين خصوصية الجمعة كمنزلة شرعية وبين اعتبارات المصلحة والتنظيم المدني؛ فالجمعة لا يلزم أن تكون عطلة شاملة، لكن المهم أن تُصان شعيرة الصلاة، مما يؤيد الرأي القائل إن العطلة قرار إداري مدني لا يحمل بذاته قداسة شرعية.
سادسا: أثر الإجازة الأسبوعية في السلوكيات الاجتماعية
تغيير يوم الإجازة لا يؤدي بالضرورة إلى تغييرات جوهرية في العادات. فأنماط الترفيه والتواصل العائلي قد تتأقلم بسهولة مع أي نظام جديد. وهذا يؤكد الطبيعة المدنية المتغيرة للإجازة، مقابل ثبات العبادات في أوقاتها الشرعية. ويُلاحظ أن أنماط السلوك الاجتماعي لا تتغير جذريًّا بتغير يوم الإجازة. فإذا اعتاد الناس الاجتماع مساء يوم الاثنين، وتناول الطعام في ساعة معينة، وممارسة الرياضة في أوقات محددة، فإنهم غالبًا سيستمرون في هذه الأنماط الزمنية حتى لو انتقلت العطلة إلى يوم آخر. هذا يوضح أن الإجازة الأسبوعية مرتبطة بالتخطيط المدني أكثر من ارتباطها بالشعائر الدينية، بينما تبقى العبادة مرتبطة بزمانها المحدد في الشرع، كصلاة الجمعة أو الصلوات اليومية
سابعا: تحديات الحياة المعاصرة وأثرها على الاجتهاد الفقهي
في ظل مستجدات العصر، تغيّر نمط الحياة الاجتماعية عن ما كان عليه قبل نحو 1400 سنة، دون أن يطرأ أي تغيير على جوهر الدين نفسه. ومن الملاحظ أن غالبية هذه التغييرات تتعلق بمفهوم “المباحات”، حيث اتسعت دائرة المباح لتشمل العديد من جوانب الحياة اليومية. ونتيجة لهذا الانتشار، ظهرت تبعات جديدة على نظم العمل، والإجازات السنوية، والإجازات المرضية والطارئة، والمراحل الدراسية، والترقيات، والفترات الزمنية بينها، وغيرها من التنظيمات الاجتماعية.
وتبرز هنا مسألة كيفية التعامل مع هذه المستجدات: هل نعترف بها ونتكيف معها، ونضع لها فتاوى معاصرة تستجيب لمقتضيات العصر، أم نعيد النظر في كل شيء من نقطة الصفر، سعياً لبناء مجتمع إسلامي مختلف كليًا عن هذه المباحات المتكاثرة التي كادت أن تطغى على الحياة الإسلامية؟
ولعل من هذا المنطلق يمكن فهم موقف بعض العلماء المعاصرين، (مثل سيد قطب)، الذي لم يشأ إصدار أحكام محددة في مثل هذه القضايا، ولم يفضل تداول الفقهاء مصطلح “الفتاوى المعاصرة”، سواء في مسائل البنوك أو غيرها، بل رأى أن على الأمة أن تبني حضارة تنطلق من ثوابت الشريعة وروح الدين.
أخيرا، تُظهر هذه الدراسة أن إجازة نهاية الأسبوع، كما تُمارَس اليوم، هي نظام مدني إداري أملته تطورات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وليست شعيرة دينية أو رمزًا تعبديًّا. أما الجمعة، فهي يوم عبادة محدد الوقت، لا يتعارض مع استمرارية العمل. ومن ثمّ، فإن الخلط بين النظام الإداري والعبادة يؤدي إلى سوء فهم، ويُعطل النظر الفقهي الصحيح القائم على الموازنة بين الثابت الشرعي والمتغير المدني. ويُوصى بزيادة الوعي بهذا التمييز لتجنب تحويل القرارات التنظيمية إلى أحكام دينية غير ثابتة.